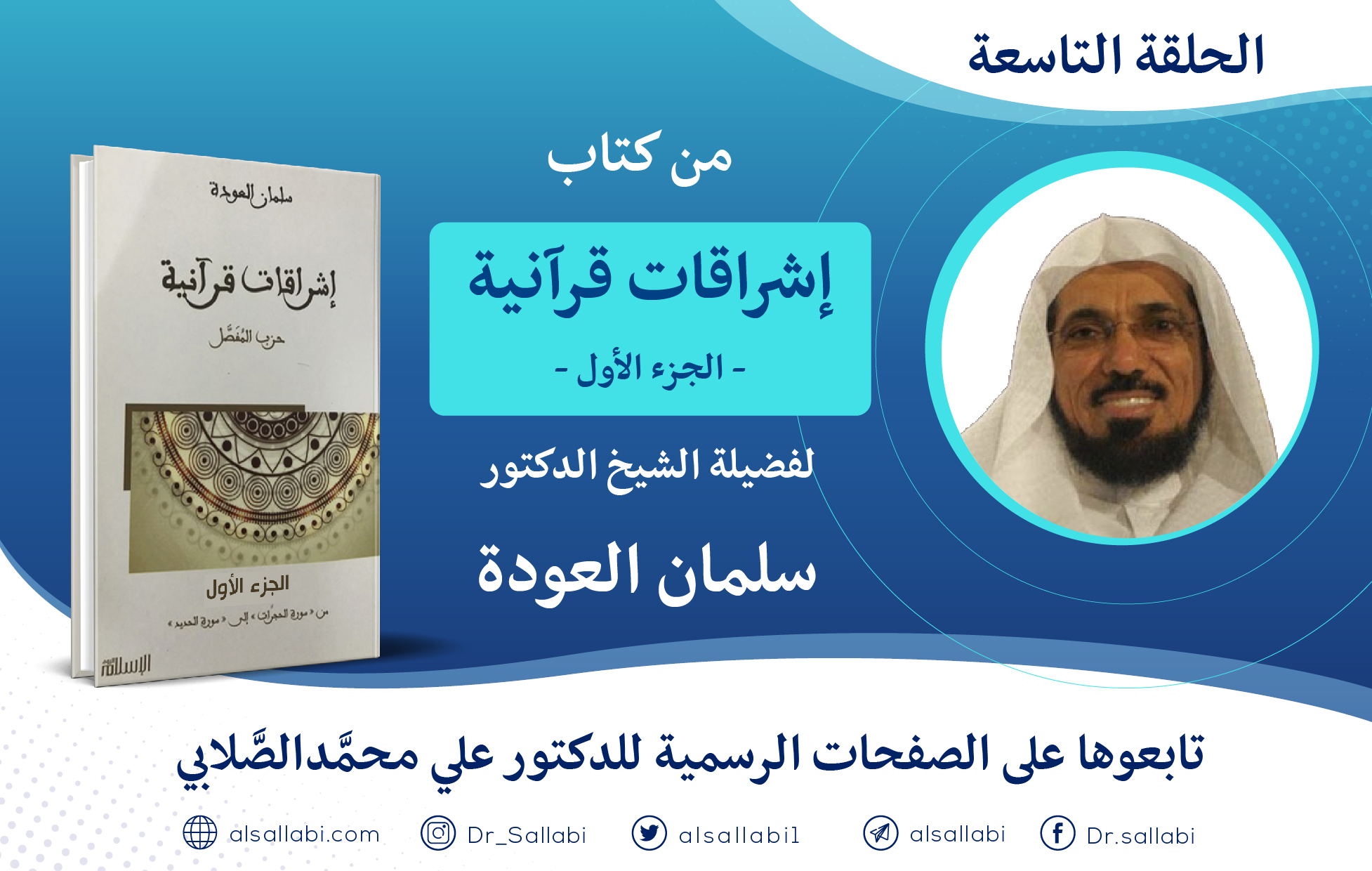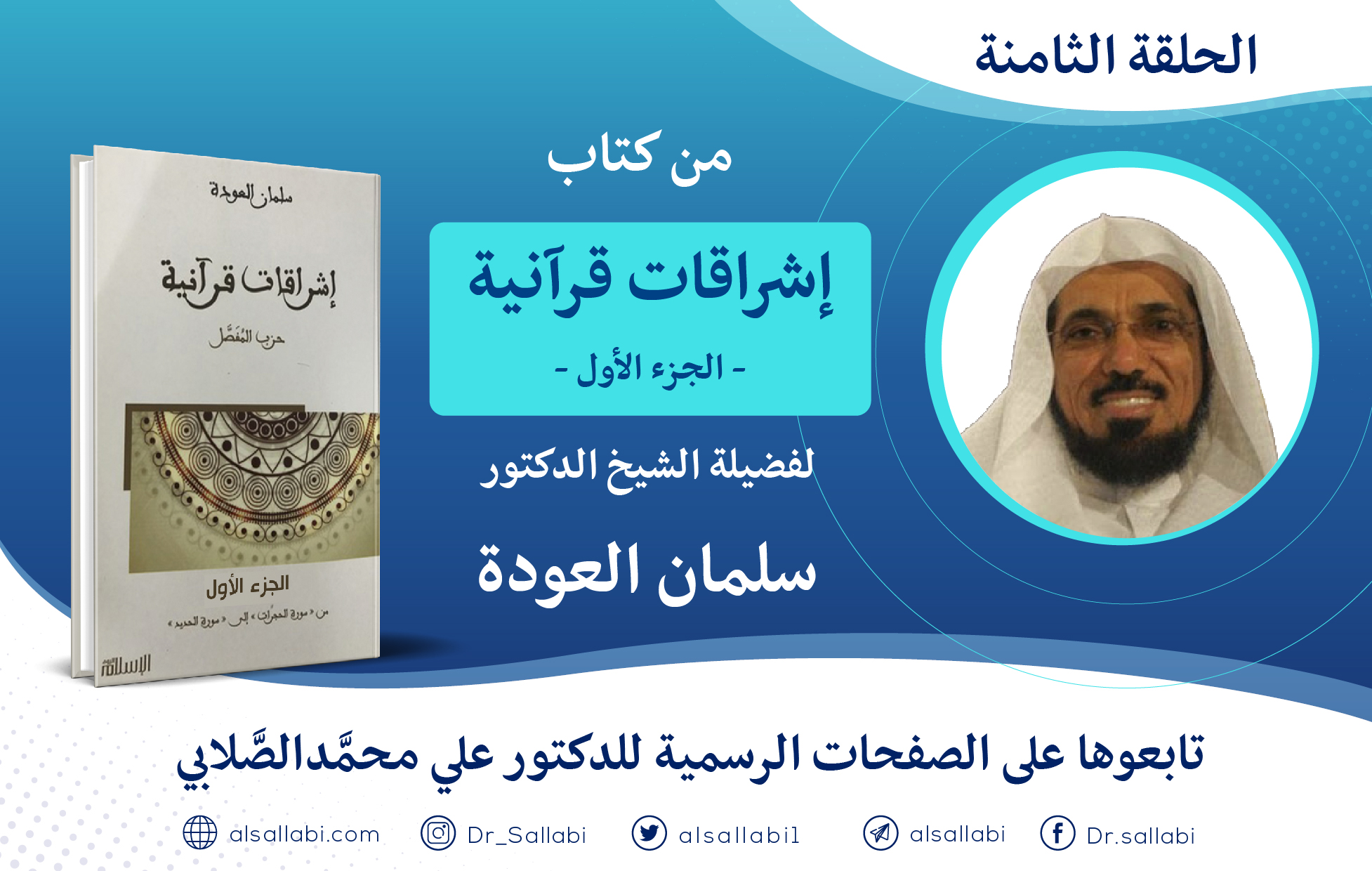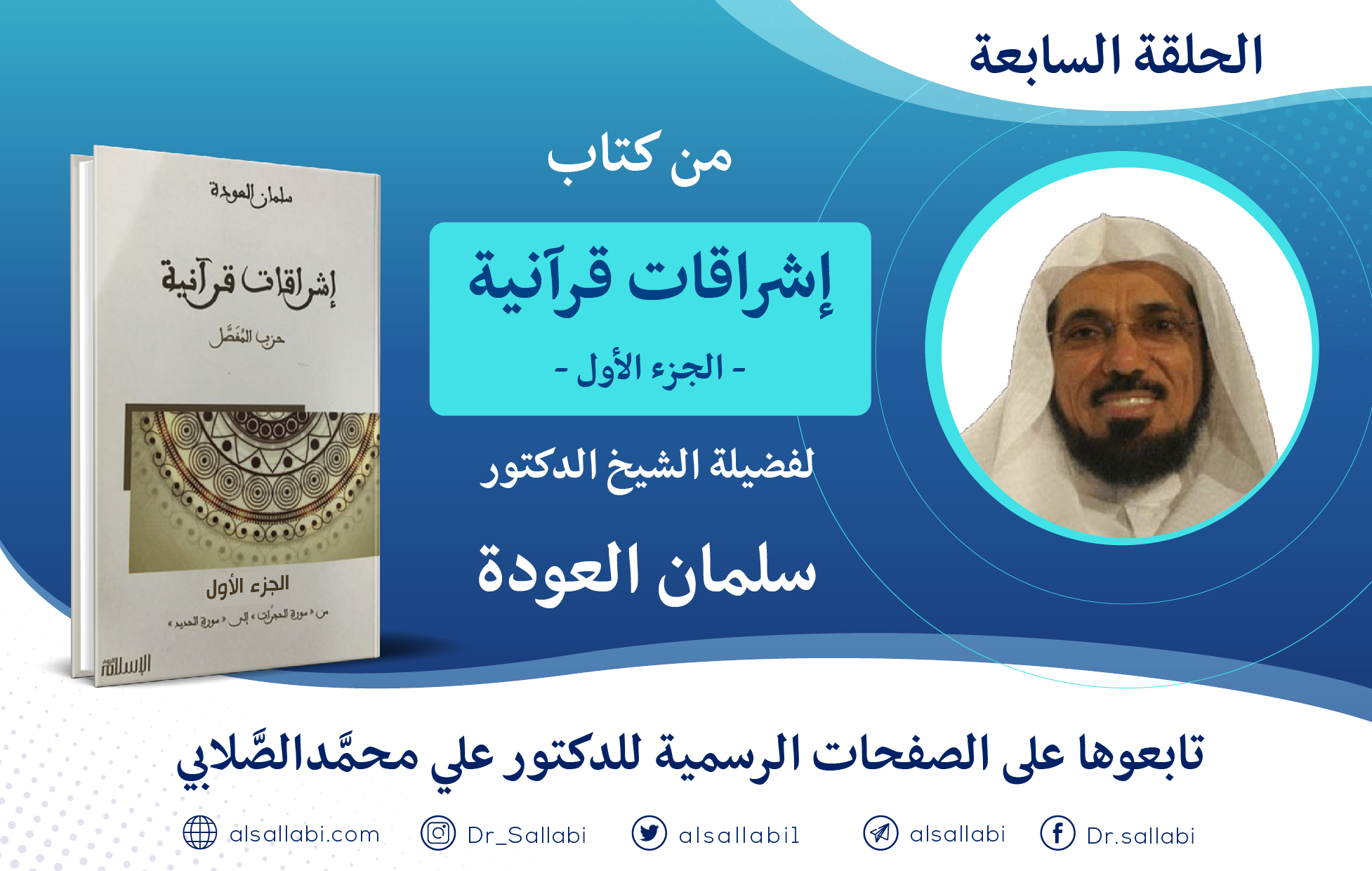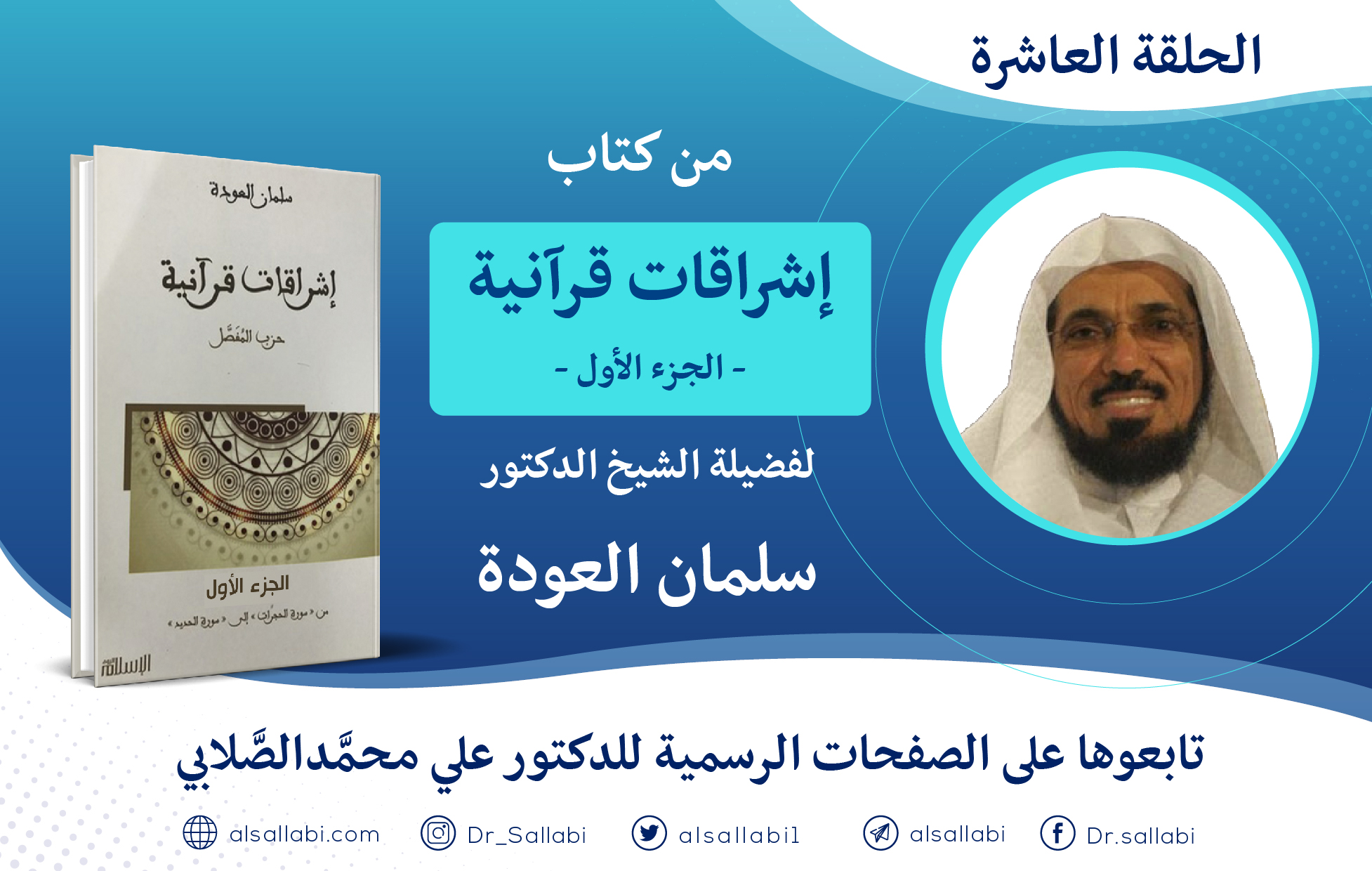من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة النجم)
الحلقة التاسعة
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الأول 1442 هــ/ نوفمبر 2020
• ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: 32] :
بعد ما وصفهم بالإحسان، الذي يعني: فعل الحسنات، في مقابل الذين أساؤوا بفعل السيئات، وصفهم ثانيًا بالتجنب والترك للكبائر والفواحش.
والترك بحدِّ ذاته لا يعتبر إحسانًا، إنما الإحسان الأصلي بالفعل، ولكن الاجتناب من آثار الإحسان، ثم فيه تعمد الترك ومجاهدة النفس مع الرغبة الفطرية في الميل لبعض ذلك.
وفيه أيضًا النية الحسنة ومراقبة الباري جل وتعالى والخوف منه، فبذلك يصبح الترك فعلًا، وتتمحَّض النفس للخير والطاعة وتتوحَّد وجهتها.
و ﴿كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ [النجم: 32] تعني: الذنوب العظيمة، كالسبع الموبقات الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «اجْتَنِبُوا السبعَ الُمُوبقات». قيل: يا رسولَ الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشركُ بالله، والسِّحْرُ، وقتلُ النفس التي حرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحقِّ، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الرِّبا، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحف، وقذفُ الُمُحصنات الغافلات المؤمنات».
وقد سُئل ابنُ عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: «هي إلى السبعينَ أقربُ».
وهي: الذنوب العظيمة التي تُوبق صاحبها، وقال تعالى مصداقًا لهذه الآية: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: 31].
ومن العلماء مَن ضبط حدَّ الكبائر بما له حدٌّ في الدنيا، كالسَّرقة، والزِّنا، وقتل النفس، والقذف.
ويندرج فيها: ما تُوُعِّد عليه بلعن أو وعيد في الآخرة، كقوله تعالى في شأن الكذب على الله: ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: 61]، وكذلك الرِّشْوة: «لعنَ اللهُ الرَّاشي والُمُرْتَشي». وأشياء ورد عليها اللَّعن في القرآن الكريم، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعلَّق بهذا الذنب عقوبة منصوصة في الآخرة أو في الدنيا دلَّ على أنه من كبائر الذنوب.
وقد يقع للمرء تردد في بعض الذنوب بين كونها كبيرة أو ليست بكبيرة، وحينئذ عليه أن يتذكر مقولة بعض السلف: «لا تنظرْ إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى مَن عَصَيْتَ».
بل ليتذكَّر قوله صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكُم ومُحَقَّرات الذنوب؛ فإنما مَثَلُ مُحَقَّرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهم، وإن مُحَقَّرات الذنوب متى يُؤْخَذْ بها صاحبُها تُهْلِكْهُ».
وكان بعض السلف يقول: «لا صغيرةَ مع الإصرار، ولا كبيرةَ مع الاستغفار».
وهذا لا يصح حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له معنى جيد.
والمعنى: أن الذنب الصغير إذا أدمن العبدُ عليه وأكثر منه، فإنه يُوجِد في القلب وحشة، وجُرأة على المعاصي، كالشاب الذي يتساهل بإطلاق النظر، ومحادثة النساء، ويقضي في ذلك الساعات الطوال، فلا يزال الأمر به حتى يُجرِّئه ويُغْرِيه ويغرس في قلبه حب الزنا، وكل شيء يمهِّد لما هو أشد منه، ما لم يكن المسلم يقظًا.
وكذلك في قوله: «لا كبيرة مع الاستغفار» ليس على إطلاقه؛ فقد جاء في أحاديث صحيحة كثيرة عن بعض الفضائل التي تكفِّر الذنوب؛ كحديث: «مَن حجَّ لله، فلم يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ، رجعَ كيوم ولدتْهُ أُمُّه». وقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاة التي بعدها، كفارةٌ لما بينهما- قال- والجمعةُ إلى الجمعة، والشهرُ إلى الشهر- يعني: رمضانَ إلى رمضانَ- كفارةٌ لما بينهما». إلى غير ذلك من الأحاديث.
وفي بعض الأحاديث ورد اشتراط «اجتناب الكبائر» لاستحقاق الوعد، كما في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق.
ومال بعض أهل العلم إلى أن العمل الصالح يُكفِّر بعض الكبائر، إذا توفَّرت الأسباب؛ كأن يكون عند العبد انكسار تام لله، وأن يأتي بالعمل على أكمل وجه في أسبابه ومقدِّماته وأحواله، ولا يخالطه شيء من الإعجاب أو الغرور أو الغفلة، فربما يكون هذا سببًا في توبة العبد إلى ربه، وإقلاعه عن الذنب، وتخفيف الذنب أو التكفير، وفضل الله تبارك وتعالى واسع.
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عبد البر وابن تيمية وابن رجب وغيرهم.
وأما ﴿اللَّمَمَ﴾ فيشمل شيئين:
الأول: الذنوب الصغار المنصوص على تحريمها، ولذلك مثَّل له بعض العلماء بالقبلة والغمزة والضَّمَّة والنظرة، فهي داخلة في دائرة المحرَّم، ولكنها ليست من قَبِيل «الفواحش»، بل من قَبِيل المقدِّمات والممهِّدات التي قد تفضي إلى ما هو أشد منها.
وقد ورد في «الصحيحين» قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أصابَ من امرأة قبلةً، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلك له، فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114]، فقال رجلٌ من القوم: يا نبيَّ الله، هذا له خاصةً؟ قال: «بل للناس كافَّةً».
فعلى مَن ابتلى بهذه الذنوب أَلَّا ييأس من رحمة الله؛ فاليأس خطره أعظم، وقد حذَّر سبحانه من اليأس من رحمة الله: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87]، و ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: 56]، وأن يجعل قلبه معلَّقًا بالله؛ يرجو رحمته، ولا يغتر بعمله، ولا ييأس من رحمته، وأن يكثر الدعاء، والعمل الصالح؛ كالمبادرة إلى الصلاة، وصحبة الأخيار، والاستغفار، وبر الوالدين، والصدقة، والإحسان إلى الزوجة والأولاد والجيران، فالميزان له كِفَّتان، وإن أنت ابتُليتَ بشيء من هذه القاذورات فاجتهد في التوبة، وأكثر من الطاعة؛ عسى أن ترجح كِفَّتها على كِفَّة الذنوب، وعسى أن تكون سببًا في توبة الله ومغفرته لك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحَكِيم بن حِزام رضي الله عنه: «أسلمتَ على ما أَسْلَفتَ من خير». ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: 17]، فالله تعالى يصطفي للتوبة الذين يعلم رغبتهم في الخير، ونفرتهم من الشر، وحبهم للخلاص.
الثاني: المرور العابر، ومنه تقول: أَلَمَّ بالمكان، أي: مرَّ عليه مرورًا سريعًا، وقال القائل:
إنْ تَغْفِرِ اللَّهمَّ تَغْفِرْ جَمَّا *** وأيُّ عَبَدٍ لكَ لا أَلَمَّا
فالمقصود هنا بـ ﴿ﮣ﴾: إلمام سريع لم يتحوَّل عنده إلى عادة أو إدمان، بل كانت زلَّة قاهرة وسقطة عابرة أفاق بعدها وندم وتاب وأناب، وهذا شأن ذنوب المقرَّبين والسابقين، حتى ربما حمل أحدهم الذنب على الاستزادة من الصالحات وقهر النفس على الطاعات والقربات، وربما وقع المؤمن في الذنب؛ لكنه لا يقيم عليه، وإنما يُسرع النهوض والخلاص، ويستنجد بالله، ويتحرَّر من أسبابه.
﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾: وما أحسن التعرف إليه سبحانه بأسمائه الحُسنى التي معظمها يدور على الرَّحْمة، فمن أسمائه: الرَّحْمن، الرَّحِيم، الغفور، التَّوَّاب.. وليس من أسمائه: الباطش، ولا المُعَذِّب، ولا شديد العقاب، فهذا على القول الراجح ليس من الأسماء الحسنى، وإنما أسماء الله الحسنى هي التي فيها الرَّحْمَة، والبِرُّ، واللُّطف بالعباد؛ ترغيبًا وتحبيبًا لهم أَلَّا تغلبهم نفوسهم الأَمَّارة بالسوء، أو شياطينهم على الإصرار على الذنب، أو اليأس من التوب.
﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾: فهو أعلم بكم قبل أن تكونوا، وهو أعلم بكم يوم أن كنتم ﴿أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ ، أو مواليد صغارًا، لا يوجد هوى في نفوسكم، ولا ميل ولا شهوة، ولكنها كانت كامنة لم تفعَّل بعد، لأنكم خلقتم من الأرض، ففيكم ثقلة الطين وداعي الهوى ومركب الشهوة والميل والغريزة، ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾: فلا تقولوا عن أنفسكم ما يزكِّيها من الادِّعاء، وإنما عليكم التواضع لله سبحانه، وهذا خطاب للفرد أَلَّا يندفع في ادِّعاء لا يتناسب مع حقيقته، أو يتظاهر بما ليس فيه؛ فيجمع بين المعصية الباطنة والكذب الظاهر؛ فإنه ربما أورث الذنب تواضعًا وازدراءً بالنفس، وحمى صاحبه من الكِبْر أو الاغترار أو التعاظم، ما دام يعرف أن الذنب ذنب، وأنه عاصٍ مستحق للعقاب، إلا أن يتجاوز الله عنه.
كما يدخل في هذا النهي أن تزكِّي قبيلة نفسها، أو عِرْق، أو شعب بمثل هذه الدعاوى العريضة، كما كان اليهود والنصارى يقولون: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: 18] ، ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة: 111]، فتتحوَّل بذلك الديانة عصبيات قومية وعِرْقية وقَبَليَّة، وهو سبحانه ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: 32].
* ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ [النجم: 33-34]:
نزلت هذه الآيات في شأن رجل معيَّن، قيل: الوليد بن المغيرة، همَّ أن يُسلم، وقدَّم شيئًا من الخير، وكاد أن ينقاد للهُدى، ثم نكس على عقبه، فالله يُوَبِّخه وأمثاله، على أنه أعرض بعد ما اقترب، ولم يغتنم الفرصة التي سنحت له. ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا﴾ من الخير، أو من التوجه والاستعداد. ﴿وَأَكْدَى﴾ أي: توقَّف، والكُدْيَة هي: الصخرة، كأنه تحوَّل إلى صخرة، لا تَبِضُّ بقطرة من الماء، أو واجه صخرة من ظلمة نفسه ومجاملتها لمَن حولها وعزوفها عن الانتقال استمرارًا للحال!
• ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: 35]:
وكأنه ممن قال: ﴿وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [فصلت: 50]، وعزف عن الإيمان اغترارًا بهذا الظن الموهوم المبني على غير أساس من علم أو تقوى.
* ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: 36-38]:
وهذا التعقيب يرجِّح أنه كان ممن يزعم أن له في الآخرة مردًّا حسنًا وعقبى صالحة!
و ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأعلى: 19] كانت عشر ورقات، في كل صفحة نحو أربع آيات من جنس آيات القرآن الكريم، فهي نحو أربعين آية، وإنما ذكر موسى عليه السلام؛ لأن صُحُفه أشهر، والتوراة معروفة، وفيها كثير من البيان والهُدى، وموسى من الرسل الذين لهم أمة قائمة، وصحفهم تشمل التوراة التي أثنى عليها الله تعالى بقوله: ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: 44]، وتشمل الألواح التي فيها الوصايا العشر وغيرها.
وإنما بدأ بموسى ثم ثنَّى بإبراهيم لأجل هذا، والله أعلم، أو لأنه يريد أن يثني على إبراهيم بالمزيد، فذكر موسى إجمالًا ثم انتقل إلى الخليل ليبني على ذكره أخبارًا وثناءً بقوله: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: 37].
﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى٣٧﴾ [النجم: 37]: أي: أنجز ووفَّى بوعده، ومن ذلك: ذبحه لابنه:
﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: 102].
أما ماذا في «صحف إبراهيم وموسى» في هذا السياق؛ فهو: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: 38]، فلا يُؤخذ أحد بذنب غيره، وهذا الذي أعطى قليلًا وأَكْدَى، وظنَّ أن ثمةَ أحدًا سوف يفديه أو ينفعه، قد رَكَنَ إلى وَهْم لا أصل له في الشرائع كلها، فالله تعالى يخبره بأن هذا لا ينفعه، وهذا معنى قرآني عظيم، فيه غاية العدل، فلا يُؤخذ أحد بجَريرة غيره، ولا يُعيَّر القوم أو القبيلة بخطأ أحدهم.
وهذه معاني لا تختص بالملأ من قريش، بل هي قواعد أخلاقية دنيوية وأخروية، أَلَّا يُؤاخذ أحدٌ بجَرِيرة أحد، ولو كان أقرب قريب؛ حتى الزوجة لا تُؤخذ بذنب زوجها، ولا الزوج بذنب زوجته، ولا الابن بأبيه، ولا الأب بابنه، ولا الجار بجاره، ولا ينبغي أن نصدر الأحكام العامة على الناس؛ بناءً على سلوك فردي، فنقول: أئمة المساجد فاسدون، أو: المدرِّسون مهملون، أو: الدُّعاة منافقون، أو: الأطباء غشاشون، أو: التجار طمَّاعون.. فهذا التعميم لا ينبغي؛ لأنه لا ﴿تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
* ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]:
فمسؤولية الإنسان تقتصر على فعله، وهذا من «صحف إبراهيم وموسى»، وهو مقرَّرٌ في شريعتنا من حيث الجملة، وإن كان الله تعالى جعل في معنى «سعي الإنسان» سعي ولده، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن أطيبَ ما أَكَلَ الرجلُ من كسبه، وإن ولدَهُ من كسبه». و«إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عنه عملُهُ إِلَّا من ثلاث: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم يُنتفعُ به، أو ولد صالح يدعُو له». والحج عن المتوفَّى، والصوم عنه، والصدقة عنه.. كل ذلك ثابت في السنة، وبعض الأعمال الصالحة يصل ثوابها إن شاء الله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهذا كله لا يتنافى مع الآية الكريمة، ولا حاجة إلى أن نقول: هذا شرع مَن قبلنا، وهو منسوخ؛ لأن الله تعالى ساقه لنا في سياق الاعتبار به.
* ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ [النجم: 40]:
سوف يراه الله تعالى والمؤمنون والناس، ويُعرض يوم القيامة.
* ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم: 41]:
إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، والجزاء الأوفى تقتضي استيعاب الجزاء على الصالح وتمامه مع الفضل، والجزاء على الشيء مع العدل، وربما التسامح والعفو.
*﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: 42]:
أصح معاني الآية: أن الناس صائرون إلى الله عز وجل، فهي من الآيات الدالة على البعث.
وقيل: معناها: أن كل تفكير رشيد عاقل يوصل الإنسان إلى الإيمان بالله عز وجل وعبوديته.
*﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: 43]:
أي: خلق غريزة الضحك والبُكاء، وهذه من خصائص الإنسان، ينفرد بها دون عامة الحيوان، إلا ما ندر.
وقولنا: الحمامة تنوح على كذا، فهو على سبيل المجاز، والله خلق لبكاء الإنسان أسبابه، ولضحكه أسبابه، وفي ذلك صناعة السعادة؛ ولهذا قدَّم «الضحك» على «البكاء»، وهذه مِنَّةٌ على الناس؛ أن الحياة فيها كثير من الجماليات، وأسباب السعادة والسرور، والرضا وقرة العين، وحتى البكاء فيه معنى التنفيس والإحساس بمشاعر الآخرين، وربما بكى المرء بسبب طغيان السرور، كما قيل:
طفحَ السرورُ عليَّ حتى إنه *** من عظم ما قد سرَّني أبكاني
ومن جمالية الحياة أن نتعامل مع تغيرات الحياة بقدر من الرضا والإيجابية، والسعادة والتفاؤل، والأمل والإشراق، هذا معنى يجب أن نتدرَّب عليه، ومما يدرِّبنا عليه ذكر الله سبحانه وتعالى والتطهر والتوبة من الذنوب والمعاصي، دون أن يغلبنا معها يأس أو قنوط من رحمة الله، أو أمن من مكره سبحانه.
* ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: 44]:
فالموت والحياة له سبحانه، وذلك وفق حكمة عليا يعلمها الله وقد يجهلها الناس، والموت عبور قنطرة إلى عالم آخر، فليس فناءً محضًّا ولا عدمًا ولا انقراضًا ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [المؤمنون: 80].
* ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]:
فهذا من حكمته سبحانه، وهي عامة في الإنسان والحيوان والطير، والأقرب أن المقصود هنا: الإنسان؛ لأنه قال بعدها: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 46]، وهذا ما لا يكون للطيور، وبعض الحيوانات، فهذه النُّطْفَة من الماء الذي يُراق ويُمنى هو يتصل ببويضة المرأة، فيكون من ذلك خلق الإنسان.
والمقصود: امتنانه سبحانه على الناس بخلق الزوجية، والاستمتاع بها، وعلاقة الحبِّ والمودة والشراكة التي هي شراكة في بناء البيت، والعمل، والاقتصاد، والمشورة والرأي، والفكر والثقافة، والحياة والوفاء.
وكثير من البيوت إنما تعاني ما تعاني بسبب الأنانية وتجاهل معاناة الطرف الآخر في هذه الشراكة، مما يوجب علينا أن نعيد النظر في طبيعة العلاقة القائمة بين الزوجين.
* ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾ [النجم: 47]:
فالله الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم للنشأة الأخرى يوم القيامة، والذي قَدَرَ على أن يخلق الإنسان من عدم قادر أن يعيد خلقه يومَ القيامة، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27].
وهذه جملة مناسبة لما قبلها؛ حيث جاءت تعقيبًا على الخلق الأول لتذكِّر بالخلق الآخر يوم القيامة.
* ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ [النجم: 48]:
﴿أَغْنَى﴾: أعطى الناس الغِنَى والمال، ﴿وَأَقْنَى﴾ [النجم: 48]: أعطاهم القُنْيَة التي يقتنونها، فـ «أَقْنى» متمِّمة لـ «أَغْنَى»، وليست مقابلها، كما في قوله: ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: 43] و ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: 44]، فأعطاهم الغنى، وأعطاهم الأشياء التي يقتنونها، أو أعطاهم الرضا بهذا الغنى، على التفسير الآخر.
* ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى﴾ [النجم: 49]:
هذا كلام مستأنف جديد، فالواو للاستئناف؛ لأن عبادة الشِّعْرَى لم تكن موجودة في عهد إبراهيم وموسى، وإنما وُجدت في العرب بعد ذلك، وهذا عطف في نهاية السورة إلى بدايتها، حيث أقسم بـ «النَّجْم إذا هَوَى»؛ لينكر على عابديها، فعاد ليذكِّر بالمعنى الأول.
* ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: 50]:
و«عاد» واحدة، ولكن سماها: ﴿الْأُولَى﴾ [النجم: 50]؛ لأنها قديمة، ولأنها القبيلة العربية المشهورة، ولأنها ذات عظمة وقوة، كما حكى تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: 15]، وهم متقدِّمون؛ كانوا بعد قوم نوح.
* ﴿وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾ [النجم: 51-52] :
﴿أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾ أي: أكثر ظلمًا، وأكثر طغيانًا.
*﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: 53-54]:
تلحظ هنا تسارع السياق، وكأنك أمام مشاهد سريعة متلاحقة في آية واحدة، تختصر السورة قصة كاملة مفصَّلة في موضع آخر.
﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾: قوم لُوط عليه السلام، وقراهم تسمَّى: «المُؤْتَفِكات»، أي: المنقلبات؛ لأنهم غيَّروا الفطرة، فعُوقبوا بقلب قراهم وتدميرها، ثم رماهم الله تعالى بـ ﴿حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود: 82].
﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: 54] أي: من تلك الحجارة، وهي قُرى سَدُوم، ويمر الحديث عن بعض أخبارها وتفصيلها في مواضع مختلفة من التفسير.
* ثم يأتي السؤال العظيم المزلزِل: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ [النجم: 55]:
وقد يكون هذا خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: أيُّ آلاء ربك أعظم عندك؟ فكلها آلاء حسنة عظيمة، وهم يريدون أن تتمارَى فيها، فبأيِّ هذه الآلاء تتمارَى أو تشك؟، هذا ما لا مجال فيه.
أو يكون خطابًا للناس كلهم، ولكل مَن يصلح له الخطاب: أن هذه الآلاء العظيمة التي تراها؛ بأيِّها تكذِّب أو تشك أو تجادل؟
* ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى﴾ [النجم: 56] :
أي: هذا القرآن من جنس ﴿النُّذُرِ الْأُولَى﴾، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: 144].
* ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ [النجم: 57] : أي: حقَّت الحاقة، ووقعت الواقعة، وأزف: اقترب، و﴿الْآزِفَةُ﴾: الساعة، فهي بمعنى السورة التالية لها: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر: 1].
* ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: 58]:
لا يكشفها أحد إلا الله عز وجل.
* ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ [النجم: 59-61]:
﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ يا معشر قريش المكذِّبين؟، ﴿وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ [النجم: 60-61]: غافلون لا هون مشغولون بالطَّرب واللَّعب والضحك، بينما الأمر جدٌّ، وفيه كرب وأهوال.
* وهنا بلغ التأثير نهايته، وجاء الختم الرَّبَّاني العظيم: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: 62]:
وهذا موضع سجود عند طائفة من أهل العلم، خلافًا للإمام مالك.
وقد قرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه السورة مرةً، ولم يسجد، وقرأها في مكة وسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجنُّ والإنسُ.
والعجيب أن يسجد المشركون، وقد أخذتهم روعة السورة ووهلتها وقوَّتها وسرعتها وتأثيرها وحصارها لهم بالسؤالات المتتابعة التي تهزُّهم من أعماقهم، وتكشف الغفلة عنهم، فأفاقوا قليلًا على وقعها وصداها وسجدوا دون تأمُّل، ثم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/books/7