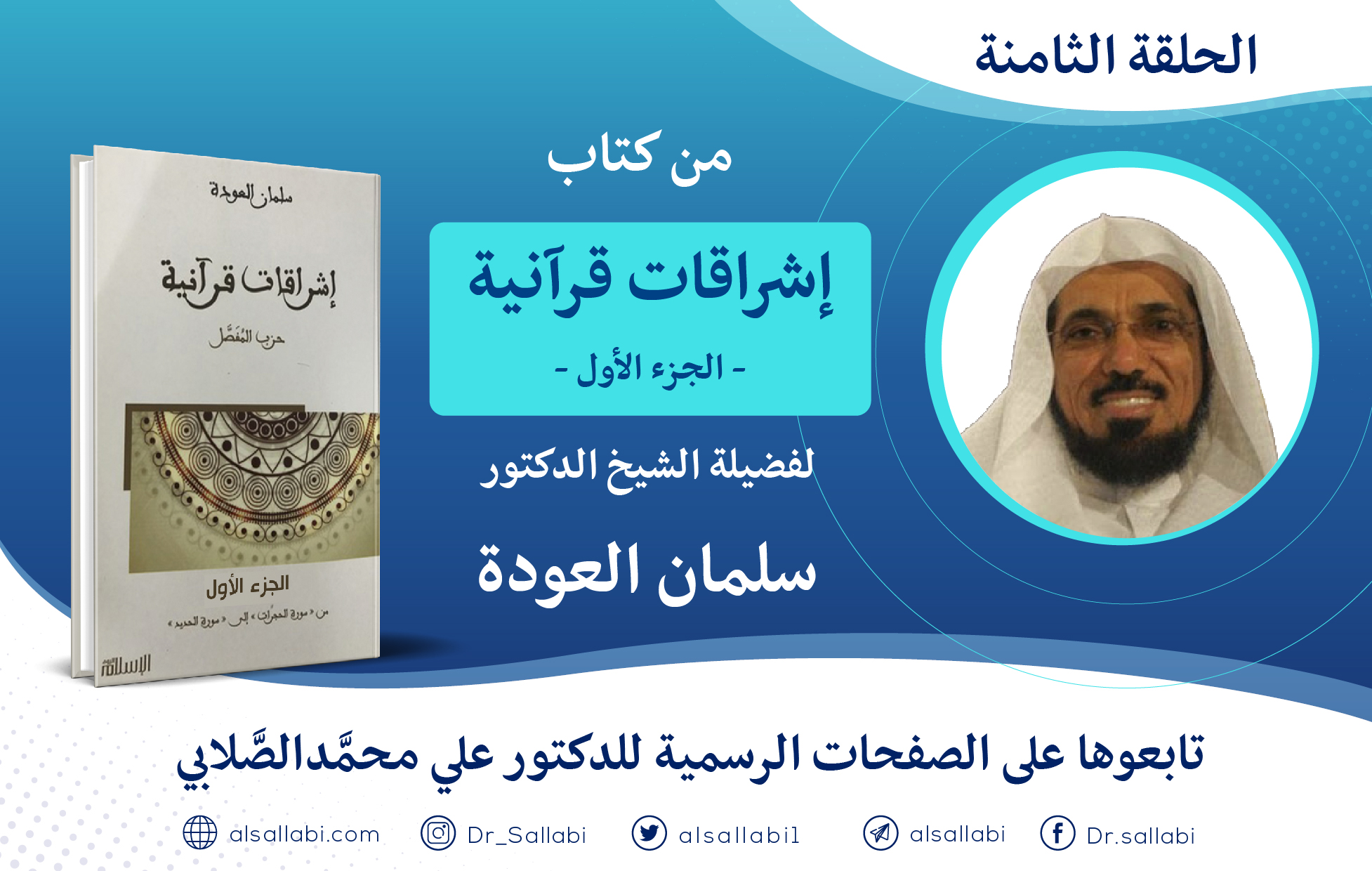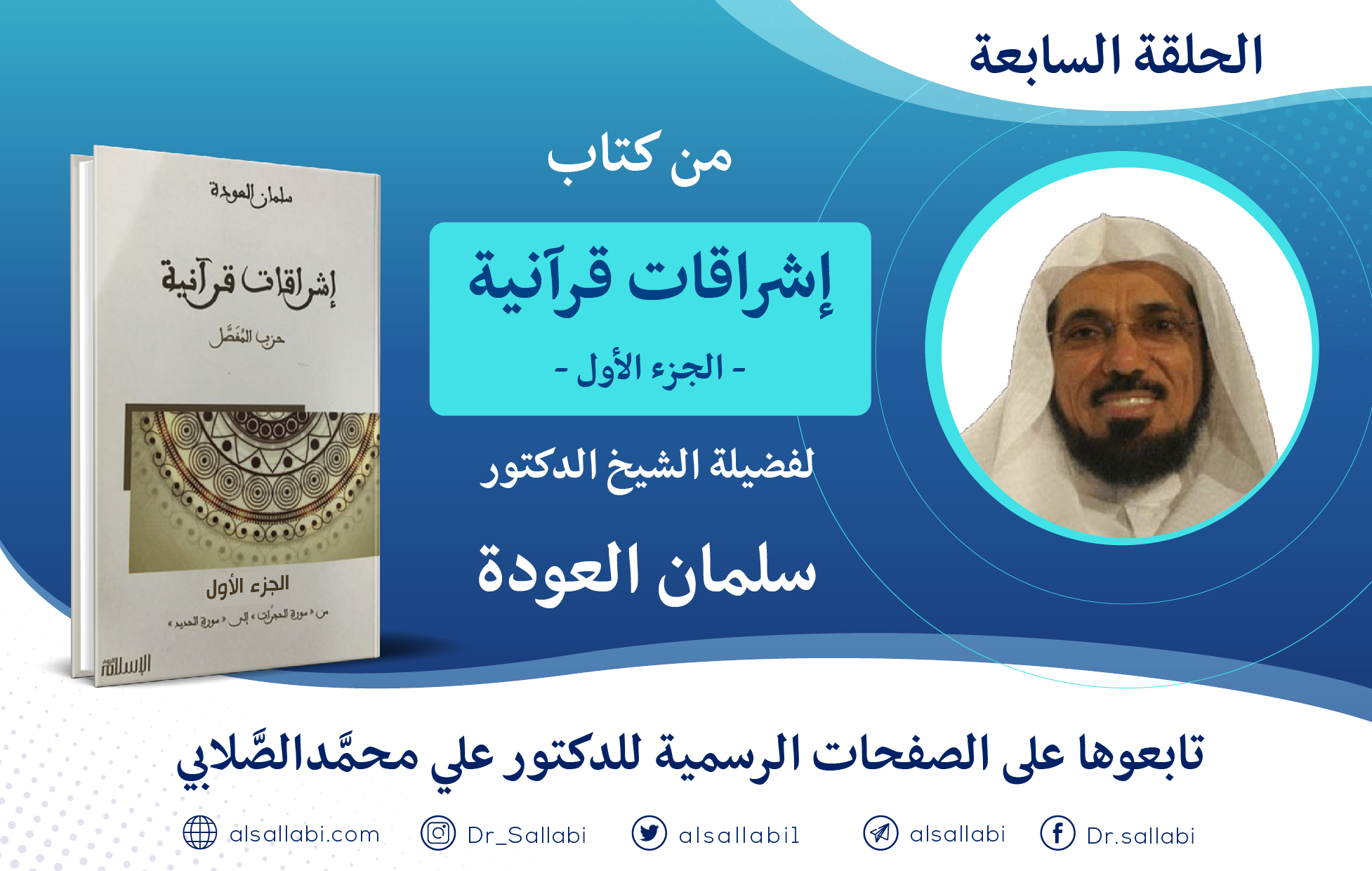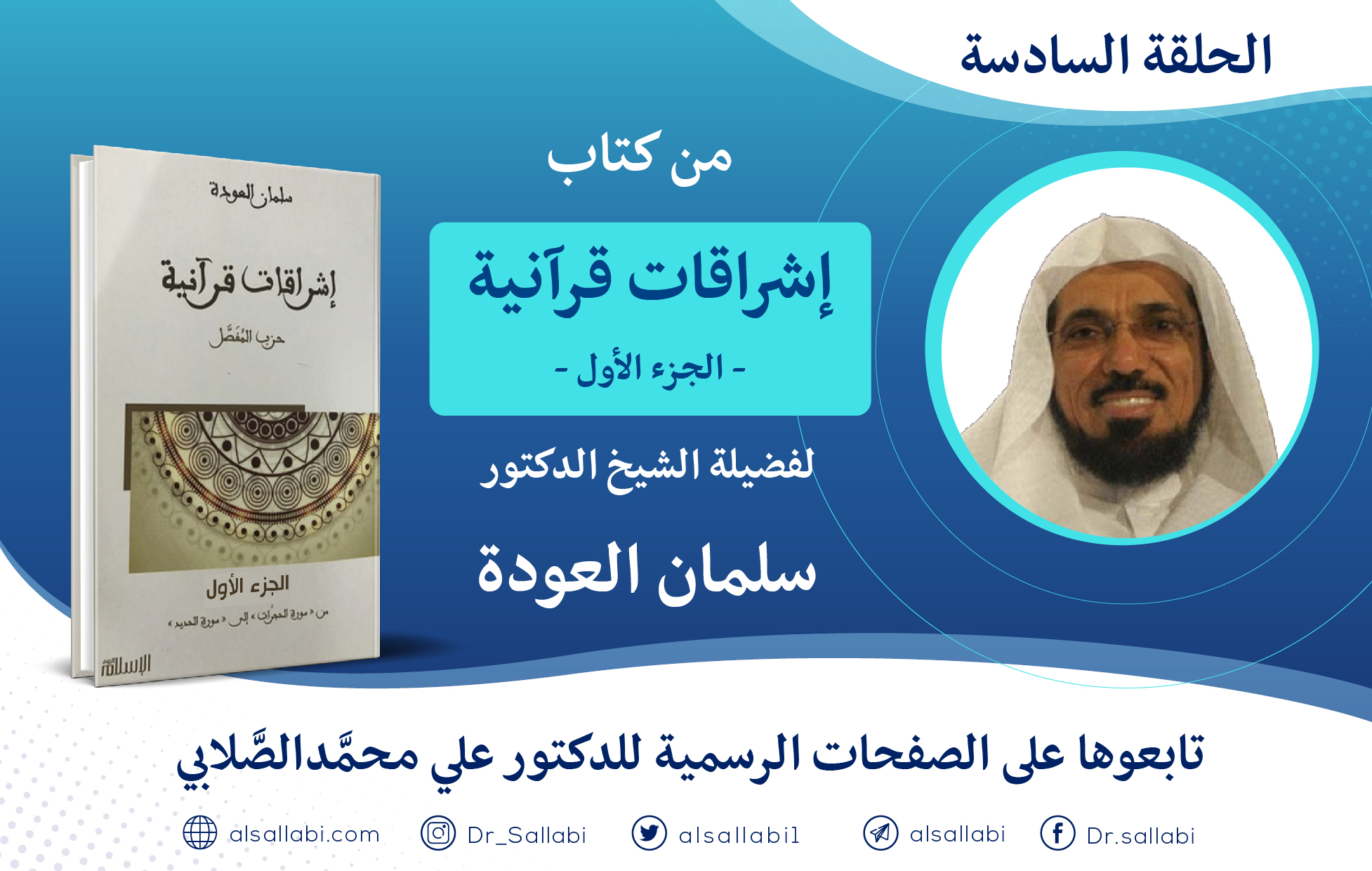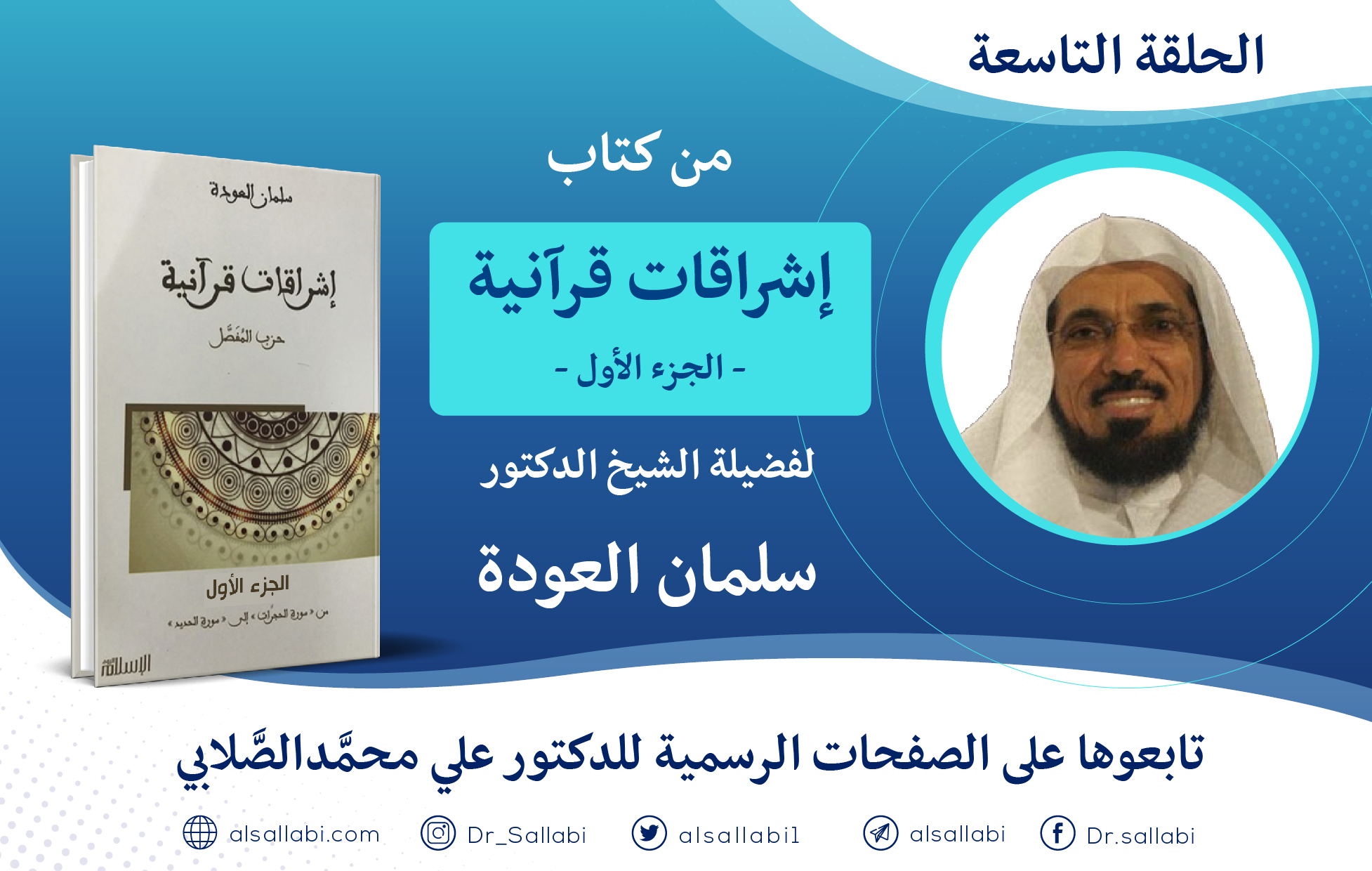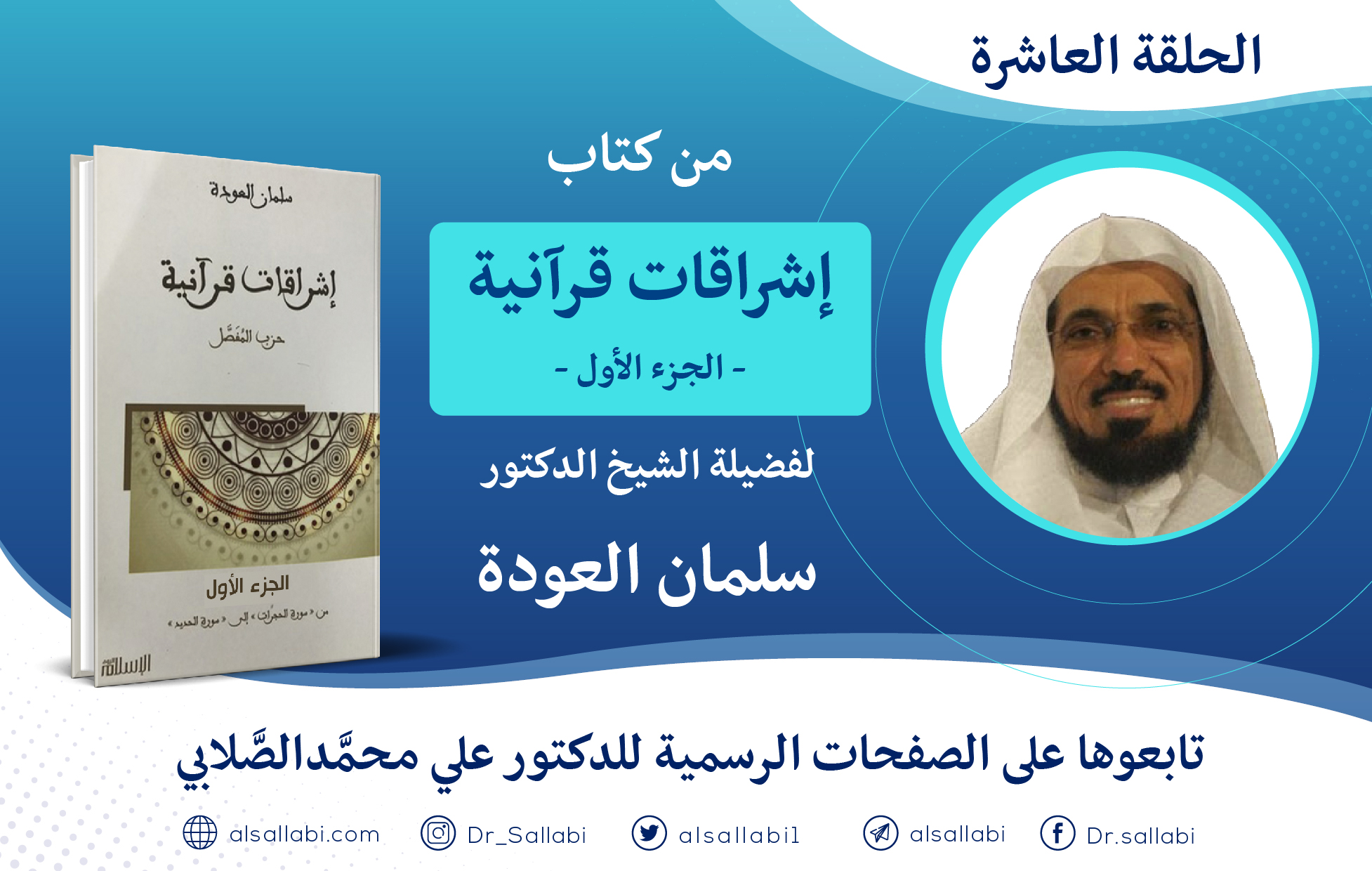من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة النجم)
الحلقة الثامنة
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الأول 1442 هــ/ نوفمبر 2020
* تسمية السورة:
تُسمَّى: «سورة النَّجْم»، أو: «سورة ﴿وَالنَّجْمِ﴾»، أو: «سورة ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى١﴾»، وهي من السور ذات الاسم الواحد.
وقد ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأها في مكة، فسجدَ، وسجدَ معه المسلمون والمشركون والجنُّ والإنسُ
وورد أنه سجدَ بها وسجدَ مَن معه، غير أن شيخًا أخذ كَفًّا من تراب، فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا.
قال ابنُ مسعود رضي الله عنه راوي الحديث: «فرأيتُه بعد ذلك قُتل كافرًا، وهو أُمَيَّة بن خلف».
* عدد آياتها: اثنتان وستون آية، أو واحد وستون آية، على اختلاف بين علماء العدِّ.
* وهي مكيَّة عند جماهير المفسرين، وهو الراجح.
وقد رُوي عن الحسن أنها مدنية، وهو قول ضعيف جدًّا.
وقال بعضهم: إن فيها آية مدنية؛ وهي قوله تعالى:﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ [النجم: 32] .
وهذا أيضًا فيه نظر؛ فالسورة مكية كلها، ولعلها نزلت جملة واحدة، والله أعلم.
* ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾:
يُقسم ربنا سبحانه وتعالى بـ «النَّجْم»، ويحتمل أن يكون المقصود: أي نجم من النجوم، كما في قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: 75]، وقوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ [التكوير: 15-16].
وقد يكون المقصود نجم خاص، قد يكون «الثُّرَيَّا»؛ فهو نجم معروف عند العرب، وكثير من مواقيتهم في الرَّعْي والزرع وغيرها، مرتبطة بـ «نَوْء الثُّرَيَّا»؛ ولذلك كانوا يقولون: «طَلَعَ النَّجْمُ عِشاءً، فابْتَغَى الرَّاعِي كِساءً»؛ كناية عن مجيء البرد، فالرَّاعي يريد الدِّفء. ويقولون: «طَلَعَ النَّجْمُ غُدَيَّةً- أي: الفجر- فابْتَغَى الرَّاعِي شُكَيَّةً». والشُكَيَّة: وعاء من جلد يوضع فيه اللَّبَن أو الماء، معناه: أنه جاء وقت الحرِّ، فيحتاج الراعي إلى الشراب.
أو القسم بـ «نَجْم الشِّعْرَى»، وهو مذكور في السورة ذاتها، وهو نَجْم تقدِّسه بعض العرب، وورد أن خُزاعة كانوا يعبدونه.
وهو لم يُقسم بـ «النَّجْمِ» مطلقًا، وإنما أقسم به في حالة خاصة؛ وهي ﴿إِذَا هَوَى﴾ أي: سقط.
ويحتمل المعنى: غاب، كقوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76].
والقَسَم بهذا الحال هو أول تفنيد لعبادة النُّجُوم؛ لأن «النَّجْم» يغيب ويختفي، فكيف تعبدونه؟!
وإذا قلنا: إن معنى ﴿هَوَى﴾: سقط، فالمقصود: الشِّهاب الذي يراه الناس وهو ينقضُّ ساقطًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: 5]، وقال: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصافات: 10].
* ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾:
الخطاب للمشركين، والواضح أن الخطاب جاء مباشرًا وقويًّا وسريعًا؛ ولذلك جاء القَسَم مختصرًا في آية واحدة وبشيء واحد، هو «النَّجْم إذا هَوَى».
وسمَّى نبيَّه صلى الله عليه وسلم: «صاحبًا لهم»، كما قال: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ [التكوير: 22] ، ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ [سبأ: 46].
وفي هذا إشعار لهم وتذكير بأنه منهم، وُلد وعاش بينهم، ويعرفون نسبه وميلاده، وعقله وخُلقه، وليس غريبًا عليهم في ولادته، ولا نشأته، ولا تفصيل حياته وسلوكه، فكيف يتأتَّى لهم أن يتنكَّروا لرسالته، وينسبوا إليه ما هو منه بريء، وهم أخلق الناس بقبول دعوته؟! وهو عزهم ومجدهم، وهو صاحبهم!
وكما قيل: «كل شخص لست تعرفه، ككتاب لست قارئه»، فالشخص الذي تجهله قد لا تحسن فهمه، وقد يتكلَّم بكلام وتظن أنه يقصد معنى آخر، فإذا عرفتَ الشخص فقد كشفتَ الكتاب، وعرفتَ السِّر، وفهمتَ المغزى، وهم عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قصده، وعزوفه عن الرئاسة والجاه والدنيا والملذَّات، وبعده عن التطلُّع والاستشراف، وتفرده عنهم بالتعبد في غار حراء، ومجانبة الأصنام والخمر والفواحش واللَّهو، ولم يعيبوه قبل النبوة بشيءٍ ألبتة.
وفي هذه الآية نفى لشيئين: الضَّلال والغِواية؛ فالضَّلال هو: عدم الهداية؛ كوصفهم إياه بالجنون، فهذا نوع من الضَّلال، وبعض الناس يتَّبعون ضلالات نفسية تتلبَّسهم، وتخرج بهم عن جادة العقل والرَّزانة، كادِّعاء أحدهم أنه المسيح ابن مريم أو أنه المهدي أو يدَّعي النبوة، وحينما تجالسه تجده بلا علم، ولا معرفة، ولا فقه، ولا بصيرة، ولا عقل، ولا اتزان نفسي، وإنما هو مبتلى بآفة نفسية سبَّبت له هذه الضلالة، والضَّال هنا يظن أنه صادق، ويصدِّق نفسه؛ بسبب تلبس حالة مرضية لعقله.
فيُقسم تعالى على نفي هذا الاضطراب أو الجنون الذي ادَّعوه، ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الغِواية فمعناها: تعمُّد الكذب عن قصد، وسبق إصرار، بدعوى يريد من ورائها دنيا أو جاهًا أو ما أشبه ذلك، وقد يدخل في الغواية: الشِّعْر، وقد كانوا يقولون: إنه شاعر، والله تعالى قال: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: 224].
* ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾:
وتأمَّل التناسب والتجانس بين قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾، وقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾، و﴿الْهَوَى﴾: ما تهواه النفس، وتميل إليه، فهذا النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم متجرِّد عن ﴿الْهَوَى﴾، ولا يتكلَّم من قِبل نفسه ورغبته، وأول ما يدخل في هذا: القرآن الكريم؛ لأنه الوحي الذي ﴿يُوحَى﴾؛ ولا يمنع مع إرادة القرآن أن يكون ذلك تزكية لمنطقه صلى الله عليه وسلم عامةً؛ ولذلك كان يمزحُ، ولا يقولُ إِلَّا حقًّا، وكان يقول المحكمات الجوامع من الأقوال، حتى إن من العلماء مَن جمعوا الأحاديث التي جرت مجرى المثل والحكمة في وجازتها واختصارها وحكمتها، فقد أُوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكَلِم بخواتمه، ودان له بذلك البعيد والقريب.
فإذا صان تعالى منطقه صلى الله عليه وسلم ﴿عَنِ الْهَوَى﴾، فقد صان سلوكه واعتقاداته وأحواله ومشاعره أيضًا ﴿عَنِ الْهَوَى﴾، وصنعه على عينه، واصطفاه في أفعاله وأقواله؛ ولذلك لما كان فتح مكة أمَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ، إلا أربعةَ نفر وامرأتين، منهم عبدُ الله بن سعد بن أبي السَّرْح، وقد اختبأ عند عثمان رضي الله عنه، فلما دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، بايعْ عبدَ الله. فرفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رأسَه فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يأبَى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رَشِيدٌ يقومُ إلى هذا حيثُ رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتله؟». فقالوا: وما يدرينا يا رسولَ الله ما في نفسك، هلَّا أَومأتَ إلينا بعينك! فقال: «إنه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكونَ له خائنةُ الأَعْيُن».
فلم يقبل صلى الله عليه وسلم على عدو مهدر الدم- لأنه انتهك الحرمات- أن يغمز لأصحابه بطرف عينه، أن عاجلوه بالقتل، فتعامله في غاية الوضوح والتجرد والصفاء.
• ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾:
ومرد الضمير للقرآن اتفاقًا.
والوَحْي هو: الصوت الخفي، والله تعالى بعث جبريل عليه السلام بهذا الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
* ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾:
أي: علَّمه جبريلُ عليه السلام القرآنَ، فالضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعود إلى القرآن الكريم، أي: أن جبريل عليه السلام علَّم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أو جبريل علَّم القرآنَ للنبي صلى الله عليه وسلم.
وجبريلُ عليه السلام هو الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين، فهذه وظيفته وحده اختصَّه اللهُ بها مع الرسل جميعًا.
* ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾:
هذا وصف لجبريل عليه السلام؛ بأن بنيته شديدة قوية، وقد ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على صورته التي خُلق عليها، وقد سَدَّ الأفق، له ستمئة جناح، سادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ ما بين السماء والأرض.
ومعنى ﴿فَاسْتَوَى﴾: اعتدل وتهيَّأ واستعد لهذه المهمة الجليلة العظيمة.
* ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾:
أي: جبريل عليه السلام، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالأُفق الأعلى، وقيل: النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام.
والأُفُق هو: ملتقى الأرض والسماء في نظر الرَّائي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الأُفُق، والأُفُق الأعلى هو: أعلى الأُفُق.
*﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾:
أي: نزل قليلًا قليلًا، حتى كان من النبي صلى الله عليه وسلم ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾، وهذا تعبير معروف، تعني أنه قريب.
والقَوْس معروف، وهو الذي تُرمى به السهام.
وقد يكون هو: الذِّراع، أي: كان قدر ذراع أو ذراعين من النبي صلى الله عليه وسلم،
﴿أَوْ أَدْنَى﴾.
وقوله: ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ ليس للشك، فالله يعلم الأشياء بحقائقها ودقائقها، فالمعنى: كان أقل من ذلك وأقرب.
ويحتمل أن له حالتين، كان في إحداهما ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾، وفي الأخرى
﴿أَدْنَى﴾ من ذلك.
وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، ثم فَتَرَ الوحي فَتْرةً، حتى تبدَّى له جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أجياد في صورته التي خلقه الله عليها، له ستمئة جناح، قد سدَّ عِظَمُ خلقه الأُفق، فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة المَلَك الذي جاءه بالرسالة، وجلالة قدره، وعُلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه.
وهكذا بدأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعتاد على نزول جبريل عليه السلام، وعلى مجيئه، وكان يأتي أحيانًا بصورة رجل، مثل: دِحْيَة بن خَلِيفة الكَلْبي رضي الله عنه؛ لجمال صورته.
وهنا تلحظ أنه تعالى يخاطب بهذا التفصيل المشركين، ويصف لهم كيف ينزل جبريل عليه السلام بالوحي، وكيف يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ من أجل أن يتدرَّبوا على مثل هذه المعاني التي قد تبدو غريبة على بيئة أُمِّيَّة مثل بيئتهم، ولا عهد لهم بها، كما حكى الله حالهم في قوله: ﴿مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [القصص: 46] ، ولم يكن لهم علم بالكتب والأنبياء والرسل، والملائكة والوحي، وطريقة نزوله، وأنواعه؛ فلذلك فصَّل تعالى لهم ذلك هنا.
* ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾:
سماه: ﴿عَبْدِهِ﴾، والعبودية تتكرَّر في سياقات الوحي، كقوله سبحانه:
﴿مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: 23]، وقوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1]، وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: 1]، فهي اصطفاء وتكريم، وعلامة التواضع له سبحانه؛ ولذلك منع اللهُ رحمته وفضله الذين يستكبرون، والله يحب المتواضعين المتنزِّهين عن العُجب والغرور، «قال اللهُ عز وجل: الكِبْرياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري، فمَن نازعني واحدًا منهما قذفتُهُ في النار».
والمقصود بقوله: ﴿مَا أَوْحَى﴾: التعظيم والتفخيم لهذا الوحي، أي: أوحى شيئًا عظيمًا كريمًا، يكشف الناس من أسراره ومعانيه بقدر عبوديتهم وتواضعهم لربهم جل وتعالى.
* ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾:
أي: فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد كذب فيما رأى، بل رأى صدقًا وحقًّا.
* ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾:
﴿أَفَتُمَارُونَهُ﴾ يا معشر قريش وتجادلونه، ﴿عَلَى مَا يَرَى﴾، وهو يرى بعينه، ويرى بقلبه وفؤاده، أفأنتم أيها الجاهلون تجادلونه في محسوسه الذي رآه بعيني رأسه، ورآه بقلبه، على أنه تعالى حجبه عنكم بجهالتكم وكثافة حسكم!
* ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾:
أي: رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم جبريلَ عليه السلام مرةً ثانيةً يومَ الإسراء والمعراج، ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾، وهي سِدرة خلقها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان المقدَّس.
وهذه معانٍ عظيمة، لا يستطيع الإنسان أن يدرك كُنْهَها، ولا أن يحيط بتفصيلاتها، ولو ذهب العقل يتأمَّل أو يفكِّر ما خرج من ذلك بطائل؛ فإنه لم يكشف له من هذا الغيب إلا أن ثمة شجرة تُسمَّى: ﴿سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾، فوق السماء السابعة، ذهب إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، حيث سمع عندها صوت صَرِيف الأقلام، والملائكة يكتبون أفعال العباد، وأقدار العباد.
وهذا النص وأمثاله يفتح عقل المؤمن ليتَّسع ويمتد، ويدرك أن الخلق والكون أعظم مما تراه العين أو يدركه الحس، فثَمَّ سماوات وعرش وكرسي وما شاء الله بعد مما لم تره عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر.
* ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾:
وهذا من الأدلة على أن الجنة في السماء عند الله سبحانه وتعالى، وسماها: ﴿جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾؛ لأنه يصير إليها المؤمنون.
* ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾:
كأن الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هناك لجبريل عليه السلام كانت في الوقت الذي غشي السِّدرة فيه شيء عظيم، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: «وغشيها ألوانٌ، لا أدري ما هي».
وقيل: إنها الملائكة، وهي في هذه السِّدْرَة كأنها الطيور على أغصان الأشجار تُسبِّح الله سبحانه وتعالى، وتفعل ما أُمرت به، فغشي السِّدرةَ تلك الأشياء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري ما هي».
* ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾:
مع ذلك كله، وما فيه من المفاجأة والهول والعجب لم يزغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع عنده اضطراب في الرؤية؛ بل كان وافر البصيرة والحكمة، والاستعداد والتهيُّؤ لهذا الموقف بما آتاه الله من القوة والثبات.
﴿وَمَا طَغَى﴾ البَصَر بأن يتجاوز أو يتعدَّى، فما حكاه هو ما رآه صلى الله عليه وسلم، من غير خطأ سببه الزيغ، ولا زيادة سببها الطغيان.
* ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾:
إما أن يكون رأى الآية الكبرى، أو رأى آيات كُبَر، وهذا أقرب، فيكون قد رأى شيئًا من آيات ربه الكبرى في هذه السماء، مما أخبر عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل.
ومع ذلك فقد كان المشركون يستغلون ما حدَّثهم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم مما رآه في الإسراء والمعراج؛ للطعن في صدقه واتهام عقله، وهكذا هم يرون أن كل ما لا تطيقه عقولهم ولا تصدِّقه يعدُّونه أساطير وصاحبه مجنونًا أو به مسٌّ، أما المصدِّق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفوِّض الأمر كله لله في خبره وأمره، فإن أخبره الوحي بما لا يحيط به عقله ولا حسُّه صدَّقه وآمن به، وجعل عقله حيث يليق به.
وهذا أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه يأتيه مشركو مكة يقولون له: هذا صاحبُك يزعمُ أنه قد أُسرِيَ به إلى بيت المقدس، ثم رجع من ليلته! فقال أبو بكر رضي الله عنه: «أَوَ قال ذلك؟». قالوا: نعم. فقال: «فإنِّي أشهدُ إن كان قال ذلك لقد صدقَ». فقالوا: أتصدِّقه بأنه جاء الشامَ في ليلة واحدة، ورجعَ قبل أن يُصبحَ؟ قال: «نعم؛ إني أصدِّقه بأبعدَ من ذلك، أصدِّقه بخبر السماء بكرةً وعشيًّا». ومن يومئذٍ سُمي: الصِّدِّيق.
فهكذا المؤمن لا يجعل عقله محصورًا في عالم الماديات الضيِّق المحدود، والبشر يدركون أنهم مسلَّطون على المادة يكتشفونها ويتعرَّفون على قوانينها ويوظِّفونها شيئًا بعد شيء، وربما كانوا ينكرون بالأمس شيئًا أصبحوا يؤمنون به الآن، فالعقل المؤمن ليس عقلًا أُسطوريًّا أو خُرافيًّا يَتَشَرَّبُ الخرافة دون آية أو حجة، وهو أيضًا ليس عقلًا ماديًّا صِرْفًا لا يؤمن بالغيب، ويحصر نفسه في حدود المادة.
* ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: 19-23]:
وقد كانوا يعبدون هذه الأصنام، وكانوا يعدُّونها إناثًا، كما هو الظاهر من أسمائها.
أما ﴿اللَّاتَ﴾: فصخرة مربعة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف، له أستار وسَدَنة، وحوله فناء معظَّم عند أهل الطائف، وهم ثَقِيف ومَن تابعها، يفتخرون بها على مَن عداهم من أحياء العرب بعد قريش.
وقيل: موضع صخرة كانت لرجل يَلِتُّ للحَجِيج في الجاهلية السَّويق، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه.
﴿وَالْعُزَّى﴾: كانت شجرة، أو صنم فيه صورة شجرة، عليها بناء وأستار بنَخْلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظِّمونها.
﴿وَمَنَاةَ﴾: صخرة كانت بالمُشَلَّل عند قُديد، بين مكة والمدينة، وكانت خُزاعة والأَوْس والخَزْرج في جاهليتها يعظِّمونها، ويُهِلُّون منها للحج إلى الكعبة.
وكل هذه الأصنام معروفة عند العرب، وقد حكى تفصيلها ابن الكلبي في كتاب «الأصنام».
فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنية للعبودية، ويتعاطونها فيما بينهم، فالله سبحانه وتعالى ينقلهم عن هذا المستوى المنحط من العبودية للأحجار والجمادات التي هي أقل من مستوى الإنسان، ويرفع آفاقهم وعقولهم إلى عبادة الإله الواحد الأحد الصمد، وإلى الإيمان بالغيب والملائكة والوحي.
وما عبد مشركو الجاهلية أصنامهم إلا لتقرِّبهم إلى الله، وبعضهم يزعمون أنها بناته، ولذا أنكر عليهم وقال: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾؟ وكأنهم جعلوها تماثيل للملائكة يعبدونها لتقرِّبهم إلى الله، وكأن هذا سر كونها تقرِّبهم إلى الله؛ لأنها في السماء قريبة إلى الله، ومع زعم بنوَّتها يصبح الأمر أشد قُربًا، وكأنهم لفرط سذاجتهم وجهلهم قاسوا على الكينونة العائلية عندهم، وظنوا عبادتها لا تضير المعبود الأكبر، وقاسوها على طاعة أولاد المَلِك أو شيخ القبيلة!
﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ أي: ظالمة، فإذا تجرَّأتم وجعلتم لله ولدًا، وهذا باطل قادح في الربوبية، فلِمَ جعلتم له البنات في الوقت الذي يتوارى أحدُكم من القوم حين يُبَشَّر بأنثى؟
وهذا كالنص على أنهم كلهم أو بعضهم يعبدون تماثيل يزعمونها للملائكة ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾، فالمعنى: أن هذه الأصنام ليس لها من الألوهية سوى ما صنعتموه وابتدعتموه.
ولئن كان هذا قد وقع في الجاهلية حيث الحياة البدوية البدائية البسيطة، فقد وقع في عصرنا هذا طغيان الماديات ونفوذ العلم المادي بشرك قريب من ذلك أو مثله.
وكأن الدِّين في منطقة معزولة داخل العقل لم يصل إليها النور، ولم تستفد من التفوق في العلوم التجريبية؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾، فهم يتَّبعون الظُّنون والتخرُّص في أصول الدِّين والاعتقاد التي لا يُقبل فيها الظنُّ ولا بد من اليقين، واللهُ تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12]، ويقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكُم والظَّنَّ؛ فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث». فهؤلاء يتبعون الظَّنَّ في أعظم القضايا وأقدسها؛ وهي قضية الألوهية والعبودية، وهو ظن موروث، ليس قائمًا على شبهة أو احتمال.
﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ أي: ويتَّبعون ما تهواه نفوسُهم وتميل إليه، ومجرد ميل النفس لا يعني شيئًا؛ فالنفس تميل إلى السهل، وإلى المألوف، وإلى ما يعزِّز جانبها وجانب القبيلة أو البلد أو الجنس أو العائلة.
والنفس إذ اعتادت شيئًا وتربَّت عليه أذعنت له وأحبَّته، ولذا أحبَّ بنو إسرائيل العجلَ، وكان الفراعنة يعبدونه، فلما مروا على لَخْم وجُذام، وكانوا يتراقصون حول صنم بقرة منحوتة حنّوا إلى مألوقهم و ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: 138]. ولما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه صنع لهم السامري العجل فعبدوه، ولما أمرهم ربُّهم بذبح البقرة تردَّدوا وأكثروا الأسئلة، قال: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71].
﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾: فإعراضهم عن الهُدَى بميل النفس والهوى والظنِّ هو غاية الخطأ، نعم الظَّنُّ يمكن أن يُعمل به في مجاله، إذا لم يكن ثَمَّةَ ما يعارضه؛ ويُؤخذ بغلبة الظَّنِّ في الأحكام الفقهية إذا لم يُوجد ما هو أقوى منه، ولكن أن يجعلوا الظَّنَّ المجرَّد العارض في قضية قطعية يعارضون به وحيًا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فهذه غاية الضلال؛ ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾!
* ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [النجم: 24-25]:
الاستفهام إنكاري، قُصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمنَّاه، وأن يجعل ما يتمنَّاه باعثًا عن أعماله ومعتقداته، بل عليه أن يتطلَّب الحقَّ من دلائله وعلاماته، وإن خالف ما يتمنَّاه، وهذا متصل بقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: 23].
وقد شمل قوله: ﴿مَا تَمَنَّى﴾ كلَّ هوًى دعاهم إلى الإعراض عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فشمل تمنِّيهم شفاعة الأصنام، وهو الأهم من أحوال الأصنام عندهم، وذلك ما يُؤذن به قوله بعد هذا: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ [النجم: 26] . وتمنِّيهم أن يكون الرسول مَلَكًا، وغير ذلك، نحو قولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: 31]، وقولهم: ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾ [يونس: 15].
وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمُّل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفًا للهوى، وليحمل نفسه عليه حتى تتخلَّق به.
وفُرِّع على الإنكار أن يكون للإنسان ما تمنَّاه، وأن الله مالك الآخرة والأولى، أي: فهو يتصرف في أحوال أهلهما بحسب إرادته، لا بحسب تمنِّي الإنسان، وهذا إبطال لمعتقدات المشركين التي منها يقينهم بشفاعة أصنامهم.
* ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى﴾ [النجم: 26-27]:
بعدما ذكر الآلهة التي يعبدونها بزعمهم أنها تشفع لهم، ذكَّرهم بحدود قدرة الملائكة، وأن علو مكانهم لا تعني عبادتهم، فهم ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 26-28]، ولو بذلوا شفاعتهم لم تغن شيئًا، ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ﴾ ، فهم لا يتقدَّمون بالشفاعة بين يدي الله سبحانه، إلا إذا أذن لهم، ولا يأذن إلا لمَن يرضى الله تعالى أن تدركه الشفاعة.
فإذا كان هذا شأن الملائكة في السماء، فما بالكم تعبدون آلهة في الأرض من الحجارة مما لا يضُرُّ ولا ينفع، فضلًا عن أن يشفع؟! وما أنزل الله تعالى بهذه الآلهة المدَّعاة من سلطان، ولا أذن لكم بعبادتها؛ وحتى لو كانت هذه المعبودات تماثيل للملائكة في أصل بنائها، أو كانت كذلك في اعتقاد عابديها، فهذا لا يغيِّر من الحقيقة شيئًا؛ فالملائكة ليسوا إناثًا، بل ﴿عِبَادٌ﴾، وهم بهذه المنزلة من الذل والطاعة فكيف عبدتموهم؟
﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى﴾ [النجم: 27]: سجَّل عليهم أنهم لا يؤمنون بالبعث، وهذا حال غالبهم أو كلهم، وما يخطر ببال أحدهم من احتمال أو خيال لا يُسَمَّى إيمانًا؛ فالإيمان هو اليقين الصادق باعتقاد خروج الناس من قبورهم إلى ربهم يوم الدِّين.
*﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾:
فلم يبنوا هذا الزعم الكاذب بأنوثة الملائكة ولا ببنوتها لله على علم، بل هو أمر أخذوه من الفلاسفة، وتوارثوه فيما بينهم، أو من بعض الأمم السابقة قبلهم، وهم بذلك يتَّبعون الظَّنَّ، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ، ولم يذكر هنا ما تهوى الأنفس؛ لأن هوى النفوس في هذه المسألة غير ظاهر.
* ثم وجَّه الخطاب إلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: 29]:
أي: أعرض عن هؤلاء المصرِّين على كفرهم، وقوله: ﴿فَأَعْرِضْ﴾ هو مثل قوله: ﴿ذَرْهُمْ﴾ [الأنعام: 91]،﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ [فاطر: 8] ، ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: 127]،﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ [الزخرف: 89] ، ﴿فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ﴾ [المؤمنون: 54].
﴿وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: 29]؛ لأنهم لما كانوا موصوفين بأنهم﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ فقُصارى همهم وإرادتهم لا يتعدَّى هذه العاجلة، وهذا حرمان أي حرمان، أن يقطع المرء نفسه عن ذلك الامتداد العظيم الفسيح اللائق بالإنسان، ويقصر إيمانه وحلمه وطموحه على مدى العمر المحدود الذي يقضيه على الأرض، وهو قد لا يتجاوز عشرات السنين! كيف يحرم العاقل نفسه من حلم الخلود وجوار الرب العظيم في جنات النعيم؟! ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: 29].
* ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ [النجم: 30]:
فعلمهم ضعيف محدود، فالآخرة ليس لها اعتبار عندهم، وقد جعلوا جهدهم وعقلهم للعاجلة، أما الآخرة فهم لا يؤمنون بها، فإن هم بُعثوا فظنهم أن هذه الآلهة سوف تشفع لهم.
﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾: وهذا تقرير لعلم الله الذي لا يخطئ ولا يجهل، فحين يقول: إنهم ضالون، فهم ضالون، وحين يبيِّن الهُدى لهم ويأمرهم به، فهو الحق بلا ريب.
وفي الآية تهديد ووعيد بأن يأخذ الله العليم أولئك الضالين، فهو بهم محيط وإليه المصير.
* ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31]:
وهذا في شأن الفصل بين هؤلاء المكذِّبين وأولئك المؤمنين، وهو تفريع على الآية السابقة التي بيَّنت علم الله بالضالين والمهتدين.
وفيها بيان أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما يُؤخذون بأعمالهم، ويجزي الله المؤمنين بالحسنى؛ لأنهم أحسنوا تقبُّل وحي الله، وأحسنوا طاعة رسله، وأحسنوا إلى عباده بالبر والخير والعطاء والبذل، فـ «الجزاء من جنس العمل»، وحتى إذا أدركتهم الشفاعة، فقد أدركتهم بأعمالهم التي جعلتهم أهلًا بأن يرضى الله تعالى عنهم، ويأذن لمَن يشفع فيهم.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/books/7