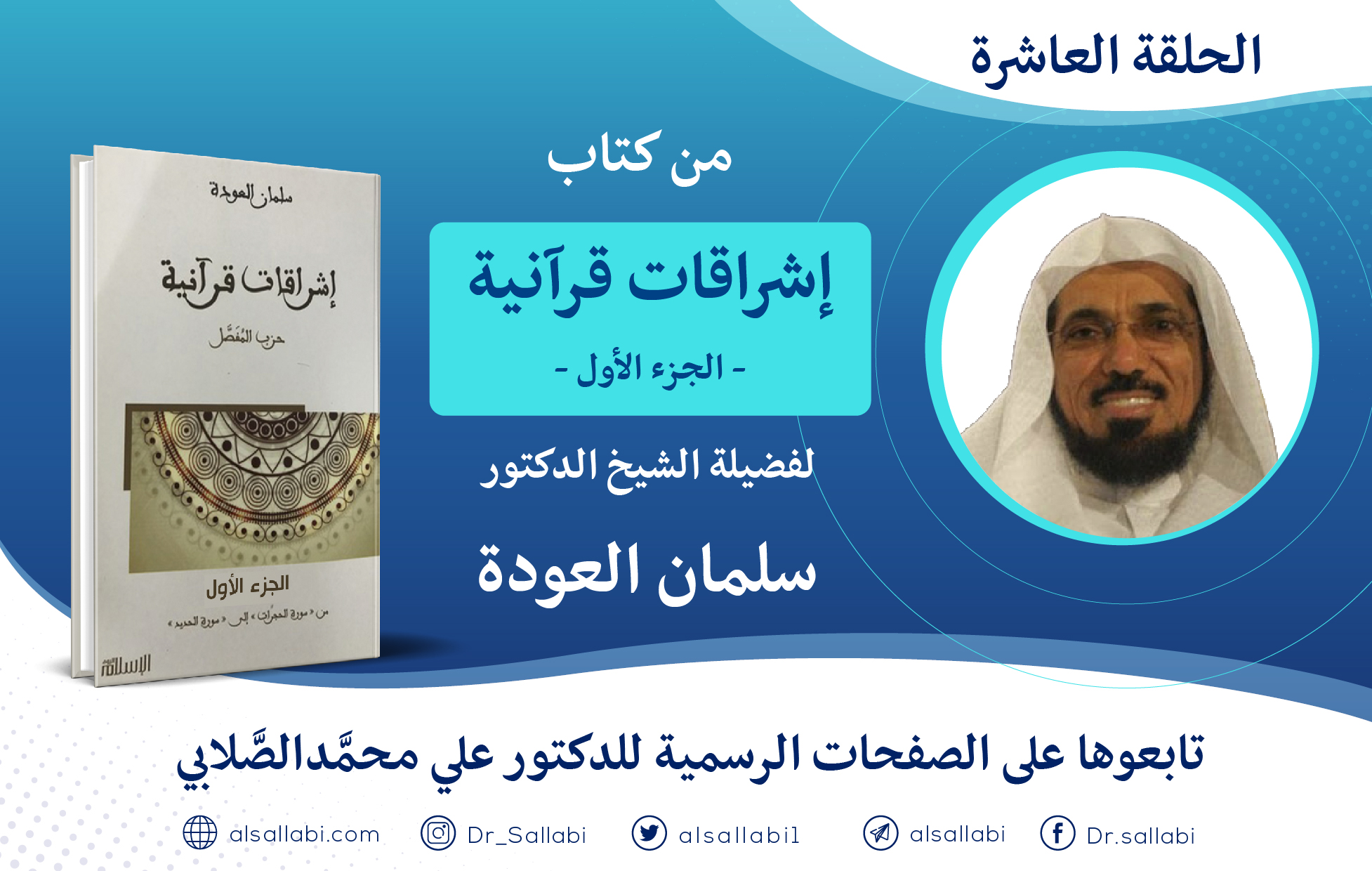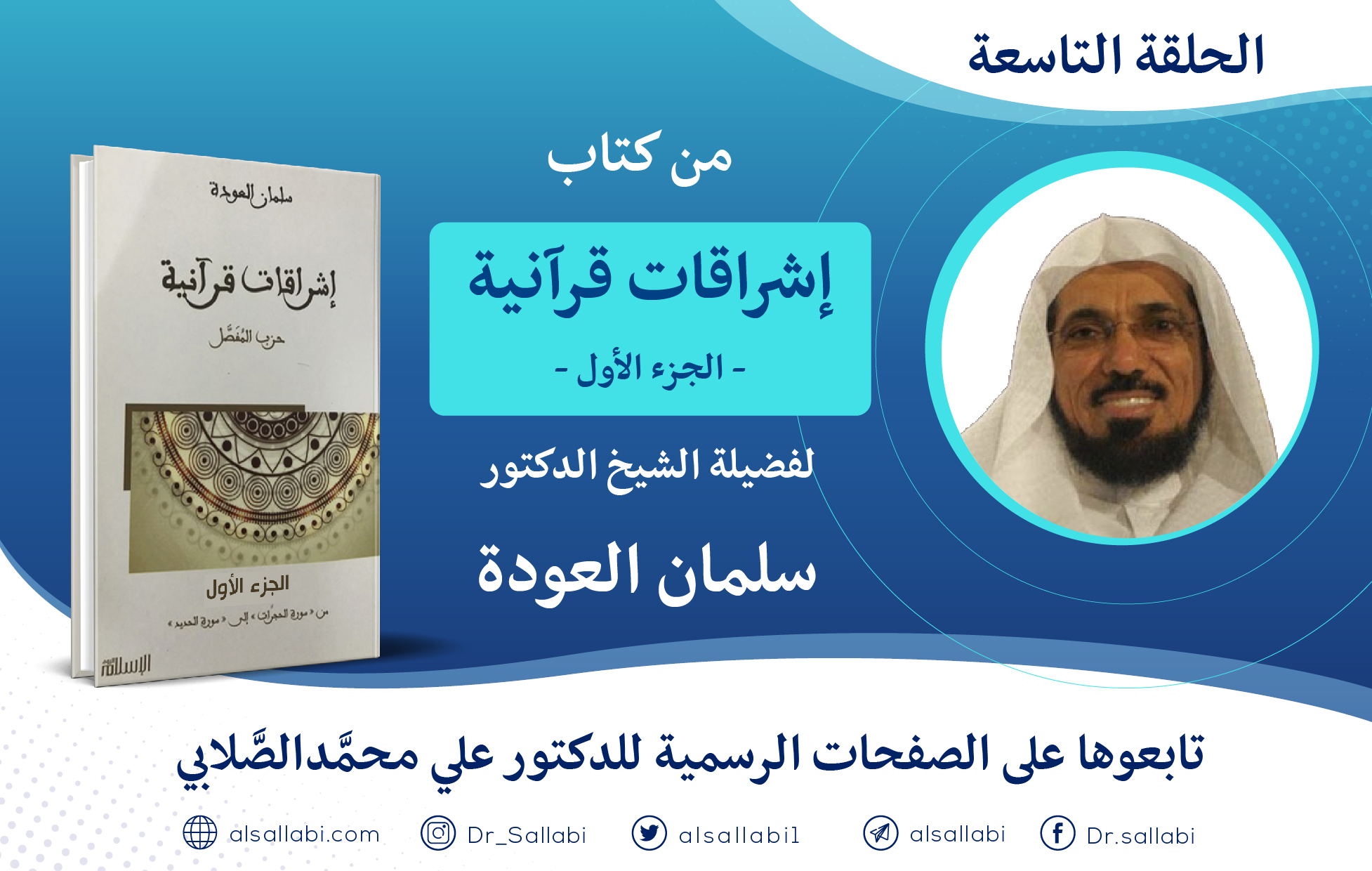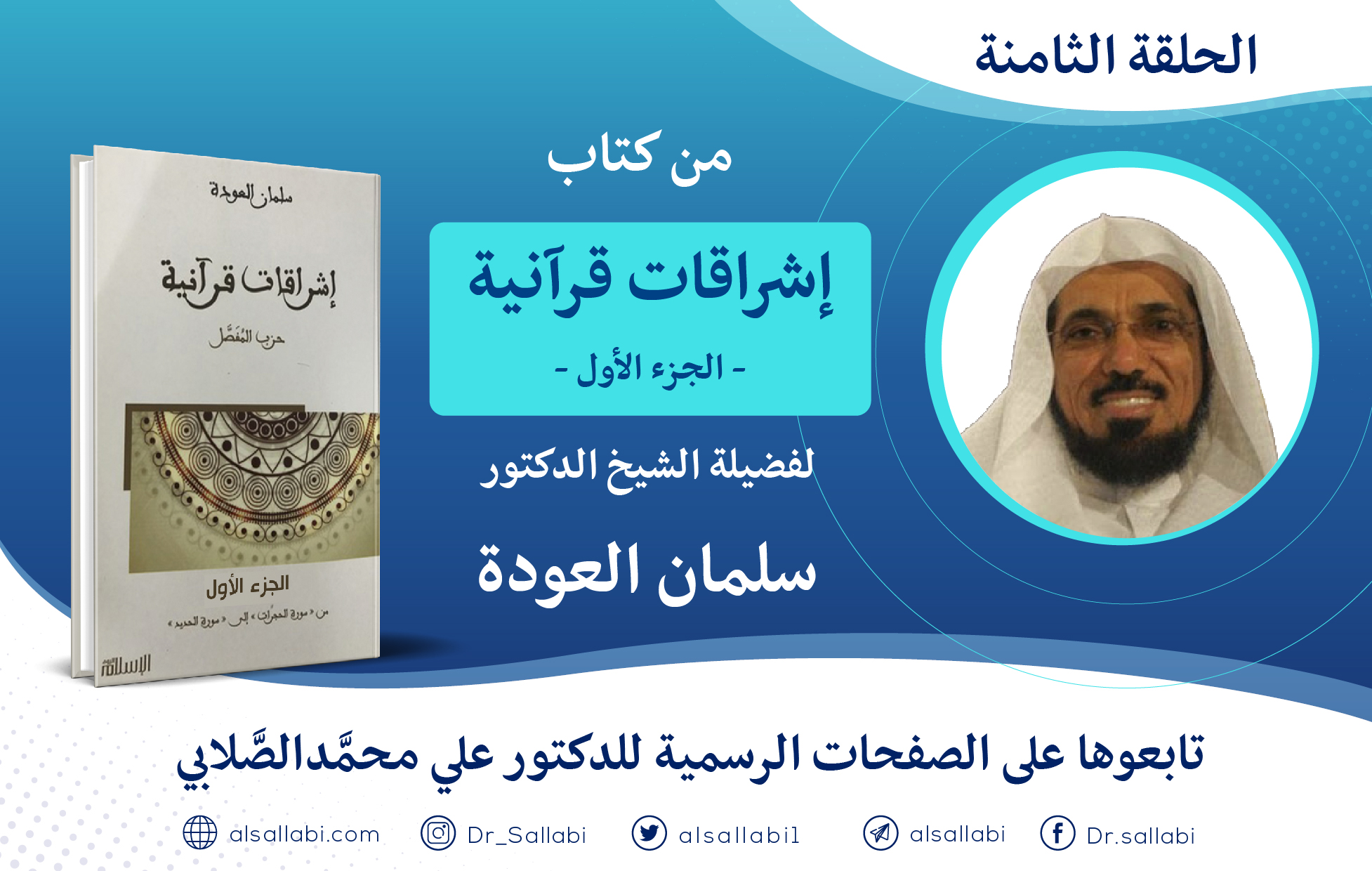من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة القمر)
الحلقة العاشرة
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الأول 1442 هــ/ نوفمبر 2020
* تسمية السورة:
تُسمَّى: «سورة القمر»؛ لذكره في صدرها، وهو الاسم الغالب في المصاحف، وكتب التفسير، والحديث.
ومن أسمائها: «سورة {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَر }»، وتختصر إلى: «سورة {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ }»، و«سورة {اقْتَرَبَتِ }».
وقد جاء هذا في حديث أبي واقد اللَّيْثي رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ بـ
{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد }، و{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} في الفطر والأضحى.
* عدد آياتها: خمس وخمسون آية باتفاق علماء العدِّ.
* وهي مكية عند الجمهور.
وذكر بعضهم أن فيها آية مدنية، وهي قوله تعالى: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر }، وأنها كانت في مناسبة غزوة بدر.
والصحيح أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية في غزوة بدر، وإلا فالسورة كلها مكية، نزلت قبل الهجرة بخمس سنوات، وقد صحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لقد أُنْزلَ على محمد صلى الله عليه وسلم بمكةَ، وإني لجاريةٌ ألعبُ: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر }».
وحادثة انشقاق القمر كانت عند المحقِّقين من أهل العلم قبل الهجرة بنحو خمس سنوات.
* {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَر }:
اقتراب الساعة: دُنوُّها، فهو اقتراب زمني، وقد جاء هذا مسجَّلًا في القرآن في مواضع، كما في قوله تعالى: {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُون } [الأنبياء: 1]، وقوله سبحانه: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا } [الأحزاب: 63]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بُعثتُ أنا والساعةُ كهاتين». وقرن بين السبَّابة والوسطى. وفي لفظ: «إن كادتْ لتسبِقُني».
وثَمَّ قربٌ عام من حيث إن كل وقت يمضي يقرِّب الساعة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين؛ وكانت بعثته من علامات الساعة الدالة على قربها، وقد ألَّف السُّيوطيُّ رسالة سماها: «الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف»، وساق فيها أحاديث وروايات تدل على أن هذه الأمة قد تتجاوز ألف سنة، وهذا صار تاريخًا ماثلًا، والسُّيوطي حين كتب كان قريبًا تاريخيًّا من الألف، حيث توفي سنة (911هـ) رحمه الله.
إن موضوع «نهاية العالم»، وتحديد ميقات {السَّاعَةُ } من الموضوعات التي تشغل بال كثيرين، وقد ينسجون حولها الأساطير والروايات، وكل شعوب العالم تتحدَّث عن موقعة «هرمجدون»، وهي المعركة بين الحقِّ والباطل، وهذا معتقد عند النصارى واليهود، والمسلمون يؤمنون أن للساعة أشراطًا وعلامات، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون أداة لترويج القصص الخيالية ونسج الحكايات الوهمية، ولا أن يكون سببًا في عزوف الناس عن مصالحهم وتحقيق مقاصدهم؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إن قامت الساعةُ، وبيد أحدكم فَسِيلةٌ، فإن استطاعَ أن لا يقومَ حتى يغرسَها فليفعلْ». فالشرع يؤكِّد أهمية العمل والانغماس فيه والدأب، حتى ولو قامت الساعة، وحفز الناس على العمل الصالح ومصالح الحياة الدنيا التي لا يقوم معاشهم إلا بها.
أما انشقاق القمر: فقد ورد عن الحسن البصري وعطاء أن المراد بالانشقاق في الآية: انشقاق القمر يوم القيامة، ونسبه بعض المفسرين إلى الجمهور.
والأقرب أن هذا قول لبعض الأئمة، وأما الجمهور فذهبوا إلى أن المقصود حادثة وقعت في مكة قبل الهجرة، حيث طلب المشركون- كعادتهم- من النبي صلى الله عليه وسلم آيةً، فأراهم اللهُ تعالى انشقاق القمر، وأخبرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن القمر سوف ينشق، ونظر الناسُ إليه فيما يشبه الخسوف، فرأوه فِلْقتين، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للصحابة: «اشهدوا». كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح.
وجاء هذا المعنى عن جمع من الصحابة، كابن عباس، وابن مسعود، وحُذيفة بن اليمان، وابن عمر، وأنس، وغيرهم رضي الله عنهم.
وادَّعى بعضهم أن الخبر متواتر، والصحيح أنه مشهور وليس بمتواتر.
وقد تردَّد البعض في صحة الرواية؛ بأن الانشقاق لو كان وقع فعلًا لذكره الفلكيون والمؤرِّخون من غير المسلمين والعرب، ويبعد أن يقع هذا ثم لا يستفيض خبره في أرجاء الأرض.
فيقال جوابًا لذلك: إن القمر في تلك الساعة قد يكون لآخرين مختفيًا غائبًا، أو يكون حدوث ذلك لبلد آخرَ في آخرِ الليل والناس نيام، أو تكون لحظة الانشقاق قصيرة، كما يحتمل أن يقدِّر الله الانشقاق بطريقة لا يتأثر بها جِرْم القمر، {وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز }.
لقد اختار الله سبحانه أن يكون محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن يمهل الناس ولو كذَّبوا، حيث موعدهم يوم القيامة، كما قال: {بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً } [الكهف: 58]، أما الأمم السابقة فكانت تُؤخذ عادة بما يُسمَّى: عذاب الاستئصال، فإذا لم يؤمنوا نزلت عليهم العقوبة، واستأصل الله تعالى شأفتهم وأبادهم وانتهوا، أما هذه الأمة فإن الله تعالى يمدُّ لهم بحيث لا يهلكهم بسَنَة بعامة حتى يأتي أمر الله.
* {وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِر }:
فإذا رأى هؤلاء المشركون آيةً من آيات الله تعالى، فإنهم يُعرضون عن تدبرها، ويكتفون بنسبتها إلى السِّحْر، كما قالوا عن القرآن ذاته- وهو أعظم الآيات-:
{إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَر } [المدثر: 24].
ومعنى {مُّسْتَمِر }: دائم، فكأنهم يقولون إن هذا الرجل يأتينا بألوان وأنماط من السِّحْر متغيِّرة، فالسِّحْر مستمر وإن تغيرت مظاهره.
* {وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِر }:
فهم يكذِّبون بالرسل، ويكذِّبون بالآيات، ويتَّبعون أهواءهم: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ } [النجم: 23].
وأما قوله: {وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِر }: فهو يجري مجرى الحكمة، فلكل أَمْرٍ قرار ونهاية ينتهي إليها، فالحقُّ نهايته البقاء والتمكين، والباطل نهايته الزوال والبَوَار، كما قال سبحانه: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ } [الرعد: 17]، وكما قال: {لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ } [الأنعام: 67]، فكل نبأ من الأنباء أو خبر من الأخبار له مستقر ونهاية يتَّضح بعدها، فالآية تقرِّر السُّنَّة الإلهية في الصراع بين الحق والباطل، وهذا تنبيه للناس أَلَّا يغترُّوا بالظواهر، ولا يستعجلوا: {سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُون } [الأنبياء: 37]؛ فإن من طبيعة البشر الاستعجال، وهم بحكم جِبِلَّتهم يرون باطلًا ينتشر، فيدعون الله تعالى أن يزيله، ويرون حقًّا يُضَّطهد، فيدعون الله تعالى أن ينصره، وهم متعبِّدون بهذا الإحساس وبهذه الروح وبهذا الدعاء، ولكنه سبحانه يريد مع هذا الدعاء الذي تُعبِّدوا به، ومع فعل الأسباب المادية الممكنة، أن تتشبَّع نفوسهم بالحكمة الإلهية والاختيار الرباني والتوقيت الحكيم: {وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَّعْدُود } [هود: 104].
* {وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَر }:
الأنباء جمع: نبأ، وغالب ما يُطلق في القرآن الكريم على الخبر العظيم، كقوله: {وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِين } [النمل: 22]، وكقوله: {قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ } [التوبة: 94]، فهو خبر له أهمية وتتوافر الدَّواعي على نقله، وهؤلاء الناس جاءهم من الأنباء المذكورة في السورة وغيرها، ومنها إهلاك الأمم السابقة، ما هو كافٍ للزجر أن تزدجر قلوبهم عن الباطل وتتَّعظ وتتعامل بصدق مع الوعيد والوعد والأخبار والنبوة.
* {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُر }:
والحكمة هي: البصيرة التي تضع الشيء في موضعه، وهي المعنى العظيم في عبارة موجزة مُحْكَمة.
وهي هنا بالغة منتهاها في جودتها وإتقانها وضبطها، والمقصود: حكمته سبحانه، فمن أسمائه: الحَكِيم؛ ولهذه الآية معنيين:
الأول: حكمته تعالى في تصريف الأمور، وخلق الإنسان بنفسية وعقلية وطبيعة قابلة للهُدى والضلال والخير والشر: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن } [البلد: 10]، وحكمته في إرسال الرسل، وحكمته في منح الناس مشيئة بأن يصدِّقوا أو يكذِّبوا: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ } [الكهف: 29]، وحكمته في إنزال العذاب بالأمم السابقة، وفي إمهال آخرين.
ومنها: الحكمة في صنعه، الحكمة في خَلْقه، وكل ما يحدث في الكون له حكمة وإن كان الناس يغفلون عنها لا سيما في المجريات التي يعيشونها أو يشاهدونها، فنحن نسمع من الأنباء ما فيه مزدجر؛ من حوادث وفواجع وزلازل، وبراكين، وفيضانات.. إلخ، ولكن كثير من الناس يكتفون بالامْتِعاض دون الاتِّعاظ.
والناس يغفلون عن الحكمة في حوادث الكون، ولكل شيء {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا }.
إن الإيمان بالحكمة يمنح المسلم عصمةً من اليأس والقنوط والكفر؛ لأن من الناس مَن قد يرتد بسبب ما يراه من تسلط الأعداء على الأمة أو تسلط الظالمين وكثرة الفساد وانتشار التخلف في مجتمعات المسلمين، وقد يدفعه هذا إلى الشك في الدين أو كرهه لأهله.
وهذه الحكمة يمكن أن نسميها: الحكمة الكونية، أو: القدرية، ونظير هذا قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم } [الدخان: 3- 4].
الثاني: حكمته سبحانه وتعالى فيما يرسله إلى عباده في القرآن؛ ولذلك عقَّب بقوله: {فَمَا تُغْنِ النُّذُر }. ولذا سَمَّى القرآن: حكيمًا؛ لأنه مبني على الحكمة في الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار والسياق والترتيب والوصل والفصل.. والشريعة كلها حكمة منزَّهة عن العبث، ويدرك المتأمِّل من أسرار التشريع والبيان بقدر سعة علمه وقوة نظره وطول وقوفه عند الأسرار الربانية المذهلة.
وقوله: {فَمَا تُغْنِ النُّذُر } يحتمل أن تكون «ما» نافية، والتقدير: فلا تغني عنهم النذر، كما قال سبحانه: {وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُون } [يونس: 101]، فهؤلاء طبعوا على الكفر والإعراض، فلا تنفعهم النذر.
ويجوز أن تكون «ما» هنا استفهامية، وفيها معنى الإنكار، ويكون المعنى: أيُّ شيء تغني النذر عن هؤلاء القوم؟ ماذا تغني النذر؟
والنُذُر جمع: نذير، ويشمل: نذير القرآن، ونذير الآيات، ونذير العذاب.
* {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُر }:
{فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُر } هنا وقف، كما قال {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ } [النساء: 63]، وقد تقدَّم معنى التولِّي.
ومن معانيها: عدم الإلحاح، وإلا فالدعوة واجبة.
ومن معانيها: عدم الدخول في مجادلات لا تقدِّم ولا تؤخِّر، وإنما الواجب دعوتهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم.
ومن معانيها: الإعراض عن فئة منهم من أشخاصهم وأعيانهم ممن علم الله أنهم لا يهتدون، وهؤلاء ماتوا على الكفر، من أمثال أبي جهل وأبي لهب.
ومن معانيها: تصبير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحزن ولا تذهب نفسه عليهم حسرات، فقد بلَّغ البلاغ المبين، وأقام حجة الله على المعاندين، فدعهم وأَنْظِرهم إلى يوم الدين.
ثم استأنف حديثًا جديدًا بقوله: {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُر }، وإذا قُدِّر للإنسان أن يسمع هذه الآيات المزلزِلة بصوت مقرئ جيد، ويعيد استماعها، وينصت لها بجوارحه كلها، فإنها سوف تعيد ترتيب نفسيته من جديد، وتهزُّه هزًّا، حيث ذكر تعالى قرابة عشر مفردات متسلسِلة، لا يشعر بها السامع إلا إذا وقف عندها متأمِّلًا:
الأولى: {يَوْمَ }، وفيه أنه أجَّلهم وأمهلهم وأَنْظَرهم إلى ذلك اليوم، وفي كلمة: {يَوْمَ } تهديد، والتنكير في اللغة من معانيه التخويف والتضخيم، فهذا يوم واحد، ولكن له ما بعده!
الثانية: وَصَفَه بقوله: {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ }، فها هنا داعٍ يدعو من قِبل الله تعالى، ولعله إسرافيل عليه السلام، فكأنه يدعو الخلق جميعًا إلى شيء واحد.
الثالثة: {إِلَى شَيْءٍ }، و{شَيْءٍ } هنا منكَّر، فهو مهول عظيم، فلو اقتصر على قوله {شَيْءٍ } لكان كافيًا ولو قيل لك: «إنه في ذلك اليوم سوف يدعو الدَّاعي إلى شيء» كان هذا كافيًا ولم يحدِّد ماهيته، بل اقتصر على وصفه بأنه {شَيْءٍ } يُدعى الناس إليه.
الرابعة: ثم وصفه بأنه {نُّكُر } أي: منكر عظيم هائل يستنكره الناس؛ لأنهم لم يعرفوه ولم يتعوَّدوا عليه ولم ينتظروه؛ ولهذا إذا بُعثوا قالوا: {مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا }، ثم يعودون إلى أنفسهم ويقولون أو يسمعون مَن يقول لهم: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُون } [يس: 52].
الخامسة: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ }، كقوله: {خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ } [القلم: 43]، والخشوع هنا تعريض بهم أنهم كانوا معرضين عن الخشوع لله تعالى في الدنيا، ففي ذلك اليوم أصبحوا خاشعين بأبصارهم، خشوع مَذَلَّة وانكسار وهوان وشعور بأن الفرصة فاتت عليهم.
السادسة: {يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ } جمع: جَدَث، وهو القبر، كقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:
حتى يقولوا إذا مَرُّوا على جَدَثي: * أرشدك اللهُ من غازٍ وقد رَشَدا
أن ترى الناس يخرجون من قبورهم سِراعًا بعدما نُفخت فيهم الأرواح وأذن الله تعالى بعودتهم إلى البَسِيطة؛ كما قال: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة * فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَة } [النازعات: 13- 14]، أي: على ظهر الأرض أحياء بعدما كانوا في بطنها أمواتًا.
السابعة: {كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِر }، والجراد: حشرة معروفة، تطير أفواجًا، فتأتي على الحرث الأخضر واليابس.
الثامنة: وصف الجراد بأنه {مُّنتَشِر }، وقد يكون معناه من النُّشُور، تشبيهًا بالجراد الصغير الذي تخلَّق صغيرًا، فكأن الإشارة إلى أنهم خرجوا من الأرض ونُشروا إلى الأرض إلى ظاهرها، والنُّشُور هو: الحياة أو البعث.
أو معنى {مُّنتَشِر } أي: متفرِّق، والجراد هنا يهيم على وجهه، ويضرب بعضه بعضًا، ويطأ بعضه بعضًا، وهذا من طبيعة الجراد.
وفيه إشارة إلى أنهم هائمون على وجوههم، ليس لهم وجهة معيَّنة، ولا يلتفت أحد لأحد.
التاسعة: {مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ }، والإِهْطاع فيه معنى الإسراع والرَّكْض على غير بصيرة، وفيه معنى الذُّل والخضوع، والمُهْطِع يتَّجه ببصره صوب وجهة واحدة، لا يكاد يلتفت إلى غيرها.
والإِهْطاع لا يكون إلا مع خوف ووَجَل، ومثله قوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء } [إبراهيم: 43]، ويقال: بعير مُهْطِع، إذا مشى وقد مدَّ عنقه وصوَّب رأسه!
العاشرة: {إِلَى الدَّاعِ }، فهم ذاهبون إلى جهة الصوت الذي يدعوهم أو يناديهم، غافلون عما حولهم، ومن عادة الذي يسمع صوت مستغيث أو مستنجد ويسرع إليه أنه يكون رافع الرأس، وقد يظهر مع ذلك ميل في رقبته وهو متجه إلى الصوت، كما تقول العرب: «لا يَلْوِي على شيء». أما هؤلاء فهم مقنعوا رؤوسهم مطأطئوها؛ لأنهم خائفون وجلون مكروبون.
الحادية عشرة: {يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِر } أي: عسير، كما قال: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِير * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير } [المدثر: 10،9]، وفي قوله: {يَقُولُ الْكَافِرُونَ } إشارةٌ إلى أن عُسْره، ليس على عامة الناس، بل هو خاصٌّ بالكافرين، أما المؤمنون فيصبهم منه ما يصيبهم، ولكن {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ } [إبراهيم: 27].
* {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِر }:
ينتقل السياق إلى عدد من القصص، ويسوقها مساقًا عجيبًا سريع الوَتِيرة، عظيم التأثير، بما يتضح معه أن المقصود ليس حكاية تفصيل القصص؛ بل هز القلوب الغافلة، وتحريك النفوس المعرضة، وإحداث الاعتبار والحَفْز على التفكر؛ احتجاجًا على الملأ من قريش.
{قَوْمُ نُوحٍ }: إنما نسبهم إلى نوح عليه السلام- كما في سائر المواضع في الكتاب العزيز- لأن هذا أسرع في البيان والبلاغ، ولم يكن لهم اسم معين، وإنما هم قومه.
{فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا }: وصفه بالعبودية، وجاء بضمير العظمة؛ تمهيدًا لذكر النجاة له وإجابة دعوته، فهو عبده الذي يستغيث به، وتمهيدًا لذكر هلاك المكذِّبين المعاندين، والغالب في القرآن الكريم أن نسبة العبيد إليه سبحانه نسبة تشريف وثناء.
{وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِر }: وصفوه بالجنون، واختار الله تعالى هذا المقطع من كلامهم عن نوح عليه السلام؛ لأن المشركين في مكة كانوا يصفون النبيَّ صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فكأنه يقول: إن قيل لك هذا فقد قيل هذا لمَن قبلك من الرسل والأنبياء، فلا تحزن، ولا تجزع، كأنهم تواصوا به، فهي كلمة قديمة يردِّدونها.
{وَازْدُجِر } أي: أنهم زجروه عليه السلام ولم يرعوا منزلته، وما بعث اللهُ بعده نبيًّا إِلَّا وله مكانة في قومه، ومع ذلك لم يرعوا منزلته، وإنما زجروه وهدَّدوه بالقتل وقالوا: {لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِين } [الشعراء: 116].
ورُوي عن مجاهد أن قوله تعالى: {وَازْدُجِر } أي هذا من تمام قولهم له فيكون تقدير الكلام: هذا مجنون ومع جنونه قد ألمَّ به شيء يزيده اندفاعًا وعتوًا، وقول الجمهور أقوى.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: