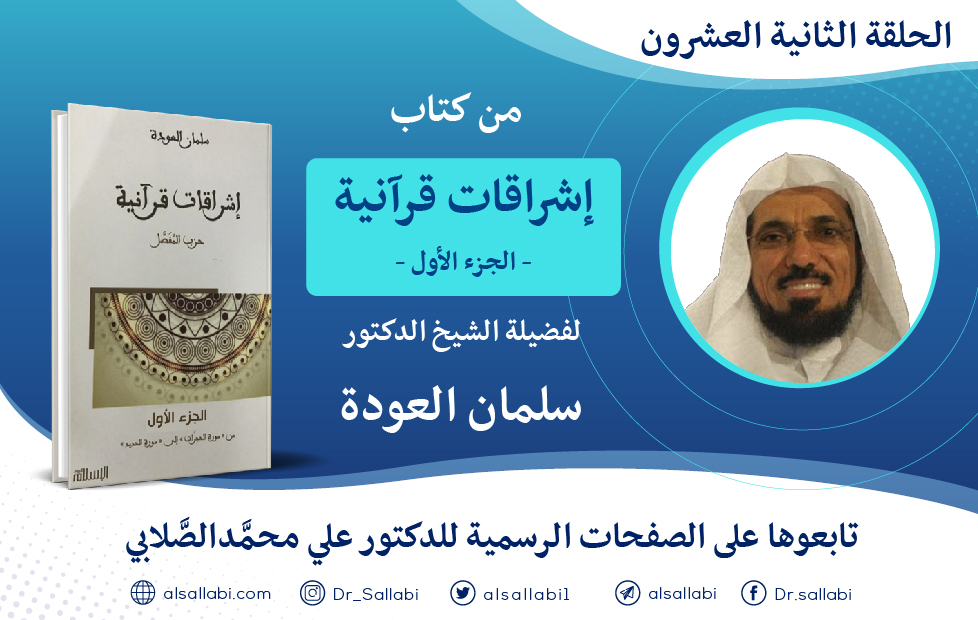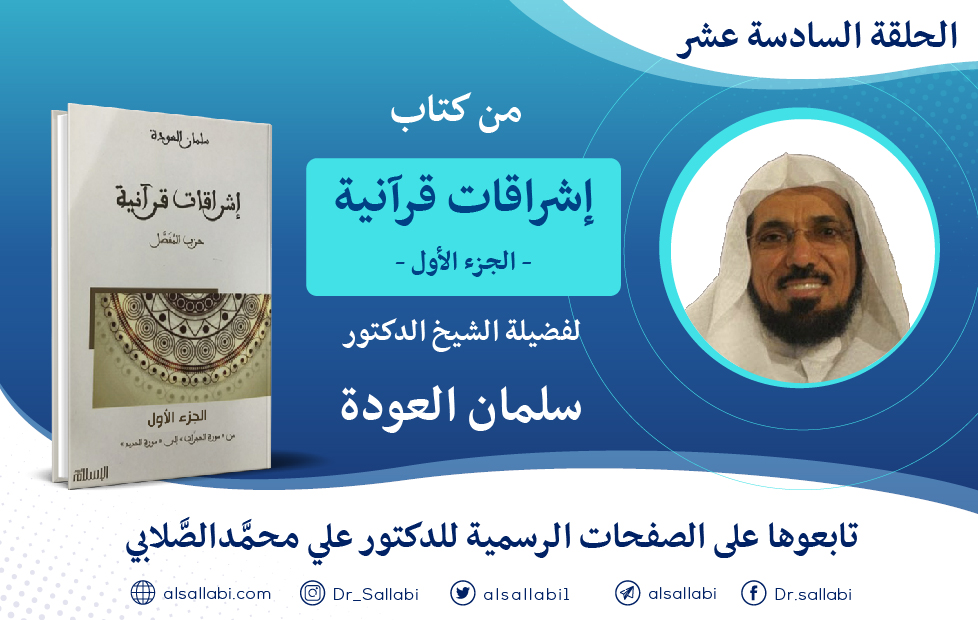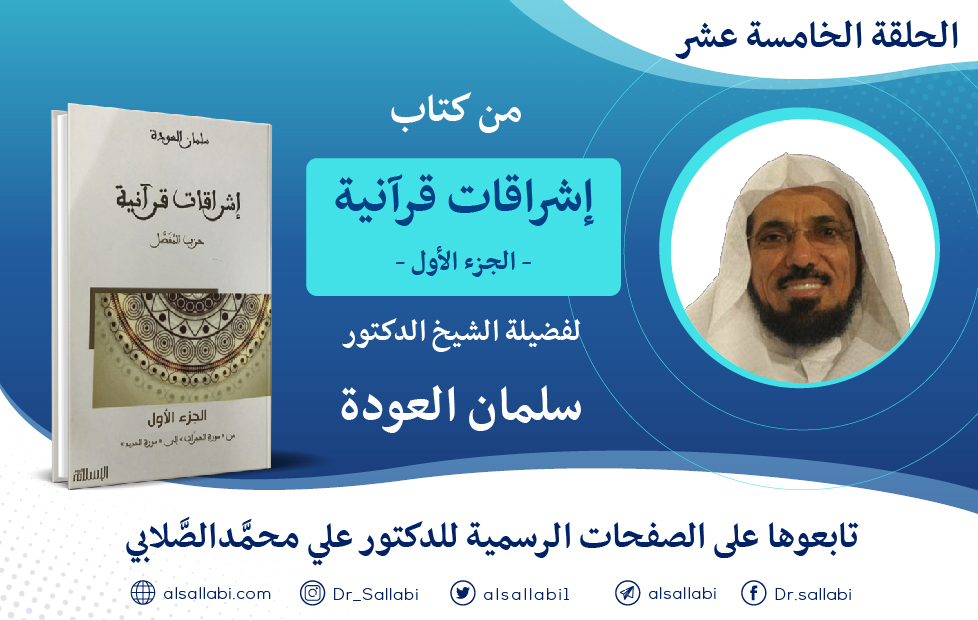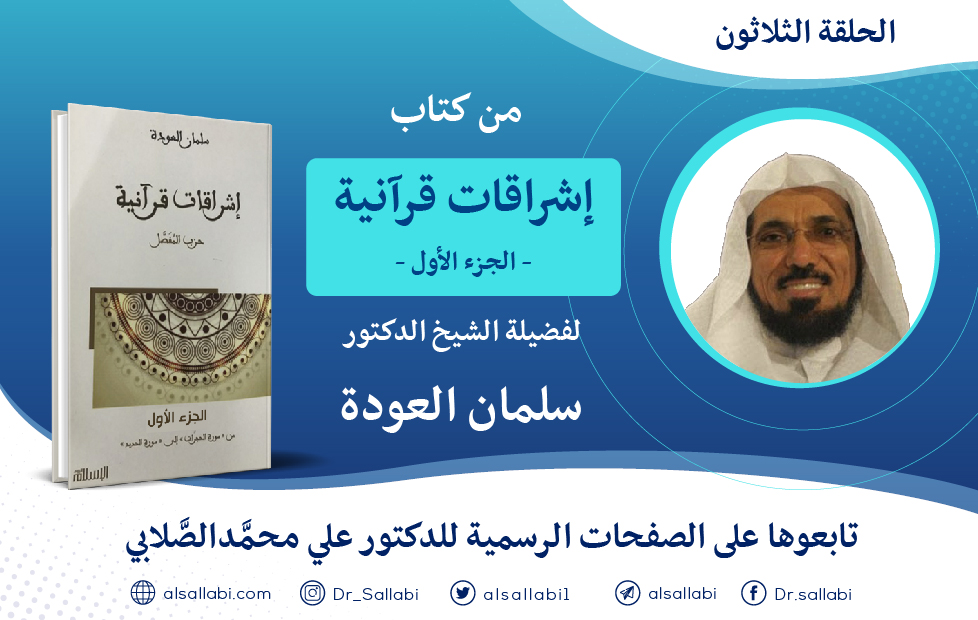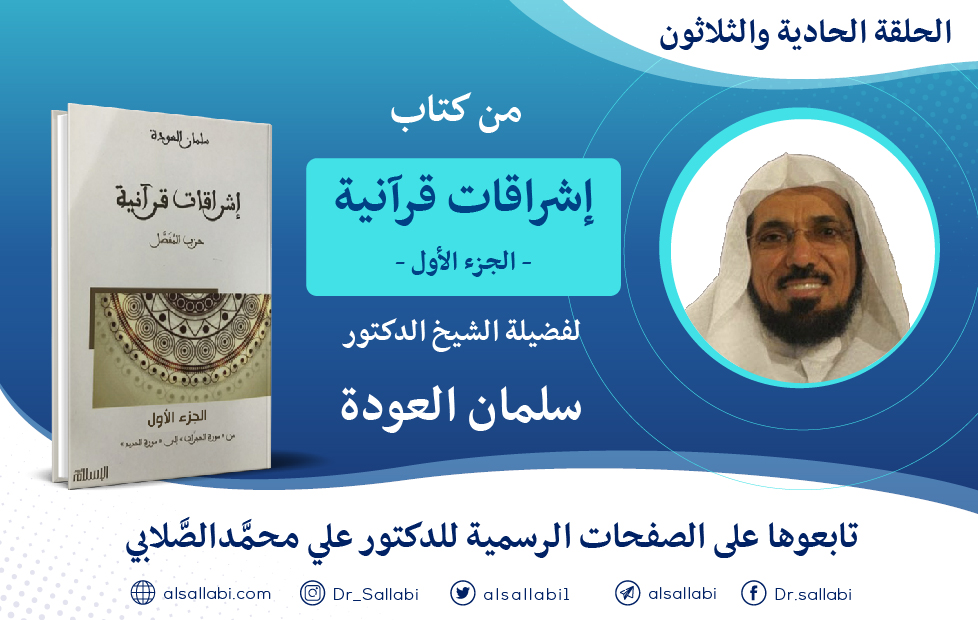من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الحديد)
الحلقة الثانية والعشرون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ نوفمبر 2020
* {فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِير }:
لقد كانوا يُسألون في الدنيا القرض الحسن- ولو بالقليل من المال- فيبخلون، ويموتون والأموال مكدَّسة عندهم لم يبذلوها ولم يُقْرِضوها، فهل كانوا يدَّخرونها لتكون فِدْية تنجيهم من عذاب الله يوم القيامة؟
ففي ذلك الموقف مهما بذل الإنسان وأعطى، فإنه لن يُقبل، على أنه لا يوجد عنده شيء يمكن أن يفتدي به: {لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ } [المائدة: 36] ولكن ليس لهم شيء يوم القيامة حتى يفتدوا به، وإذن لا يُقبل منكم أيها {الْمُنَافِقُونَ }، {وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا }، و {مَأْوَاكُمُ النَّارُ } أي: مصيركم النار، فهي أولى بكم وأجدر؛ بحكم ما كنتم عليه من النفاق والتلون والخداع والتضليل وسوء الظن بالله عز وجل.
* {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون }:
هذه الآية قيل: إنها مكية؛ حيث ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتَبَنا اللهُ بهذه الآية، إِلَّا أربعُ سنينَ».
وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم- منهم ابن عباس- أنهم قالوا: إنهم خُوطبوا بالآية بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من إيمانهم.
وفي ذلك آثار عديدة؛ فالأقرب أن الآية مدنية، والله أعلم، والسياق مدني.
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتَبَنا اللهُ بهذه الآية إِلَّا أربعُ سنينَ». فلعل هذا محمول على ملأ من الصحابة ممن تأخَّر إسلامهم، وليس على خصوص ابن مسعود رضي الله عنه.
وفي القصة معنى لطيف، وهو أن الإنسان يكون خشوع قلبه وحضوره في أول إيمانه أكثر؛ لأنه حديث عهد بالجاهلية والمعاصي، فإذا سمع القرآن أو صلَّى أو دعا أو سمع موعظة، أجهش وتأثَّر؛ لطراوة إيمانه وحماسه وحضور قلبه، فإذا مضى عليه وقت هدأت نفسه، وتحوَّلت بعض العبادات إلى شيء من المألوف، وعافس الأزواج والأولاد والضَّيْعات والأموال، ونسي ولابسته غفلة.
ولذلك رُوي أنه لمَّا قدم أهلُ اليمن في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وسمعوا القرآن، جعلوا يبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: «هكذا كنا، ثم قستِ القلوب».
يعني إنه في فترة مضت كان أكثر رقة، وهذا نوع من عتاب النفس.
فلذلك خاطبهم سبحانه وقال: {أَلَمْ يَأْنِ }، وهو مأخوذ من «الإنى» بالألف المقصورة، وهو الوقت، كما قال سبحانه: {إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ } [الأحزاب: 53]، أي: غير منتظرين وقت نضجه، أي: ألم يحن؟ وهذا استفهام المقصود منه التقرير والاستدعاء والطلب، أي: قد آن لكم أن تخشع قلوبكم بعد أن آمنتم وأن يتحوَّل الإيمان إلى حركة في الرُّوح ويقظة في الضمير.
فالخشوع هو: الإخبات والانكسار له سبحانه، وأن يكون في القلب يقظة للآيات والذِّكر، وقد دعاهم إلى الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق، والذِّكر في الأصل شامل للقرآن وغيره، أما وقد عطف عليه {وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ } - وهو القرآن- فيكون المقصود بالذِّكر: التسبيح، وعموم الذكر والدعاء ونحوه.
{وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ }: وهم اليهود والنصارى، فهم أُوتوا الكتابَ، وحصل لأولهم إيمان وخشوع، {فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } أي: طال عليهم الزمن، {فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون } يحذِّر المؤمنين أن يكون مصيرهم كمصيرهم، فيطول عليهم الزمن، وتقسو قلوبهم، كما قال لليهود:
{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً } [البقرة: 74]، وقال: {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ } [الزمر: 22].
وهنا سؤال: هل طول الأَمَد يسبِّب قوة الإيمان ورسوخه، أم يسبِّب ضعفه وقسوة قلب العبد؟
على الصعيد الفردي يعتمد الأمر على المجاهدة والعمل، فالزمن عنصر محايد يمكن توظيفه في ترسيخ الإيمان وحشد دلائله، وفي العبادة والخير وطلب العلم وصحبة الصالحين، فيكون طول العمر سببًا للقرب من الله.
ويحدث غالبًا أن يقع المَلَل والتثاقل والميل للشهوات وترك الجِد والحزم، فيكون الزمن سببًا للغفلة وضعف الإيمان.
والآية تشير إلى سُنَّة إلهية غالبة، في أن الأمم والدول تبدأ قوية، وفيها اندفاع واهتمام، ثم يدخلها الضعف والترهُّل والرُّكون إلى الدنيا والفساد والأَثَرة، ثم تحق عليهم السنة ويعم الضعف: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ } [مريم: 59].
وفي هذا الخطاب الربَّاني اللَّطيف دعوة إلى الوعي واليقظة؛ لأن الزمن ليس في صالحك دائمًا، فإذا لم توظِّف الزمن توظيفًا إيجابيًّا، فستكون سريع الانهيار، وهكذا الدول والقوى المختلفة.
ولذلك كان أفضل هذه الأمة: الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذا شاهد على السُّنَّة الإلهية على أن الأمة لا تخلو من خير حتى في آخرها، ولكن الكلام عن المجموع.
وبعض الناس يغلبهم التشاؤم فلا يرى الناس إلا في هلاك وفساد، وأن العصر عصر انحلال، وبعضهم- مع هذا- يتخيل أن دولة الخلافة الراشدة على الأبواب.
وهذا توقع مجافٍ للسياق التاريخي، وليس له ما يسنده من سُنَّة ولا من واقع، والمطلوب الاعتدال والتوازن، فلا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم، ولا تواكل ولا غفلة ولا مبالغة.
* {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون }:
هذا مَثَل ضربه الله سبحانه وتعالى في الخشوع والإيمان، فيا مَن تشعرون بقسوة في قلوبكم لا تيأسوا، و{اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا }، فكما أن الأرض الميتة تحيا بالمطر فتصبح خاشعة: {فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ } [فصلت: 39]، كذلك أنتم أيها المؤمنون إن شعرتم بقسوة في قلوبكم فتذكَّروا {أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا } أي: فيحيي قلوبكم بالإيمان كما أحيا الأرض بالمطر؛ ولهذا شبَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الوحي بالمطر، فقال: «مَثَلُ ما بعثني اللهُ به من الهُدَى والعلم، كمَثَل الغَيْث الكثير أصابَ أرضًا، فكان منها نَقِيَّةٌ، قَبِلت الماءَ، فأنبتت الكَلَأَ والعُشْبَ الكثيرَ، وكانت منها أَجَادِبُ، أمسكت الماءَ، فَنَفَعَ اللهُ بها الناسَ، فشربوا وسَقَوْا وزرعوا، وأصابتْ منها طائفةً أخرى، إنما هي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلَأً، فذلك مثلُ مَن فَقُهَ في دين الله، ونَفَعَهُ ما بعثني اللهُ به فعَلِمَ وعَلَّمَ، ومثلُ مَن لم يَرْفَعْ بذلكَ رَأْسًا، ولم يَقْبَلْ هُدى الله الذي أُرْسِلْت به».
{قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون }: فالقرآن الكريم يبعث على الخشوع، فهو {مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ } [الزمر: 23]، وهو أهم سبب للإيمان ويقظة القلب؛ لأنه آيات الله البينات، وحججه الواضحة، وحديثه وكلامه إلى خلقه {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون } [المرسلات: 50]!
واختار كلمة: {تَعْقِلُون } قصدًا؛ فالخشوع ليس نقيضًا للعقل، وليس هو حالة خاصة البسطاء السُّذَّج الذين ليس لديهم عقل يفكِّرون به، أو ليس لديهم قدرات ذهنية على التحصيل، فالإيمان دعوة إلى عقول نيِّرة تعقل وتتفكَّر، والعقل هو من أعظم الأدلة والشواهد على الله سبحانه وتعالى، على وجوده وعلى أسمائه وصفاته، ومن غير عقل لا يوجد تكليف أصلًا، والخشوع ليس نقيضًا لوجود العقل الرشيد الذي يهتدي به المؤمن في مصالح دنياه وأسرته ووظيفته ودراسته وأمته ومشاريعها في النهضة والتنمية والتقدُّم، فهما قرينان لا ينفصلان، وإذا انفصلا وقع في الأمة انحراف؛ إما إلى الغلو أو التفريط، فيكون السلوك التعبُّدي منفصلًا عن العقل، ومنفصلًا عن الفقه والشريعة، أو يتجَّه العقل المجرَّد المغرور للاتجاهات المادية.
إن الضعف حالة إنسانية أصيلة، وأعتى الناس وأطغاهم وأقساهم إذا مرض أو هَرِم أو يئيس أو تعرَّض لأزمة ما.. انكشفت بشريته المخبوءة تحت ستار الوهم والتعاظم والكبرياء الكاذب!
* {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيم }:
في قراءة سبعية: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ }، بتخفيف الصاد، من الصدق، فعلى هذه القراءة تكون الآية ثناءً على المؤمنين والمؤمنات.
وفي القراءة الأخرى بالتشديد، يعني المتصدِّقين، وأدغمت التاء في الصاد.
فيكون الله تعالى أثنى على النساء والرجال بالإيمان والصدقة، كما قال سبحانه:﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 15-18] ، وقال هنا: {يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيم }.
وأثنى على النساء في الصدقة كما أثنى على الرجال، وفيه إشارة صريحة إلى حق المرأة في التملك؛ لأنها إنما تتصدَّق من مالها، وفي العالم الغربي قبل مئة وخمسين سنة لم تكن المرأة قادرة على التملُّك، في حين جاءت آيات تحثها على الصدقة، وهي لن تتصدَّق إلا من مال لا يتسلط عليه أبوها، كما يفعل بعض الآباء الجشعين الذين لا يخافون الله، فيتسلَّطون على رواتب بناتهم، وربما يحرمها من الزواج من أجل مالها، أو يسخط عليها إذا لم تعطه، ويحرجها من باب الأُبوة، وقد يعيِّرها أو يسبها، ولا يتسلط عليها الأزواج الذين يبحثون عن امرأة ذات غنى ومال، مع أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فَاظْفرْ بذاتِ الدِّين، تَرِبَتْ يداكَ».
* {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم }:
أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالله والرسل بأنهم {الصِّدِّيقُونَ}،
و {الصِّدِّيقُونَ } هم: السابقون، أو من السابقين، وقد ذكر سبحانه في القرآن ألوانًا من الصِّدِّيقين، كما ذكر عن يوسف عليه السلام: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ } [يوسف: 46]، وكما قال عن مريم عليها السلام: {وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ } [المائدة: 75]، ومن هذه الأمة أفضلها بعد نبيها: أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، ولو وُزن إيمانه بالأمة لوزنها ورجح بها، فالصِّدِّيقية ليست شيئًا مستحيلًا، وهي أعلى درجات الإحسان، وهي الرتبة الرفيعة النادرة التي يصطفي لها الخلاصة والخاصة من عباده السابقين، وحين جعل الله درجات الإيمان والإحسان والإسلام كان ذلك لتحفيز الناس إلى أن يترقوا في درجات الإيمان والإحسان، ويتنافسوا فيها، ويتسابقوا إليها، كما يتسابق أهل الدنيا إلى مقاماتها ومنازلها.
والصِّدِّيقية تعني سرعة التصديق، ولذلك سُمِّي أبو بكر رضي الله عنه بالصِّدِّيق؛ لأنه أول مَن صدَّق وأسرع مَن صدَّق، ولم يُقل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء إلا قال: «صدق صدق».
لكن حذار أن يفهم أحدٌ أن معنى التصديق أن يكون عقل الإنسان قابلًا لأن يصدِّق كل خبر دون نظر وتفكُّر، مسَتَقَرًّا للخرافات والأساطير، وإنما يُصدِّق بما هو مُتعبَّد بالتصديق به من قول الله سبحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت بالإسناد الصحيح، ويصدِّق الحقائق العلمية النافعة في الدنيا أو في الآخرة، أما ما وراء ذلك فينبغي أن يكون تصديقه عن تعقل وتثبت وحسن نظر.
ومن معاني الصِّدِّيقية: أن يكون صادقًا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِين } [التوبة:119]، {فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم } [محمد: 21]، والصدق هنا خُلق عظيم، يشمل الصدق بالكلام فلا يكذب مهما كلَّفه الأمر، إلا فيما جاءت الرخصة فيه مما رُوعيت فيه المصلحة الغالبة، دون توسع في التأويل، أو وقوع في التدليس.
كما يشمل الصدق في الأفعال والإيمان، فلا يكون متلوِّنًا يدور حيث تدور به مصلحته، ولا يدعو إلى شيء ويكون أول مَن يسارع إلى مخالفته.
ومن أعظم ألوان الصدق: الصدق في القلب، صفاء القلب، صفاء النية، حسن المقصد، إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة، أن يسلم الإنسان في داخله من الغل والحقد والحسد على الناس، بل يفرح لهم، وأن يجاهد نفسه في دفع الغل والحسد والغيرة، فإن «الحِلم بالتحلُّم، والعلم بالتعلُّم»، والصبر بالتصبُّر، ومن أسباب تحقيق ذلك أن يدعو للناس بخير في سجوده ولا يستثني أحدًا، فيدعو لنفسه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والمؤمن في كل حالاته يتمثَّل قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصِّدق؛ فإن الصِّدقَ يَهدي إلى البرِّ، وإن البرَّ يَهدي إلى الجنة، وما يزالُ الرجلُ يصدُقُ ويتَحَرَّى الصِّدقَ حتى يُكْتَبَ عند الله صدِّيقًا».
ثم وصفهم بأنهم: شهداء {عِندَ رَبِّهِمْ }، وهذه الأمة هي بالجملة أمة الشُّهداء على الناس، وهم شهداء على أنفسهم قبل ذلك، بالعدل والإنصاف والتحرِّي والنزاهة، فمؤمنو هذه الأمة مثل شهداء الأمم السابقة، وهم بمنزلة الشُّهداء عند الله، ولو ماتوا على فرشهم، {وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ }، فلهم أجر الصِّدِّيقية، ولهم النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
ويحتمل أن يكون قوله: {وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ } استئنافًا لكلام جديد، فتكون الواو للاستئناف، أي: أن الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وقُتلوا في سبيل الله لهم أجر عظيم.
وقد ورد: «للشَّهيد ستُّ خصال: يُغفرُ له في أول دَفْعة، ويَرَى مقعدَه من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُوضع على رأسه تاجُ الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوَّج اثنتين وسبعينَ زوجةً من الحُور العين، ويشفع في سبعينَ من أقاربه».
وفي الحديث: «إن في الجنة مئةَ درجة، أعَدَّها اللهُ للمجاهدينَ في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض».
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم }: عادة القرآن في المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء؛ ليكون العبد بين الخوف والرجاء.
* {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور }:
إذا وجدت الآية تُستفتح بهذا الأمر: {اعْلَمُوا }، فثمة أمر جَلَلٌ مهمٌّ، كما قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ } [محمد: 19]، وهي دعوة إلى التيقظ والمعرفة القلبية التي تتجاوز الكلام اللساني، والنظر العقلي، والقناعة الجافة، إلى ملامسة القلب والوجدان وصبغ الشخصية الإنسانية بصبغة الربانية الصادقة.
والحديث عن الدنيا ليس على سبيل الذم المطلق للحياة الدنيا، ولكنه وصف يهيِّئ المسلم إلى أن يقف موقف الاعتدال والاتزان، فيأخذ منها نصيبًا لا يشغله عن طلب الآخرة، ووصفها بأنها {لَعِبٌ }، واللَّعب ليس كله حرامًا ولا كله مذمومًا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يلاعب أهله، ويلاعب الصبيان ويمازحهم، وإنما المذموم ما تعدَّى إلى أن ينقلب أذى للآخرين أو عدوانًا على الممتلكات، أو انشغالًا عن الفرائض.
واللَّهو يكون عادة للمراهقين والشباب، وكذلك النساء فيهن ميل للهو.
وليس كل اللَّهو مذمومًا، و «الأنصارُ يعجبهم اللَّهو»، ويُثْنَى عليه في الأفراح والأعياد والمناسبات المشروعة، والمذموم منه ما تعدَّى الحدود، أو خالف الأمر، أو كان سببًا في تفويت فريضة، أو أشغل عن ذكر الله.
والزِّينة مطلوبة، والله تعالى خلق النجوم زِينة، والمال زِينة، والخضرة زِينة، وما على الأرض زِينة، والحيوانات زِينة، فهذا من بديع حكمته وصنعه، والمذموم منها ما بلغ حد السَّرَف والتَّرَف، مثل أن يتزيَّن الإنسان بالذهب أو بالحرير، أو تتزيَّن المرأة بما لا يجوز، أو يكون المقصود به الفتنة والإثارة والإغراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: «صِنفانِ من أهل النار لم أرهما». وذكر منهما: «ونساءٌ كاسياتٌ عاريَاتٌ مُمِيلَاتٌ مائلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائلة، لا يدخلنَ الجنةَ، ولا يجدنَ ريحها، وإن ريحَها لَيُوجدُ من مسيرة كذا وكذا». فهذه زينة مبذولة لغير الزوج، بل للفتنة والإثارة والإغراء، ومعظم ما وردت فيه النصوص من النهي عن ألوان من الزِّينة، فإنما النهي عنها لأنها تفضي إلى ما لا يحل، أو كانت ذريعة موصلة للمنكر والمفسدة، أو كانت غشًّا وخداعًا وتلبيسًا.
ثم ذكر التفاخر، وهو غالبًا للكهول ومَن هم أكبر منهم، فهم عادةً يتفاخرون بما هو لهم مجد زاهر، ومال وافر، وولد حاضر.
والتكاثُر في الأموال والأولاد في الغالب للكهول ومَن فوقهم في العمر، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يزالُ قلبُ الكبير شابًّا في اثنتين: في حُبِّ الدنيا، وطول الأمل». فهذا الشيخ الهَرِم يحب التكاثر في الأموال والأولاد، كما قال سبحانه: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر } [التكاثر:1]، و{التَّكَاثُر } هنا يشمل معنيين:
الأول: منافسة الآخرين.
والثاني: الحرص على الكثرة.
والمذموم منه هو المبالغة، وأن يكون مصدره حرامًا، أو أن يتحول إلى مفاخرة ومباهاة، أو حجب الحق عن المستحقين.
{كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ }: مثَّل تعالى الدنيا بالمطر الذي يعجب نباته الزُّرَّاع، والزَّارع يسمى: كافرًا، والقرية تسمى: كَفْرًا، وتشتهر هذه التسمية في مصر، وفي اختيار لفظ {الْكُفَّارَ } تعريض بالكفار الذين كفروا بالله ورسله وغرَّتهم الحياة الدنيا، وغرَّهم بالله الغَرور.
{ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا }: فهذا هياج يمثِّل مرحلة الشباب والكُهولة؛ لأن الزرع هنا قد اكتمل ونضج، ثم سَرْعان ما يصفر ويبدأ في الذُّبول، {ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا }: وهو تعبير عن النهاية والموت، فانظر إلى تناسب مراحل الحياة الدنيا مع مراحل الزرع في هذا المثل القرآني العظيم.
{وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ }: فالحياة الدنيا هي مزرعة الآخرة.
{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور } أي: أنها تغر صاحبها.
* {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم }:
ليس المقصود بالعَرْض هنا العَرْض المقابل للطول، وإنما المقصود بعرضها: سعتها؛ إذ لا معنى من تخصيص العرض دون الطول، فالمقصود سعتها وهذا معروف عند العرب، كما قال قائلهم:
ودونَ يدِ الحجَّاجِ من أن تَنالَني * بَساطٌ لأَيْدي الناعجات عَريضُ
وفي قوله: {كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ } تشبيه يقصد به أنها شديدة السعة، ولذلك لا يقال كما يقول بعضهم إذا كانت الجنة عرضها السماء والأرض، فأين النار؟ ولا يقول هذا إلا جاهل يظن أن الكون ليس فيه إلا ما يعرفه من السماوات والأرض.
{أُعِدَّتْ }: فيه دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، كما قال الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان». فالجنة موجودة، والأدلة على ذلك عديدة، منها هذه الآية.
* {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير }:
ما مناسبة الكلام عن المصيبة في السياق؟
قال بعضهم: لما جرى الحديث عن الجهاد والشهادة ناسب أن يذكر المصيبة.
والأقرب أنه لما ذكر الحياة الدنيا وما فيها والأموال والأولاد، عُرف أن الحياة الدنيا مبناها على الخطر، وحال الإنسان فيها الشقاء والمكابدة، وأنها لا تسلم من العوارض، فلا أحد بمنجاة من مرض أو نكسة في ماله أو نفسه أو أهله أو ولده، وما من أحد قط إلا وحاول شيئًا في الدنيا ثم لم يحصل عليه أو حُرم من أمر كان يتمنَّاه أيًّا كان ذلك الشيء، فالحياة لا تخلو من مصائب؛ ولهذا قال: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ }، وقد تكون المصيبة في النفس مرضًا أو همًّا أو غمًّا أو كآبة، وبعض الناس قد يسلم من الإعاقة والعجز البدني؛ ولكن في داخله من الاكتئاب والأحزان والقلق ما يعيقه عن تحقيق سعادته وراحته واستقرار نفسه واطمئنان قلبه.
على أن تخفيف ذلك أو إزالته ممكن بالقرآن واتِّباع هَدْي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يخالط الناس السُّعداء الذين يعيشون التفاؤل، فإن هذا يُعدي.
وقوله: {فِي الأَرْضِ }: إشارة إلى نوع آخر من المصائب، وهي المصائب العامة، مثل الطوفان، والزلازل، والبراكين، وحالات الفقر والجوع، والأمراض المعدية التي تنتشر بين الناس.. ونحوها من المصائب العامة التي تقع للأمم، فهذه كلها مكتوبة عند الله، وقد علمها وقدَّرها، وهذا من معاني الكتاب، فعلمه كتاب سبحانه، والقدر مدوَّن في اللَّوح المحفوظ، وهو كتاب عند الله لا يضل ولا يتغيَّر.
ومن معاني الكتاب: إذن الله بوقوعها، ولهذا قال: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11].
ونصَّ على المصيبة، مع أن الحوادث كلها- خيرها وشرها، كبيرها وصغيرها- لا تقع إلا بقَدَر، لكنه خصَّ المصيبة؛ ليؤكِّد أن الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، والاحتجاج بالقدر هنا يعطيك قوة ويمنحك إيمانًا، فبدلًا من أن تذهب نفسك حسرات في أمر لا يد لك فيه تركن إلى تقدير الله: «قَدَرُ الله، وما شاءَ فعل»، فيكون الأمر بَرْدًا وسلامًا على قلبك، ويذهب ما تجد من الإحساس بالألم أو الفقد أو الخسارة أو ضياع الأحلام، وتتهيَّأ الروح للبدء من جديد.
وثَمَّ فرقٌ ما بين المصيبة الفردية، والمصيبة الجماعية: فالمصائب العامة هي بما كسبت أيدي الناس: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ } [الروم: 41]، ولا يتعيَّن أن تكون مسؤولية فرد، وينزل البلاء عليهم جميعًا؛ لأنه لا يمكن إلا هذا، ثم يُبعثون على نياتهم.
ولا يحسن حينئذ أن نقول عن كارثة ما إنها مسؤولية قبيلة بعينها، أو أسرة بعينها، أو بلد بعينه؛ بحيث إذا نزل البلاء في بلد نتَّهم ذلك البلد تهمة عامة.
هذا ليس بسائغ شرعًا ولا عقلًا، فإذا وقع في بلد أمطار وأصيب الفقراء والمساكين والضعفاء، لم يحسن أن نقول: أنتم يا أهل البلد أهل معاصٍ وفجور.. فهذا توبيخ وتحكُّم، والمصيبة لا يلزم أن تكون عقوبة للأشخاص الذين نزلت بهم خاصة، وإنما هي عقاب عام، ودعوة إلى الاعتبار والتصحيح.
وكون المصيبة بسبب ذنب لا يمنع أن يكون ثمة آيات تُرسل للناس على سبيل الرحمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إنكم تَعُدُّونَ الآيات عذابًا، وإنَّا كنا نَعُدُّها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرَكَةً».
ونظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى معنى الاعتبار، فالله تعالى قد يعاقب أُناسًا ويترك مَن هم أشد منهم، حتى يذرهم في طغيانهم يعمهون: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: 182-183] ، وقد تكون المصيبة تخويفًا وتنبيهًا؛ لقوله ﴿يَعْلَمُونَ﴾ ﮕ تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا } [الإسراء: 59]، فتكون خيرًا من جهة أنها لو تأخرت لكانت أهول وأطول وأعظم، ومن علم أن التدبير بيد الحكيم الخبير رضي وآمن وسلَّم، وأدار البحث الرشيد في معرفة مصدر البلاء، وكيف يمكن للمكلَّف تداركه أو تلافيه.
{مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا }: الضمير هنا يعود على المصيبة، أو يعود على النفس، أو يعود على الأرض، وكلها مما سبق في الآية: {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير } أي: ضبط ذلك وحفظه.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: