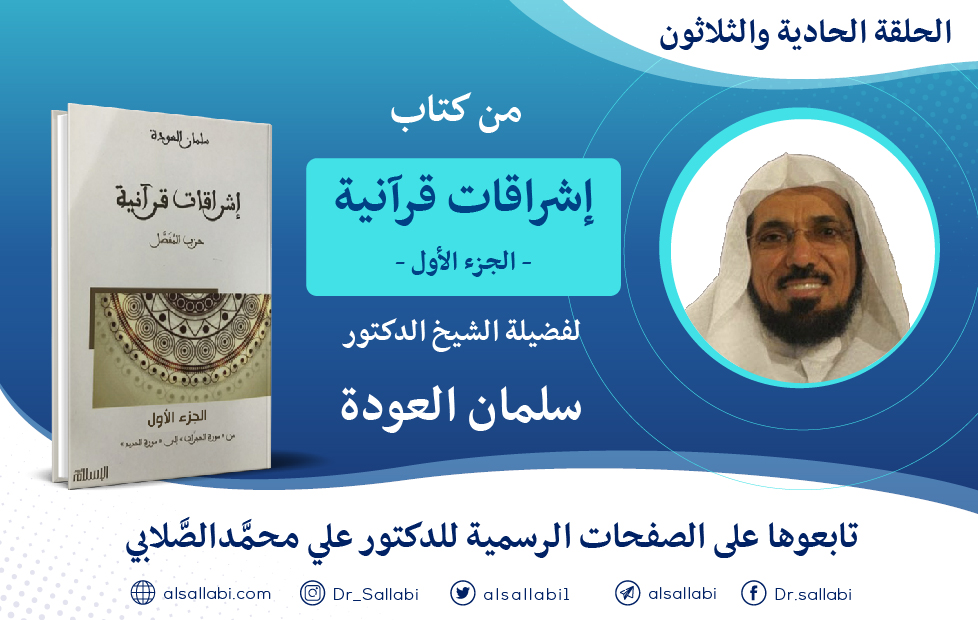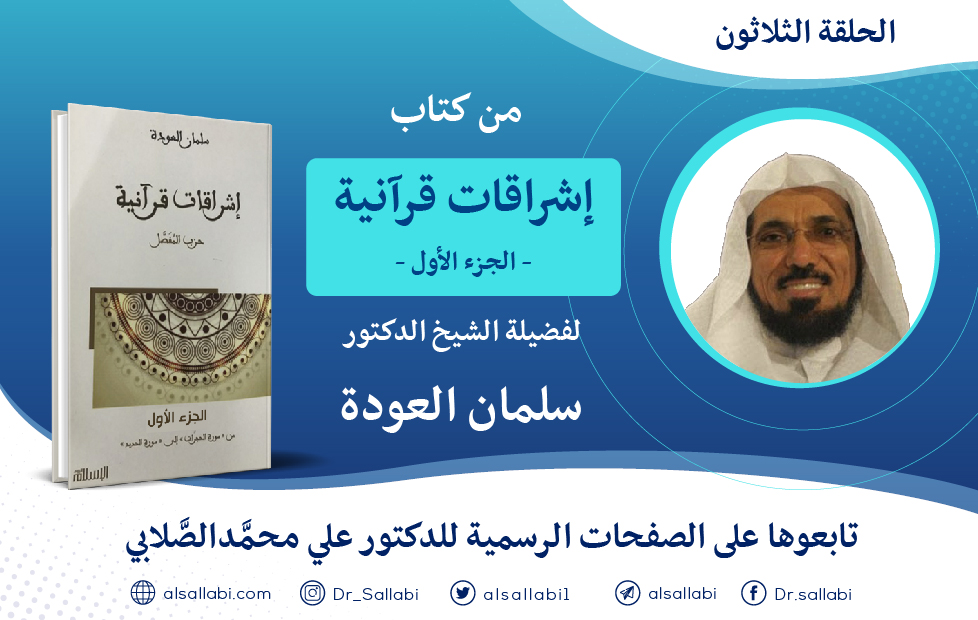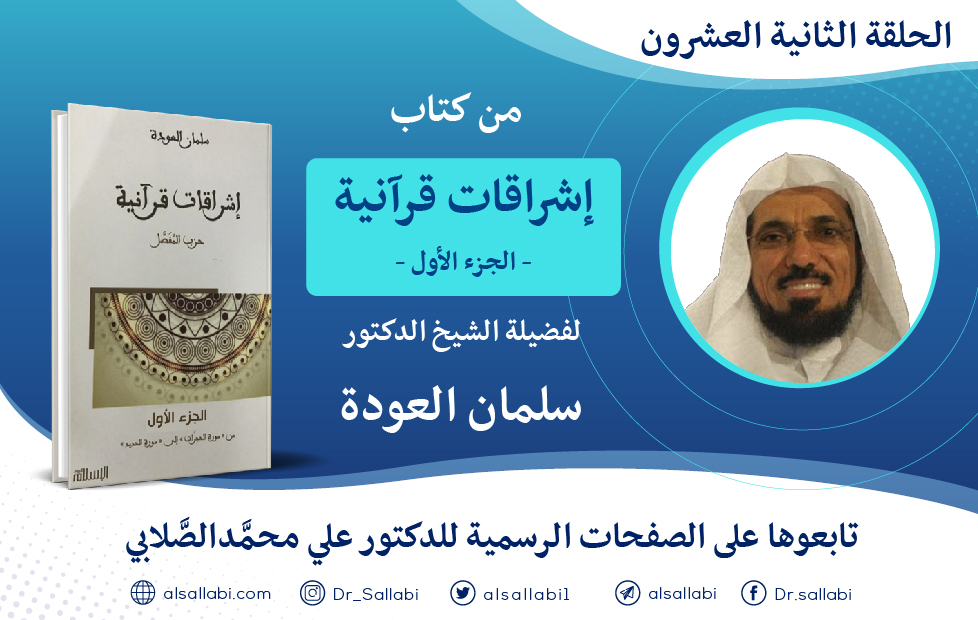من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الحشر)
الحلقة الواحدة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* {كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم }:
والمقصود: قريش- والله أعلم- في هزيمتهم يوم بدر، أو بنو قُريظة الذين جرى لهم ما جرى بعد بدر.
والوبال هو: السوء، ومنه المرعى الوَبِيل، إذا كان مرعى سيئًا ومذمومًا، {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم } في الآخرة.
* {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِين }:
ويشبه هذا قوله تعالى: {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ } [إبراهيم: 22].
والمعنى: أن هؤلاء المنافقين الذين وعدوا بني النَّضِير أن يخرجوا معهم لو أُخرجوا، هم في ذلك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر، فلما كفر تبرأ منه.
وادِّعاء الشيطان خوفه من الله هنا كذب؛ إلا أن يكون المقصود: خوفه من أن يأخذه الله عز وجل.
وقد ذكر بعض المفسرين قصة الرجل الذي يسمى: بَرْصِيصا، والذي زيَّن له الشيطان أن يزني بامرأة ثم حملت، فزين له أن يقتلها، فأمسكوا به، فجاء الشيطان وزيَّن له أن يسجد له لينقذه، فسجد له ثم تخلَّى عنه وقُتل.
وهذه القصة لا يصلح أن يفسَّر بها القرآن الكريم؛ لأنه ليس لها إسناد يعتد به، وهي من روايات بني إسرائيل.
وقد سمى الله سبحانه اليهود في علاقتهم بالمنافقين في أول «سورة البقرة» بالشياطين، كما في قوله: {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُون }، وذكر في «سورة الزخرف» الشيطان القرين، فلا مانع إذًا من إرادة الشيطان الإنسي في هذا السياق، وأنه يغري الإنسان بالكفر ثم يتخلَّى عنه.
وفي الآية تعريض باليهود الذين يخافون البشر أشدَّ من خوفهم من الله، وهم بهذا أسوأ حتى من الشيطان الذي قد يتخلَّى عن حليفه خوفًا من الله.
وليس لفظ {الشَّيْطَانِ } مقصورًا على إبليس الذي وعده الله بالإنظار إلى يوم الدين؛ بل هو عام لكل شياطين الجن والإنس.
* {فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِين }:
المثل هنا واضح، فكما أن المنافقين أَغْرَوْا اليهود بالبقاء وانخذلوا عنهم، وكان مصيرهم سيئًا، فاليهود طُردوا والمنافقون خُذلوا؛ لأنهم كانوا يتعزَّزون باليهود، فلما طُرد اليهود ذهبت قوتهم- ومنهم عبدُ الله بنُ أُبيٍّ ابنُ سَلُولَ ومَن معه- ولم يعد لهم شأن، فكذلك الشيطان والإنسان، فالشيطان يغري الإنسان ويقول له: {اكْفُرْ }، وإذا كفر كان مصيرهما معًا هو النار، فهذا عذاب الدنيا، وذاك عذاب الآخرة.
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون }:
ختم الله تعالى السورة الكريمة بهذا النداء القوي المؤثِّر الذي هو تعقيب على مجمل الحوادث المذكورة؛ فيذكِّرهم بهذا الحبل المتين، وأَلَّا تلهيهم الانتصارات والمكاسب التي حقَّقوها عن معنى الإيمان الذي به عَزُّوا وتميَّزوا، وأَلَّا تحملهم المعارك وخصوماتها وتفاصيلها والانهماك فيها عن مراعاة التقوى، حتى مع العداوة والشنآن، والتقوى معنى عامٌ يقتضي فعل الأوامر وترك النواهي وتجنب الحرام.
والغد هو: ما بعد اليوم، مثلما أن الأمس هو ما قبله، وكما يقول زُهير:
وأَعلَمُ عِلمَ اليَومِ والأَمسِ قَبلَهُ * ولَكِنَّني عَن عِلمِ ما في غَدٍ عَمِ
والمقصود بالغد: يوم القيامة؛ إشارة إلى قربه.
ثم كرَّر الأمر بالتقوى، ويحتمل أن يكون الأمر الثاني مختلفًا عن الأول، فأمرهم بتقوى الله بفعل الطاعات؛ ولهذا قال: {وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } يعني: من الطاعات وأعمال الخير، ثم كرَّر وقال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون} إشارة إلى ترك المنهيات والمحرمات.
* {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون }:
وفي هذا إشارة إلى اليهود الذين نَسُوا الله فأنساهم أنفسهم، فأصبح في تدبيرهم من الخرق وسوء التقدير وفساد الحساب ما هو ظاهر للعيان، فلا تكونوا مثلهم واعتبروا بحالهم.
ومن المعاني هنا: أنهم انشغلوا بالأشياء عن أنفسهم؛ فكثير ممن نَسُوا الله تعالى تجدهم مشغولين بتجارة أو وظيفة أو شهرة أو متعة تلهيهم حتى عن حاجات نفوسهم.
وأنت تجد هذا بشكل أوسع في الأمم والشعوب التي نسيت الله تعالى وانشغلت بمادياتها وحياتها العاجلة، وشاعت فيها نظريات الإلحاد والكفر بالله والجراءة على ذاته العلية وحدوده وشرائعه باسم الحرية، بينما لا تسمح تلك الحرية بالمساس برموز تاريخية أو وطنية وتعاقب مَن يشكِّك أو ينفي الهولوكوست (المحرقة النازية)!
ثم تدرَّج بها الحال إلى أن تكفر بالإنسان ذاته ولا تُقيم له وزنًا، وتُشكِّك في حقيقته وأهميته وأصله وعقله، فهم نَسُوا الله تعالى فأنساهم أنفسهم، كفروا بالله فآل الأمر إلى أن يكفروا بالإنسان.
ومن هذا أنهم لما نسوا الله جعل الله الأشياء التي يمتلكونها وبالًا عليهم، وضرُّوا بها أنفسهم وأضلُّوا بها غيرهم وأضروهم:
فالعلم تحوَّل إلى أداة لتحصيل الأسلحة التي من شأنها تدمير الحياة البشرية على وجه الأرض، حينما انفلت من عقاله، ولم يكن باسم الله سبحانه.
والعبث في الجينات البشرية وعمليات الاستنساخ واللعب بالأجنة التي تحوَّلت إلى مزارع، ليس لخدمة الإنسان، أو للقضاء على بعض الأمراض أو معالجتها، فهذا مطلب مشروع، ولكن لأنه لم يكن باسم الله فقد انفلت من عقال الأخلاق والمصلحة الإنسانية العامة، وأصبح ضررًا ووبالًا على الإنسان.
ونحن اليوم نتكلم عن المدنية والحضارة والتسهيلات في المواصلات والاتصالات والإعلام والخدمات الطبية، لكن مَن الذي يستطيع أن يقول: إن الرفاهية والسعادة التي يشعر بها الإنسان اليوم أفضل مما كان عليه الإنسان قبل مئتين أو ثلاثمئة سنة؟
ومَن يقول: إن البشرية نجت من غوائل العدوانية والعنصرية والسعي لتكريس الأنانية الفردية لثري أو زعيم، أو الأنانية الجماعية لجنس أو لون أو شعب على حساب الآخرين؟
* {لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُون }:
فالناس صنفان، لا ثالث لهما، وهما متباينان كليًّا، وفي التعبير إشارة إلى عمق المسافة بينهما؛ ولهذا لم يقل: «أصحاب الجنة أفضل»، وإنما قال: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُون}، أما أصحاب النار فلا فوز لهم بوجه من الوجوه.
* {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون }:
المعنى: لو خاطبنا الجبل بالقرآن بعد أن أصبح مؤهَّلًا ومهيَّئًا للخطاب بقدرة الله سبحانه، مع أنه حجر صلد، لخشع وتصدَّع من خوف الله.
والمتصدِّع هو: المتشقِّق، {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ }، فهذا مثل ضربه الله لعباده، والمثل هو: القول المأثور والحكمة التي يتناقلها الناس، وضرب الأمثال بمعنى: أنها تُسَكّ سكًّا وتُتخذ اتخاذًا، كما يستخدم في ضرب العملة الرائجة بين الناس، فيتعاطونها ويتناقلونها.
{لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون } أي: يتدبرون معانيها ويُعملون فيها عقولهم.
وهذه دعوة إلى الفكر والتفكر، وتدبر آيات الله الشرعية؛ لأن كل أحد من الناس لو قرأ القرآن بوعي وإقبال لأثمرت القراءة هدايةً لقلبه وصفاءً لروحه، وهذا من التيسير؛ {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر } [القمر: 17].
ومن العوام مَن يدرك من معاني القرآن ودلالاته وقصصه وأخباره ما تدمع له عينه ويخشع له فؤاده، وإن فاتته المعاني التي تحتاج إلى مراجعة أو فهم أو قراءة في كتب التفسير، وفي القرآن قدر كبير واضح تعرفه العرب من لغاتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي دعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية في السماوات والأرض والجبال التي تسبِّح الله عز وجل.
ويشبه هذا ما جاء في «سورة البقرة»: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون}، وقد نزلت الآيات على المؤمنين وهم بعد انتصار فرحوا به، فكأنها تدعوهم إلى أن يتواضعوا لله عز وجل، ويعرفوا أن الأمر كله لله، وأن النصر من عند الله، وأنه ليس لهم منه شيء إلا أن الله تعالى استعملهم وسخَّرهم فيه، والله يسلط رسله على مَن يشاء.
وفيه توبيخٌ لليهود؛ فإنهم يوصفون بقسوة القلوب، وغلظ الأكباد، والغفلة عن المعاني؛ ولهذا حذَّرنا ربنا عز وجل أن يكون مصيرنا كمصيرهم في قسوة القلوب، {فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون} [الحديد: 16]. وعاتبهم في «سورة البقرة» - كما سبق- بأن قلوبهم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها، وهذا يعزِّز مناسبة الآية لقصة بني النَّضِير وملحقاتها.
* ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾:
ختم الله تعالى السورة بآيات في تمجيده، وذكر طائفة من أسمائه الحسنى تناسب المقام، وتسعى لإحياء القلوب، ولله تعالى تسعةٌ وتسعونَ اسمًا، مئةٌ إِلَّا واحدًا، مَن أحصاهَا دَخَلَ الجنةَ.
وليس المقصود حصر الأسماء، فإن الله تعالى لا يحيط بأسمائه إلا هو؛ ولهذا كان في دعائه صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه-: «أسألُكَ بكلِّ اسم هو لك، سمَّيتَ به نفسك، أو علَّمتهُ أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك».
ويوم القيامة يسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش، فيُلهمه الله تعالى أسماء ومحامد يحمده بها، لم يكن يعلمها من قبل.
والمعنى: أن من أسماء الله الحسنى تسع وتسعين اسمًا، من صفتها وخصيصتها أن «مَن أَحْصَاها دخلَ الجنةَ».
والإحصاء يكون بحفظها، ولهذا يحسن أن يكون عند المؤمن كتاب موثوق يجمعها أو لوحة تحصيها، وأن يحفظها ويُحفِّظها لأطفاله، وأن يتعلَّم معانيها، فهي ليست رموزًا ولا ألغازًا، وإنما أسماء معروفة المعنى، وأن يدعو الله تعالى ويناديه بها: يا غفور، اغفر لي، يا رحيم، ارحمني، وأن يحاول أن يقتدي بمعاني تلك الأسماء، فيتعلم؛ لأن الله عليم يحب العلماء، ورحيم يرحم من عباده الرحماء، ويغفر للناس حتى يغفر الله له، يعفو لمَن أخطأ عليه أو ظلمه؛ لأن الله عفو يحب العفو، ويتوب؛ لأن الله يحب التوابين، وهو التواب الرحيم.
* {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم }:
{هُوَ } ضمير الشأن، إشارة إلى تعظيمه جل وعزَّ، ثم ذكر اسمه العظيم؛ بل قيل: هو الاسم الأعظم: {اللَّهُ }.
وقيل: الاسم الأعظم مجموعة في قولك: «الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيومُ، الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ، المنانُ، بديعُ السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام»، كما عند أحمد، وأهل «السنن».
والله هو الذي تألهه القلوب وتحنُّ إليه، فكل مَن عرف الله حنَّ إليه وأحبه وتمنَّى لقاءه ورؤيته، ومَن أكرمه الله بالرؤية ذهل عن كل نعيم سواها، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22-23] ، فلا نعيم أعظم من رؤيته جل وعزَّ وسماع كلامه، وذكره تعالى واللَّهج بأسمائه يمنح القلب تعلقًا وحنينًا حتى يشتاق العبد للحظات الخشوع والاستحضار ويحزن لفقدها ويحاول استعادتها، حتى تصبح سرور قلبه ونعيم عيشه وبهجة حياته.
وهو الذي تألهه العقول وتتحيَّر فيه؛ لأنه لا يعلم ذاته وأسماءه وصفاته إلا هو.
فيك يا أعجوبةَ الكَوْ * نِ غدا الفِكْرُ كليلَا
كلما أَقْدَمَ فكري * فيك شبرًا فرَّ ميلَا
ناكصًا يخبط في عَمْـ * ـياءَ لا يُهْدَى السبيلَا
ومن معانيها: المألوه المعبود الذي لا يُعبد بحق سواه.
{الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ }: {الْغَيْبِ }: ما غاب عن إحساس الناس وإدراكهم، فلم يعلموه ولا عاينوه، {وَالشَّهَادَةِ }: الموجود الحاضر المدرَك مما علموا وشاهدوا.
وقيل: {الْغَيْبِ }: الآخرة، {وَالشَّهَادَةِ }: الدنيا.
فكل ذلك في علمه سبحانه.
{هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم }: واستفتح بهذه الآية الكريمة؛ إشارة إلى أن أسماءه الحسنى سبحانه كلها أسماء تتَّصف بالحُسن؛ بل هي أحسن الأسماء، فأسماؤه كلها حسنة، فيها الخير، والبر، والجُود، والكرم، والعطاء، والفضل، والرحمة، نحو: الله، الرحمن، الرحيم، البَر، الجواد، الكريم، التوَّاب، الغفور، الحليم، الشَّكور، الكريم.
لكن ليس في أسماء الله سبحانه: المنتقم، أو: المعذِّب، أو: الآخذ، أو: شديد العقاب.. على القول الصحيح، أو: أليم العذاب، ولكنه صفة لبعض فعله؛ ولهذا قال: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49] ، فهنا ذكر المغفرة والرحمة وبدأ بها وخاطب بها عباده تقرُّبًا وتحبُّبًا، ثم لم يقل: «وأني المعذِّب، أو: الباطش، أو: الآخذ». وإنما قال: {وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيم } [الحجر: 50]، فوصف عذابه بأنه أليم.
ولذلك ذكر الغزالي وابن تيمية وابن القيم وسواهم ممن كتبوا في أسماء الله تعالى وصفاته: أن أسماء الله تعالى الحسنى تدور على أسماء الخير والبر والرحمة والجود؛ وبذلك يتعرف الله تعالى إلى عباده؛ لأن الناس ينساقون إلى الطاعة بالرحمة والعفو والمغفرة والرغبة أكثر مما ينساقون بالوعيد، مع أن أهل السنة يقررون المعاني الثلاثة؛ وهي الحبُّ والخوف والرجاء، والحبُّ بالاتفاق أفضل المعاني التي يتعبَّد بها الناس لربهم، ويأتي بعده الخوف والرجاء، وهما متساويان، كما قال الإمام أحمد: «ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا». أي: متساويين.
وبعضهم يرجِّح جانب الخوف عند الهمِّ بالمعصية، ويرجِّح جانب الرجاء عند فعل الطاعة، ويرجِّح جانب الرجاء عند الاحتضار، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يموتنَّ أحدُكم إِلَّا وهو يُحسنُ الظنَّ بالله عز وجل».
كل هذه المعاني متآلفة متناسقة، لا يقضي بعضها على بعض، ولا يهدم بعضها بعضًا؛ ولهذا قال سبحانه عن الرسل والأنبياء عليهم السلام: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين } [الأنبياء: 90]، وقال: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 55-56]، فجمع بين الخوف والرجاء والحب، ولكن الحب بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، والرأس أهم وألزم لبقاء الحياة من الأجنحة.
* {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون }:
{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }: تكرر هذا المطلع في بدايات الآيات؛ لتوكيد قيمة الألوهية التي ترسم صلة العبد بربه، وتقرِّر الوحدانية لله وأنه المعبود بلا شريك، وهذا هو المقصد الأَسْمى من سرد الأسماء؛ بل هو المقصد الأعظم للكتب والرسالات السماوية.
{الْمَلِكُ }: لا مُلك إلا له، ولم يحدث في عصر من العصور أن وُجد من البشر من ملك الدنيا كلها شرقًا وغربها؛ حتى الملوك المشهورين، والأباطرة، والفراعنة، وغيرهم من أمثال بُخْتَنَصَّر، وذي القَرْنين، والإسكندر المَقْدوني، وهُولاكو، وجِنْكيزخان، وغيرهم ملكوا رُقعة من الأرض وزاحمهم غيرهم ونافسهم.
ولو فرض أن مَلِكًا مَلك الدنيا كلها، فهو يملكها اليوم، لكنه لم يملكها أمس ولن يملكها غدًا.
ولو فُرض أنه طال ملكه فهو إلى زوال، ولو دامت لك ما وصلت لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وهذا كله ملك طارئ يتعلق بالتدبير، لكن ملك الله سبحانه ملك أصلي؛ لأنه هو الذي خلقها وأوجدها من العدم، فهي تدين له في كل ذرة من ذراتها؛ وملكه سبحانه لكل شيء في السماء والأرض، والبر والبحر، والإنسان والحيوان، والدنيا والآخرة، والأملاك والأفلاك، ويوم القيامة يتجلَّى الأمر وينكشف، فيقول سبحانه: {لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ } ثم يجيب جلَّ وعزَّ: {للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار } [غافر: 16].
{الْقُدُّوسُ }: ففي ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يعتري الملوك عادةً من صفات النقص، فإن بعض الملوك يقع له العُجب، ويقع منه الظلم ويتكبَّر على مرؤوسيه، ويقع في الشهوات، ويداخله العُجب، وتصيبه الآفات، ويعتريه النقص والعجز، أما الله سبحانه فهو المقدَّس الكامل المنزَّه عن النقائص والعيوب.
{السَّلاَمُ }: يعني: السالم من كل آفة، فلا يعتريه نقص ولا عيب، ولا خطأ ولا زلل ولا نسيان، وهو الذي يُسلِّم عباده ويرزقهم، ولذا كان السلام تحية الإسلام، وملكه لعباده سلام وخير وبر ورحمة وجود.
ولذا كان في الدعاء الذي علَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير } [آل عمران: 26]، فملكه خير وفضل وبركة.
{الْمُؤْمِنُ }: فهو يُؤمِّن عباده، أي: يمنحهم الأمن، فالأمن في الدنيا من عطائه وفضله، وهو مطلب ومقصد، فالأمن على النفس والمال والولد هو من الله، وهو نعمة من عنده، وكثير من الملوك ينشرون الخوف في رعاياهم لأجل الهيبة والانكفاف، أما الله فهو يُؤمِّن عباده، ويخص المؤمنين السالمين من الظلم بالأمن التام: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُون } [الأنعام: 82]، وهو يُؤمِّن عباده بما جعل في الكون من الأسرار والحكم والنواميس بتوفير الهواء والماء والطعام والشراب والثروات في باطن الأرض والخيرات، وهو يُؤمِّن عباده من الظلم والجَوْر، ويُؤمِّن عباده يوم القيامة أَلَّا يقع عليهم حَيْف.
{الْمُهَيْمِنُ }: الشاهد الذي لا يغيب، والرَّقيب الذي لا يغفل، والملوك وإن كانوا يجتهدون في معرفة أحوال رعاياهم إلا أنه يخفى عنهم الكثير مما تخفيه صدور الناس أو ما يدبرونه في الخفاء، أما الله عز وجل فهو مطَّلعٌ على أحوال عباده وأسرارهم وأقوالهم وذوات صدورهم وخططهم ونواياهم وظاهرهم وباطنهم.
{الْعَزِيزُ }: وهذا أيضًا من توابع الملك، فله تعالى العزَّة الذاتية التامة الدائمة، وهو يمنحها لمَن يشاء، كما منحها محمدًا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه حين نصرهم على المشركين واليهود والمنافقين.
وكثير من ملوك الدنيا وسلاطينها، وإن كان لهم قوة وعزة ظاهرة، إلا أن نوعًا من الذُّل يغشاهم ممن هو أعلى منهم وأقوى فيخافون منه، بل حتى مَن دونهم يخافون من تمردهم وخروجهم عن طاعتهم، فيراعونهم ويخادعونهم، أما الله عز وجل فهو العزيز من كل وجه؛ لأنه الغنيُّ عن خلقه والخلق كلهم مفتقرون إليه.
{الْجَبَّارُ }: الذي يَجْبر كسر المنكسرين، ويَجْبر مصابهم، ويزيل ما بهم، ويعوِّضهم ويمنحهم الرضا والصبر.
و{الْجَبَّارُ } الذي يُجبر عباده على ما يشاء؛ فإنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذنه ولا رادَّ لقضائه ولا معقِّب لحكمه.
{الْمُتَكَبِّرُ }: والكبر من سيماء الملوك، ولكنه يُعَدُّ عيبًا؛ لأنهم يأخذون فيه ما ليس لهم ويتظاهرون بعظمة لا يستحقونها، فيورث ذلك ازدراءً منهم لمَن تحت أيديهم؛ ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «الكبرياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري، مَن نازعني واحدًا منهما ألقيتُهُ في جهنمَ». فالكبرياء لله سبحانه وحده.
ومن معاني {الْمُتَكَبِّرُ }: الكبير الذي لا أكبر منه عز وجل؛ ولهذا يستفتح المصلِّي صلاته بـ«الله أكبر»، والمؤذِّن يستفتح أذانه بـ«الله أكبر» فهو أكبر من كل شيء وهو الكبير المتعال، وله الكبرياء في السماوات والأرض والدنيا والآخرة بالوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فإن كبرياءه سبحانه تليق به.
وليس الكبر الذي اتصف به سبحانه هو الذي عند الناس حين يداخلهم التِّيه والغرور، مع ما فيهم من صفات النقص والضعف الأصلي والطارئ، وإنما الله تعالى له صفة الكمال والعظمة والمجد الذاتي.
{سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون }: تأكيدٌ لهذه المعاني كلها؛ فإن لله تعالى من هذه الأسماء أجمل المعاني، فمن حسن ظنك بالله وحسن معرفتك به أن تعلم أن له الكمال والجلال والجمال من كل شيء، فمُلكه كامل مقدَّس ليس كمُلك البشر، وكبرياؤه عظمة بحق وكمال، وعزته تامة لا يشوبها ذل، وقدرته لا يعتريها نقص..
والتسبيح معناه: التقديس والتنزيه؛ ولهذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكة والرُّوح». فهو السُّبُوح القدُّوس، المسبَّح المقدَّس المنزه عن كل ما يخطر ببال الناس من الخيالات والأوهام والظنون، وعن كل ما يقوله الضالون والمكذِّبون والمشركون.
* {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم }:
{الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ }: ثلاثة أسماء، قيل: هي مترادفة.
والصحيح أنها ليست مترادفة؛ ولكن بينها عمومًا وخصوصًا، فالخلق أعم، ثم البَرْء وهو ظهور المخلوقات إلى الواقع وإلى العيان، والتصوير هو: حصول المخلوقات على صورها؛ هذا إنسان، وهذا حيوان، وهذا طويل، وهذا قصير، وهذا أبيض، وهذا أحمر.
وقد يكون المعنى- كما أشار إليه أبو حامد الغزالي وغيره-: أن السياق يشمل ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: الخلق، وهي التقدير، أي: أن الإرادة الإلهية قبل حصول الأشياء وكتابة الأشياء، فهذا يعتبر خلقًا، مثل قول الشاعر:
ولأَنَت تَفْرِي ما خلقتَ وبعـ * ـضُ القوم يخلُقُ ثم لا يَفْرِي
أي: يعد ولا يفي، فيكون معنى الخلق: تقدير الأشياء قبل حصولها، فإن الله تعالى قدَّرها قبل أن تحصل وأراد أن تحصل في مواقيتها المعلومة، فهذا معنى الخلق والتقدير.
ثم مرحلة البَرْء، ومنه البَرَيَّة، وهم الناس، وكل الأشياء بُرئت وخُلقت، كما قال علي رضي الله عنه: «والذي فَلَقَ الحبةَ وَبَرأَ النَّسَمةَ». أي: أوجد، فـ {الْبَارِئُ }: الموجد الذي خلق الأشياء التي نراها في العيان.
ثم {الْمُصَوِّرُ }: الذي أعطاها صورها وميَّز بعضها عن بعض.
وفي هذه الأسماء الثلاثة معجزة الخلق والإبداع من العدم، وفيها الحكمة البالغة، وفيها الرحمة العظيمة التي بها تتراحم الناس والدواب والطيور، وفيها الجمال الباهر الذي جمال المخلوقات من جماله.
{يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم }: ختم بالتسبيح لله عز وجل، وأعاد الاسمين اللذين بدأ بهما أول السورة: {الْعَزِيزُ الْحَكِيم }؛ إشارة إلى ربط هذه الأسماء بمجريات الواقع والأحوال، وأن أسماء الله الحسنى ليست مجرد أسماء يتبرَّك بها في الصباح والمساء- وإن كان هذا مطلوبًا مشروعًا- ولكنها عقيدة تصبغ حس المرء حينما يشاهد ما يقع في الكون من آيات وحوادث، فيلحظ آثار الأسماء الحسنى في جملها وتفصيلاتها.. في نفسه، وفي الآخرين، وفي الحوادث؛ الصغيرة والكبيرة، السياسية والعسكرية، والاقتصادية والاجتماعية، والعلمية المعرفية.. فإذا آمن العبد بالله وأحصى أسماءه واستحضر معانيها وهو يمضي في حياته ويتأمل ما حوله، لم تطش موازينه ولم تضطرب رؤيته، وقرأ العلم والقدرة والرحمة والحكمة والعزة والصبر وسائر الأسماء والصفات الجليلة في كل ما يرى ويسمع، فسبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، ولا ربَّ سواك.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/books/7