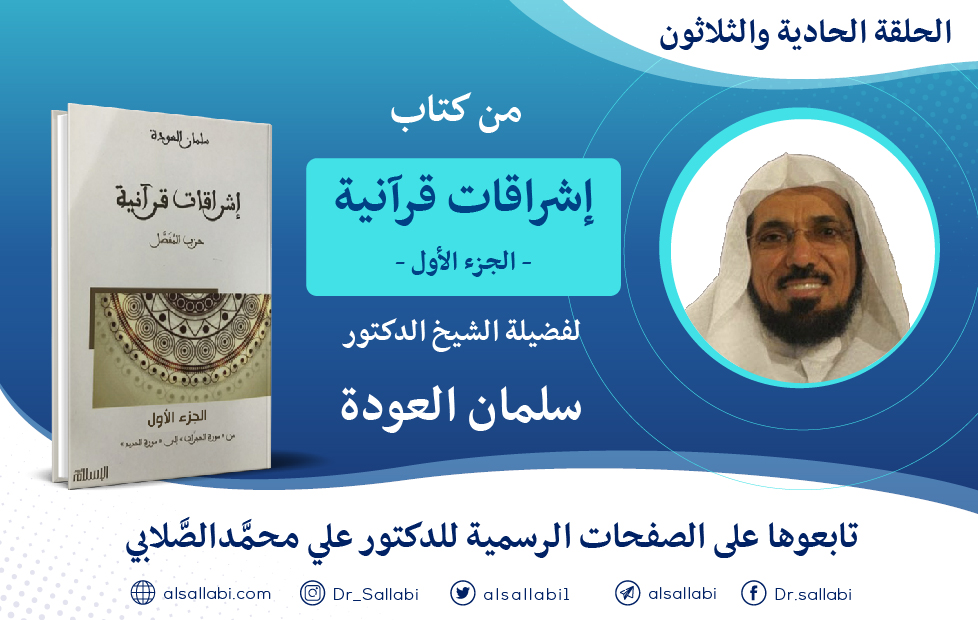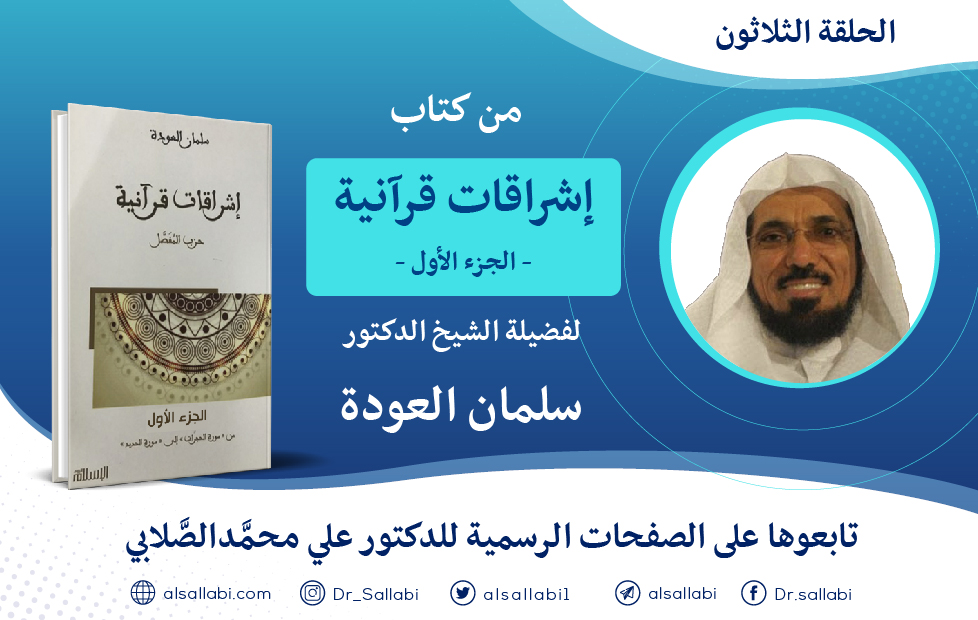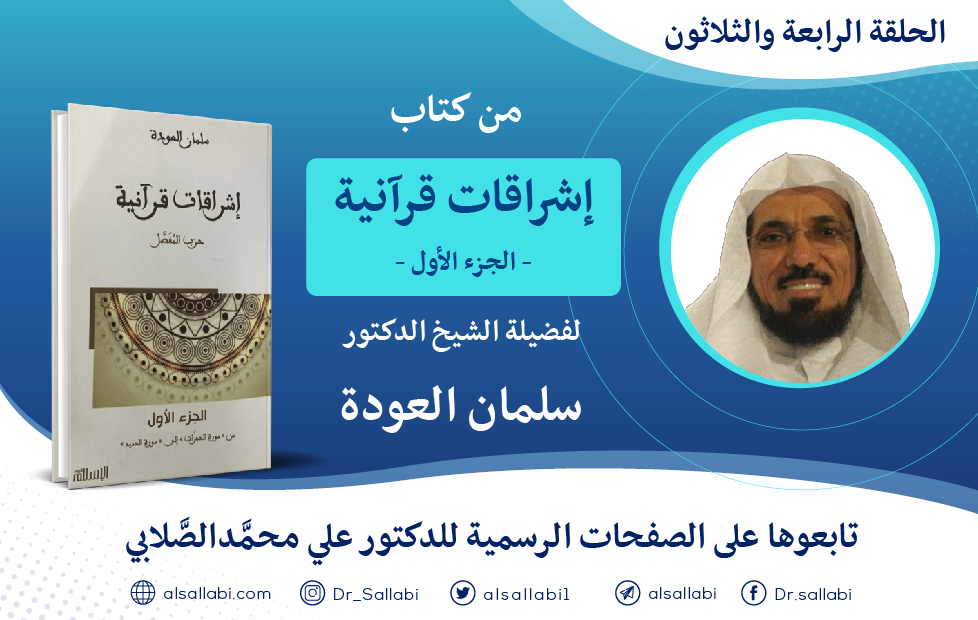من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الممتحنة)
الحلقة الثانية والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* تسمية السورة:
اسمها: «سورة الممتحِنة»، وتنطق بكسر الحاء؛ باعتبارها وصفًا للسورة نفسها، حيث ورد فيها الامتحان، وهذا عند الأكثرين.
وبعضهم ينطقها بفتح الحاء: «سورة الممتحَنة»؛ إشارة إلى المرأة الممتحَنة.
وأول امرأة وقع عليها الامتحان هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط رضي الله عنها، في القصة المعروفة.
وبعضهم يسمِّيها: «سورة الامتحان»؛ لقوله تعالى فيها: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ }.
ولها اسم ثالث، وهو: «سورة المودة».
* عدد آياتها: ثلاث عشرة آية.
* وهي مدنية بالاتفاق.
* { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل *}:
لهذا السياق قصة رواها البخاري ومسلم عن عليٍّ رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة أرسل حاطبُ بنُ أبي بَلْتعة رضي الله عنه بكتاب إلى مشركي مكة؛ يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطاه امرأةً، فأخبر اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عَلِيًّا والزُّبيرَ والمقدادَ بنَ الأسود رضي الله عنهم، فقال: «ائتوا روضةَ خاخ؛ فإن بها ظَعينةً معها كتابٌ، فخذوه منها». يقول عليٌّ رضي الله عنه: فانطلقنا تَعادَى بنا خيْلُنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرجي الكتابَ. فقالت: ما معي كتابٌ. فقلنا: لَتُخرجنَّ الكتابَ أو لَنُلْقينَّ الثيابَ. فأخرجته من عِقاصِها، فأتينا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَعةَ إلى ناس من المشركينَ من أهل مكة... يخبرُهم ببعض أمر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا حاطبُ، ما هذا؟». قال: لا تعجلْ عليَّ يا رسولَ الله، إني كنتُ امرأً ملصقًا في قريش- كان حليفًا لهم، ولم يكن من أنفسها- وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمونَ بها أهليهم، فأحببتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذَ فيهم يدًا يحمونَ بها قرابتي، ولم أفعلْهُ كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صدق». فقال عمرُ: دعني يا رسولَ الله، أضرب عنقَ هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهدَ بدرًا، وما يُدريكَ لعلَّ اللهَ اطَّلَعَ على أهل بدر فقال: اعملوا مَا شئتم، فقد غفرتُ لكم». فأنزل اللهُ عز وجل: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء *}.
وهذه القصة فيها عجائب:
أن هذا يجري من صحابي قد شهد بدرًا، وشهد الحُدَيْيِيَة، وشهد له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالجنة؛ لما جاء غلامُه وقال: يا رسولَ الله، ليدخلنَّ حاطبٌ النارَ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كذبتَ، لا يدخلها؛ فإنه شهدَ بدْرًا والحُدَيْبِيَةَ».
وهو صحابي جليل صادق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحدث منه مثل هذا الأمر العظيم المتعلق بإفشاء سرٍّ عسكريٍّ خطيرٍ إلى المشركين، وبطريقة سرِّية دقيقة توحي بأنه يدرك ما هو مقدم عليه؟!
ثم تتعجَّب كيف استطاع المجتمع المسلم آنذاك أن يستوعب هذا الموقف، ويتعامل معه بتوازن لا يُفهم منه الاستهانة بخطورة هذا الأمر فيتجرَّأ الناس بإفشاء الأسرار الخطيرة، وفي الوقت ذاته لا يتعامل بغلظة زائدة تجعل المجتمع ينشق على نفسه، فإن المجتمعات إذا كانت تتعامل وتُعامِل الخطَّائين وأصحاب الزلَّات معاملة قاسية، تُجاوز حد العدل والإنصاف والحكمة، فهذا قد يكون سببًا في إقصائهم وقطع صلتهم وصلة مَن يتعاطف معهم.
ونلحظ أن اللهَ افتتح السورة بتقرير وصف الإيمان للمنادَى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }، وإن وقع منه من الكبائر ما وقع، وهذا يدل على أن حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعة رضي الله عنه هو من الذين آمنوا.
ثم كان التذكير بعداوة أولئك القوم لله ورسوله وعداوتهم للمؤمنين مهما تظاهروا لبعض المؤمنين بغير ذلك، وفيه تشنيع هذا الفعل؛ وهو اتخاذهم أولياء؛ لأن أعداء الله تعالى يصُدُّون عن المسجد الحرام، ويُحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقتلون المؤمنين والمؤمنات، وهم لم يتوبوا من إجرامهم، فهم أعداء الله؛ فموالاتهم والبَوْح بالأسرار لهم خيانة لله؛ لأنهم عدو لله، وهي خيانة للنفس؛ لأنهم أعداؤكم.
ومعنى {لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء }: لا تجعلوا مَن عادى اللهَ ورسولَه وعاداكم وليًّا حَمِيمًا صديقًا تبوحون له بالأسرار تودُّدًا وتحبُّبًا إليهم.
{تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ }: وألقى الشيء: إذا رمى به، فصار المعنى هنا: ترمون إليهم بالوُّدِّ وبالسِّرِّ على غير تفكُّر، وأحيانًا ربما يصدر من المرء شيء دون تفكير، فإذا فكَّر تعجب كيف صدر منه ذلك الفعل المشين؟! فهو إشعار بأن ما وقع كان من غير تأنٍّ ولا تحرٍّ ولا تخطيط؛ بل هي خاطرة عاجلة لم تأخذ حقها من النظر والتحرير وتقليب وجوه الرأي، والمودة هي: الحُب، والمقصود: ظاهر المودة المتمثِّل في إخبارهم بما همَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الفتح.
{وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ }: فيه تذكير بأنهم يعلنون كفرهم بالحقِّ الذي تؤمنون به، وليس هذا فحسب، بل و {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ }، فقد أخرجوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم من مكة وأخرجوكم أنتم منها، وحاطبٌ رضي الله عنه الذي نزلت هذه الآيات بسببه مهاجر، فقد أخرجوا المسلمين بالتضييق عليهم ومحاصرتهم واضطرارهم إلى الهجرة، وبمنعهم من العبادة، ومنعهم من إظهار دينهم، وهمُّوا بقتلهم، وقتلوا منهم مَن قتلوا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يقول وقت خروجه منها: «واللهِ، إنك لخيرُ أرض الله، وأحبُّ أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجتُ منك ما خرجتُ».
فهكذا كان معنى الإخراج، وأنه ليس طردًا؛ ولكنهم حاصروه صلى الله عليه وسلم وحاصروا المؤمنين معه، حتى اضطروا للبحث عن مناخ مناسب للدعوة وتأسيس الدولة.
{أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ } أي: أخرجوكم بسبب الإيمان، وحاربوكم في دينكم، ومنعوكم من الصلاة عند الكعبة. { وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد } [البروج: 8].
{إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي }: وهذا هو الواقع أنه ما أخرجهم دنيا؛ بل هم تركوا الدنيا وراءهم وخرجوا من مكة؛ جهادًا في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته.
وصدَّر هذه الجملة بـ { ﭪ} التي هي أداة للشرط، يعني: إذا كنتم خرجتم، وكأنه جعله محل تردد واختبار.
والمعنى: ما دمتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فكيف تُسِرُّون إليهم بالمودة، وتفشون إليهم هذا السِّر؟!
{وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ }: أي أعلم ما أخفيتم من أمر الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخفيتم من الإيمان في قلوبكم، وأعلم أن ما وقع منكم لم يكن كفرًا بعد الإسلام، ولا رغبة في القضاء على الدِّين؛ ولكنه طمع في مصالح الدنيا لم يحالفه التوفيق، ولم يرع حرمة الأمانة وحفظ السِّر.
وفي التذكير بالعلم الإلهي لكل خافية ومعلنة ترغيب وتحفيز للتوبة والإنابة، وترهيب من الفعل وما يصاحبه من ضعف نفسي وعزوب عن المراقبة الإلهية وغفلة عن مقتضاياتها.
{وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل }: فسمى الفعل: «ضلالًا عن السبيل»، ولم يتساهل فيه أو يجعل العذر مانعًا من توصيفه المستحق، كما لم يصفه بأنه كفر ورِدَّة.
وهذا الخطاب بعد حدوث الفعل ليس دعوة إلى الجَدَل أو التهرب؛ بل هو تذكير بخطورة الأمر، ودعوة إلى التوبة من هذا الجُرم العظيم، ولذا تاب حاطب رضي الله عنه مما فعل، واعتذر إلى الله ورسوله والمؤمنين، وفي ذلك دعوة للآخرين أَلَّا يفعلوا، وإذا وقعوا في كبيرة أن يتوبوا.
وفيه إشارة إلى أن «الولاية» أنواع:
لقد ذكر الله تعالى عن حاطب رضي الله عنه «المودة» في موضعين: {تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ }، و {تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ }، واعتُبر هذا ضلالًا عن سواء السبيل؛ ولكن لم يعدّه كفرًا، وجعل حاطبًا رضي الله عنه في عداد الذين آمنوا، واعتذر له عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهد بدرًا، والبدريون مشهود لهم بالجنة.
فولاية الكفار منها ما هو كفرٌ؛ وهو أن يواليهم لدينهم؛ لأنه أحبَّ دينهم وفضَّله على دين الإسلام.
ومنها ما هو معصية؛ مثل: أن يواليهم ويظاهرهم على المسلمين لمصلحة خاصة، كما في قصة حَاطِب رضي الله عنه مع طُمأنينة قلبه بالإيمان، وقد يرى أنَّ ما يفعله ليس مؤثِّرًا في النتائج النهائية للمعركة، فهو ينفعه ويدفع عنه، وضرره على المسلمين قليل أو معدوم، بالنظر إلى معطيات النصر الكثيرة المتوفرة لهم، فهذا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وإثم وضلال عن سواء السبيل.
ويدخل في هذا الجاسوس الذي يتجسَّس على المسلمين، فهو مرتكب جُرمًا عظيمًا؛ ولكنه لا يكفر، وهل يُقتل؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أن ذلك إلى الإمام يُقدِّر ما هو الأصلح في شأنه.
وتأمل كيف أن حاطبًا رضي الله عنه ما سُجن ولا عوقب إلا بهذا اللَّوم، وحسبك بهذا تأنيبًا وتأديبًا!
* { إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون }:
{ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء }: أي: هؤلاء الذين كتبتم إليهم وكشفتم لهم بعض أسرار المسلمين، لا تظنوا أنهم سوف يرقبون فيكم بذلك إلًّا وذِمة، سوف يُظهرون لكم العداوة.
{وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ }: أي: يمدوا إليكم، {أَيْدِيَهُمْ }: بالضرب والقتل، {وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ }: أي: بالسَّبِّ والشتم والتعنيف، ولن يلتفتوا إلى ما قدمتم لهم أو خدمتموهم، ليس هذا فحسب، بل {وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون }، كما قال في الآية الأخرى: { وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء } [النساء: 89].
وقد جاء التعبير في أول الآية وآخرها متغايرًا؛ ففي أولها عبَّر بالفعل المضارع: { إِن يَثْقَفُوكُمْ }، {وَيَبْسُطُوا }، وفي آخرها عبَّر بالماضي، فقال: {وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون }؛ لأن مودتهم الكفر ليست جديدة ولا مرهونة بأن يثقفوكم، وإنما هي أصلية راسخة عندهم قبل أن يظفروا بكم وبعد الظفر، { وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُون *} [القلم: 9].
* { لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير }:
الوقف يحتمل أن يكون على {أَوْلاَدُكُمْ }، ثم الجملة التي بعدها مستأنفة: {يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ }، ويحتمل أن يكون الوقف على قوله: {يَوْمَ الْقِيَامَةِ }، فعلى الثاني يكون المعنى: أنها لن تنفعكم يوم القيامة، هذا وجه.
وعلى الأول يكون المقصود: { لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ } أي: مطلقًا، ثم قوله: {يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ } جملة مستأنفة، أي: أن الله يفصل بينكم يوم القيامة، وليس المقصود بـ«الفصل» هنا «الحُكْم»، وإنما المقصود: التفريق؛ بأن كل أحد مشغول بنفسه.
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير } أي: أن ما عملتَ يا حاطب، وما أسررتَ وما كتبتَ وما أرسلتَ فالله تعالى يعلمه.
* { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير}:
الأُسوة هي: القدوة، وهو درس للمؤمنين، {فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ }، وإبراهيم أبو الأنبياء، وأبو الحنفاء عليه السلام، وكان قويًّا في الحقِّ صادعًا، وقوته مما عرفه العرب والعجم والروم والهند وغيرهم، حتى إن الهنود عندهم عبادة البراهمة، يقال: إن أصلها من اسم إبراهيم، ثم تحرَّف الاسم، وضلت العقيدة!
فإبراهيم عليه السلام كان مثالًا في القوة والصبر والتحمل، وهو من أولي العزم من الرسل، وقصته مبسوطة في مواضع كثيرة، كما في «سورة هود»، و«سورة الأنبياء»، و«سورة الصافات»، وفيها جرأته على قومه وتكسير الأصنام، دون اكتراث بهم وبوعيدهم، مع كونه شابًّا لا سند له من الناس!
جعله الله لنا أُسْوَةً حَسَنَةً في مصارمته لقومه، مع أنه لم يكن معه سوى ابن أخيه: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ } [العنكبوت: 26]، وزوجته سارة، كانوا ثلاثة فقط، فأشاد الله بهم وجعلهم قدوة للمؤمنين عبر العصور.
{إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ }: وهذا موضع القدوة والأُسوة؛ وهو البراءة من أعداء الله. ولم يقع منهم هذا لأول وهلة من الرسالة؛ بل صبروا على قومهم ودعوهم بالحسنى والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، فلما تبيَّن لهم أنهم أعداء لله كاشفوهم بالعداوة، ولقد وصل بهم الحال إلى أن يوقدوا النار لإحراق إبراهيم عليه السلام والقضاء عليه، فلما ظهرت عداوتهم ويئس من إسلامهم وأعلنوا الحرب على الله وعلى إبراهيم عليه السلام صرَّح لهم بقوله: {إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ } أي: من أفعالكم، من كفر ومحادَّة لله.
{وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ }: من الأنداد والأصنام والمعبودات المختلفة، كالكواكب وغيرها. واستثنى اللهَ وحده.
وهل كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، أو يعبدون الأصنام فقط؟ يحتمل.
{كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ } أي: ظهر واستمر، {الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ }، وهذه هي الغاية.
درس في البراءة من المشركين الذين يحاربون الله تعالى ورسوله، ويخرجون المؤمنين ويعلنون عداوتهم وحربهم، فلا بد أن يكون المسلمون بُرآء منهم، وأن يفاصلوهم مفاصلة واضحة لا لبس فيها.
{إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ }، وهذا استثناء، أي: ليس لكم في هذا المستثنى قدوة ولا أسوة، والمقصود: وعد إبراهيم عليه السلام لأبيه أن يستغفر له، فنهاه الله تعالى عن ذلك واستثنى هذا من موضع القدوة، فقال: { وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ } [التوبة: 114].
وكون إبراهيم عليه السلام وقع منه هذا الأمر في شأن أبيه، ووقع من حاطب بن أبي بَلْتعة رضي الله عنه ما وقع في شأن قريش، يدل على أن تمازج المجتمع وتداخل العلاقات بين المسلمين وغيرهم، فيحتاج الأمر إلى كثير من الإيضاح في ضوابط هذه العلاقة؛ ولهذا تكفلت السورة بإيضاح الأمر وتجليته وبيانه.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: