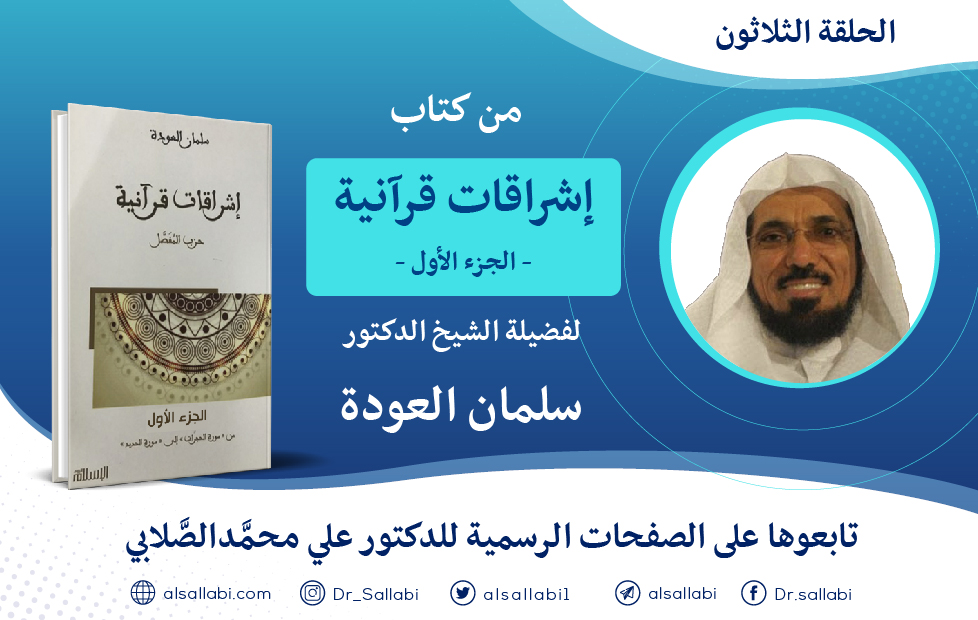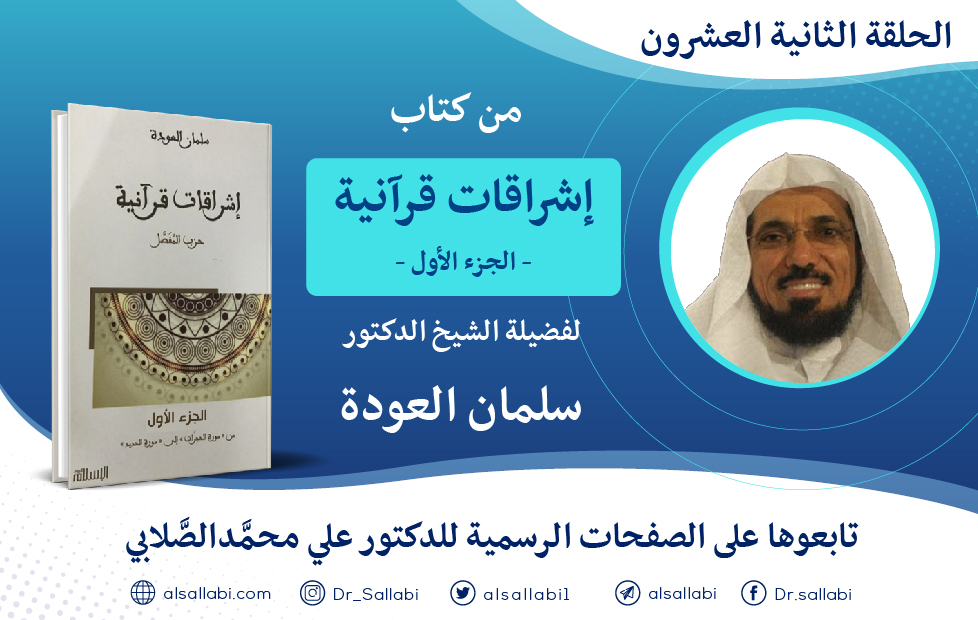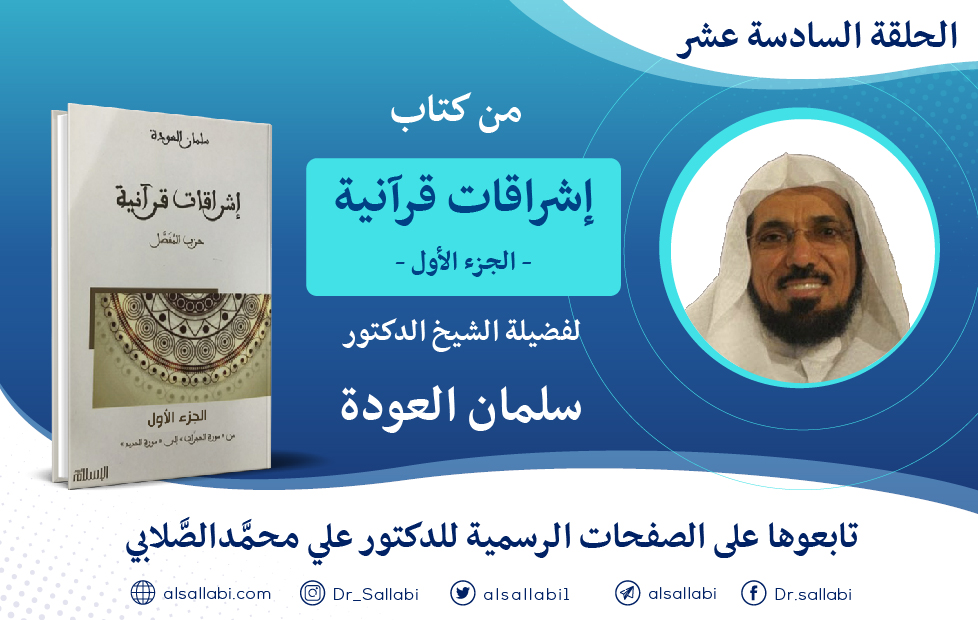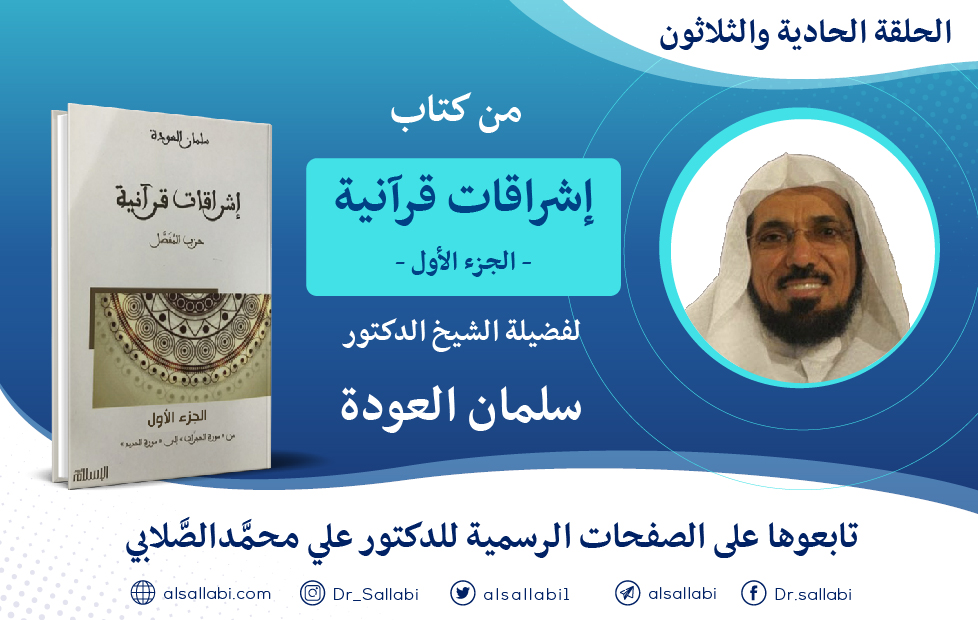من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الحشر)
الحلقة الثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ }: والإيثار: أن تجعل حظ الآخرين من الشيء قبل حظك، والآية نزلت في الأنصار، وورد أنها نزلت في أبي طلحة رضي الله عنه خاصَّةً؛ لما جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عند أزواجه شيء، فذهب مع أبي طلحة رضي الله عنه، فقال لامرأته: ضيفُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، لا تدَّخريه شيئًا. قالت: والله، ما عندي إِلَّا قُوتُ الصبية. قال: فإذا أراد الصبيةُ العَشاءَ فنَوِّميهم، وتعالَي فأَطْفئي السراجَ ونَطْوِي بطُوننا الليلةَ. ففعلت ثم غَدَا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لقد عَجِبَ اللهُ عز وجل- أو: ضحك- من فلان وفلانة». فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل الآية.
فهذه مقامات النبل الأخلاقي، والاستعلاء على الحاجات الذاتية، والانحياز للصديق والرَّفيق والجار والشريك، أو الانحياز للفريق والمجموع ولو على حساب المصالح الفردية.
فهنا أثنى على الأنصار بالإيثار، وهو مقام أعظم مما مدح الله به قومًا آخرين بقوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } [الإنسان: 8].
فإن هؤلاء يحبون المال والطعام، ويطعمونه غيرهم، أما الأنصار ففوق الحب هم يحتاجونه وبهم إليه فاقة ملحة وخصاصة، ومع هذا يقمعون دوافع الأَثَرة والأنانية ويقدِّمون غيرهم عليهم!
ولم يكن قصدهم أن يُثنى عليهم بهذا، كما كان عين الحال عند بعض العرب في الجاهلية، بل حبًّا في الله ورسوله وكَرَم أخلاقٍ جُبلوا عليها، ولذا قال: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}، فهم قد وقوا شُحَّ أنفسهم فوعدهم بالفلاح.
والفرق بين «الشُّحِّ» و«البُخْل» دقيق، وبعضهم قال: هما مترادفان.
وقيل: البخل: الامتناع من إخراج ما حصل عندك، والشُّح: الحرص على تحصيل ما ليس عندك.
وقيل: الشُّحَّ معنى نفسي، والبخل معنى عملي حِسِّي؛ ولهذا قال عز وجل:
{وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ } [النساء: 128]، فما من نفس إلا وفيها شُحٌّ؛ شُحٌّ بالنفس، وشُحٌّ بالمال، وشُحٌّ بكل ما تملكه النفس.
وأما البخل: فهو ما يظهر على الإنسان من المنع وعدم العطاء أو الحرص على المال، فيكون البخل أثرًا للشُّحِّ، وكأن الشُّحَّ سيئة القلب، والبخل سيئة اليد واللِّسان.
والأقرب أن الشُّحَّ أشد درجات البخل.
وبعد، فنحن نُشهد الله سبحانه على حُبِّ المهاجرين والأنصار الذين أَحَبَّ بعضهم بعضًا، وأحَبُّوا ربهم، وأحَبُّوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم الله تعالى في كتابه بخير المنازل، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم، وهكذا نقول: إن كل مؤمن بالله ورسوله لا بد أن تكون هذه من أصول دينه وإيمانه؛ أن يُحِبَّ هذا الجيل الذي أَحَبَّه الله ورسوله، وألا يتكلم فيهم إلا بخير، فهم خيرة الله من عباده، وصفوة خلقه بعد النبيين، وثمرة التربية المحمدية العظيمة التي زكَّاها الوحي؛ لتكون منارة يهتدي بها السائرون على الطريق إلى يوم الدين.
* {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيم }:
قد يكون المقصود بالذين جاؤوا من بعدهم: الذين جاؤوا إلى المدينة من غير المهاجرين ومن غير الأنصار، كالقبائل التي تأخر إسلامها.
والجمهور من المفسرين على أن المقصود: الأجيال اللاحقة بعد عصر المهاجرين والأنصار، فهؤلاء يحبون المهاجرين والأنصار، ويدعون لأنفسهم ولهم بهذا الدعاء الخاشع المتبتِّل، وبدؤوا بأنفسهم؛ لأن من السُّنَّة أن يبدأ الإنسان بنفسه قبل غيره في الدعاء، كما قال إبراهيم عليه السلام في دعوته: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ } [إبراهيم: 41]، وكما قال نوح عليه السلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ } [نوح: 28].
فدعوا لمَن سبقوهم بالإيمان بالمغفرة، وأول ما يشمل ذلك المهاجرين والأنصار، ووصفوهم بـ«الأخوة»، وأي شرفٍ ومجدٍ أعظم من أن يعقد الله لواء الأخوة- بغض النظر عن الجنس واللون والشكل- بين هؤلاء المؤمنين وبين كل مَن يحبهم ويثني عليهم إلى يوم القيامة، وشهدوا لهم بالإيمان وأثنوا عليهم بالسابقة؛ وهي سابقة زمانية وسابقة رتبية في الفضل، ولذا جاء في حديث عمران وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم: أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذي يلونهم.
{وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا }: دعوا أَلَّا يجعل الله في قلوبهم حقدًا أو كراهية أو بغضًا للمؤمنين، سواءً كانوا سابقين أم لاحقين.
والغِلُّ يقع للسابق بسبب ما يرثه الإنسان من معتقد، أو بسبب قراءة تاريخية خاطئة أو منحازة، كما يقع للمعاصر بسبب الاختلاف والتنافس والتحزب وسوء الظن، وتحريش شياطين الإنس والجنِّ، وتغرير الإعلام الذي من شأنه قلب الحقائق وتوسيع الشُّقَّة وزرع العداوة بين الناس ليحفظ بذلك سيادته.
وفيه وجوب محبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة، وكتب فيه أهل العلم وألَّفوا، ولكن مما يستحق أن نشير إليه ونؤكده هنا أنه لا ينبغي لأحد من الناس أن ينال من أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الصحابة اختلفوا فيما بينهم، فهم بشر يختلفون في أمر من أمور الدين وليسوا في منزلة واحدة؛ بل هم درجات عند الله، لكن لهم شرف الصحبة.
أما مَن جاؤوا بعدهم فهم بمنزلة دونهم، ولم ينالوا هذا الشرف؛ ولذلك ليس من حقك أن تتعصَّب أو تنحاز لهذا ضد هذا، أو تجعل من النيل والوقيعة دينًا يتدين به.
ولا شك أن الشتم والسَّبَّ ليس من قيم الدين ألبتة، فالله تعالى لا يُتعبَّد بالسَّبِّ، حتى إن الله نهى عن سَبِّ آلهة المشركين، فقال: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ } [الأنعام: 108].
وحتى سَبِّ الشيطان لم نُؤمر به، وإنما أُمرنا بالاستعاذة منه، وحتى سَبِّ فرعون وهامان وقارون وأبي جهل ليس فيه أجر وليس عبادة، ولا يزيد القلب إشراقًا، ولا يزيد النفس إيمانًا، ولا يزيد الحسنات، ولا يثقل الميزان.
بل إن اعتياد اللِّسان على لغة السَّبِّ والوقيعة يفضي إلى الازدراء والاحتقار وخشونة الخُلق؛ ولذلك لا يتديَّن الإنسان بِسَبِّ المنحرفين والضالين والإفراط في ذلك إلا بقدر ما يستدعيه بيان الحق مما يتعلق بالأحكام الشرعية أو الجرح والتعديل في المرويات؛ لتعلقها بحفظ السنة النبوية.
* ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الحشر: 11]:
وهذا المقطع عجيب؛ فقد التفت فيه السياق إلى جماعة أخرى تعمل في الظلام عمل الهدم والتحريش، يرأسهم عبدُ الله بنُ أُبيٍّ ابنُ سَلُولَ، ومعه سبعة أو ثمانية من رؤوس النفاق كانت تخطِّط في المعركة؛ لكن دون جدوى: {أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ }، هم ليسوا إخوانًا في النَّسَب ولا في العروبة؛ لأن هؤلاء من بني إسرائيل وهؤلاء من العرب، وإنما الأخوة هنا أنهم كانوا حلفاء وإخوة لهم في الشَّر وفي حرب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه بعدما ذكر الأخوة السابقة الصادقة بين المؤمنين حتى بين الجيل المتأخِّر والجيل المتقدِّم انتقل إلى الأخوة الباطلة الفاسدة، وبيَّن أن هؤلاء منافقون يبطنون الشرك والكفر، وأولئك يهود من أهل الكتاب، وإنما جمعهم وألَّفَ بينهم العداءُ لله ورسوله والمؤمنين.
وهكذا يقع في كل زمان ومكان حينما يستشعر المجرمون الخطر من قوة الإسلام وأهله، يلجؤون إلى عقد التحالف وينسون ما بينهم من العداء والتباعد في الملة والمذهب والمقصد!
وكان القول المذكور تهامسًا في مجالس خاصَّة عُقدت لمعالجة الموقف، فهم يقولون لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب من بني النَّضِير قبل المعركة: نحن منكم وأنتم منَّا، والمصير واحد، ولئن أُخرجتم من المدينة لنخرجن معكم. وأرادوا بهذا التحريض على المقاومة والتثبيت لهم.
{وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا } أي: لا نطيع فيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولا غيره، فما بيننا وبينكم من العقود والمواثيق أعظم من أن نطيع فيكم أحدًا.
{وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ }، فإن صار الأمر إلى قتال فسوف نخوضه معكم، وقال لهم عبد الله بن أُبيٍّ: إن عنده أكثر من ألفين مقاتل مدرَّبين مجهَّزين بأسلحتهم مستعدين لخوض المعركة، فقال الله سبحانه: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون }، قال هذا في مقابل ما قال عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: {أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون }، فهم كاذبون حتى في هذه الدعوى المادية.
* {لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُون }:
{لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ }؛ لأن حُبَّ البلاد متأصِّل فيهم فلن يخرجوا، وليس لديهم عقيدة صادقة يُضَحُّون من أجلها، {وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ }؛ بل سوف يتخلُّون عنهم، {وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ } على افتراض ذلك، {لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُون }.
نفى سبحانه أن يكونوا صادقين في العزم على الخروج معهم من المدينة لو أُخرجوا منها، أو أن يكونوا مستعدِّين لمناصرتهم في المعركة لو وقعت، وقرَّر أنهم لو خاضوا المعركة سيُهزمون ويولُّون الأدبار، وخوضهم المعركة هو افتراض بعيد؛ إما على سبيل التنزُّل أو التهوين من شأنهم، أو أنه قد يوجد منهم مَن يفكِّر بخوض المعركة من أصحاب الهوج والحمق الذين لا يفكِّرون في عواقب الأمور.
* {لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون }:
وهذا من الأسلوب المعجز في القرآن، ولو أردت التعبير عن هذه الحقيقة فلن تجد أبلغ ولا أدق وصفًا من هذا السياق؛ فأشخاصكم أصبحت مرهوبة عندهم وهم لا يُظهرون ذلك؛ بل يُكِنُّونه في صدورهم، وهم يَرْهَبُونكم أشد من رهبتهم من الله عز وجل، أما أنتم فيعلمون قوتكم وبأسكم وشجاعتكم ويرونها ماثلة أمامهم، وأما الله تعالى فإنهم لم يقدروه حق قدره؛ ولهذا لا يخافونه.
وقد قيل: «مَن كان بالله أعرفَ كان منه أخوفَ»، ولذا قال هنا: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون }، والفقه هو: المعرفة القلبية الباطنة، ومعرفة الله هي من المعرفة الباطنة التي تلامس القلوب فتورث الخشية؛ ولو كان عندهم فقه لخافوا الله عز وجل وخافوا بطشه خوفًا لا يقارن به خوف أحد؛ إذ الملائكة المسبِّحة بحمده تخافه: {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ } [النحل: 50]، والأنبياء تخافه: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا } [الأنبياء: 90]، فكيف بالعصاة من بني آدم؟ ولكن غياب الفقه عن قلوبهم جعلهم مشغولين بخوف البشر عن خوف الله، وبخوف العقاب العاجل عن الآجل.
والكلام يصدق على اليهود والمنافقين معًا؛ لأنه ليس أحد من الطرفين بأولى برجوع الضمير إليه من الآخر، فهذه صفة أنهم يخافون المؤمنين أكثر مما يخافون الله.
وهل هم يخافون الله؟ قد يوجد منهم مَن يعرف الله بعض المعرفة، واليهود أهل كتاب، والمنافقون وإن كانوا في غالب أصلهم وثنيين، إلا أنه قد يوجد عند بعضهم إيمان بوجود الله، لكن خوفهم منه ضعيف أو منعدم.
* {لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُون }:
فليس لديهم استعداد أن يخوضوا معركة عسكرية فيها مواجهة جيش بجيش، والتاريخ بالاستقراء شاهد على هذا، فلا تجد في تاريخ اليهود مثل هذا، بخلاف الصليبيين؛ فلهم معارك ضارية مع المسلمين، ثم جاء الاستثناء كأنه استئناف لكلام جديد، فهم بارعون في الكيد والمكر والقتال من وراء الجُدُر والأحابيل والحيل التي يتفننون بها في القتال؛ وكانوا يمتنعون بالحصون المَشِيدة في قراهم، أما المواجهة فهم لا يحسنونها ولا يتقنونها؛ لأن الرُّعْبَ يعصف بقلوبهم.
{أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ }: والقتال من وراء الجُدُرِ يعني قتالًا من غير مواجهة؛ بل هو رشق بالنبل أو القذائف أو القنابل بلا رحمة، كما يفعلون الآن في حروبهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
{بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ }: هذا الوصف يحتمل معنيين:
1- أنهم إذا اجتمعوا قوَّى بعضهم بعضًا، فإذا جدَّ الجِدُّ وحزم الأمر غيروا ذلك ونقضوا ما أبرموا.
2- وهو أصح: أن خلافاتهم فيما بينهم شديدة؛ ولهذا عقَّب سبحانه بقوله: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى }، فهم مختلفون ما بين قبائل وأحزاب وجماعات من الأشكناز والسفرديم والفلاشا وغيرها من مكونات المجتمع اليهودي، والأحزاب اليمينية واليسارية تتكايد فيما بينها حتى في حال الحرب يسعى بعضها لإسقاط بعض، على أنهم الآن في حالة التمكين بحبل من الله أو حبل من الناس، وربما لا تبدو هذه الاختلافات ظاهرة للعين، ولذا قال: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا }، فالناظر يظنهم أمة واحدة مجتمعة، والله يخبر أن قلوبهم شتى.
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُون }: وصفهم في الآية السابقة بأنهم {لاَّ يَفْقَهُونَ }؛ لأن معرفة الله فقه تحتاج إلى قلب واعٍ مؤمن بصير، ووصفهم هنا بأنهم {لاَّ يَعْقِلُون }؛ لأن العقل الرشيد يدرك أهمية الاجتماع وعدم التفرُّق، وأن الله تعالى لا ينصر القوم المختلفين حتى لو كانوا من المؤمنين؛ ولهذا خاطب محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوله: {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ } [الأنفال: 46]، وكان الناس يوصي بعضهم بعضًا بالاتفاق والاجتماع، كما قال الرجل الذي حضرته الوفاة لأولاده:
كونوا جميعًا يا بَنيَّ إذا اعَتْرَى * خَطْبٌ ولا تتفــرقـوا آحادَا
تَأْبَى الرِّماحُ إذا اجتمعن تكـسُّرًا * وإذا افترقن تكسَّـرت أفرادَا
فالعقل الرشيد حتى من دون إيمان يوحي بأهمية الاجتماع، وأن تضم قوتك إلى قوة غيرك، فمَن كان دأبه إذكاء الاختلاف وتأجيجه والانشغال به لم يعد في طاقته جهد لمواجهة عدوه والتفرغ لحربه، وبهذا ترك العمل بمشورة العقل ونصيحته، فجُمع لهؤلاء بين غياب الفقه القلبي وغياب الفهم العقلي؛ إذ فقدوا تأثير القلوب، حتى صاروا يخافون الناس أكثر مما يخافون الله، وفقدوا تأثير العقول، حتى أصبحوا مختلفين فيما بينهم، فماذا بقي لهم إلا الأجساد؟!
وقد أمرنا الله بالاعتبار في قصة بني النَّضِير، وهذا من أعظم مواطن الاعتبار، أن يكون خوفنا من الله فوق خوفنا من كل أحد من الناس، وأن نُصِرَّ على التوحد وتنسيق الجهد مهما كانت الفروق والاختلافات بيننا.
وإن أكثر ما جنى به المسلمون على أنفسهم وسبَّب لهم الهزيمة والفشل وذهاب الريح هو التفرُّق والتنازع الذي عصف بهم طويلًا، ومثله التعصب للمذهب أو البلد أو القبيلة أو الحزب.
ومن المؤسف أن هذا سرى إلى بعض طلبة العلم والمثقفين والدُّعاة، فلم يعد التفكير: كيف نستطيع أن نوصل رسالتنا إلى العالم؟ ولا: كيف نستطيع أن نبني نهضة؟ ولا: كيف نستطيع أن نرسم القدوة الحسنة؟ بل أصبحت كثير من المشروعات والبرامج والانشغالات: كيف نسقط الآخر ونضعف قدرته؟ حتى مظهر الاجتماع الذي حكاه الله عن اليهود ليس مشاهدًا، فلا تحسبنا جميعًا، بل يدرك الناظر لأول وهلة أننا شيع وأمم وفرق تتهاجى، ويهدم بعضنا بنيان بعض، وصدق علينا قول محمد إقبال:
كلُّ شعب قام يبني نهضةً * وأرى بنيانَكـــم منقســمًا
في قيم الدهر كنتم أمةً * لهفَ نفسـي كيف صرتم أُممًا؟
بل إنك تجد الدولة المسلمة الواحدة عبارة عن أقاليم وجماعات وأعراق وتيارات، وكلها مستعدة لأن تتشظَّى وتسعى للانفصال، فهذا مما حذَّرنا الله منه؛ حين نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب والمشركين، وقال: {وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } [الحديد: 16].
والنهي عن التشبه بهم ليس محصورًا في المظاهر الشكلية، ولكن يعم الجوانب الأخلاقية والعملية والتربوية، وهي أمور ينبغي أن نتقي الله فيها ونتواصى بها حتى يأتي ذلك الجيل الذي يدرك أهمية أن يكون المؤمنون جماعة واحدة، وأن نركِّز على ما يستحق الاجتماع عليه، كأصول التوحيد والإيمان وأصول العبادات والأخلاق بدلًا من التركيز الدائم على مسائل الاختلاف وأسبابه وتضخيمها، وجعلها سببًا للتنازع والفرقة.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/books/7