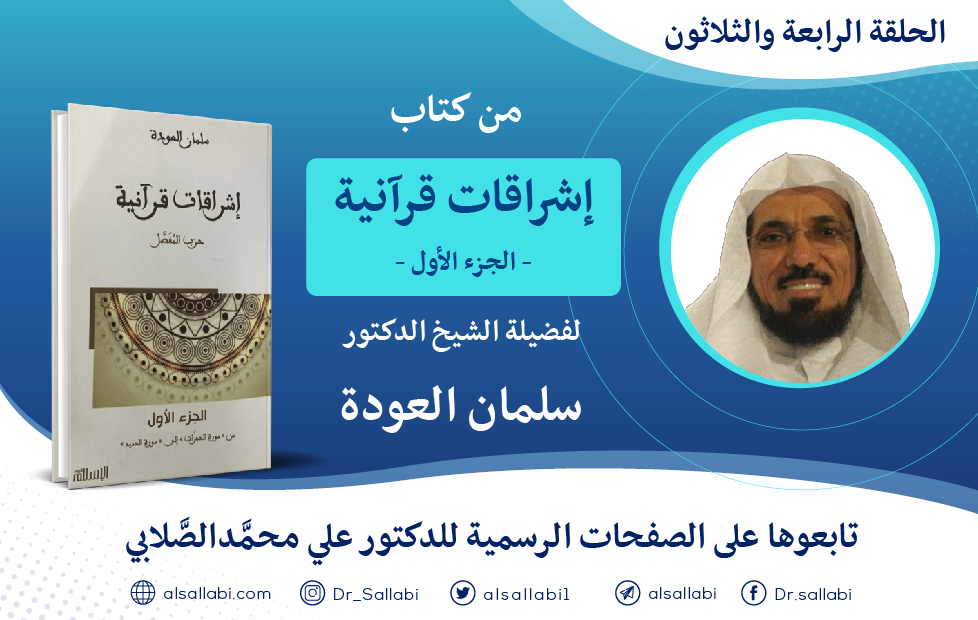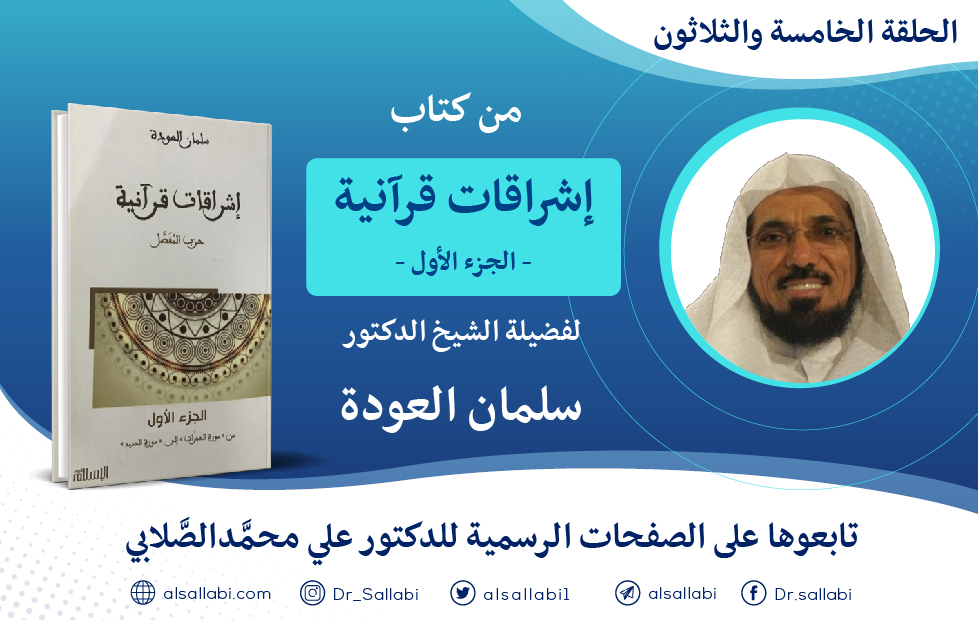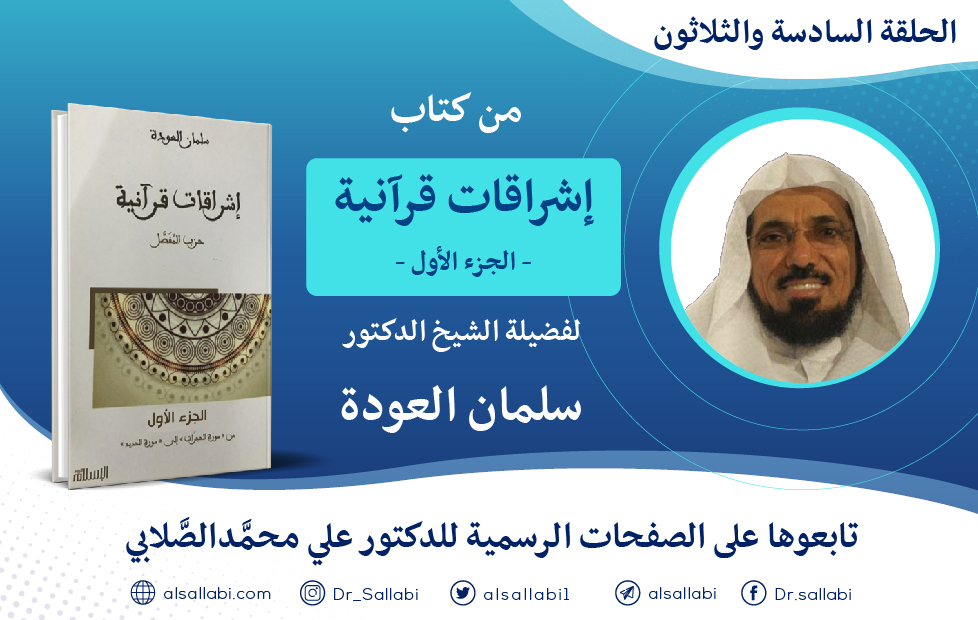من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان: (سورة الصف)
الحلقة الرابعة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* تسمية السورة:
أشهر أسمائها: «سورة الصَّف»، ووجه هذه التسمية وقوع لفظ: {صَفًّا } فِيهَا، وهو صَفُّ القتال.
ومن أسمائها: «سورة الحواريين»؛ لذكر الحواريين فيها.
وسمَّاها بعضهم: «سورة عيسى».
* عدد آياتها: أربع عشرة آية بلا خلاف.
* وهي مدنية عند الجمهور.
وقيل: إنها مكية، ونُسب هذا لابن عباس رضي الله عنهما.
وقال بعضهم: إن فيها المكي والمدني.
والصواب أنها مدنية.
* {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم }:
عبَّر بلفظ الماضي؛ إشارة إلى عَرَاقة التسبيح، وقِدَم الرسالات التي أرسل الله تعالى إلى عباده، حتى آدم عليه السلام هو نبيٌّ مكلَّمٌ.
واختار اسم {الْعَزِيزُ } و{الْحَكِيم } مراعاةً لسياق السورة، وإشارة إلى عِزَّة وغلبة الذين يطيعونه، كما قال في آخر السورة: {فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِين }، فمن عِزَّته أن يُعزَّ أولياءه، ومن حكمته أنه يرسل الرسل تترا، ويجعل لكل رسول شريعة وحُكمًا، كما أرسل موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام مصدِّقًا لما بين يديه، ثم محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتمًا للرسل ومصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه.
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون }:
ظاهر النداء العتاب، وفي هذا تحذير من حال اليهود الذين لا يفعلون ما يقولون، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون.
وقد ورد في سبب نزولها- كما في حديث عبد الله بن سلَام رضي الله عنه، عند أحمد، والترمذي- أن جماعةً من الصحابة اجتمعوا وقالوا: لو نعلمُ أيَّ الأعمال أحبُّ إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه السورة، وقرأها عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
فأُخبروا أن أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى الجهاد.
قال المفسرون: كان المسلمون يقولون: لو نعلم أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالَنا وأنفسَنا. فدلَّهم اللهُ على أحب الأعمال إليه فقال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا }. فابتُلوا يومَ أُحُدٍ بذلك، فولَّوْا مدبِرِين، فأنزلَ الله تعالى: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون }.
وعلى هذا السبب فالمعنى: لِمَ تَعِدُون بأمر ولا توفون به؟
ومن هنا أخذ بعض أهل العلم وجوب الوفاء بالوعد من الآية الكريمة.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «آيةُ المنافق ثلاثٌ، ومنها: إذا وعد أخلفَ».
والعلماء متفقون على وجوب الوفاء بالوعد ديانةً، إذا لم يكن حرامًا، واختلفوا في الإلزام به قضاءً، أي: إذا رُفعت فيه دعوى مطالبة بالإلزام بالوعد، فذهب مالك إلى وجوبه إذا ترتب عليه التزام.
وقيل: يجب الوفاء بالوعد قضاءً، فلو قلت لأحد: تزوَّج وأعطيك عشرة آلاف ريال، فإنه يجب عليك الوفاء؛ لأن عقد الزواج يترتب عليه التزام بالنفقة على الزوجة والمهر ونحو ذلك من الحقوق المالية.
وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجب الوفاء بالوعد قضاءً- أي: عند التقاضي- لكن لا يجوز أن يتعمَّد أن يَعِدَ ويخلف، ولو وعد ثم طرأ عليه أن يخلف لعارض فلا حرج عليه، والموعود به لا يلزم إلا بالقبض، كالهبة لا تلزم إلا بالقبض.
وقيل في سبب النزول: إن بعض الناس كان يقول: قاتلتُ. ولم يقاتل، وصليتُ. ولم يصلِّ.
حتى ورد أن صُهيبًا رضي الله عنه قتل رجلًا، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَبه، فجاءه عمر رضي الله عنه وقال: إن فلانًا يدَّعي أنه قتله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه هو الذي قتله، فنزلت هذه الآية. فعلى هذا الوجه فهي تحذيرٌ من الادِّعاء والكذب.
وثَمَّ معنى يلتبس عند بعض الناس، ويظنونه داخلًا في دلالة الآية؛ وهو أن يأمر الإنسان بالشيء، ثم لا يفعله؛ كمَن يحثُّ على قيام الليل أو الصيام أو عمل الخير، ولا يفعله، ومثله: أن ينهى عن الشرِّ والمنكر، ويفعله.
وهذا غير داخل في معنى الآية؛ لأن الأمر بالخير خيرٌ، ولو لم يفعله، وعلى المؤمن أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو قارفه، وقد نقل القرطبي عن بعض الأصوليين قولهم: «فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضًا». ويكاد أن يجمع العلماء على أنه واجب على المسلم أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعله، وينهى عن المنكر ولو وقع فيه.
أما قوله عز وجل: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُون } [البقرة: 44]، فهو دليل على أن من القبيح أن يأمر الإنسانُ الناسَ بالبِرِّ ثم ينسى نفسه فلا يأمرها به، ولا يعني هذا أَلَّا يأمر الناس بالمعروف، فكونه لا يفعل المعروف ولا يأمر غيره به شرٌّ من كونه يأمر غيره بالمعروف ولا يفعله، كما أن المأمورات متفاوتة؛ فمنها الفرائض والواجبات والمندوبات، وقد يكون في المرء نقص في بعض المعروف واجتهاد مشهود في غيره من الصور الأخرى.
* {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون }:
المقت: أشدُّ البغض، والآية تفيد بأنه مقت كبير عظيم عند الله أن يقع ما توعَّد عليه في الآية، وإذا كان البغض من الناس شاقًّا على نفس أحدنا، فكيف ببغض الله للعبد؟! وهذا يقع حين تدَّعي شيئًا لم تفعله، ولا يجوز لك بحال أن تحبَّ أن تُحمد بما لم تفعل، ولا تعد وفي نيتك أَلَّا تفي.. هذه قيم أخلاقية يربَّى الناس عليها.
* {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوص }:
مقابل المقت العظيم للمُدَّعِين ما ليس فيهم ذكر الله تعالى الحب لنقيضهم من المؤمنين الباذلين نفوسهم في سبيله؛ ذودًا عن حِياض الدين، وحفظًا لمقام الإسلام، ودفعًا لغوائل الشر والعدوان عن الحقِّ وأهله، وليس في سبيل الدنيا وشهواتها.
وقوله: {صَفًّا } أي: صافِّين، أو مصطفِّين، والصَّفُّ يكون في الصلاة، ويكون في الحرب، وهو إشارة إلى النظام واجتماع الكلمة والراية، وأن النظام والانضباط جزء من القيم الإسلامية؛ يكون في العبادة التي يقف الناس فيها أمام ربهم، ويكون في الجهاد الذي هو من أعظم شرائع الإسلام وذِروة سَنامه، وهو كذلك في سائر شؤون الحياة، يعلِّم الناس الانضباط ووحدة الكلمة والتقارب واجتناب أسباب الفرقة؛ ولهذا شبههم بـ«البنيان المرصوص»، فهم بشرٌ؛ لكنَّ أكتافهم وأجسادهم متراصة متلاحمة كالبنيان الذي لا تجد فيه ثغرة ولا فجوة ولا اعوجاجًا؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمنَ للمؤمن كالبُنيان؛ يَشُدُّ بعضُه بعضًا». وقال: «مَثَلُ المؤمنينَ في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد».
وقد وصف الله سبحانه صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم {أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ } [الفتح: 29].
ويجوز أن يكون معنى «المرصوص»: الذي وُضع عليه الرصاص، كما ذكر الفرَّاء، وغيره من أئمة اللغة، واختاره ابن العربي، وذكر مباني في الشام وفي غيرها قد وضع فيها الرصاص، فكانت من أقوى ما يكون من البناء، وفي ذلك إشارة إلى قيمة عظيمة من قيم الوحدة بين المسلمين وتقارب قلوبهم، وأن الله تعالى يحب هؤلاء، ومفاده: أن الله تعالى لا يُحِبُّ أولئك الذين {فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا } [الأنعام: 159].
* {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين }:
ذكر تعالى أمرًا وقع لموسى عليه السلام مع قومه حين ناداهم بهذا الدعاء المحبَّب الذي يجعلهم يستجيبون له ويستمعون إليه، وعاتبهم على أذيتهم له مع علمهم برسالته، وقد آذوه في أشياء كثيرة، كما في قولهم: {لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ } [البقرة: 61]، وكما في قصة البقرة، وعبادتهم للعجل، وقصة دعوته لهم لدخول بيت المقدس، ولعلَّ هذا أقرب ما يكون علاقة بالآية الكريمة لما {قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا } [المائدة: 22] ثم قالوا: {يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا } [المائدة: 24].
وفي هذا من سوء الخطاب وسوء الأدب مع الله ومع رسوله، ومع ذلك يتلطَّفهم فيقول لهم: {يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي }.
وقد بلغ من أذيتهم له أن عيَّروه عليه السلام بشيء من خلقته الباطنة بما ليس فيه، كما في «الصحيحين» أنهم قالوا: «إن موسى رجل آدر». أي: أن في خصيتيه انتفاخًا، وهكذا كل قوم خُزِنَ عنهم العمل وابتُلوا بالقول يبحثون عن أي شيء حتى يكون سببًا للقيل والقال، فأذن الله تعالى أن يراه كثير من الناس بعدما خرج واغتسل وذهبت ثيابه، فرآه الناس أجمل ما كان وأحسن ما كان، وعرفوا أن هذا كان إفكًا وفرية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلونَ عُراةً، ينظرُ بعضُهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسلُ وحده، فقالوا: والله ما يمنعُ موسى أن يغتسلَ معنا إلا أنه آدَرُ، فذهب مرة يغتسلُ، فوضع ثوبه على حجر، ففرَّ الحجرُ بثوبه، فخرج موسى في إثره، يقول: ثوبي يا حجرُ، حتى نظرت بنو إسرائيلَ إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطَفِقَ بالحجر ضَرْبًا».
وعبَّر بالماضي ولم يقل: «وقد علمتم»، وإن كان هذا هو المعنى، و«قد» تدلُّ على التحقيق، وهو التأكيد أنكم تعلمون، ولكن التعبير بالمضارع يشير إلى تجدد العلم بتوالي الآيات والمعجزات، وقد حصل لموسى عليه السلام من الآيات شيء كثير؛ {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ } [الأعراف: 133].
{فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } أي: فلما أصرُّوا على الضلال والزيف والتحايل والكذب والتحريف، جاءت العقوبة من جنس عملهم؛ فصرفهم الله عن الحقِّ، فهم لا يهتدون؛ ولهذا قال: {وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين }، فوصفهم بالفسق، كما قال في «سورة المائدة»: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِين }. وقال سبحانه: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِين }، وأشدُّ ما يكون الفسق حينما يكون من الأحبار الذين يعصون على بصيرة وعلم.
وفي الآيات إشارة إلى بقاء هذه الأمة، وأنها لا تزول مهما صادفها من النكبات، فإن التعبير بالفعل المضارع {يُقَاتِلُونَ }، يدل على التجدد والتكرر مرة بعد مرة.
وفيه إشارة إلى ديمومة صراع الحق والباطل إلى قيام الساعة، فلا تزول القوى الظالمة الضالة، سواء كانت معصيتها بعلم أو بجهل أو بكفر، ولا سبيل إلى استئصالها أو زوالها، ومن شأن هذا أن يجعل المؤمن أكثر تواضعًا واعتدلًا وتكيفًا مع ما في الحياة البشرية من النقائص والأخطاء، فالأرض لن تَتَمَحْضَ للخير، ولن تسيطر عليها كلمة الله تعالى في كل مكان، وكانت الشيوعية تبشِّر الناس بالفردوس الموعود، وكانت الليبرالية الغربية تتنبَّأ بنهاية التاريخ واستسلام العالم لها، فالإسلام لا يوجد فيه هذا، وإنما يوجد فيه الإشارة إلى أن الخير والشر موجودان مما يجعل المؤمن سالمًا من اندفاع غير مدروس في دعوته أو عمله أو جهاده.
* {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِين }:
لم يقل عيسى عليه السلام لهم: «يا قوم»؛ لأنهم ليسوا قومه، فهو يخاطب بني إسرائيل الذين أُرسل إليهم موسى عليه السلام، وقد كانوا متعصِّبين للتوراة تعصبًا مفرطًا، وعيسى عليه السلام جاء مصدِّقًا لما بين يديه، أي: معزِّزًا ومؤكِّدًا لما سبقه من التوراة؛ حتى يؤلِّف قلوبهم على القبول، وإن كان التصديق لا يعني أنه لم ينسخ شيئًا منها؛ ولهذا قال تعالى: {وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } [آل عمران: 50]، وعيسى صلة بين موسى ومحمد عليهم السلام، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينما سُئل: ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوةُ أبي إبراهيمَ، وبُشرَى عيسى، ورأت أمي أنه خرجَ منها نورٌ أضاءت منه قصورُ الشام»
والبشارة هي: الإخبار بالأمر السَّارِّ، وقد بشَّر الرسلُ عليهم السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى موسى عليه السلام، وقد ذكر تعالى في الكتاب الكريم بشارة النبي به في قوله: {ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِين } [آل عمران: 81]. ولذلك جاء في التوراة: «إن الحق أقبل أو تجلَّى من سَيْنَاء، وأشرق من سَاعِير بفلسطين، واستعلن واستعلى في فَارَان؛ وفَارَان: جبل بمكة؛ إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي التوراة أيضًا: «أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل جبل فَارَان»، وهو بالاتفاق جبل بمكة المكرمة، وفي هذا يقول الشاعر محمد إقبال في قصيدته:
يا طِيْبَ عَهْدٍ كنتَ فيه مَنارَنا * فبَعَثْتَ نورَ الحقِّ مِنْ فَارانِ
وأسرْتَ فيه العاشقينَ بلَمْحةٍ * وسَقَيْتَهم راحًا بغير دِنَانِ
أحرقتَ فيه قلوبَهم بتوقُّدِ الـ * إيمـان لا بِتَلَهُّب النيرانِ
لم نبقَ نحن ولا القلوبُ كأنها * لم تَحْظَ من نار الهَوَى بدُخَانِ
وجاءت البشارة في إنجيل مَتَّى، وإنجيل يُوحَنَّا، ومنها: الإشارة إلى الناموس الذي يأتي بعد موسى عليه السلام، وأنه الخاتم، وعباراته بعضها صريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم: «محمد»، وبعضها تشير إلى «وادي البكاء»، وهي هنا كلمة لا تعني «البُكاء»، وإنما تعني: «البَكَا»، وقد كُتبت بالحروف الكبيرة، مما يدل على أنها اسم علم؛ إشارة إلى مكة، فهنا تحريف لاسم الوادي: وادي مكة، وهذا موجود في الأناجيل المتداولة اليوم بين أيدي الناس مع تواصيهم بكتمان الأمر، ويوجد منهم المنصفون الذين يعترفون بذلك، فضلًا عن الإشارات الكثيرة التي ليس فيها تصريح باسمه صلى الله عليه وسلم.
و{أَحْمَدُ } من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيغة مبالغة من الحمد، فهو أكثر الناس حمدًا لربه عز وجل، وهو أكثر الناس استحقاقًا للحمد؛ ولهذا من أسمائه: أحمد، ومحمد، وكذلك: الماحي، والحاشر، والعاقب.
وبعض العلماء أوصل أسماءه الشريفة إلى تسعة وتسعين اسمًا، وبعضهم أوصلها إلى ثلاثمئة اسم، وبعضها ألقاب أو صفات، كما ذكره ابن القيم، وغيره.
{فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِين }: هل مرجع الضمير في هذا الفعل إلى عيسى عليه السلام، أم إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟
وهل الذين قالوا هذا القول العظيم هم قوم النصارى، أم هم مشركو العرب؟
جاءت الآية بهذا مبهمًا لتشمل الأمرين، ويعزِّز هذا قوله سبحانه: {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون } [الذاريات: 52]، وقال: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ } [الزخرف: 23].
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: