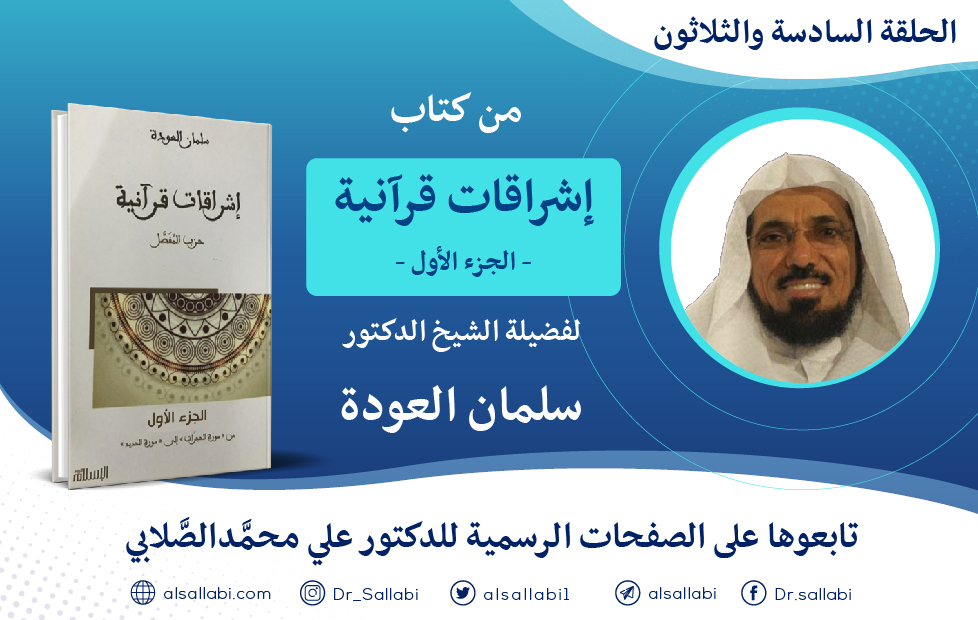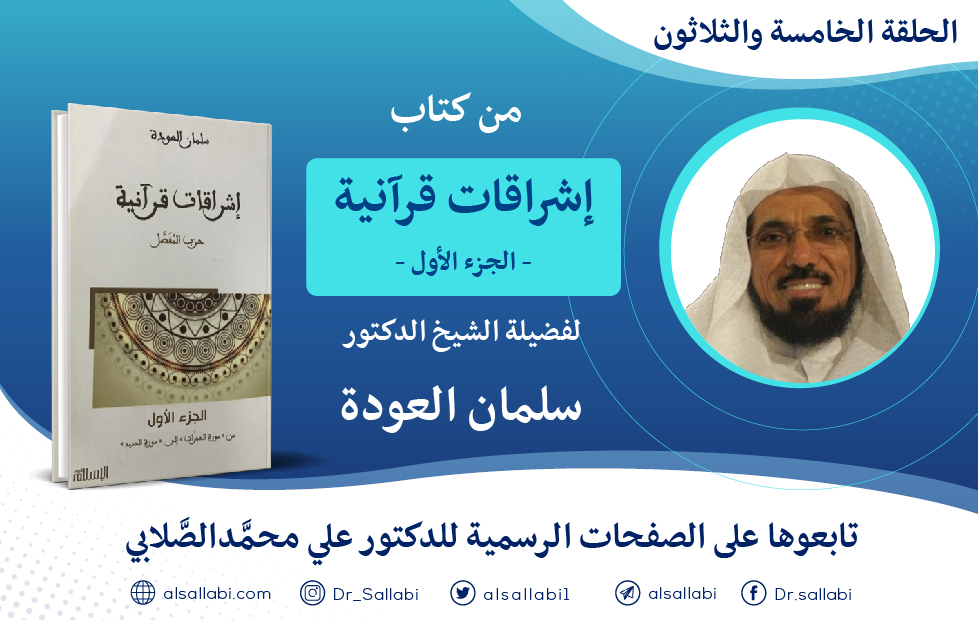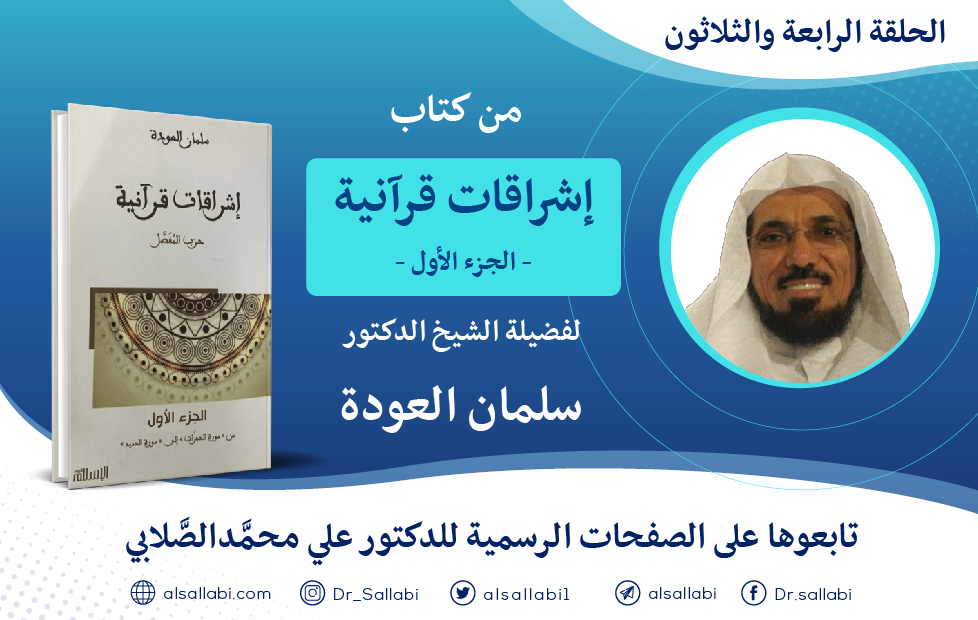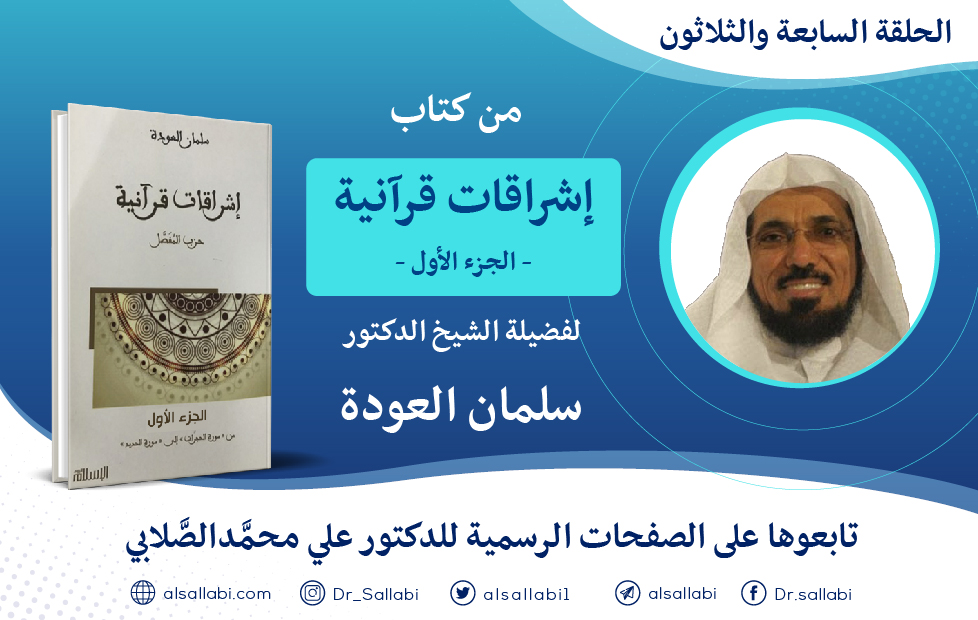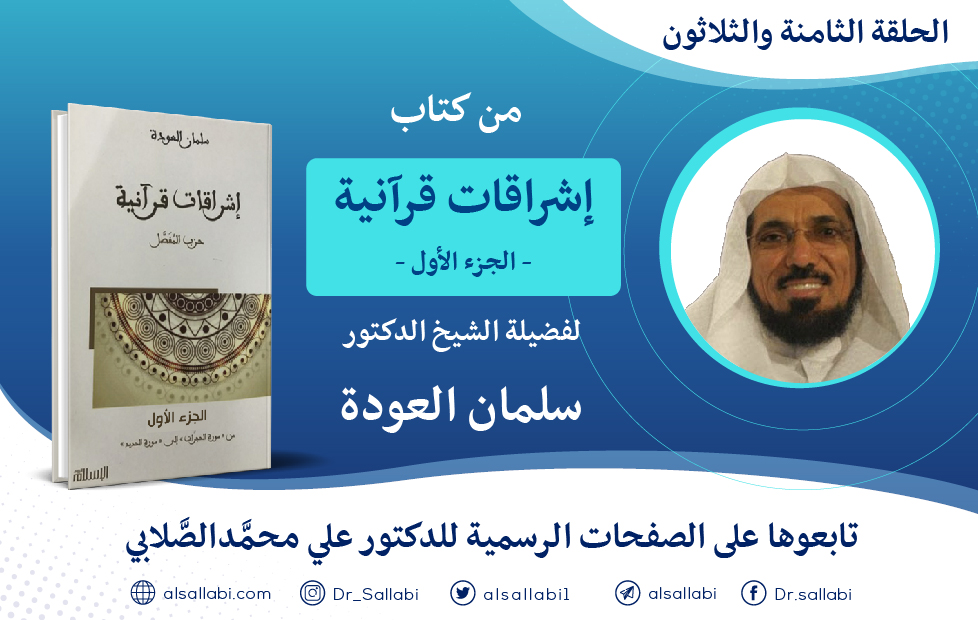من كتاب إشراقات قرآنية: (سورة الجمعة)
الحلقة السادسة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* تسمية السورة:
اسمها: «سورة الجُمُعة»، كما في كتب التفسير، والمصاحف، و«السنن»، وفي الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ووجه تسميتها: وقوع لفظ: {الْجُمُعَةِ } فيها، وهو اسمٌ لليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام.
* عدد آياتها: إحدى عشرة آية باتفاق علماء العدِّ.
* وهي مدنية باتفاق علماء التفسير.
* {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم }:
استفتحها بالتسبيح الدال على أن الكون كله خاضع لعبودية لله، وأن الذي يقع منه المخالفة والتمرد هم بعض الإنس والجنِّ.
{الْمَلِكِ } أي: المالك الخالق المدبِّر، {الْقُدُّوسِ }: المنزَّه الكامل الذي لا يعتريه نقص ولا عيب، {الْعَزِيزِ }: الذي له العزة، والذي يمنح العزة لمَن يشاء،
{الْحَكِيم } الذي يضع الأمور في نصابها، والمحكم المتقِن لما يخلق، والحكيم في شرعه وأمره ونهيه ووحيه، ولذا ذكر بعدها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
* {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِين }:
{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ }: وهذا من مقتضى الملك؛ حيث اعتنى بعباده، ولم يهملهم ويتركهم سُدى، وإنما أرسل إليهم رسلًا، وأنزل إليهم كتبًا، ومن مقتضى القُدُّوْسِية والتنزُّه عما لا معنى له، وهو مقتضى العزة، حيث سينصر رسله وأولياءه في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، وهو مقتضى الحكمة فيما شرع لهم، وفيما قدَّر وقضى.
والأُمِّيُّون جمع: أُمِّيٍّ؛ وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وتُطلق على العرب من حيث الجملة، حتى لو كان فيهم مَن يقرأ، فإنهم يسمون: أمة الأُمِّيِّين، وهذا نبي الأُمِّيِّين، لما غلب عليهم من عدم القراءة والكتابة.
ووقوع البعثة في العرب لم يكن اتفاقًا، وإنما اصطفاء وابتلاء، ولحكمة أرادها سبحانه، مع أن في الأرض يوم ذاك أمم لها سيادتها وحضارتها وعلومها وفلسفتها وسلطانها؛ كالرومان، والفرس، واليونان، والصينيين، وغيرهم، ولكن اختار الله العرب؛ لأنهم أخلق وأجدر الأمم بحمل الرسالة آنذاك.
وليس معنى هذا أنهم كَمَلَة، كلا؛ بل فيهم عيوب، وفي غيرهم من الأمم خصائص يفوقون فيها العرب؛ لكن من حيث مجموع الصفات، فالعرب أخلق من غيرهم بحمل الرسالة، فقد كانت فيهم أخلاق عظيمة؛ كالكرم، والشجاعة، والصدق، ولم تفسدهم آثار الحضارة المادية، ولم يغلب عليهم الترف، فكان لديهم من الاستعداد الذاتي والنفسي الفردي والجماعي ما ليس لغيرهم.
وكونه مبعوثًا في الأُمِّيِّين هذا وصف للواقع، فقد كانت بعثته فيهم، وليس في النص أنه لهم، فهو مبعوث فيهم ومن بينهم؛ ولكنه مبعوث إلى الناس كافَّة، وإن كانت مسؤولية الأُمِّيِّين أعظم؛ لأن الرسول منهم، والكتاب بلغتهم، والحجة عليهم أعظم.
وكان صلى الله عليه وسلم أُمِّيًّا، لا يقرأ ولا يكتب؛ ولهذا لما جاءه الملَك وقال: {اقْرَأْ }. قال: ما أنا بقارئ. وقال الله عز وجل: {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُون } [العنكبوت: 48]، وهذا أدعى إلى أن تتحقق فيه البشارة التي بَشَّر بها الرسل والأنبياء السابقون ببعثة النبي الأُمِّيِّ، فهي تتحقق بهذه الصفة، وهو أدعى إلى أن يتقبل العرب منه ويستجيبوا له ويتجمعوا حوله؛ لأنه رسول منهم، وهو نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ لئلًا يرتاب المبطلون، أو يظنوا أنه تلقَّى هذا العلم من أحد أو قرأه في الكتب؛ فهو الأُمِّيُّ الذي علَّم البشرية كلها، واستفتح نبوته بـ{اقْرَأْ }، وجاء بالكتاب العظيم، وأنشأ أعظم حضارة على وجه الأرض.
{يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ }: وهذا هو المقصد الأول، وبدأ بالتلاوة؛ لأنها أول مراحل العلم، وأول ما خُوطب به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {اقْرَأْ }، ومعناها: اتْلُ، كما قال سبحانه: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ } [العنكبوت: 45]، ولذا سُمِّيت قراءة القرآن: تلاوة، كما قال تعالى: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ } [البقرة: 121]. فالتلاوة، وإن كانت أولى المراحل، إلا أنها مشعرة بما بعدها من المتابعة والتأسِّي والإِذعان.
والآيات هي: آيات الله، أو آيات القرآن.
{وَيُزَكِّيهِمْ }: وهذا هو المقصد الثاني: وهو تزكية القلوب، وهو مقصد عظيم؛ لأن مدار النجاح والفلاح على صلاح القلوب واستعدادها لتلقي الوحي وقبوله والإيمان به، وما يترتب على ذلك من حسن التنسك والعبادة، والصلة بالله التي هي سِرُّ الخشية والتقوى والخلق الكريم، والعلم الشرعي ليس المقصود به التكثُّر أو المباهاة أو المفاخرة، وإنما تزكية النفوس، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام:
{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ } [البقرة: 129]، والتي تحقَّقت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
وذكر التزكية التي هي أثر عن العلم؛ دليل على أن تصحيح المعرفة وتصحيح الفكر وضبط (عادات التفكير) أسبق من تصحيح السلوك، فالتزكية أثر عن المعرفة الصحيحة والفكر السليم، فالعقل أولًا، والقلب ثانيًا.
{وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ }: وهذا هو المقصد الثالث، و{الْكِتَابَ } يقتضي الكتابة، فهو أُمِّيٌّ يُعلِّم الناس الكتابة، ولذا قال الشاعر:
أَخوكَ عيسى دَعا مَيْتًا فَقامَ له * وأَنتَ أَحيَيتَ أَجيالًا مِنَ الرِّمِمِ
ولهذا رُوي عنه صلى الله عليه وسلم: «طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم». يعني: ذكرًا كان أو أنثى.
والكتابة أصبحت جزءًا من ضرورة الشريعة في مسائل وأحكام كثيرة، كما في البيوع مثلًا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ } [البقرة: 282]، ولم يعلِّمهم الكتابة بالخط أو بالقلم فحسب، بل علَّمهم ما هو أوسع من ذلك؛ إذ فتح مداركهم للمعرفة وللاطلاع وللبحث.
يا طالِبي عِلمَ النَبِيِّ مُحَمَّدٍ * ما أَنتُمُ وَسِواكُمُ بِسَواءِ
فمِدادُ ما تَجري بِهِ أَقلامُكُم * أزكى وأفضلُ مِن دَمِ الشُهَداءِ
ولم يكن الإسلام يخاف من المعرفة، ولا يحجر عليها، إلا ما كان ضررًا مَحْضًا أو غالبًا؛ بل جعل للعلم تلك المكانة العالية، وجعل فضل العلماء على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب.
والكتاب هو أيضًا القرآن، وهو أعظم الكتب وأشرفها وأجمعها لخير الدنيا والآخرة.
{وَالْحِكْمَةَ }، فالمقصد الرابع: أن يعلِّمهم الحكمة، وقد تكون هي السنة، كما قاله غير واحد من السلف؛ وهي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكَلِم، وإلا فإن لفظ الحكمة أبعد من ذلك، فالحكمة هي: القول المحكم المبني على الخبرة والتجربة والمعرفة، والحكمة هي: البصيرة، وهذا لا يتحقَّق إلا بطول المجالسة والاقتباس والتأسِّي، وهي أثر من صفاء القلوب بالتزكية، وصفاء العقول بالمعرفة.
وعقَّب بقوله: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } وهذا انتقال من الصلاح إلى الإصلاح، ففي المقام الأول: تزكية ذاتية للفرد والجماعة.
والتدرُّج والترقِّي ينتقل بهم إلى أن يكونوا علماء حكماء قادة.
ومما ظهر لي في الجمع بين الكتاب والحكمة: أن الكتاب يعني: الكتابة والقراءة والفهم والتعليم. وأن الحكمة هي: البصيرة والخبرة وخلاصة التجربة الإنسانية.
فهذه هي المقاصد الأربعة للبعثة، وهذا مدعاة إلى أن نتساءل دائمًا: هل الاهتمامات التي تشغل حياتنا اليوم، سواء كانت علمية معرفية، أو دعوية، أو اجتماعية، أو سياسية، هي ضمن هذه الأربع وبشكل جوهري؟ أم إننا فرَّطنا كثيرًا في الأولويات، وأصبحنا نُضيع كثيرًا من الوقت والجهد في أمور ليست جوهرية؛ بل هي فروع وتفصيلات في الشريعة وقع الخُلف فيها، واختار كل إمام أو فريق ما يميل إليه، أو هي جزئيات من أمر الحياة الدنيا لا يتعلق بها نهوض ولا نجاح ولا فلاح!
{وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِين } أي: وإنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين.
ويمكن ربط هذه المقاصد الأربعة بأسماء الله الأربعة، فمن كمال ملكه سبحانه أن يوجِّه إلى عباده الرسالة، ويُقيم لهم الطريق والمحجَّة، و«القدُّوس» يُناسب قوله: {وَيُزَكِّيهِمْ }؛ لأن القَدَاسة والتزكية متقاربان، والتقديس: تزكية، ولذا يسمَّى الصَّدِيق التَّقي: قِدِّيسًا. و«العزيز» يناسب تعليم الكتاب، وقد وصف الله كتابه بأنه عزيز: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز } [فصلت: 41]، والعِزُّ هو: بالتمسك بهذا الكتاب والأخذ به، و«الحكيم» يناسب تعليم الحكمة، فهو يُلْهِم عباده الصالحين الذين يقتبسون من وحيه الحكمة والصواب في أقوالهم وآرائهم ودعائهم.
* {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم }:
النص هنا يبيِّن أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيًّا خاصًّا بالعرب؛ بل هو رسول للأبيض والأسود، والعربي والأعجمي، ولكل أحد من الناس بلغته رسالته.
والمقصود: آخرون من العرب من الأجيال اللاحقة من التابعين وتابعي التابعين، أو من كانوا صغارًا وقت النبوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «وَدِدْتُّ أنَّا قد رأينا إخواننا».
فتشوَّف إلى أن يرى المؤمنين الذين آمنوا به، ووعدهم بأن الصابر منهم على دينه له أجر خمسين، فهؤلاء من «الأميين»، ولكنهم لم يلحقوا بهم في الزمان والرتبة، وهم متأخرون عنهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: «خيرُ أُمَّتي قَرْني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
وقال أيضًا: «مثلُ أُمَّتي مثلُ المطر، لا يُدرى أولُهُ خيرٌ أم آخرُهُ».
وفيه إشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن الله تعالى اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقِّي عنه، وفضَّلهم على غيرهم من أصحاب الأنبياء السابقين، وفضَّلهم على غيرهم من اللاحقين، فهم أفضل الأمم من حيث الجملة.
ويحتمل السياق معنى آخر؛ وهو أن المقصود: الأمم الأخرى من غير الأميين، وكأن الضمير في قوله: {مِنْهُمْ } يعود إلى المبعوث إليهم عامة، وليس إلى الأميين خاصَّة، وكأنه قال: هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين أيضًا، أو يرجع إلى قوله: {وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِين } يعني: وآخرين ممن كانوا في ضلال مبين بعث فيهم محمدًا صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فالآية تؤكِّد أن الرسالة للبشر كلهم جميعًا.
ومما يُعزِّز هذا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأُنزلت عليه «سورةُ الجمعة»: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } قال: قلتُ: مَن هم يا رسولَ الله؟ فلم يراجعه حتى سألَ ثلاثًا، وفينا سلمانُ الفارسيُّ، فوضع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمانَ، ثم قال: «لو كان الإيمانُ عند الثُّرَيَّا، لنالَهُ رجالٌ- أو: رجلٌ- من هؤلاء». ولهذا قال مجاهد في الرواية المشهورة عنه: هم الأعاجم.
وقيل: هم الفرس. وهو يعود إلى ما قبله.
وقيل: هم الأطفال الصغار.
وقيل: هم الأمم الأخرى.
وكل ذلك داخل في معنى الآية، فهؤلاء الآخرون الذين بُعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيهم لم يكونوا في درجتهم، أو لم يكونوا في زمانهم، وهذه معجزة نبوية في إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب؛ لأنه يومئذ لم يكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الناس، كان فيهم سلمان الفارسيُّ، وصُهيب الرُّوميُّ، وبلال الحبشيُّ رضي الله عنهم، أفراد يُعَدُّون على الأصابع، والسياق هنا عن أمم بُعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيلحقون بهم؛ لأن قوله:
{لَمَّا } يعني: لم يلحقوه ولكنهم قاربوا أن يلحقوا، وهكذا كان؛ فإن كل شعب من شعوب الأرض كان له أثر وعمل في خدمة الدين ورفعة شأنه، وقد نبغ علماء من غير العرب وتميَّزوا باللغة العربية والبلاغة والفصاحة، وكتبوا، وألَّفوا، وأصَّلوا، ونظَّروا، وفي النحو كذلك، وفي الحديث النبوي والفقه، ولعل المؤلِّفين من غير العرب أكثر وأشهر، وهؤلاء الأئمة الستة الذين صنَّفوا الكتب الستة في السنة النبوية غالبهم من الأعاجم، وكذلك أئمة التفسير، أما الأئمة الأربعة المتبوعون في الفقه فهم من العرب، غير أبي حنيفة فهو من فارس، رحمهم الله جميعًا.
* {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم }:
أي: فضل الله تعالى بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم واختياره، وفضل الله واختياره للعرب الأُمِّيِّين، وكون الرسول منهم والقرآن بلغتهم، وفي ذلك رد على الحاسدين، وخاصة اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والحاسد في حقيقة الأمر يعترض على قضاء الله تعالى واختياره.
{وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم }: ففضله يعود على مَن اختارهم بما لم يكونوا يحتسبون، وهو واسع أيضًا لغيرهم ممن تواضع لعظمته وسأله من فضله.
* {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين }:
انتقل السياق إلى الحديث عن أمة سابقة لها كتابها ورسولها وتاريخها يشبه من بعض الوجوه تاريخ الأمة المحمدية؛ وهم اليهود.
وفي الآية إشارة إلى أنهم كُلِّفوا ذلك الأمر على غير طوعهم، وثمة فرق بين مَن يختار الخير ويقصده ويبحث عنه، وبين مَن فُرضت عليه بعض الفروض أو العادات أو الرسوم فرضًا بسبب البيئة أو المجتمع الذي من حوله من غير أن يكون عنده اختيار؛ ولهذا فرَّق أهل العلم بين مسلمة الاختيار ومسلمة الاضطرار.
و{التَّوْرَاةَ } هي: الكتاب الذي أُنزل على موسى عليه السلام.
والحمل هنا معنوي من باب: الحَمَالَة، كما تقول: فلان تحمَّل دينًا أو تبعةً معنوية؛ ولكن اليهود لم يحملوها، أي: لم يقوموا بها، فهم قرؤوها، وحفظوها، ظانين أنهم بذلك حملوا الأمانة وأدَّوها، ولكنهم لم يعملوا بها، ولم يقوموا بحقها، وفي ذلك تحذير للأُمِّيِّين أن يسلكوا سبيلهم، وحَثٌّ على أن يحققوا مقاصد الرسالة المشار إليها في أول السورة، وأَلَّا ينشغلوا باللفظ عن المعنى، ولا بالوجاهة والرئاسة والتصدر عن الإيمان والتقوى، ولا بالرسوم والأشكال الظاهرة عن الحقائق والمعاني والأحوال.
{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا }: والمقصود ليس تشبيه شخص بعينه؛ لأن سياق الكلام هنا ليس عن شخص؛ بل عن أمة أو طائفة، وإنما ضُرب المثل بالحمار؛ لأنه من أكثر الحيوانات بلادة.
وكان اليهود يفاخرون العرب بأنهم يقرؤون التوراة، وأنهم أصحاب علم وأهل كتاب، ويحتقرون العرب الأُمِّيِّين، وكان العرب يُسلِّمون لهم تسليم الجاهل للعالم، فلما كفروا وجحدوا فضحهم الله، وحقَّرهم، وكشف حقيقة أمرهم.
والمثل هنا يختلف عن قوله: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا } إلى قوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث } [الأعراف: 175- 176]، فـ«المثل» هنا حكاية عن شخص بعينه.
{بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ }: كذَّبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا بعثته، وفي أحسن الأحوال قالوا: هو رسول العرب الأُمِّيِّين.
{وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين }؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بجحد الحق، وظلموا أتباعهم بحرمانهم من الاتباع الصادق، وظلموا الحقيقة بالتنكر لها وافتروا.
وفي الآية بيان أن الله لا يهديهم، وأنه ميئوس منهم، وسيظلون كذلك، وهكذا وُجد، فمع أن الرسالة بُعثت وهم في المدينة، ثم طُردوا منها، ومن خيبر، ومن جزيرة العرب، إلا أن موقفهم ظل كما هو إلى اليوم وإلى الأبد، ولم يُسلم منهم إلا أفراد قلائل، كما أسلم عبد الله بن سلَام رضي الله عنه.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: