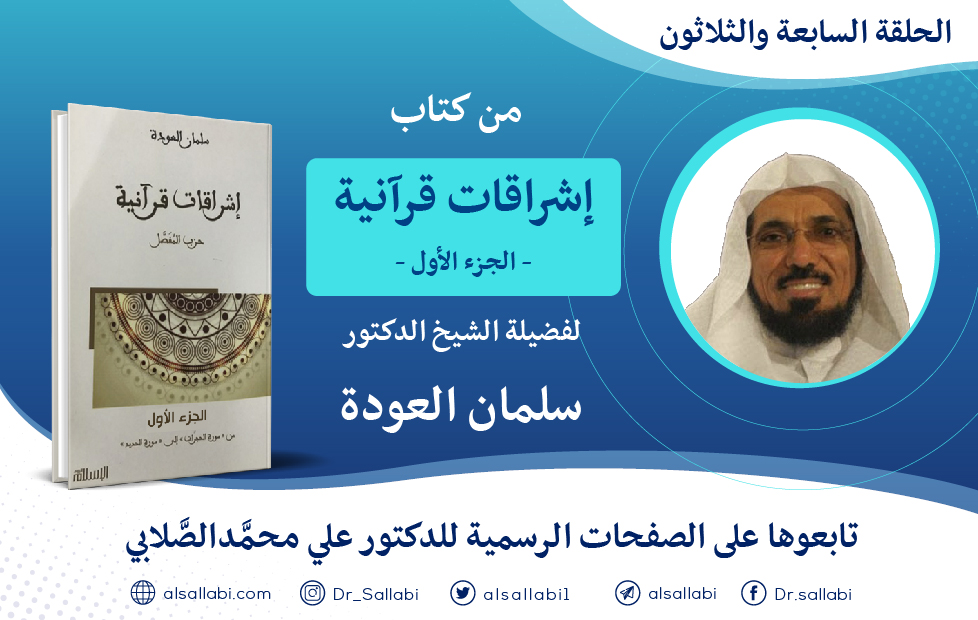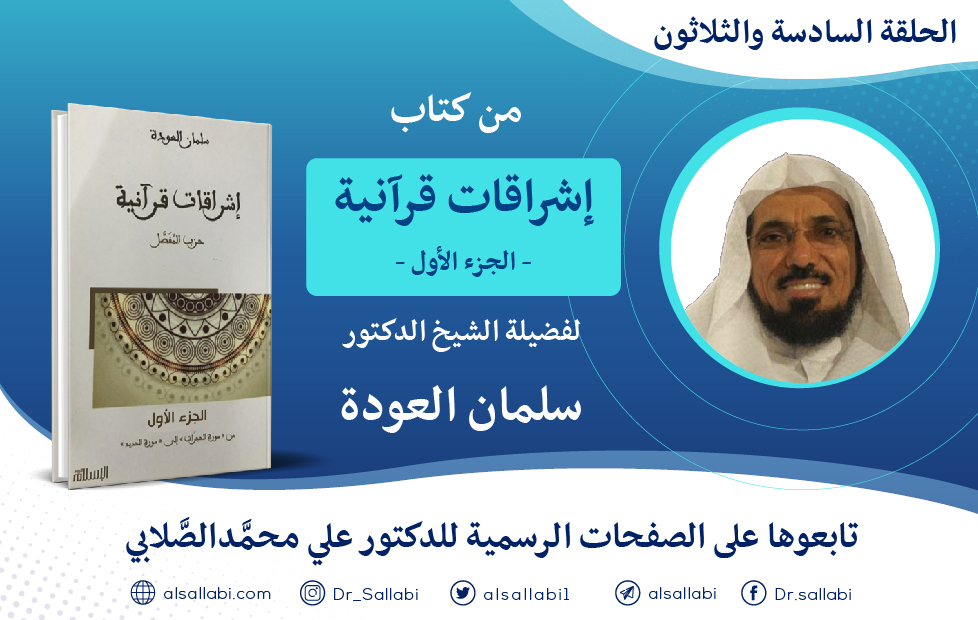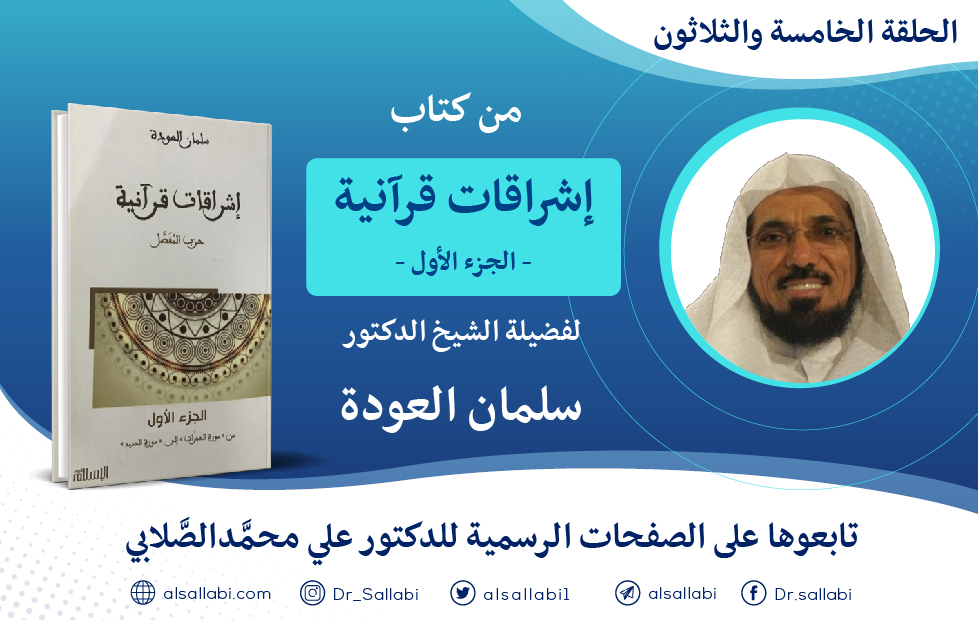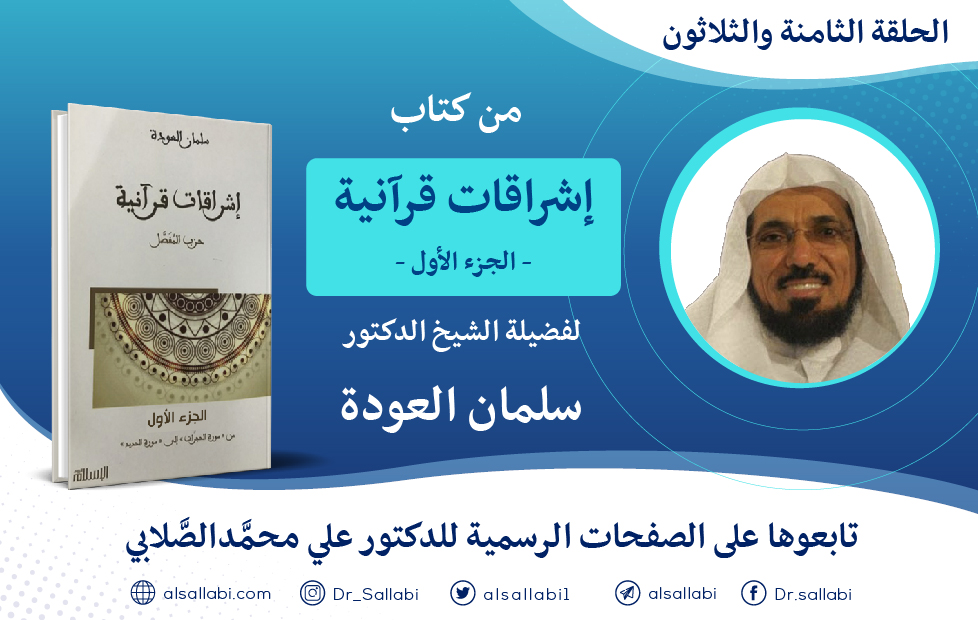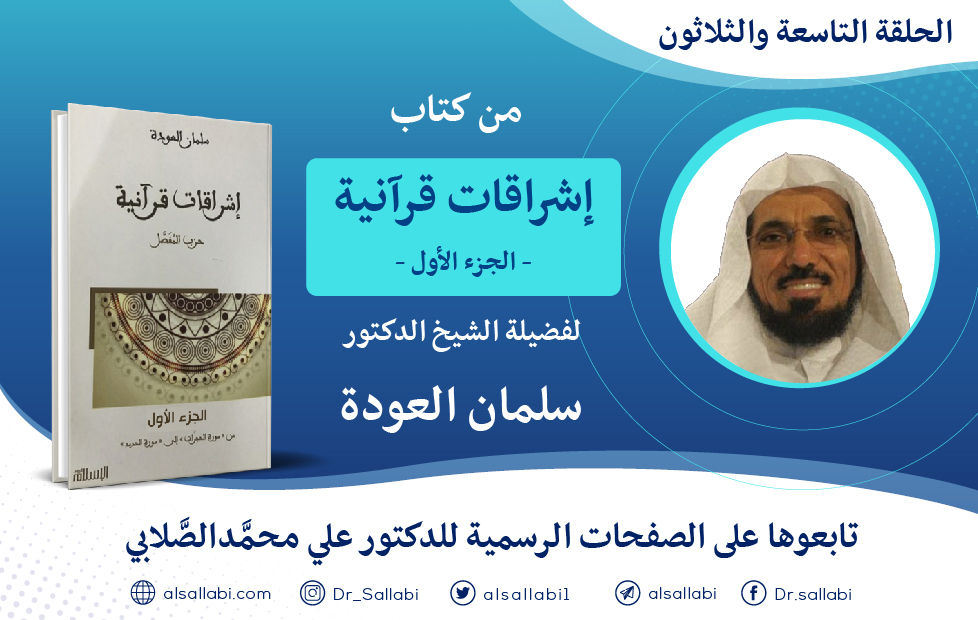من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان: (سورة الجمعة)
الحلقة السابعة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 6-7]:
{قُلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا}، وفي هذا تحقيق لمقام النبوة وخطاب للنبي الأُمِّيِّ أن يخاطبهم، ويقول لهم: إن الله تعالى يختبرهم بهذا.
وسمى اليهود بهذا؛ لأنهم عادوا وتابوا في عهد موسى عليه السلام إلى الله، وقالوا: {إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ } [الأعراف: 156].
ويمكن أن يكون نسبة إلى يهوذا بن يعقوب، أو مملكة يهوذا التي عاشوا في ظلها حقبة من الزمن.
{إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ }: لقد كان مما ادَّعوه أنهم أولياء الله وأبناؤه وأحباؤه، وأنهم فُضِّلوا بيوم السبت، فواجه دعواهم بهذه المطالبة لإثباتها؛ {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِين }: أي: فادعوا على أنفسكم بالموت.
والأمر بتمنِّي الموت ليس من باب ما جاء في النهي عن تمنِّي الموت، كما في حديث: «لا يتمنينَّ أحدُكم الموتَ من ضُرٍّ أصابَهُ». فإن الأمر بتمني الموت هنا يحمل على المباهلة، والله تعالى ذكر المباهلة في القرآن مع اليهود في قوله تعالى: {قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِين } [البقرة: 94]، بأن يجتمعوا فيدعوا على أنفسهم جميعًا أينا كان أرشد وأصدق وأقوم بأمر الله أن الله تعالى يحفظه وينجيه، وأن يهلك الظالم، والمباهلة مع النصارى في قوله: {فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِين } [آل عمران: 61]، ومع الوثنين في قوله: {قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا } [مريم: 75].
وهم لن يتمنوه، كما قال هنا: {وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ }، وهو خبر، وفي «سورة البقرة» قال: {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا } [البقرة: 95]، وهو نفي، فهم {وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ } الآن، {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ } في المستقبل.
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لو تمنَّوه لم يبق على الأرض يهوديٌّ إلا مات.
{بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ }، فهم يعرفون في دواخلهم أنهم ليسوا أولياء الله وليسوا على هُدى، وما قدمت أيديهم هو ما عملوا، وإنما يعبِّر باليد عن كل ما عمله الإنسان من قول أو فعل أو عمل؛ لأن غالب معاناة الأفعال باليد.
{وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِين }: فهم ظالمون لا ينفكون عن الظلم؛ وليسوا لله بأولياء؛ لأن الولاية لا تجتمع مع الظلم، كما قال إبراهيم عليه السلام: {قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين } [البقرة: 124].
* {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون }:
شبَّه حالهم بحال مَن يفرُّ من الموت، ولا مَفَرَّ منه، فلا بد لكم من الموت.
وفيها تذكير بالأجل وقرب حلوله، ولو كان منتهى الأمر الموت لهان الأمر، ولكن بعد الموت بعث ونشور وجنة ونار:
ولو أنا إذا مُتنا تُركنا * لكان الموتُ راحةَ كلِّ حيٍّ
ولكنَّا إذا مُتنا بُعثنا * ونُسألُ بعدَ ذا عن كلِّ شيء
وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ [الشعراء: 205-207].
{ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ }: الذي يعلم سركم ونجواكم، {فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون }؛ وجاء التذكير بالموت كثيرًا في القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ندب إلى الإكثار من تذكره؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكرَ هاذمِ اللَّذَّات». أي: هادمها وقاطعها.
فالموت حقيقة واقعة، لا ينكرها إلا مسلوب العقل، وتذكر الموت لا يراد به إفساد حياة الناس والفرار من لأوائها بطلب الموت، ولا الحرمان من المتعة والبهجة والنعيم، كلا! وإنما لإصلاح الحياة بزجر النفس عن الظلم والإفساد والتعدِّي ونسيان حقوق الخلق والخالق ويحفِّزها على تدارك الزمان واغتنام الفرص والمبادرة.
ولذا كان الحث على استذكار النهاية أحد الوصايا الأساسية التي يكرِّرها علماء التنمية البشرية، كما فعل ستيفن كوفي صاحب كتاب «العادات السبع»، وستيف جويز صاحب شركة (أبل).
فالموت حافز على العمل والنجاح والصفاء واستثمار الوقت، ولا يشرع أن يكون الحديث عن الموت سلبيًّا بوصف الميت وحال بدنه بعد دفنه، وتعفنه وسريان الدود في لحمه وعظامه، والتهييج على النياحة، وإنما المشروع أن يكون الموت موعظة تجعل الإنسان أكثر انتفاعًا بالحياة، وأكثر عملًا فيها، وأبعد عن مقارفة المعاصي والاستجابة للمغريات والشهوات.
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون }:
انتقل من مخاطبة {الَّذِينَ هَادُوا } وتقريعهم إلى مخاطبة {الَّذِينَ آمَنُوا } من الأمة الرسالية الخاتمة: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ }.
والمقصود: النداء الذي يكون عند صعود الخطيب إلى المنبر، ويسمى: النداء الثاني، وأما النداء الأول فقد أمرَ به أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه؛ حتى يستعد الناسُ لصلاة الجمعة، ويكون قبل دخول الوقت.
و {مِن} للتبعيض، أي: وقت الزوال، ويوم الجمعة هو اليوم الذي خصَّ الله به تعالى هذه الأمة، فاليهود كانوا يفتخرون بيوم السبت، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، وهو قبل يوم السبت؛ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن الآخرونَ، ونحن السابقونَ يومَ القيامة، بيد أن كلَّ أمة أُوتيت الكتابَ من قبلنا، وأُوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليومُ الذي كتبه اللهُ علينا، هدانا اللهُ له، فالناسُ لنا فيه تَبَعٌ، اليهودُ غدًا، والنصارى بعد غد».
والعرب كانوا تبعًا للأمم الكتابية قبل البعثة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع الله تعالى لهم يوم الجمعة، والجمعة اسم إسلامي قرآني، وبعضهم يقولون: إنه كان معروفًا على قلة عند العرب، فقُصَيِّ بن كِلاب كان يُسمَّى: مُجَمِّعًا، وهو الذي قيل فيه:
أبوكم قُصَـيٌّ كان يُدْعَى مُجَمِّعًا * به جمعَ اللهُ القبائلَ من فِهْرِ
لكن الأقرب أنه اسم إسلامي جاء به القرآن، وكان يُسمَّى في الجاهلية: العَروبة، بفتح العين.
وكان العرب في الجاهلية يسمون يوم الأحد: أول، والاثنين: أَهْوَن، والثلاثاء: جُبَار، أو: جِبار، والأربعاء: دُبَار، أو: دِبار، والخميس: مُؤْنِس، والجمعة: العَروبة، والسبت: شِيار.
ولا شك أن الأسماء المتداولة اليوم كانت معروفة عند العرب، وربما كانت الأسماء المشار إليها قديمة، وإلا فالسيرة النبوية والروايات تدل على أنهم كانوا يستخدمون أسماء الأيام المعروفة الآن، ولم يجر الإسلام لها تغييرًا جوهريًا، سوى الجمعة.
وفي «الجمعة» فضائل كَتَبَ العلماء فيها مصنفات، وأشار ابن القيم إلى طرف منها في «زاد المعاد»، منها: فضيلة اجتماع المسلمين للصلاة وقت الزوال، والخطبة، وأن صلاة الجمعة جهرية، ومشروعية الاغتسال، والطيب، ولبس أحسن الثياب، وساعة الإجابة، وقراءة «سورة الأعلى» و«سورة الغاشية» في صلاة الجمعة، وقراءة «سورة السجدة» و«سورة الإنسان» في فجرها.
وأوصل بعضهم خصائص الجمعة إلى أكثر من مئة خصيصة أو تزيد.
وأول جمعة في الإسلام كانت في المدينة، أقامها أسعد بن زُرارة، ومصعب بن عُمير رضي الله عنهما، وكان كعب بن مالك رضي الله عنه كلما سمع نداء الجمعة ترحَّم على أسعد بن زُرارة، فقال له ولده: أراك تترحَّم عليه. قال: نعم، هو أول مَن جمع بنا الجمعة في نقيع يقال له: نَقِيع الخَضِمات، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان وصوله المدينة يوم الاثنين، فجلس في قباء، وفي يوم الجمعة انطلق إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدًا، فصلَّى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب في ذلك اليوم خطبة مروية ذكرها القرطبي في «تفسيره»، وإن كانت تحتاج إلى التوثيق من سندها.
و«السعي إلى ذكر الله» هو: المضي إلى المسجد مشيًا بسكينة ووقار.
{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }: فامْضُوا إلى ذكرِ الله، واعملوا له؛ وأصل السعيِ في هذا الموضع: العمل، أي: التوجُّه لاستماع الخطبة والصلاة، والمضي إليها، وترك ما يشتغل به من أعمال تؤخِّر عنها.
قال قتادة: «أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضيُّ إليها».
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لو كان السعي لسعيتُ حتى يسقط ردائي». قال: ولكنها: «فامضوا إلى ذكر الله».
وهذا يبيِّن أن المراد بالسعي التوجه والمضي إلى الصلاة، وليس المقصود السعي بمعنى العَدْو والإسراع في المشي.
و«ذكر الله» هو الخطبة والصلاة على القول الراجح، وسماها: «ذكرًا»؛ لما فيها من ذكر الله سبحانه.
وفي ذلك إشارة إلى أن هذا مقصد الخطبة؛ ولذلك جعلت الجمعة ركعتين، بخلاف الظهر، فكأن الخطبتين مقام الركعتين؛ ولذلك ينبغي أن تكون الخطبة هادفة تخاطب القلوب وترقّقها وتشعل فيها جذوة الإيمان، وأن تكون توجيهات شرعية مؤصلة على قواعد النصوص لا على محض الاجتهادات الشخصية، ومن الخطأ أن نفرط أثناء الخطبة في تفصيلات جزئية تتحول إلى تصفية حسابات مع اتجاهات أو مذاهب أو أحزاب أو آراء.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاةُ فلا تأتوها تسعونَ، وأتوها تمشونَ عليكم السَّكينةَ، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا».
والمقصود: انبعاث القلب وتوجهه إلى ذكر الله، وترك الشواغل الأخرى، أي: استعدوا لذكر الله.
ويشهد لهذا المعنى: قوله تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ } [الصافات: 102]، أي: أطاق الولد أن يمشي مع والده.
أو: فامضوا إلى ذكر الله، وهكذا كان يقرأها عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وكأنها قراءة للتفسير.
وينبغي أن نترقَّى بالخطبة؛ لتكون معنى يخاطب المصلِّين جميعًا؛ لأن الجمعة يحضرها المسلمون كلهم لزامًا، وقد استنصتهم الشرع للخطيب، لا لمعنى فيه يخصُّه حتى يجعل منبر الجمعة محلًّا لاجتهاداته الشخصية، ربما ليس لها دليل، بل يجب أن تنحصر في محكمات الشريعة وقيمها وأصولها التي تهم الناس جميعًا، وأن تكون قبسًا من الذكر الحكيم، ودعوة إلى التزكِّي والتطهُّر والخلق العظيم، وعرضًا لسير الصالحين، وعلى رأسهم قادتهم من الأنبياء والمرسلين.
{وَذَرُوا الْبَيْعَ } أي: اتركوا البيع في هذا الوقت.
وفيه دليل على جواز البيع من حيث الأصل؛ لكن طلب منهم ترك ذلك وقتًا محدَّدًا؛ ولهذا لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني عند جماهير أهل العلم، وهو الصحيح، والبيع بعد ذلك باطل، وألحق طوائف من الفقهاء بالبيع والشراء ما كان في معناها من المعاملات المالية الأخرى؛ لأنها تشترك جميعًا في كونها تلهي عن ذكر الله.
{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون }: فيه إلماح إلى قداسة هذا اليوم، وفضيلة هذا الوقت، وأنه وقت إجابة للدعاء، ووقت تجمع المسلمين، فهذا خير عند الله لمَن كان لديه العلم الهادي بقيم الأشياء.
* {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُون }:
{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ } أي: انصرفتم منها، {فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ }، و{فَضْلِ اللَّهِ } غالبًا ما يُطلق على الرزق؛ ولهذا شُرع لداخل المسجد قول: «اللهمَّ افتحْ لي أبوابَ رحمتك». وإذا خرج قال: «اللهمَّ إني أسألُك من فضلك». وفي الحج يقول سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ } [البقرة: 198]. والمقصود: البيع والشراء.
وهكذا تأتي النصوص الشرعية لتربط ما بين الدين والدنيا، حتى لا يكون ثمة انفصال في واقع الحياة، فالدين لا يدعو إلى التخلِّي عن الدنيا وإهمالها، وذكر بعضهم أن في السعي في الأرض بعد الجمعة والضرب فيها والبيع والشراء بركة ورزقًا.
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُون }، فذِكْر الله لا ينبغي أن يقتصر على وقت الخطبة، أو في وقت الصلاة، أو في المسجد، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكرُ اللهَ على كلِّ أحيانه».
وليس للذكر طقوس معينة، بل شُرع للمؤمنين أن يذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، متوضِّئين وغير متوضِّئين، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكر اللهَ وهو جنب، غير أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا تطَّهر، وفي حالة التبايع والمعاملات ينبغي ألَّا ينقطع فيها الذكر، وكان السلف يشوبون بيعهم بالذكر والدعاء والكلام المبارك.
* {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِين }:
سبب نزول هذه الآية: ما رواه جابر رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عِيرٌ من الشام، فسمع الناسُ وقعها، وعادة ما يكون معها دفوف وطبول تخبر بقدومها، فخرج أكثرُ الناس من المسجد، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ، ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول جابر رضي الله عنه: وأنا فيهم، فنزلت هذه الآية.
وقد ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحدٌ، لسالَ بكم الوادي نارًا».
وقد كانت الحادثة في السنة الرابعة أو قريبًا منها، وكانت الخطبة بعد الصلاة، فهؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا يستمعون الموعظة، كما هي الحال في صلاة العيد، ولم يكن الاستماع للخطبة واجبًا بعد، وكانوا في مجاعة شديدة وشظف من العيش، ومسهم الضُّر، وجاءت العِيرُ فتنادوا إليها.
ويظهر لي أن للمنافقين في هذا عملًا ويدًا، وهو تجرئة الناس على الانفضاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج المتعجِّلون، وخرج الأعراب، وخرج أطراف الناس، حتى لم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلًا على سبيل التقريب.
وفي رواية: بقي ثلاثة عشر، أو أربعة عشر، ومن عَدِّ أسمائهم يتبين أنهم كانوا فوق الاثني عشر رجلًا، وبعضهم قدَّروا أنهم يستطيعون أن يسمعوا الفائدة أو الحكمة من غيرهم.
وبهذه الوجوه يزول الإشكال الذي يخطر بالبال في انصراف رجال الصدر الأول عن الخطبة إلى التجارة.
و«اللَّهو» تابع غير مقصود، بل المقصود: «التجارة»، وقرن تعالى بينهما؛ توبيخًا وتقريًعا لمَن فضَّل التجارة على الذِّكر والحكمة، وبدأ بالتجارة؛ لأنها هي المقصود، ولذا قال: {انفَضُّوا إِلَيْهَا } ولم يقل: «إليهما»؛ لأن انفضاضهم كان قصده التجارة.
{وَتَرَكُوكَ قَائِمًا }، وهذا دليل على أن خطبة الجمعة تكون عن قيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم للخطبة الثانية.
وفي السياق شيء من التأنيب والتوبيخ؛ إذ كيف يتركون النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدِّثهم ويذكِّرُهم؟
وقيامه يدل على احتفائه وحرصه، وهو الرؤوف الرحيم بهم.
{قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ } أي: ما أعدَّ الله تعالى للمؤمنين في الآخرة خيرٌ مما ذهبتم إليه، كما قال قبل: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون }.
فالرزق عند الله عز وجل؛ ولهذا يُروى أن أبا هريرةَ رضي الله عنه مر بسوق المدينة، فوقف عليها، فقال: «يا أهلَ السوق، ما أعجزكم!». قالوا: وما ذاك يا أبا هريرةَ؟ قال: «ذاك ميراثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقْسَم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه!». قالوا: وأين هو؟ قال: «في المسجد». فخرجوا سِراعًا إلى المسجد، ووقف أبو هريرةَ لهم حتى رجعوا، فقال لهم: «ما لكم؟». قالوا: يا أبا هريرةَ، فقد أتينا المسجدَ، فدخلنا، فلم نر فيه شيئًا يُقْسَم. فقال لهم أبو هريرةَ: «أما رأيتم في المسجد أحدًا؟». قالوا: بلى، رأينا قومًا يصلون، وقومًا يقرءون القرآن، وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: «ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم».
والقصة تدل على أن المجتمع المدني كان مجتمعًا بشريًّا، فلم يكونوا ملائكة في الأرض يخلفون، وكانت تحلُّ بهم الضرورات والحاجات، وفيهم القوي والضعيف، ولكن كان فيهم أكابر من عِلية الصحابة ومقدَّميهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزُّبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت هذه الآية تأدَّب بها الصحابة رضي الله عنهم، ثم شُرعت الخطبة قبل الصلاة، فكانوا يأتون إليها مبكِّرين، ويستعدون لها بالطيب وجميل اللباس والغُسل والتبكير.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: