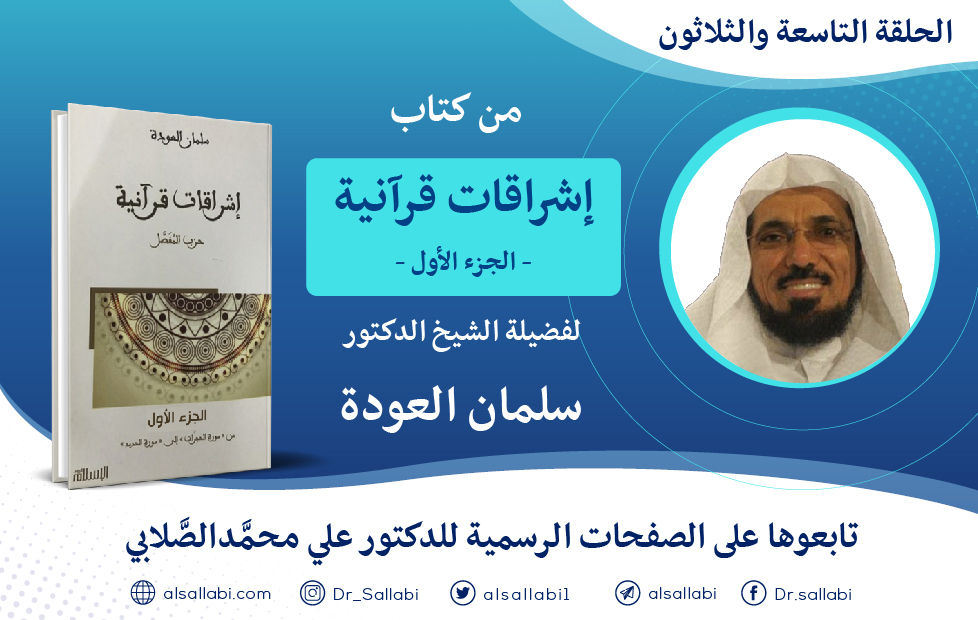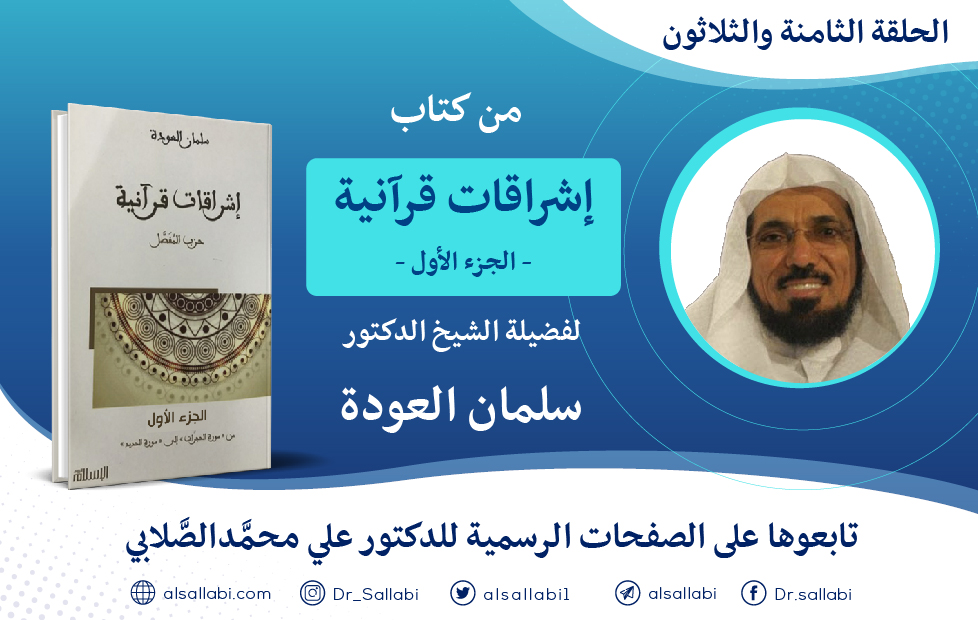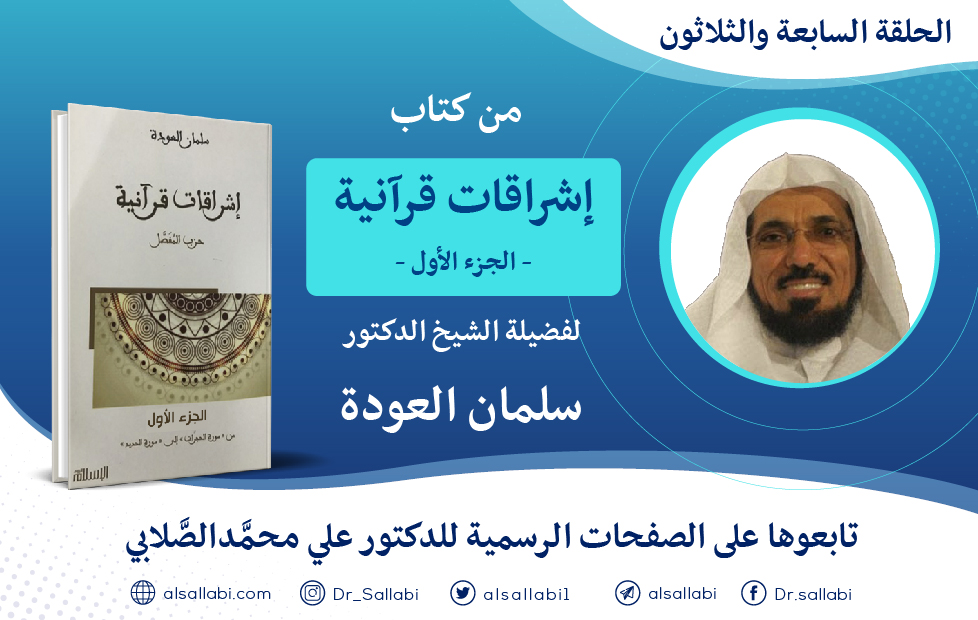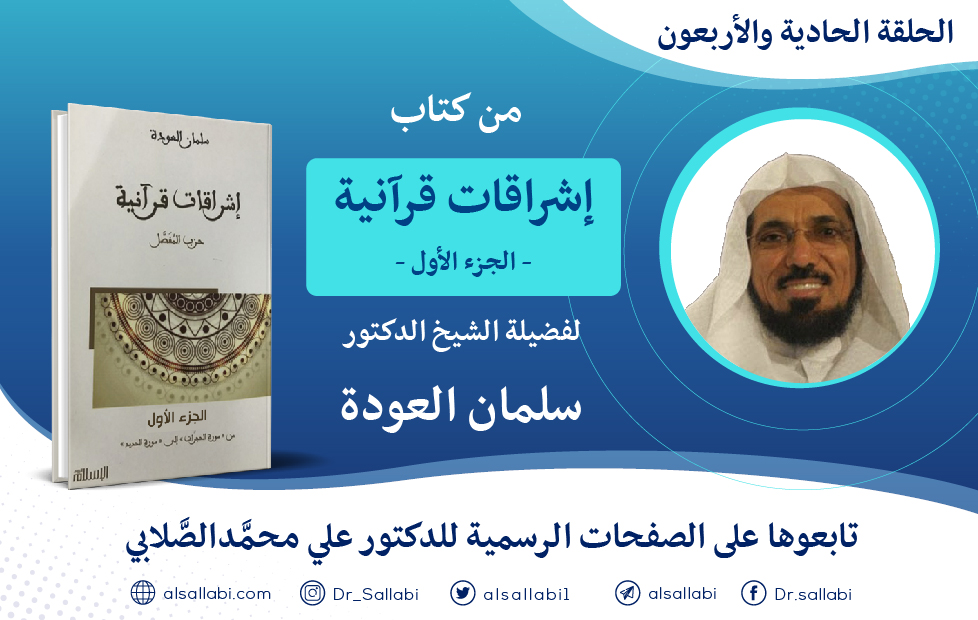من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة المنافقون)
الحلقة التاسعة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الأولى 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُون }:
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ }: لعل القائل ممن يختلط بهم، وهو أحسن حالًا منهم، فهم كانوا درجات، كما نُقل عن عبد الله بن أُبَيٍّ ابن سَلُولَ أنه لما رجع في غزوة أُحد بثلث الجيش، أو بعد قصة المُريْسِيع بدأ الناس يتفرقون من حوله ويسيئون الظن به، فحينئذ جاءه بعضهم وقال له: تعال يستغفر لك رسولُ الله.
وتعال: أصلها مشتق من العلو، أي: اذهب إلى جهة العلو، لكن نُسي هذا المعنى، وصار يراد بها معنى: هلم، أو: احضر.
وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لين سمح سهل يحب الخير للناس ويؤثر جانب الرحمة، وقد قال له ربه: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ } [التوبة: 80].
وليس المقصود العدد، وإنما المراد أنك مهما أكثرت من الاستغفار فلن يغفر لهم ربهم، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: «إني خُيِّرتُ فاخترتُ، لو أعلمُ أني إن زدتُ على السبعينَ يُغفرُ له لزدتُ عليها».
{لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ }: قُرئت بالتشديد وبالتخفيف، والتشديد أبلغ؛ لأن معناه أنه لم يلووه مرة واحدة، وإنما مرات، وقالوا: لن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لنا.
و{لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ } مظهر من مظاهر الإعراض والتعالي والصدود، فهم يميلون رؤوسهم ويصرفون وجوههم امتناعًا واستهزاءً، ولذا قال: {وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُون }.
وفيها معنى آخر، وهو أنهم لا يريدون أن تلتقي أعينهم بأعين مَن يحادثهم ويقترح عليهم؛ لأن العيون تفضح؛ ولهذا قال سبحانه عنهم: {تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ } [الأحزاب: 19].
فهم يلوون رؤوسهم إلى غير جهة المتحدِّث حتى لا يراهم ولا يقرأ علامات الكذب والخبث في عيونهم.
{وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُون }: فليس في صدورهم إيمان ولا هُدى، إنما هو الكِبر، وما منعهم من الإيمان إلا هو؛ ولهذا لا يجتمع الإيمان والكبر في قلب امرئ مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنةَ مَن كان في قلبه مثقالُ ذَرَّةٍ من كِبْرٍ». قال رجلٌ: إن الرجلَ يحبُّ أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنةً. قال: «إن اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ، الكبرُ بَطَرُ الحقِّ، وغَمْطُ الناس».
وكان من رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم أَلَّا يأتوا إليه؛ لأنهم لو جاؤوه فاستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، فمن حِفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أَلَّا يدعو الدعاء الذي لا يستجاب، فرحمه الله بأنهم لم يأتوه وصاروا يصدون وهم مستكبرون.
* {سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين }:
{سَوَاء } هنا، وفي «سورة البقرة» في شأن الذين كفروا: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ } [البقرة: 6]، تدل على استواء الطرفين؛ ولهذا يأتي بعدها ذكر الطرفين، وهما هنا الاستغفار وعدمه، وفي «سورة البقرة» الإنذار وتركه؛ ولأنه يستوي عندهم الاستغفار وعدمه حَكَم الله عليه بأنه سواء عليهم هذا أم ذاك، فالله تعالى علم منهم ما جعل المغفرة عليهم حرام: {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين }، والفاسق هو: الخارج على الطاعة وعن الحق، فهم لا يهتدون.
* {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُون }:
{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ }: يحتمل أن يكون المراد المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وتركوا أموالهم وبيوتهم في سبيل الله، فيقولون: لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا، ويتركوه ويبتعدوا عنه، وهم يظنون أن الدنيا تدار بالدرهم والدينار، وبمجرد ما يتوقف الإنفاق سوف ينفضون مسرعين زرافات زرافات!
وربما قصدوا فئة من الفقراء، كأصحاب الصُّفَّة، وبعض الأعراب الذين يأتون وما عندهم شيء.
وقد ورد أن عبد الله بن أُبَيٍّ قال ذلك مظهِرًا للشفقة، وأعلنه؛ ولهذا قال: {عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ }، ولم يقل: «على من عند محمد»؛ لأنه قالها في المجلس، فذكر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأتي عنده الأعراب والفقراء فيحضرون مائدته، فلا تقدِّموا الطعام حتى يذهبوا بعيدًا.
وهم بهذا يظهرون الشفقة، وقصدهم أن يبتعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان والعلم، وينقطعوا عن مجالسته.
والمهاجرون كانوا رجالًا يعتمدون على أنفسهم في الكسب والتجارة، وهم أهل أسواق ومواسم ورحلات مشهورة.
يدل لذلك: قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الرَّبيع رضي الله عنهما، لما آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما، فعرض سعد بن الرَّبيع عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فربح شيئًا من أَقِطٍ وسمن، فرآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، بعد أيام وعليه وَضَرٌ من صُفْرة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «مَهْيَمْ يا عبدَ الرحمن؟». أي: ما الخبر؟ قال: يا رسولَ الله، تزوجتُ امرأةً من الأنصار. قال: «كم أصدقتها؟». فقال: وزن نواة من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: «بارك اللهُ لك، أولم ولو بشاة».
وقد أثنى أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه على الأنصار وحسن بلائهم، واستشهد بقول الطُّفَيل الغَنَويِّ لبني جعفر:
جزى اللهُ عنا جعفرًا حين أَزْلَقَتْ * بنا نعلُنا في الواطئين فزلَّت
أَبَوْا أن يَمَلُّونا ولو أنَّ أُمَّنا * تُلاقي الذي يَلْقَونَ منا لملَّت
هم خَلَطونا بالنفوس وألجئُوا * إلى حُجُرات أَدْفَأَتْ وأظلَّت
والإسلام دين ينهى عن التواكل، ويحث على العمل والكدح والإنتاج.
{وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ }: قيل: خزائن السماوات: المطر، وخزائن الأرض: النبات.
وقيل: خزائن السماوات: الغيوب، {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ } [المدثر: 31]، وخزائن الأرض: القلوب، أن يسخر الله قلوب العباد بعضهم لبعض.
والأولى العموم، ويدخل في خزائن السماوات: المطر، والشمس بأشعتها، والهواء، وكل ما ينزل مما ينفع الناس، وغيرها مما لا يعلمه الناس، وخزائن الأرض: النبات والنفط والثروات المكنوزة في باطنها، وما يظهر ويدب على ظاهرها من حيوانات وناس.
{وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُون }: فهذا من المعاني الإيمانية القلبية، والمنافقون لا يفقهون في الإيمان والأخوة والإيثار والقيم النبيلة، فكيف لمَن هم كالخُشُب المسندة أن يفقهوا هذه المعاني المشرقة؟ إنما هم عكوف على ظاهر من الحياة الدنيا وعلى الأشكال والرسوم.
* {يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُون }:
وهم يعتقدون أنفسهم أعزة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومَن معه هم الأذلاء، فرد الله عليهم بقوله: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ }، فالعزة لله ولرسوله ولمَن آمنوا بالله ورسوله، فلهم عزة الباطن بالإيمان، وعزة الظاهر بالنصر والغنى والتمكين، وفي حال الاستضعاف لهم عزة الثقة بالله والانتساب لدينه وانتظار فرجه.
{وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُون }: وقد عبَّر في شأن المال والخزائن بأنهم لا يفقهون؛ لأن الأمر يتطلَّب فقهًا قلبيًّا عميقًا، في حين أنه عبَّر هنا في شأن العزة بعدم العلم؛ لأن الأمر أوضح وأظهر، فهو مدرَك بالعيان لمَن أراد، وإن كان بعض المنافقين يغالطون ويجادلون في الحقائق، ويتجاهلون الدلائل الواقعية على ظهور الإسلام وقوته وانتشاره وغلبة أهله.
وهم حسبوها حسية سطحية أن عدد أهل المدينة كذا وعدد المهاجرين كذا، فأهل المدينة أكثر، ولذا يمكن أن نُخرجهم من المدينة، في حين أن الأمر على خلاف تقديرهم لأمرين:
1- أن المهاجرين ازدادوا يومًا بعد يوم؛ وإذا كانت غزوة المُريْسِيع في السنة الخامسة، فمن المحتمل آنذاك أن يكون عدد المهاجرين متساويًّا لأهل المدينة إن لم يكن أكثر.
2- أن أهل المدينة أنفسهم أصبح أكثرهم مع صف الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومع المهاجرين ضدكم أيها المنافقون؛ ولذلك أنتم محشورون منعزلون وعددكم قليل ولكنكم لا تعلمون ولم تدركوا أن ثمة تغيرًا يطرأ على الساحة تتسارع خطاه.
والجملة التهديدية التي قالها ابنُ سَلُولَ كانت في حالة غضب، فكانت في بدايتها صغيرة، ومعظم النار من مستصغر الشَّرر.
وكثيرًا ما تكون الحروب العظيمة بسبب شرارة لا يُؤْبَه لها، والظاهر أن إدراك المنافقين- وكبارهم بخاصة- أن الوقت ليس في صالحهم، وأن قوتهم تتآكل، وقوة الإسلام تزداد، يجعلهم يفتعلون مثل هذه الحوادث، ويستغلونها لإحداث البلبلة وتهييج البسطاء، وتغريرًا لحدثاء العهد بالإسلام، وإضلالًا لهم ليرجعوا إلى الكفر.
وهنا فائدة، وهي أن على العقلاء والحكماء أَلَّا يسترسلوا في سماع كلام الصغار والسفهاء ولو نشروه في وسائل الإعلام، فقد يُثير فتنًا من لا شيء، وطي الكلام وتجاهله ما أمكن أفضل من إشاعته وإعادته وترديده ولو على سبيل النقد أو الرفض له، فإماتة الباطل بتجاهله أفضل وأولى.
ثم إن من المداخل الخطيرة على المجتمعات محاولة زرع الفتنة فيها، وتحريك بذور العصبيات التي تحمل على الاحتراب، كالإقليمية والقبلية والعنصرية والعصبية الجاهلية، والواجب أن يشعر الناس بنعمة الله عليهم بالوحدة: {فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا } [آل عمران: 103]، وألا يتعاطى طرف ازدراءً أو تهوينًا أو تحقيرًا لغيره، ولا يستعرض قوته وعدته، فالأمر كما قيل:
جاء شَقِيقٌ عارضًا رُمحه * إن بني عمك فيهم رِماحُ!
وفي القصة مشهد يسترعي الانتباه، وهو أن عبدَ الله بنَ أُبَيٍّ ابنَ سَلُولَ بعد ما قال ما قال، استأذن عمرُ رضي الله عنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم في قتله، فأبى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «ادعُوا لي عبدَ الله بنَ عبد الله بن أُبَيٍّ». فدعاه، فقال: «أَلَا ترى ما يقولُ أبوك؟». قال: وما يقولُ بأبي أنت وأمي؟ قال: «يقولُ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ». فقال: فقد صدق والله يا رسولَ الله، أنت والله الأعزُّ، وهو الأذلُّ، أما والله، لقد قدمتَ المدينةَ يا رسولَ الله، وإن أهلَ يثربَ ليعلمون ما بها أحدٌ أبرَّ مني، ولئن كان يُرْضي اللهَ ورسولَه أن آتيَهما برأسه لآتينَّهما به. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا». فلما قدموا المدينةَ قام عبدُ الله بنُ عبد الله بن أُبَيٍّ على بابها بالسيف لأبيه، ثم قال: أنت القائلُ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ؟ أما والله لتعرفنَّ العزةُ لك أو لرسول الله، والله لا يأويك ظلُّه، ولا تأويه أبدًا إلا بإذن من الله ورسوله. فقال: يا للَخزرج، ابني يمنعني بيتي، يا للَخزرج، ابني يمنعني بيتي. فقال: والله لا تأويه أبدًا إلا بإذن منه. فاجتمع إليه رجالٌ فكلَّموه، فقال: والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله. فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: «اذهبوا إليه، فقولوا له: خَلِّه ومسكنه». فأتوه، فقال: أما إذ جاء أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم فنعم.
ثم جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنه بلغني أنك تريدُ قَتْلَ عبدِ الله بنِ أُبَيٍّ، فإن كنتَ فاعلًا فَأْمُرني به، فأنا أحملُ إليك رأَسَهُ، فوالله لقد عَلِمَتِ الخزرجُ ما كان بها رجلٌ أبرُّ بوالدِهِ مني، ولكني أخشى أن تأمرَ به رجلًا مُسلمًا فيقتلَهُ، فلا تَدَعُني نفسي أن أنظرَ إلى قاتلِ عبدِ الله يمشي في الأرض حيًّا حتى أقتلَه، فأَقْتُلَ مؤمنًا بكافرٍ، فأدخلَ النارَ. فقال صلى الله عليه وسلم: «بل نُحْسِنُ صُحْبَتَهُ، ونَتَرَفَّقُ به ما صَحِبَنا».
وعاده النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مرضه، وصلَّى عليه عند موته، وفيه نزل قوله سبحانه:
{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ } [التوبة: 84].
ففي هذا البر والحفاظ ورعاية الحقوق وحسن التأتِّي وسياسة الأمور بصبر ورويَّة وتسامح مع اليقظة والحذر وعزل التأثير السيء للقوى المضادة.
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون }:
مناسبة الآية لما قبلها: أن من سمات المنافقين أنهم {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلا } [النساء: 142]، بخلاف المؤمنين الأتقياء الذين {يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ } [آل عمران: 191]، بألسنتهم، وبقلوبهم، وبأبدانهم، بالتزام الطاعة وترك المعصية.
ففي الآية التحذير من صفات المنافقين الذين اعتزُّوا بأموالهم وأولادهم، وظنوا أن المال هو كل شيء، وأن مَن أعطوه المال فقد كسبوه، ومَن حرموه المال افتضَّ وذهب، وأن الغنى دليل الفلاح والنجاح، والفقر دليل الشقاء والتعاسة والتحقير: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون }، وليس المقصود التخلِّي عن المال، فقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ المالُ الصالح للمرء الصالح».
والمال له عبودية وزكاة، وبه يستطيع المسلم أن يعف ويكف وينفق ويتصدَّق ويجاهد، وإنما المذموم تجاوز حدود ما أمر الله به، أو أن يكون المال مشغلة عن ذكر الله.
* {وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِين }:
طلب إليهم أن يكسبوا المال من حلال، وأن ينفقوه في حلال، وأن يبادروا الآجال بصالح الأعمال، وذكَّرهم بأن المال عارية، وهو من الله وإليه، فهو من فضله ورزقه، وسوف يزول عنك أو تزول أنت عنه، وتصبح وحيدًا فريدًا بلا أهل ولا مال، ولذا عبَّر بقوله: {أَحَدَكُمُ } ولم يقل: «من قبل أن يأتيكم الموت»؛ لأن الإنسان يموت وحده، كما قال ربنا: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى } [الأنعام: 94]، {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا } [مريم: 95]. والإنسان يتعزَّز بقرابته وأهله ومَن حوله، لكن إذا حضرته الوفاة لم ينفعه أحد {فَيَقُولَ } إذا أتاه الموت على سبيل التمنِّي والدعاء: {رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ }، يريد أيامًا معدودات، وفرصة ولو قصيرة طالما توفرت له فضيَّعها وسوَّف وماطل وغفل {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِين }، ولن ينفع هذا التمني بعد إذ وقع الأمر موقعه وحضرت الوفاة.
وفي الآية سر عظيم، فما من أحد يموت إلا وتحضره ندامة؛ إن كان محسنًا ندم أَلَّا يكون ازداد، وإن كان مسيئًا ندم أَلَّا يكون نزع وتاب، وغالب ما يندم عليه المرء عند الموت يتعلق بأمور خلاصتها ما يأتي:
1- يندم أَلَّا يكون مؤمنًا صالحًا تقيًّا، كما أشارت الآية، وهذا يتعلق بصلته بربه، وضمن ذلك استذكار الذنوب والمعاصي والمخالفات والأوقات التي أُهدرت فيها، وكلما كانت المعصية أكثر متعةً وأطول وقتًا كانت ندامتها عند الموت أعظم.
2- يندم أَلَّا يكون قدَّم إحسانًا إلى الناس وخيرًا، كما دلَّ عليه الندم في الآية على عدم الصدقة والإنفاق، ويشمل هذا من باب أولى الندم على ظلم الناس أو بخسهم حقوقهم أو العدوان عليهم في أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم.
3- يندم على أن يكون عاش عمره في مجاملة للآخرين وتصنع لهم، ولم يعش حياته كما يريد هو، ويتمنى لو أنه اعتزل التمثيل وظهر بشخصيته الحقيقية وأحلامه وطموحاته.
4- يندم على الإفراط في العمل الدنيوي كالوظيفة أو التجارة بما أثَّر على صحته ونفسيته، ومن ثَمَّ حُرم من متعة الحياة وزينتها، وقصَّر في حقوق الأهل والقرابة من أجل شيء لم يعد ينفعه في قليل ولا كثير.
5- يندم على تفويت الأصدقاء الذين كانوا يستحقون أن يضحِّي من أجلهم فضحَّى بهم.
6- يندم على فوات فرص الاستمتاع والسعادة التي كانت على مقربة منه، ولكنه عاش مع المظاهر والشكليَّات وليس مع الحقائق.
7- يندم على كبت مشاعره وأحاسيسه، سواءً كانت إيجابية بالتعبير عن الرضا والحب والامتنان، أو سلبية بالتعبير عن العتب والمؤاخذة.
وقد كتبت الممرضة الأسترالية (بروني وير) كتابًا مفيدًا عن أهم خمسة أشياء يندم عليها الإنسان عند الموت.
* {وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون }:
النفس: مشتقة من النَّفَس الذي يتردد شهيقًا وزفيرًا، وهو علامة الحياة، فيكون معناه: الروح، ويحتمل أن يكون المقصود: الإنسان: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة } [المدثر: 38]، {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [المائدة: 45].
ومصداق هذه الآيات: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «ويؤمرُ بأربع كلمات: بكَتْب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيدٌ». فهي آجال مضروبة وأعمال مكتوبة لا تتقدم ولا تتأخر.
{وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون }: الخبير من أسماء الله الحسنى، والخبرة أدقُّ وأخص من العلم، وهي المعرفة بالدقائق واللطائف والأسرار.
وهذا مناسب للسياق؛ لأن ما يقوله الإنسان عند بغتة الموت هي دعوى كاذبة غالبًا، {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ } [الأنعام: 28]، ولو صحت منه النية لحسن منه العمل، والمؤمن يُؤجر على نيته الصادقة ولو حال القدر بينه وبين العمل؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «يقولُ الله: إذا أراد عبدي أن يعملَ سيئةً، فلا تكتبوها عليه حتى يعملَها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنةً، وإذا أراد أن يعملَ حسنةً فلم يعملها فاكتبوها له حسنةً، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف».
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: