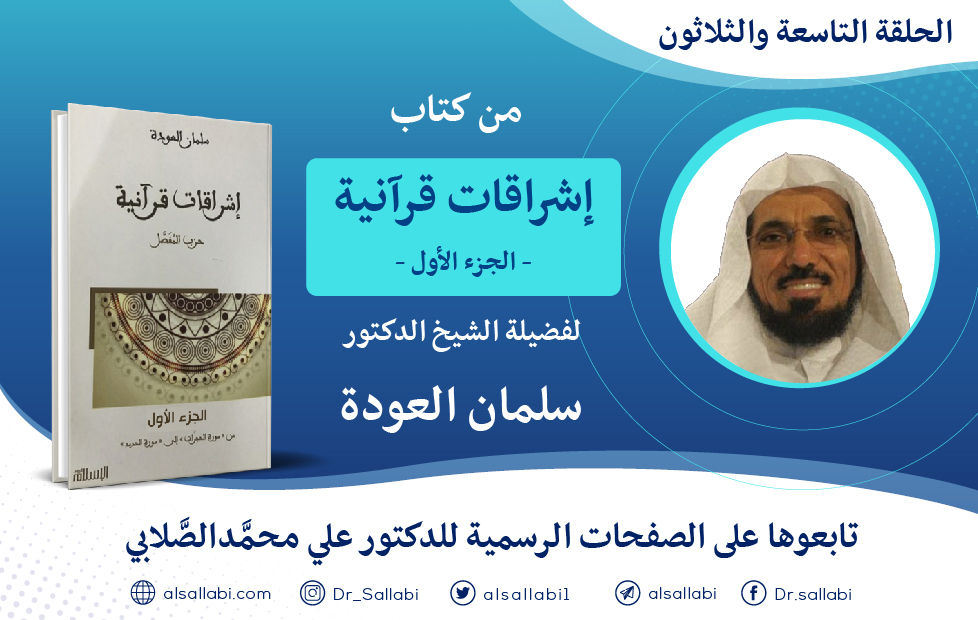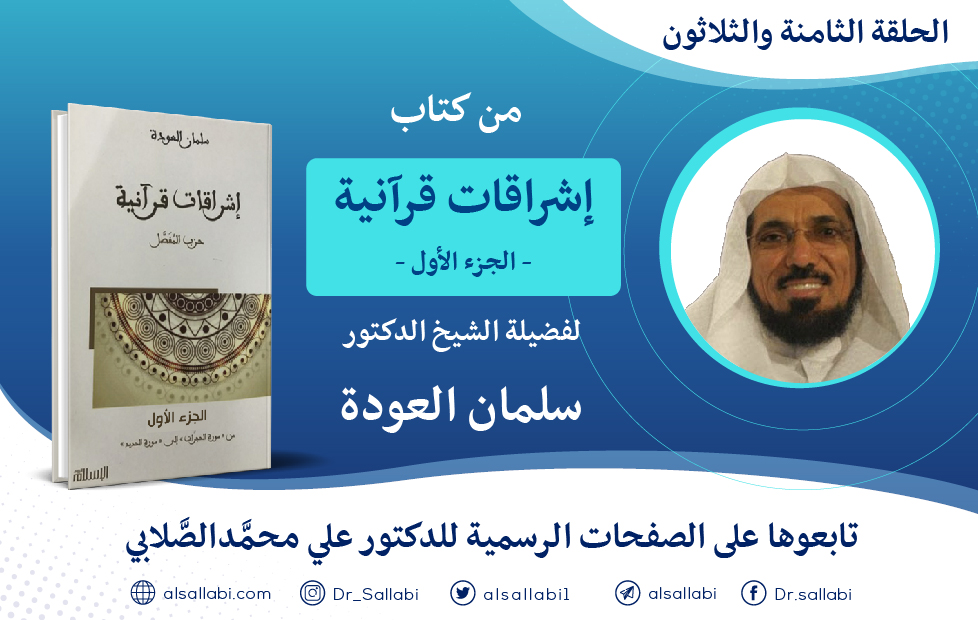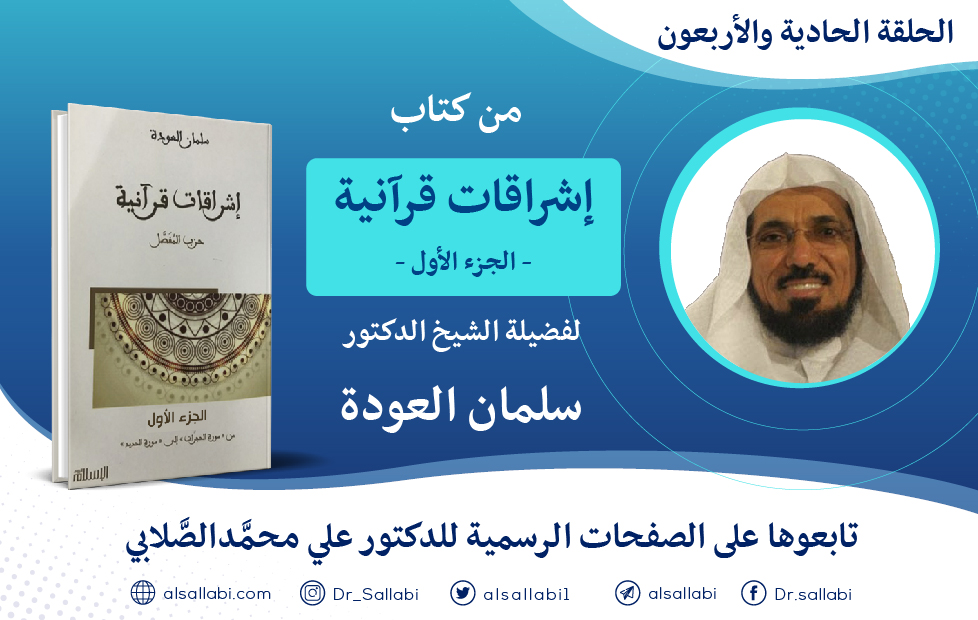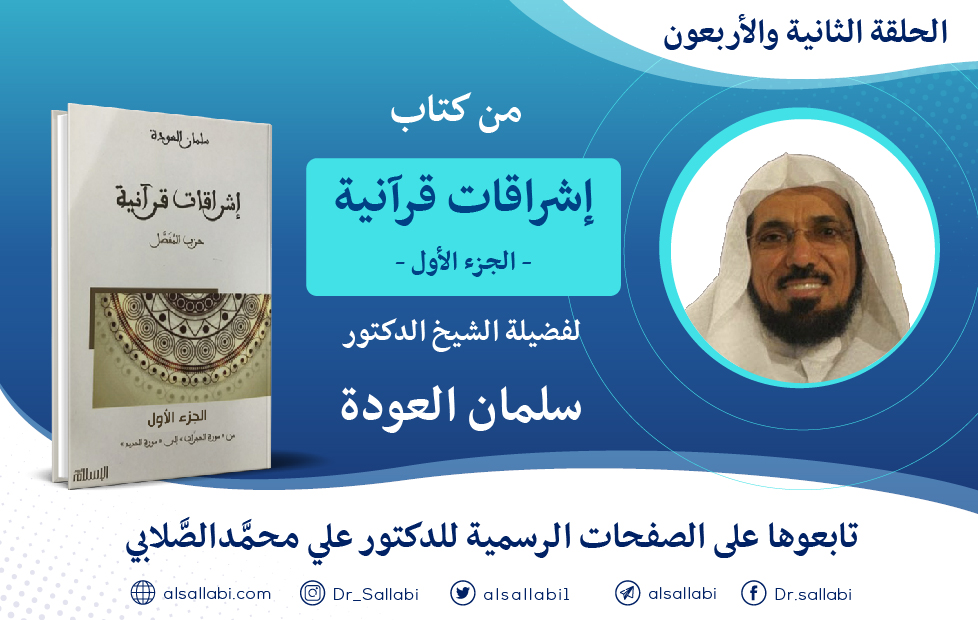من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان: (سورة التغابن)
الحلقة الأربعون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الأولى 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* تسمية السورة:
اسمها المشهور، ولا تُعرف إلا به: «سورة التغابن».
* عدد آياتها: ثماني عشرة آية باتفاق علماء العدِّ.
* وهي مدنية عند جمهور المفسرين، وذهب الضحاك إلى أنها مكية.
ولابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة وجماعة أن فيها المكي والمدني.
وهذا أظهر وأقوى؛ فإن ما في السورة من موضوع البعث ومجادلة المشركين ما هو من أغراض السور المكية، وفيها من التحذير من عداوة الأولاد والأزواج ما هو أشبه بالمدني.
* {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير }:
الاستفتاح بالتسبيح معهود في مطالع السور، وخاصة المسبِّحات، وهو يأتي بصيغة المضارع، كما في هذه السورة، و«سورة الجمعة»، ويأتي بصيغة الماضي، كما في «سورة الحديد»، و«سورة الصف»، ويأتي بصيغة المستقبل(الأمر)، كما في «سورة الأعلى».
وصيغة الماضي إشارة إلى عراقة التسبيح، وأن التسبيح لله وُجد منذ وُجد مَن يسبِّح الله سبحانه وتعالى، فليس أمرًا طارئًا، بل هو راسخٌ قديمٌ قدم الأكوان.
أما في المضارع، فهو إشارة إلى التجدُّد، وأنه ليس شيئًا وقع وانتهى، بل هو مستديم مستمر مستغرق للزمان.
وأما الأمر، فهو إشارة إلى المستقبل وأن التسبيح باق لا يزول.
وثمة تسبيح الكون اللاهج بالثناء على الله وتمجيده: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا } [الإسراء: 44].
ومن تسبيح الكائنات: انسياقها لأمر الله في نظام فلكي رباني منضبط لا يتقدم ولا يتأخر، وبهذا فسره بعض أهل العلم، وهو جزء من المعنى، لكن لا يمنع أن نفهم من السياق أن كل شيء يسبِّح الله بلغة لا نفهمها؛ ولهذا قال: {وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ }، في حين أن حركة الأفلاك مما يفقهه الناس ويدركونه ويقرؤونه.
ففي آيات الأمر بالتسبيح إشارة إلى الفرق بين تسبيح الكائنات الاضطراري الذي جُبلت عليه، وبين التسبيح الاختياري الذي يُؤمر به الجان والإنسان فيكون به مكلَّفًا؛ ولهذا لما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } [الأعلى: 1]، قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم». ولما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم } [الواقعة: 74]، قال: «اجعلوها في ركوعكم». والصلاة جزء منها تسبيح.
والتسبيح: تقديس الله سبحانه وتنزيهه عن صفات النقص كلها، وإثبات الكمال له وحده.
{وَمَا } تُطلق غالبًا على غير العاقل، كالسماء والأرض والنجوم والأفلاك.
وفي ذلك إشارة إلى أن في السماوات عوالم عظيمة لا يعلمها إلا الله، وفي الأرض مثل ذلك، فهي تفتح عقل الإنسان على امتداد المخلوقات وسعتها، وأنها كلها على كثرتها تلهج بالتسبيح بربها، أفلا يليق بالإنسان أن يكون مثلها؟! أَلَا يستحق المولى الذي {لَهُ الْمُلْكُ }، هذا التسبيح؟! فهو سبحانه متفرِّد بالملك التام المطلق.
ولذلك من أسمائه: المَلِك، والمالك، ومالك يوم الدين، ولا ملك إلا له؛ لأن ملك الناس ملك ناقص محدود بزمن، أما ملك الله سبحانه فهو دائم لا يزول ولا يحول ولا يتغير.
وهو الذي خلق الأشياء ومنحها خصائصها ووجودها، وهو المتصرِّف وحده، فليس ثمتَ مُلْك حقيقي إلا له؛ ولهذا يقول سبحانه يوم القيامة: {لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ } ويجيب نفسه: {للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار } [غافر: 16].
{وَلَهُ الْحَمْدُ} فلا حمد حقًّا إلا له، ولا يستحق الحمد المطلق إلا هو سبحانه،
فـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين } [الفاتحة: 2]، فهو المحمود بحق واستحقاق، وهو الخليق بقول المتنبي:
تملَّك الحمدَ حتى ما لمفتخر * في الحمد حاءٌ ولا ميمٌ ولا دالُ
والحمد هو: الثناء على الله بصفات الكمال، كالقدرة والعلم والحلم والشكر والرضا والكرم والجود والفضل.
ويلحق الحمد الشكر، وهو الثناء على المحمود بالنعم التي أسداها إلى العباد، فتشكره على السمع والبصر والعقل والمال والولد.
{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير }: له القدرة التامة، ومن قدرته خلق السماوات والأرض وما فيهما.
وهذا الاستهلال العظيم يوحي بما بعده؛ لأنه سوف يتوجَّه بالتوبيخ والعتاب للشاردين عن الله.
* {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير }:
{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ } أيها البشر.
ويحتمل أن يكون هنا وقف، ثم جاء ما بعده مستأنفًا: {فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ }.
ويحتمل أنه كلام متصل كالجملة الواحدة، وبين المعنيين فرق:
وعلى قراءة الفصل يكون المعنى: أن الله تعالى خلق الناس، ثم بعد ذلك استأنف خبرًا جديدًا، وهو أن الناس أقسام؛ منهم الكافر ومنهم المؤمن، وعلى هذا لا إشكال.
أما على قراءة الوصل فالمعنى: أن الله تعالى خلقكم مختلفين، منكم الكافر ومنكم المؤمن، والمؤمن أشرف وأعظم منزلة، فكان المظنون أن يبدأ به، لكن الله تعالى بدأ بالكافر؛ لأنه حال أغلب الناس، كما في آيات كثيرة {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين } [يوسف: 103].
ولأن سياق السورة في معاتبة وتوبيخ صنف من الكافرين، ودحض حججهم وادعاءاتهم، فكان من المناسب أن يبدأ بذلك تمهيدًا لما بعده.
وليس في الآية ما يدل على أن الإنسان مجبر لا اختيار له ولا مشيئة؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن للأمر بالإيمان معنى، والله تعالى ضمَّن السورة نفسها الأمر بالإيمان: {فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ } [التغابن: 8]، وحذَّر من الكفر، وأن مَن كفر فإن الله تعالى غني عنه، وتوعَّد الكافرين، مما يدل على أن الإيمان أو الكفر هو اختيار العبد لنفسه، وإن كان الله علم ماذا سوف يحدث من العباد جملة وتفصيلًا.
فهو عليم بصير خبير لا تخفى عليه خافية، وقد ثبت أن الله لو شاء ما أشركوا: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ } [يونس: 100]، فلو شاء الله أن يجبر الناس على الإيمان لأكرههم عليه فكانوا مؤمنين كلهم، أو جعله جِبلَّة فيهم لا مندوحة لهم عنها كشأن الملائكة، ولكنه أراد بحكمته أن يجعل لهم مشيئة وإرادة، وهي ضرورة نفسية يعرفها كل أحد، أنه إن شاء أن يرفع هذا الإناء أو يضعه أو يشرب أو يقرأ أو يقوم أو يقعد أو يتكلم أو يسكت... وقد يأخذ شيئًا ثم يعزف عنه ويقول: لا أريده، هذا أمر مستقر معلوم، وكذلك ما يتعلق بالأخلاق والدين الأصل فيها أن الإنسان كائن مختار وحسابه على ضوء ما اختار لنفسه.
ومناسبة الآية لما قبلها ظاهر، فبعد ما ذكر أن التسبيح يصدر من السماوات والأرض وما فيها على سبيل الفطرة والجِبلَّة، انتقل إلى خصوص الكائن المختار الذي بمقدوره أن يسبِّح أو يكفر وهو الإنسان، فبيَّن أن خلق الناس خاصة توجد فيه صفة أن يكون كافرًا أو مؤمنًا، وأن كثرة الكفر لا تضر الله شيئًا، ولله عوالم وملائكة تسبِّح دون فتور ولا كفور!
* {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِير }:
ومن الحقِّ: إتقان خلق السماوات والأرض، ووجود النظام والسنن والنواميس الضابطة لحركة الأفلاك، فلا يبغي بعضها على بعض، ولا تصطدم، وكلها تسير بمقدار يحقِّق مصالح الذين يعيشون على ظاهرها.
ومن الحق: أن الله تعالى خلقها لحكمة في الدارين، ولإرادة تتعلق بإنزال الكتب وإرسال الرسل وابتلاء الناس؛ ولهذا ذكر عن المؤمنين تسليمهم ويقظة قلوبهم: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ}.
{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} أي: أعطى كل إنسان صورته.
ولهذا من أسمائه سبحانه: الخالق، البارئ، المصوِّر، فهذه معانٍ متسلسلة نهايتها التصوير، وهو ظهورك للحياة بهذه الصورة التي أنت عليها.
والله تعالى يمتن على الإنسان بحسن الصورة، واعتدال القوام وجمال الوجه والثغر والشعر واللسان والعقل والحركة، وفيه دليل على أن حسن صور الناس أمر مقصود، وكلها من أسرار الخلقة الربانية للإنسان: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم } [التين: 4].
وهذا يصنع إدراكًا لفضيلة الإنسانية، فهو بشر ومختار، وصورته أحسن صورة، ولو شاء الله لجعله كسائر الحيوان، كما قال: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَك } [الانفطار: 8]، وما يطرأ على هذه الصورة من نقص، فإن الغالب أنه من فعل الناس وتعدياتهم على الأجنة، كتسربات نووية إشعاعية، وهو خلاف الصورة المألوفة العامة بين الخلق كلهم، ومع ذلك هو لا يؤثِّر على أصل الصورة وجمالها، وإذا قارنت الإنسان بالحيوان، وجدت الفرق الكبير في الجمال والاعتدال والأشكال والنظرة والابتسامة والتفاهم، ومع تفاوت الناس في الصورة إلا أنهم يشتركون في حسن الخلقة.
{وَإِلَيْهِ الْمَصِير }: وهو إلماح إلى أن العمل من إيمان أو كفر سوف يرى ويحاسب عليه.
* {يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور }:
فعلمه سبحانه محيط بكل شيء، فيعلم ما تعلنون من الأعمال وما تسرون من العقائد والنوايا، ويعلم ما تظهرون وما تسرون، وما سوف يقع منكم من هذا وذاك في المستقبل مما لا تعلمونه الآن.
{وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور } أي: صاحبة الصدور التي لم تغادرها، كالأشياء المستكنة في الصدر، ومنها الشعور الخفي الذي لا يحس به صاحبه والعقل الباطن (اللاواعي) الذي يحتوي على مخزون المشاعر والانفعالات والبواعث والذكريات التي لا يشعر بها صاحبها.
* {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم }:
أي: من قبلكم من الأمم السابقة الذين عُذِّبوا، {فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ } أي: عاقبة كفرهم في الدنيا بالاستئصال والنكال، {وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الآخرة.
* {ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد }:
{ذَلِكَ } الذي أصابهم في الدنيا وينتظرهم في الآخرة، {بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ } أي: بالحجج الواضحات، {فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا }؟ كيف يرسل الله بشرًا مثلنا لهدايتنا؟ وفيه ازدراء للإنسانية.
فاستنكروا أن ينتمي النبي إلى جنس البشر، ولو عقلوا لعرفوا أن غاية تكريم البشرية أن يكون من بينهم مَن يختاره الله للرسالة والنبوة.
والبشر لا يهديهم إلا نبيٌّ مثلهم، فلو جاءهم مَلَك ما استطاع أن يتعامل معهم كما يتعاملون هم، ولا يعرف طبائعهم وتكوينهم وعاداتهم وما جُبلوا عليه؛ ولهذا قال الله سبحانه: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُون } [الأنعام: 9]؛ فكونه بشرًا أدعى للتأثير والاقتداء؛ ولذلك قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ } [إبراهيم: 4].
ومن الحكمة في الدعوة أن يكون من كل أمة دعاة من أنفسهم، ولذا فالأبلغ أن يكون الدعاة في الولايات المتحدة الأمريكية من شعبها نفسه، وأن يكون دعاة الأوربيين منهم، وأن يكون مَن يدعو العجم من العجم، ومن الفرس الفرس؛ لأن كونه من جنسهم أدعى أن يكون أعرف بثقافتهم وخطابهم ولغتهم، وأقدر على معرفة طريقتهم في التفكير وأكثر فهمًا واستيعابًا لهم.
فاستنكارهم أن تكون هدايتهم من بشر عين الخطأ والإزراء بالإنسانية، ولذا قال: {فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا } كفروا بالرسل والأنبياء، وأعرضوا عنهم وعن دعوتهم.
{وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد }: والله تعالى غني بكل حال، ولكن يذكر الغنى بمناسبة وقوع الكفر، كما في قوله سبحانه: {إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ } [الزمر: 7].
وفي الحديث القدسي: «يا عبادي، لو أن أوَّلَكُم وآخرَكم وإنسَكم وجنَّكُم كانوا على أَتْقَى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا». وذلك إشارة إلى أنه حينما دعاهم لم يكن ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعزَّ بهم من ذلة، وإنما دعاهم لأنفسهم وأمهلهم وأقام عليهم الحجج وصبر عليهم، وهو الغني وهم الفقراء، ومع فقرهم وكفرهم وغناه سبحانه فإنه يصطفي قومًا غيرهم من المؤمنين العارفين ثم لا يكونوا أمثالهم.
ومعنى استغنى: غَنِيَ، أو استغنى عن تكرار الدعوة لهم، فبعدما رفضوا الدعوة عوقبوا، وهو سبحانه غني عمَّن عصاه حميد لمَن أطاعه.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: