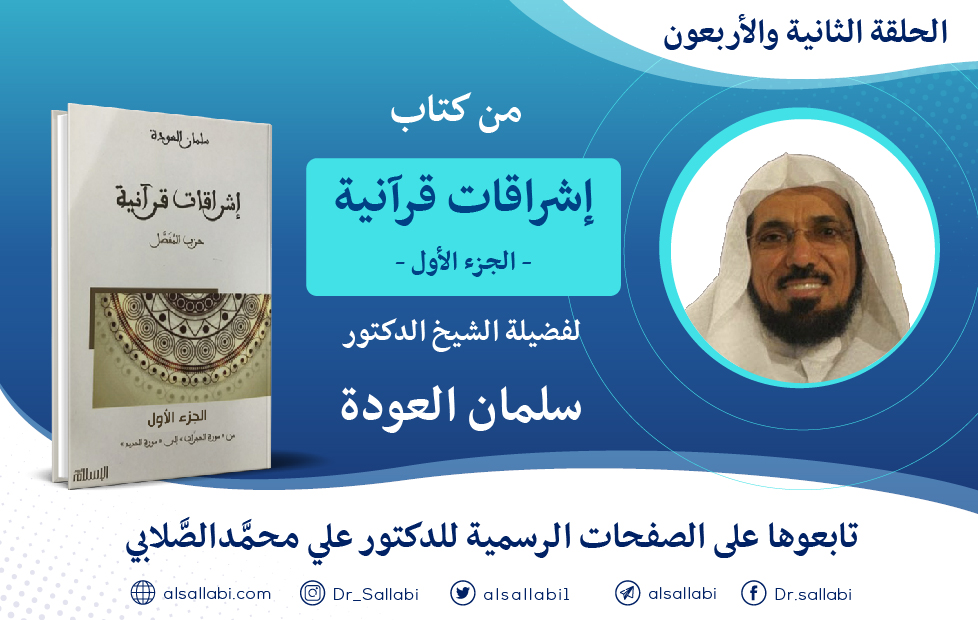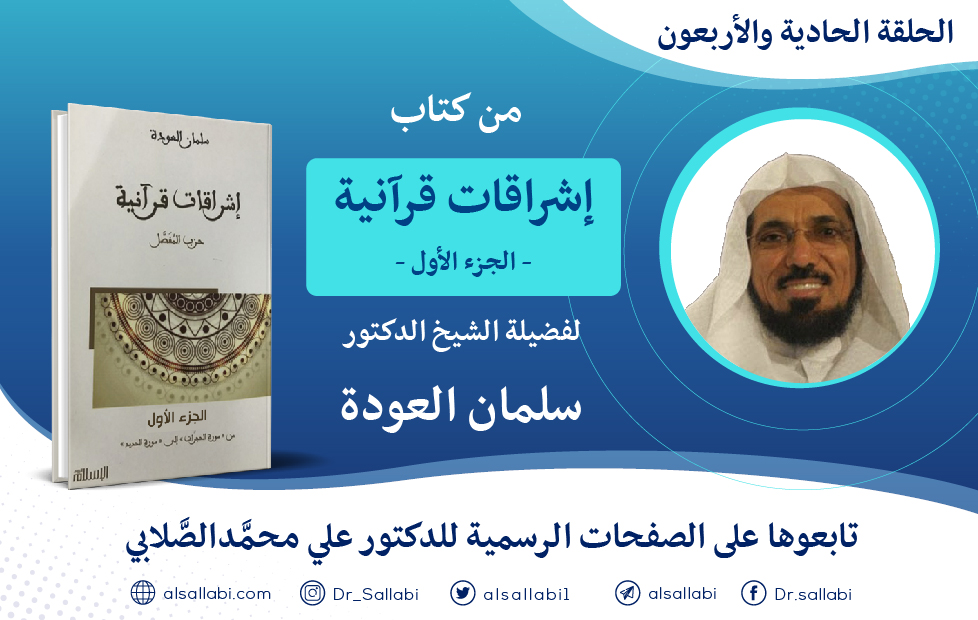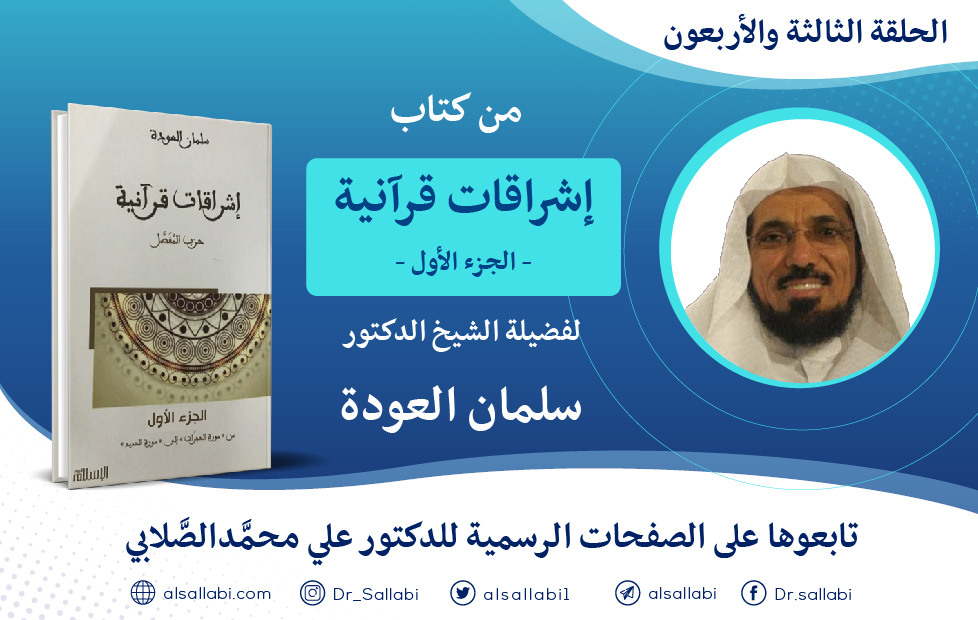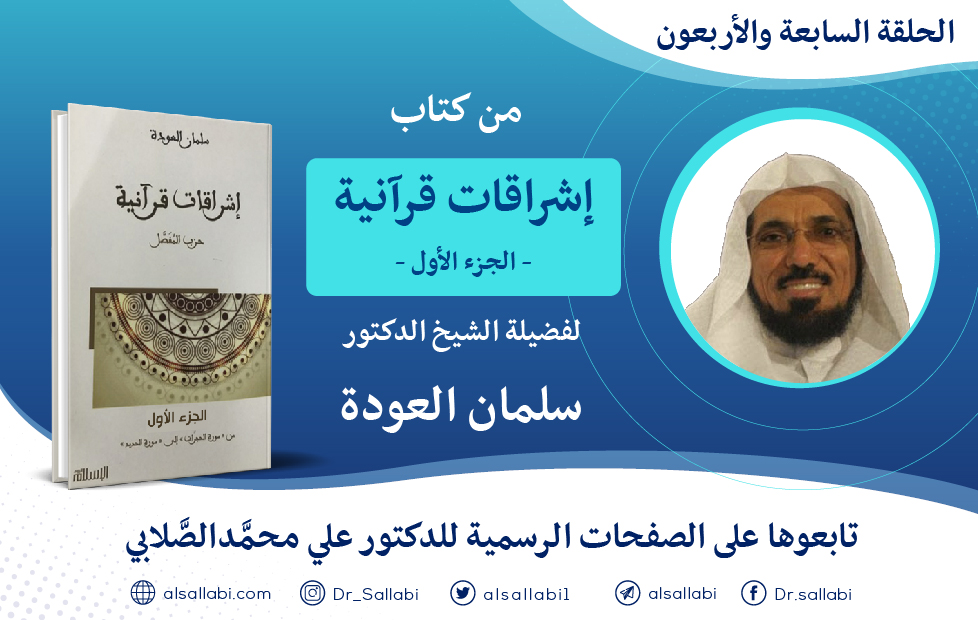من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان: (سورة التغابن)
الحلقة: الثانية والأربعون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الأولى 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}:
هذه الآية مدنية، وسبب نزولها- كما قال ابن عباس وعكرمة وغيرهما- أن أناسًا من المسلمين بمكة أرادوا أن يهاجروا، فمنعهم أولادهم وأزواجهم، فتركوا الهجرة، فلما هاجروا بعد ذلك وجدوا الناس سبقوا وتعلَّموا وحفظوا وفقهوا في الدين، فهمَّ هؤلاء أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم؛ لأنهم كانوا سببًا في تأخر هجرتهم، فأنزل الله الآية.
وعبَّر هنا بـ{أَزْوَاجِكُمْ}، ولم يقل: «زوجاتكم»؛ حتى تعم الكلمة الرجال والنساء، وكذلك الأولاد تعم الأبناء والبنات.
و{مِنْ } هنا للتبعيض، أي: أن بعض أزواجكم وبعض أولادكم عدو لكم.
ومفهوم العداوة هنا ليس منصرفًا للعداوة في الدين فحسب، بل يشمل الصد عن الخير والإلهاء عنه بأي سبيل، فيكون معنى العداوة أن يكون أثره عليك كأثر الأعداء.
{فَاحْذَرُوهُمْ}: فلم يقل سبحانه: «ضارّوهم»، أو: «عاقبوهم»، وإنما قال:
{فَاحْذَرُوهُمْ} أي: احذروا أن يبلغ بكم الحب للزوجة أو الولد أن يرتكب المؤمن الإثم بسببهم أو بترك الطاعات.
{وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا}: ذكر ثلاثة أشياء: أن يعفوا عنهم، فتعفوا عمن ظلمكم، وأن تصفحوا عن الجاهل، كما قال: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين} [الأعراف: 199]، وأن تغفروا للمسيء، فهي ثلاث درجات.
ويحتمل أن يكون العفو أَلَّا تُؤاخذ أحدًا بالعقوبة، وإن جرى منك عتاب له، والصفح أن تضرب صفحًا عنه، والصفح درجة أعلى من العفو، وأما الغَفْر فمن معانيه: السَّتْر، فلا تذكر ما فعله أولادك وزوجتك من الأعمال السيئة.
{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}: فهذه من أسمائه الحسنى، والمغفرة والرحمة من صفاته، والله يحب من عباده أن يغفروا ويرحموا؛ وهو جميل يحب الجمال، وغفور يحب المغفرة، ورحيم يحب الرحماء، وعفو يحب العفو، فمَن أراد أن ينال رضى الله فليتخلق بهذه الأخلاق النبيلة.
* {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم }:
وهذا لفظ عام، ولم يأت ما يدل على التبعيض كما في الآية السابقة.
وبدأ بالأموال؛ لأن الغالب أنها إذا توفرت شغلت حتى عن الأولاد، وفتنةُ الناس بالأموال ظاهرة لا تحتاج إلى استدلال، وقد يُشغل الإنسان عن ولده ولا يُشغل عن ماله، والأولاد يعم الأبناء والبنات وأولادهم وأحفادهم، وفي هذا يقول الشاعر:
لَوْلا بُنَيَّاتٌ كَزُغْبِ القَطا * رُدِدْنَ من بَعْضٍ إلى بَعْضِ
لَكانَ لِي مُضْطَرَبٌ واسِعٌ * في الأَرْضِ ذاتِ الطُّولِ والعَرْضِ
وإنَّما أوْلادُنا بَيْنَنا * أَكْبادُنا تَمْشـِي على الأَرْضِ
لو هبَّتِ الريحُ على بعضِهم * لامتنعتْ عيني عن الغمضِ
وكان أبو حَكِيم المُرِّي- وهو شاعر جاهلي- يحب أن يعيش من أجل ولده حَكِيم، وكان يقول:
يَقَرُّ بعيني وهو يُنقِصُ مدَّتي * مرورُ الليالي كي يَشِبَّ حَكِيمُ
مخافةَ أن يغتالني الموتُ قبلَهُ * فيغشى بيوتَ الحيِّ وهو يتيمُ
والفتنة هي: الابتلاء والاختبار، وليس في هذا ذم للمال ولا للأولاد.
والمقصود أن وصف الولد والمال بالفتنة لا يعني الترغيب في التخلص مما في اليد من المال ولا في إهمال الولد، وإنما هو تحذير وطلبُ ترشيد للعاطفة في هذين المحبوبَيْن، وأكثر الناس إذا اغتنى طغى، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى٦ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6-7]، فأصبح يتوسع ويتأوَّل، أو يجترئ على الحرام، ويزداد تعلقه بالدنيا.. هذا حال أكثر الناس.
ومن الناس مَن يعطيه الله المال، فلا يزيده إلا إيمانًا وطاعة وتصدقًا وتواضعًا وقربًا ومزيد شكر.
ومثل هؤلاء مَن عناهم بعض الصحابة بقوله: إن فقراء المهاجرين أَتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهلُ الدُّثُور بالدرجات العُلى، والنعيم المقيم! فقال: «وما ذاك؟». قالوا: يصلون كما نصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق، ويُعتقونَ ولا نُعتقُ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أفلا أعلِّمُكم شيئًا تُدركونَ به مَن سبقكم، وتسبقونَ به مَن بعدكم، ولا يكونُ أحدٌ أفضلَ منكم إلا مَن صنعَ مثلَ ما صنعتم؟». قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «تسبِّحونَ، وتكبِّرونَ، وتحمدونَ دُبُرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثينَ مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهلُ الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك فضلُ الله يؤتيه مَن يشاءُ».
{وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم } تذكير لهم أَلَّا ينسوا أجر الآخرة، فإن الدنيا لا تعدّ شيئًا في مقياس الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «والله، ما الدنيا في الآخرة إلا مثلُ ما يجعلُ أحدُكم إصبعه هذه في اليمِّ، فلينظرْ بمَ ترجعُ؟».
* {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون }:
ولهذه الآية شواهد، كقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286]، وهي تدل على أن المؤمن لا يكلّف إلا قدر طاقته.
وكيف نوفِّق بينها وبين قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } [آل عمران: 102]؟
ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت: {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } شقَّ ذلك عليهم، فأنزل الله سبحانه التخفيف بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }. ونُقل هذا عن الحسن البصري.
والراجح الذي اختاره ابن عباس رضي الله عنهما، وأكثر المفسرين: أنه ليس في الباب نسخ بمعنى إبطال الحكم الأول بالثاني، ولكنه التخصيص لذلك العموم، أو التبيين لذلك المجمل، فالآية الثانية بيَّنت وأوضحت الآية الأولى، وأن تقواه حقَّ تقاته لا تدل على أنه يحمِّلكم فوق قدرتكم، فلا تكليف بما لا يُطاق، وإنما المقصود استيعاب التقوى فيما تقدرون عليه، وفيه تحفيز للنفوس على التقوى.
ولا شك أن من تقوى الله حقَّ تقاته أن يعرف الإنسان حدود الاستطاعة؛ لأن تكليف النفس فوق طاقتها خلاف التقوى، وتكليف الزوجة والأولاد فوق طاقتهم خلاف التقوى، والمرء يعرف طاقة نفسه جيدًا، مثل تطبيقه لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ فعلى جنب».
وثمتَ نوع من الاستطاعة فقهه خفي، وكثير من الفتن تقع بسببه، وهو ما يتعلَّق بالمجموع، كالأسرة والمؤسسة والمدرسة والوزارة والشركة، ففيها قدر من الاستطاعة يراعى؛ لأن تجاهله يحدث مفسدة أكثر مما يرجى فيه من المصلحة، فحمل الناس عليه ليس من التقوى التي أمر بها الشرع، فربما قصَّروا في كثير من الطاعات والعبادات بسبب المشقة، وسياسة المجتمعات أدق وأحوج إلى الفقه، ولذا ينبغي لمَن يخالط الناس بقصد الإصلاح أن يستوعب «فقه الممكن»، فلا يحمل الناس على ما لا يطيقون، وهذا مَزْلق يقع فيه المسؤول أو الوالي الذي يغفل عن طاقة الناس وإمكانيَّاتهم، ويقع فيه الداعية أو المصلح الذي يقودهم إلى المستوى المثالي، دون أن يراعي رغباتهم وهممهم وانفعالاتهم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم كان هو الأسوة في تحقيق التقوى، ولذا لما حاصر الطائف ولم ينل منهم شيئًا قال: «إنا قافلونَ إن شاء الله». فثقُل عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه! فقال: «اغدُوا على القتال». فغَدَوْا فأصابهم جراح، فقال: «إنا قافلون غدًا إن شاء الله». فأعجبهم، فضحك النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وحمل الناس على الصعب والوعر وعلى العزائم لا يطيقه إلا أولو العزم من الناس، وهم قليل، ولهم في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحُدَيْبِيَة أسوة حسنة مع الشروط التي رضيها صلى الله عليه وسلم وأمضى المعاهدة بها، وكانت فتحًا للمسلمين وتيسيرًا لهم، رغم كرههم لها أول الأمر، وإذا كانت الاستطاعة مشروطة في العبادات، فالاستطاعة فيما يخص أمور المال والدنيا والتعليم والسياسة آكد وألزم.
{وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا }: والمراد: اسمعوا لله، واسمعوا لرسوله، وأطيعوا الله، وأطيعوا رسوله.
{وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ }: والأمر بالإنفاق ليس أمرًا بالتخلِّي عن المال برمته، فإنه لا يُؤمر بالإنفاق إلا الواجد للمال الذي عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة مَن يعول من أهله.
ومعنى الآية: أنفقوا إنفاقًا يكون خيرًا لأنفسكم، أو أنفقوا شيئًا يكون خيرًا لأنفسكم.
{وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون }: هذه من الآيات العظيمة التي تُساق مساق المثل، وفيها إشارة جلية إلى موطن الخلل في نفس المرء، فعلى الإنسان أن يتوقَّى شحَّ نفسه، ليس في المال فحسب، وإنما في كل شيء.
وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول في طوافه: «اللهمَّ قني شُحَّ نفسي». لا يزيد على ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: «إني إذا وُقيتُ شُحَّ نفسي لم أسرق، ولم أزنِ، ولم أفعل شيئًا».
والفلاح الذي يبتغيه الناس {يَوْمُ التَّغَابُنِ } هو بأن يوقى الإنسان شح النفس ويسلم من الأَثَرة.
ولا يشق على المتأمِّل المخالط للناس أن يلمح التشاح بينهم في الطعام والشراب ومواقف السيارات والطريق، وعند الطبيب وفي كل اصطفاف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «فمَن أحبَّ أن يُزَحزحَ عن النار، ويُدْخَلَ الجنةَ، فلتأته منيَّتُهُ وهو يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر، ولْيَأْتِ إلى الناس الذي يُحِبُّ أن يُؤْتَى إليه».
ولهذا كان من أفضل ما مُدح به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنها خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم.
* {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم }:
والمقصود: الصدقة، وفيها تأكيد للأمر بالإنفاق، فإن تنفقوا صدقة فكأنكم تقرضون الله، وإنما تقرضون مليئًا سبحانه، وسيوفي لكم ما أنفقتم أضعافًا مضاعفة.
{وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم }: {شَكُورٌ } يشكر لعباده أعمالهم الصالحة، كما قال: {وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ } [الزمر: 7]، و{حَلِيم } على العصاة، فلا يعاجلهم بالأخذ والنكال.
* {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيم }:
تتميم للتذكير بعظمة الله تعالى، مع مناسبتها للترغيب والترهيب اللذين اشتملت عليهما الآيات السابقة كلها؛ لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيها لا يُفِيتُ شيئًا من الجزاء عليها بما رتَّب لها.
ولأن {الْعَزِيزُ } لا يعجزه شيء، و{الْحَكِيم } الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة من وضع الأشياء مواضعها، ونَوْط الأمور بما يناسب حقائقها.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: