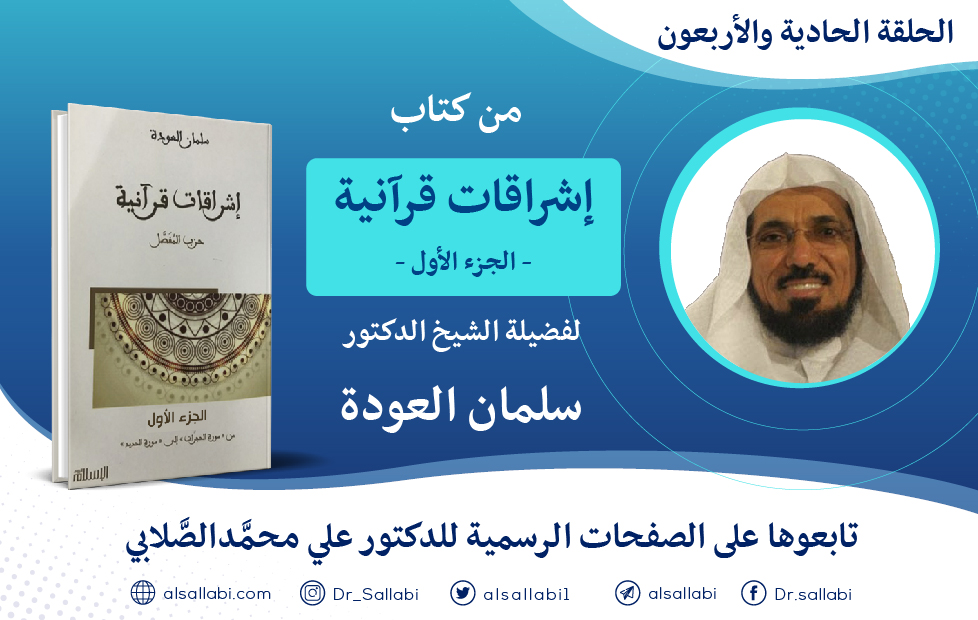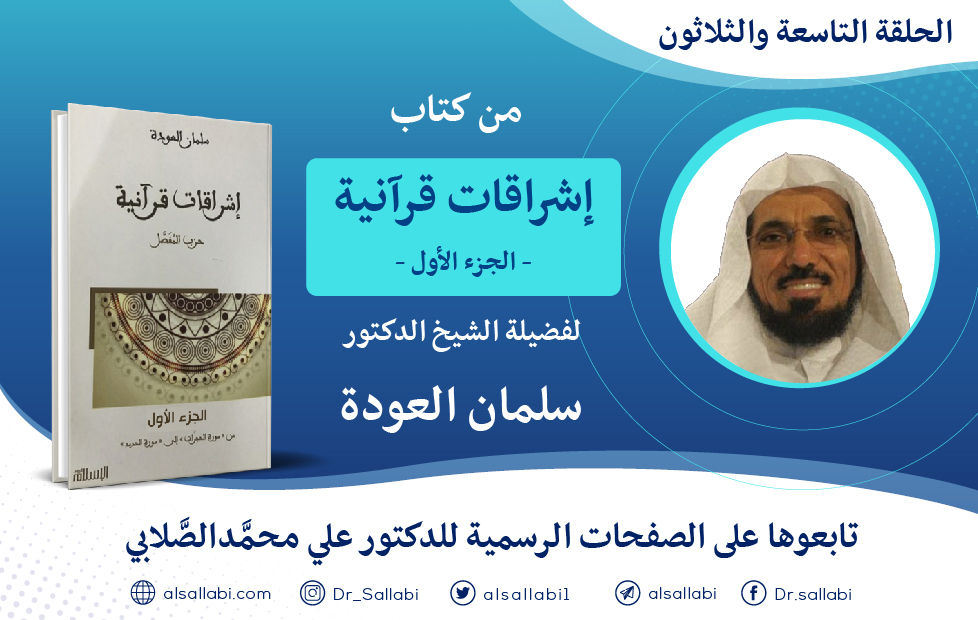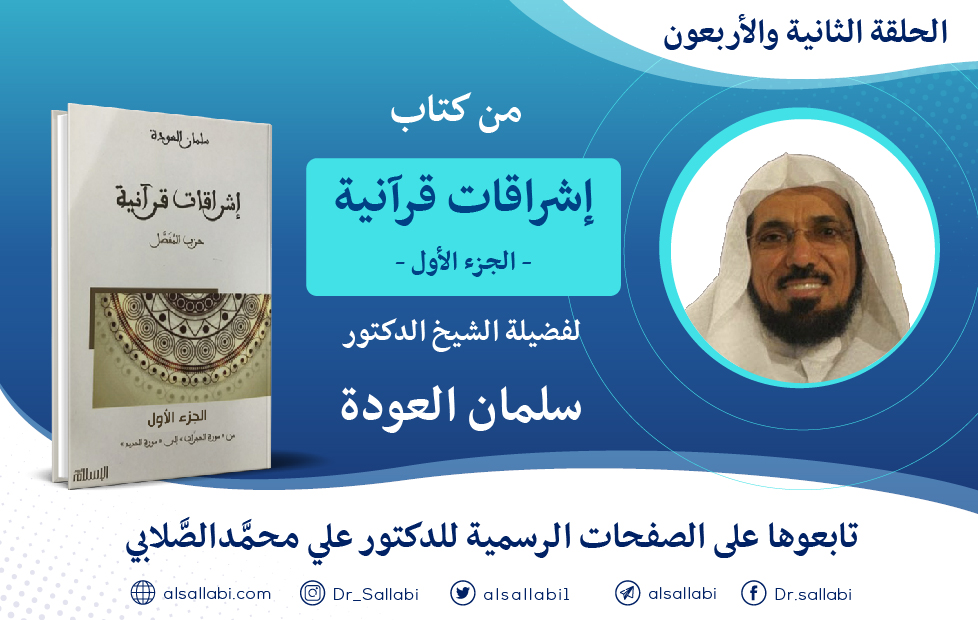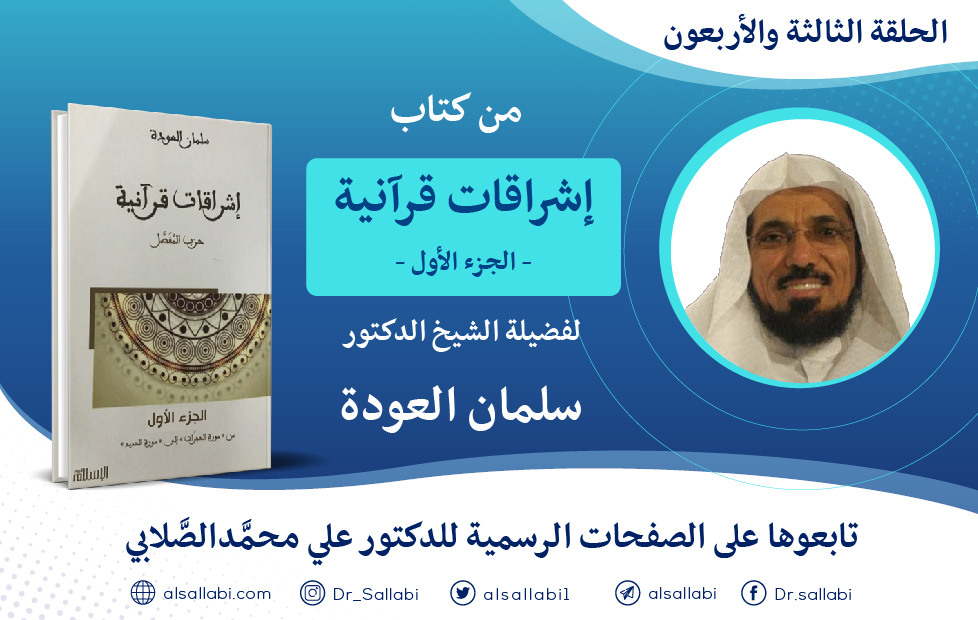من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان: (سورة التغابن)
الحلقة الواحدة والأربعون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الأولى 1442 هــ/ نوفمبر 2020
* {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير }:
والزَّعْم هو: حكاية قول مظنته الكذب؛ ولهذا جاء في الحديث: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرجلِ: زعموا». وفي سنده ضعف، ومعناه: أن يحدِّث بكل ما سمع، ولا يتحقَّق من أخباره.
ومن معانيه: الادِّعاء دون بينة، ومنه زَعْم الذين كفروا هنا؛ فقد ادَّعوا أَلَّا بعث ولا نشور، والمقصود: كفار مكة ومَن كان على ديانتهم الوثنية، أما غيرهم كأهل الكتاب فهم يؤمنون بالبعث، وإن لم يكن بالصورة الصحيحة السالمة من الخرافات.
ولما كان زعم الذين كفروا باطلًا قال الله لنبيه: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ }: أقسم عليهم بأن ما زعموه باطل، وأن الله تعالى سوف يبعثهم.
وهذه آية من ثلاث آيات في القرآن الكريم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُقسِم فيها.
وفي «سورة يونس»: {ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ} [يونس: 53]، وفي «سورة سبأ»: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3].
وفي هذه السورة أقسم على حقيقتين: الأولى: البعث، وهي القضية الأهم التي مَن يؤمن بها سيلزمه الإيمان بما بعدها من الحساب.
والثانية: أن الإنسان سوف يُنبَّأ بما عمل: {ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ}، وليس المقصود مجرد الإخبار والكشف، بل المحاسبة والجزاء بالخير والشر.
{وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير}: وما له لا يكون يسيرًا عليه سبحانه، وهو الذي إذا أراد شيئًا {فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون} [البقرة: 117].
* {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}:
{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}: والمخاطَبون ربما زعم بعضهم أنهم يؤمنون بالله، ولكن الله يريد أن يكون إيمانًا حقيقيًّا موافقا لما جاءت به الرسل، وأن يتحول من مجرد إيمان نظري عقلي أو لفظي إلى إيمان عملي، فبعض الناس يؤمن بوجود الله، ولكن لا يعبده، ولا يلتزم بشرائعه مطلقًا، ولا يدين بها، فلا ينفعه هذا الإيمان، حتى يتحول إلى إيمان حقيقي والتزام واقعي.
{وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا} وهو القرآن؛ بقرينة الإنزال. {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}.
* {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم}:
{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ}: يجمع أعضاءكم، ثم تعود الروح إلى الجسد، ويخرج الناس من قبورهم، فهذا يوم القيامة، ومن أسمائه: يوم الجمع.
وسُمِّي: يوم الجمع؛ لأن الناس كلهم يجتمعون فيه، وتجمع لكل نبي أمته كما قال سبحانه: {يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ } [المائدة: 109].
وفيه جمع أعضاء الإنسان بعدما تفرقت؛ وذاك سمي: يوم الجمع، كما قال سبحانه: {لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير} [الشورى: 7].
{ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ}: ولم يرد في القرآن الكريم لفظ {التَّغَابُنِ} إلا هنا، وهو مأخوذ من الغَبْن، وهو: أن يبيع الإنسان سلعة بأقل من ثمنها، ويكون الفرق فاحشًا.
ووصف ذلك اليوم بـ{يَوْمُ التَّغَابُنِ}، والأصل أن التغابن يكون بين طرفين، كما تقول: تضاربا، أو تقاتلا.
والوجه الآخر: أنه ما من مكلَّف إلا ويقع له غَبْن يوم القيامة، ويتمنى أن يُعاد إلى الدنيا، إن كان مسيئًا حتى يستعتب ويتوب، وإن كان محسنًا حتى يزداد إحسانًا، فيكون الغَبْن لكل أحد من الناس، حتى الصالح الذي عمل الخير يتمنى أن يعود ليعمل أفضل، وإذا رأى ما عند الله من الفضل والكرامة تمنَّى المزيد، كما جاء في الحديث: «يودُّ أهلُ العافية يومَ القيامة حين يُعطَى أهلُ البلاء الثوابَ لو أن جلودَهم كانت قُرضت في الدنيا بالمقاريض». ولا تغابن حقًّا إلا في ذلك اليوم.
{وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ}: فيه إشارة إلى علاج الغَبْن بالمبادرة إلى التوبة وعمل الصالحات مما يكون سببًا في تكفير الذنوب، كما قال سبحانه: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ} [هود: 114]، وفي استطاعتك يا عبد الله أن تنقذ نفسك من مغبة الغَبْن والتغابن يوم القيامة بأن تبادر للعمل الصالح والثبات على الإيمان.
{وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}: والجنات بالنظر إلى مجموع المؤمنين الذين عملوا الصالحات، وكل امرئ منهم له جنته.
والآية دليل على الخلود الأبدي السرمدي الذي لا يحول ولا يزول {خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً} [الكهف: 108].
{ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم} في مقابل {التَّغَابُنِ}، فهذا هو الفوز في الجنة.
* {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِير}:
ولم يقل {أَبَدًا}، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن ثمتَ فرقًا بين خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وأن خلود أهل الجنة سرمدٌ لا نهاية له، وخلود أهل النار هو المكث الطويل، وهذا ما يُفهم من كلام ابن تيمية في بعض كتبه، وابن القيم، وحكاه شارح «الطحاوية» قولًا في مذهب أهل السنة، واختاره رشيد رضا من المتأخرين، وألَّف فيه الصنعاني.
واختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا، والمسألة ليست من مسائل الإجماع، ولا من القطعيات، بل هي من مواطن الخلاف، ومَن أخذ بقول منها فلا حرج عليه.
* {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}:
الحديث عن المصائب بعد الحديث عن الإيمان والكفر، قد يكون متعلّقًا بمصائب سببها الكفار بعدوانهم على المؤمنين بالتعذيب أو الأذى أو القتل أو مفارقة الأهل والديار، كما تعرَّض له المؤمنون بمكة، أو تكون المصيبة أحيانًا في كفر قريب، كأب أو أم أو أخ، فيغتم لذلك قريبهم المسلم الذي حاول هدايتهم فلم تنفعهم الذكرى.
والمصيبة هي: ما يصيب الإنسان، ولكن جرى العرف اللُّغوي على أنها لا تستخدم إلا في الشر، كما هنا، والمصيبة وإن كان لها سبب معلوم غالبًا، إلا أنها مكتوبة من قبل، ولذا ذكر الإذن الإلهي، وهو العلم والقدر المكتوب عند الله تعالى.
{وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}: يقول علقمة بن قيس رحمه الله: «هو الرجلُ تصيبه المصيبةُ، فيعلمُ أنها من عند الله، فيسلِّم لذلك ويرضى».
ويقول بعض السلف: يَهْد قلبه إلى أن يكثر من قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون».
ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: «يَهْد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئَه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه».
فمَن يؤمن بالله ويعلم أن المصائب بإذنه وأنه يُؤجر على الصبر {يَهْدِ قَلْبَهُ}.
وفي قراءة بفتح الدال وبعدها همزة ساكنة: (يَهْدَأْ قَلْبُه)، أي: يصبح قلبه هادئًا في مواجهة المصيبة؛ لأن المصائب تجعل القلب يضطرب ويرتبك، ويفقد الإنسان قدرته على الاتزان، فمَن آمن بالله رُزق الهدوء عند المصيبة، فيرضى ويسلِّم ويلجأ إلى ربه فيذكره ويسترجعه.
وقد كتب ابن القيم «عِدَة الصابرين وذخيرة الشاكرين»، وكتب أبو يحيى الغرناطي «جَنَّة الرضا في التسليم لما قدَّر الله وقضى»، وكتب كثيرون مؤلفات عن الصبر على البلاء والمصاب وفضله وحسن عاقبته.
ويُروى أن ذا القَرْنين لما نزل به الموت، وحزنت أمه حزنًا شديدًا، قال لها: يا أم، إذا أنا مت فاصنعي وليمة وادعي إليها الناس، واطلبي أَلَّا يحضر إلى الوليمة أحدٌ أُصيب بمصيبة. فعملت وليمة ودعت الناس إليها وقالت: كل مَن أُصيب بمصيبة فلا يأت. فلم يحضر أحد، قالت: أين الناسُ؟ قالوا: وضعتِ شرطًا لا يتحقَّق في أحد. فعلمت أنه أراد تسليتها بعد موته!
{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} أي: فيما قدَّر من المصائب، وفيما يقع من الناس من التسليم أو الاحتجاج أو الاعتراض، فمَن تذكَّر علم الله تجلَّد وصبر، {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور: 48].
* {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِين}:
أمر بطاعته سبحانه، ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد فعل {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}، ولم يكتف بالعطف فقط، مع أنه يغني، كما في قوله تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران: 132]؛ ففي إظهار فعل {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} هنا إشارة إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، فكما يُطاع الله فيما أمر ونهى، كذلك يُطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى؛ فتجب طاعته فيما يأمر به، ولو كان غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي؛ لئلا يتوهَّم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلِّغه عن الله دون ما يأمر به غير التشريع، فإن امتثال أمره كله خير. ولهذا قال سبحانه: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} [النساء: 80].
ويُؤخذ من هذه الآية الكريمة أن السنة النبوية الثابتة حجة مستقلة بذاتها، وقد تنفرد بتشريع أحكام لم ترد بنصها في القرآن، كما في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأنه يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النسب، وتحريم كلِّ ذي ناب من السباع، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير.
{فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِين}: فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، والهداية بيد الله يهدي مَن يشاء ويضل مَن يشاء، فليس على الرسول صلى الله عليه وسلم هدايتهم، وإنما عليه أن يقيم الحجة والبلاغ، وأضاف الرسول إلى ذاته العلية سبحانه، فقال: {رَسُولِنَا} تشريفًا لمقامه وتعظيمًا لقدره.
* {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون}:
تذكير بكلمة التوحيد، ووحدانية الله سبحانه وتعالى هي التي لأجلها بُعثت الرسل وأُنزلت الكتب، فليس أحد من الرسل بمعبود، بل المعبود هو الله وحده، وليس لأحد شيء من الأمر، فالأمر كله لله.
{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون}: فإذا كان المرء موحِّدًا لله، فيلزمه أن يتوكَّل على الله الحي الذي لا يموت، والتوكل معنى قلبي، لا تفي به العبارة، وهو جمع بين فعل السبب الممكن وبين الاعتقاد الجازم بأن الأمر بيد الله، وأن ما يفعله الله فهو خير للعبد مما يتمنى.
والتوكل قرين الإيمان: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: 123]، {وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين} [المائدة: 23].
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: