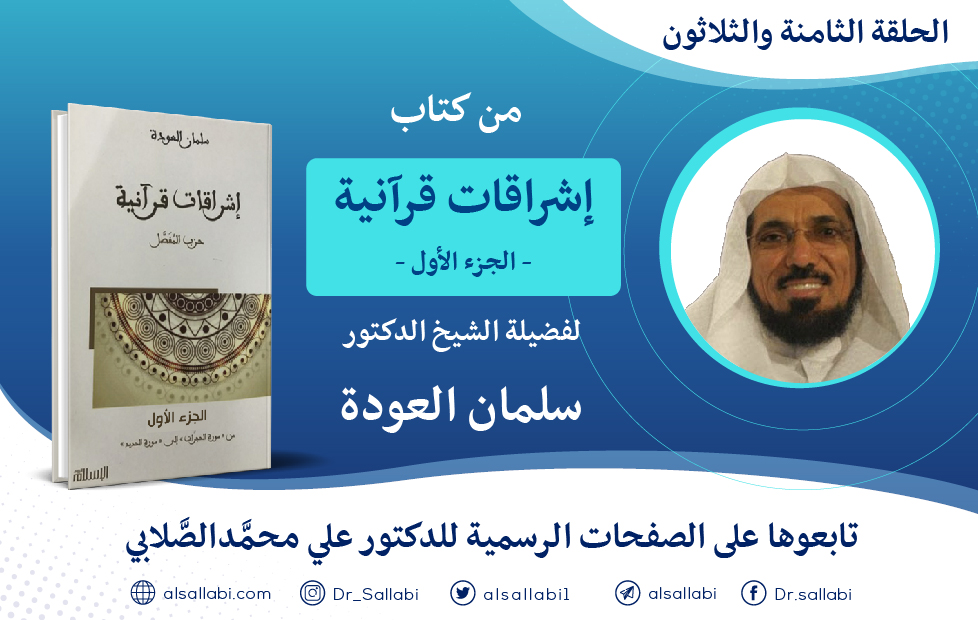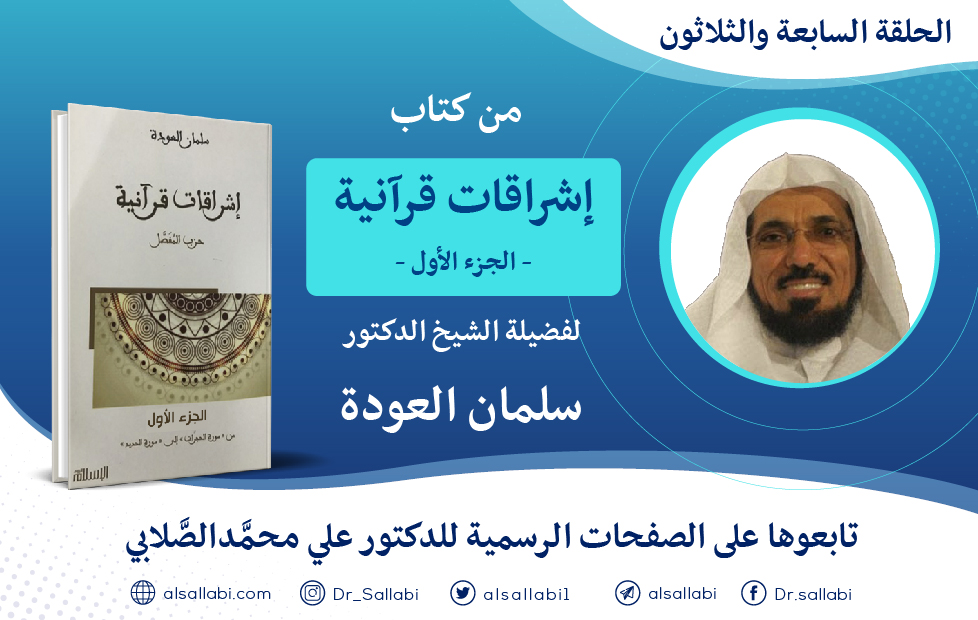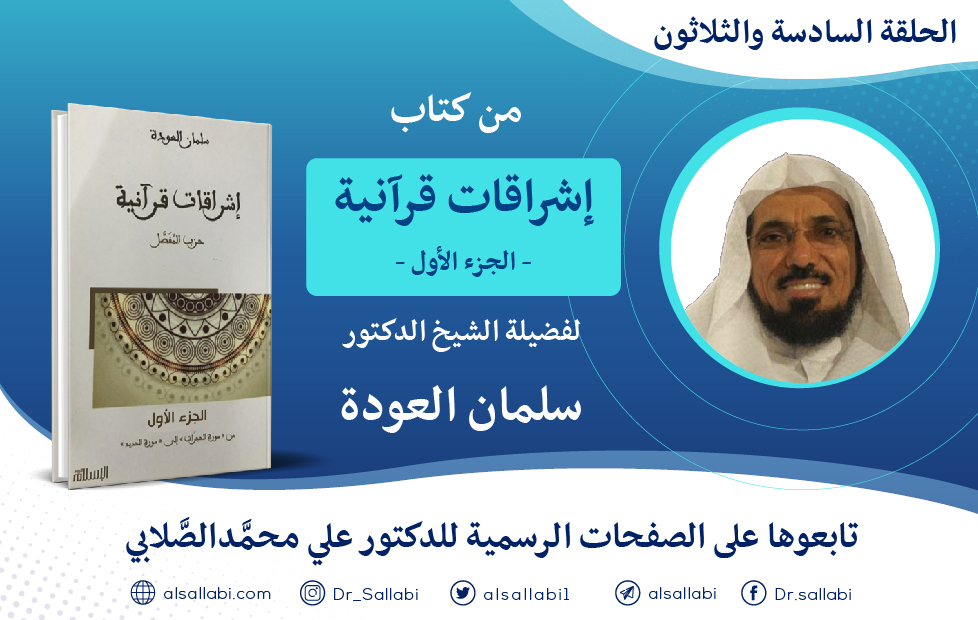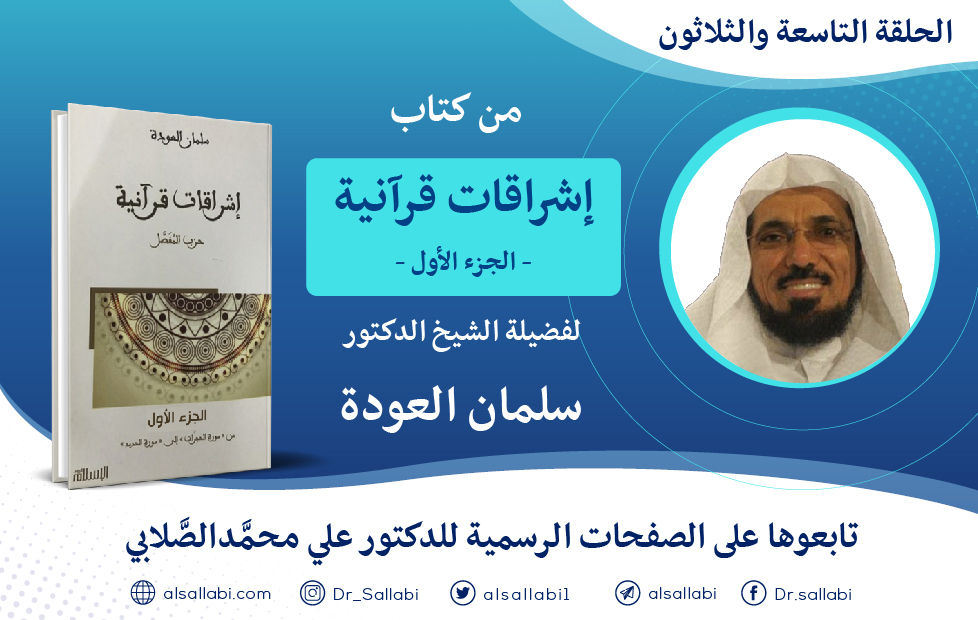من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة المنافقون)
الحلقة الثامنة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الأول 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* تسمية السورة:
تُسمَّى: «سورة المنافقون» بالرفع على الحكاية؛ لأن الله تعالى قال: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ }.
أو: «سورة المنافقين» على الإضافة.
* عدد آياتها: إحدى عشرة آية باتفاق علماء العدِّ.
* وهي مدنية بالاتفاق أيضًا؛ لأن حركة النفاق لم تظهر إلا في المدينة.
* وسبب نزولها مشهور، والراجح أنه كان في غزوة المُريْسِيع، أو غزوة بني المُصْطَلق، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكَسَعَ رجلٌ من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فغضب الأنصارِيُّ غضبًا شديدًا، حتى تَدَاعَوْا، فقال الأنصاريُّ: يا للأنصار. وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بالُ دعوى الجاهلية؟». قالوا: يا رسولَ الله، كَسَعَ رجلٌ من المهاجرينَ رجلًا من الأنصار. فقال: «دعوها؛ فإنها منتنةٌ». فسمعها عبدُ الله بنُ أُبَيٍّ فقال: قد فعلوها، أَقَدْ تَدَاعَوْا علينا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ. قال عمرُ: دعني أضربْ عُنقَ هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ؛ لا يتحدَّثُ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابه».
وعن زيد بن أَرْقم رضي الله عنه قال: كنتُ في غزاة، فسمعتُ عبدَ الله بنَ أُبَيٍّ ابنَ سَلُولَ يقول: لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ. فذكرتُ ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدَّثته، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أُبَيٍّ وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذَّبني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصدَّقه، فأصابني همٌّ لم يصبني مثله قط، فجلستُ في البيت، فقال لي عمي: ما أردتَ إلى أن كذَّبك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَقَتَكَ؟ فأنزلَ اللهُ تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ }. فبعث إليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقرأ، فقال: «إن اللهَ قد صدَّقك يا زيدُ».
وقيل: إن الحادثة وقعت في غزوة تبوك، وهو ضعيف، بل كانت في غزوة بني المُصْطَلِق- وهي: المُرَيْسِيع- في السنة الخامسة من الهجرة.
* {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون }:
{الْمُنَافِقُونَ } جمع: منافق، وهو اصطلاح شرعي جديد لم يكن مستخدمًا من قبل، وهو مأخوذ من النفق، وهو الطريق الخفي المفتوح من جهتيه، وبعض الحيوانات تحفر في الأرض حفرة وتجعل لها بابين إن حوصرت من هنا خرجت من هنا، فهم قد وضعوا رِجْلًا مع الإسلام ورِجْلًا مع الكفر، فإن غلب هؤلاء كانوا معهم، وإن غلب هؤلاء كانوا معهم، وأول مَن أنشأ النفاق في المدينة هم اليهود، فهم مؤسِّسو النفاق وزعماؤه؛ ولذلك كان كثير من المنافقين من يهود أهل المدينة الذين أظهروا الإسلام، وفيهم من الأوس والخزرج الذين تأثروا بهم.
{إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ }: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
{نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ }: فيعلنون إيمانهم خداعًا وحقنًا لدمائهم، وبحثًا عن مصلحتهم العاجلة، ويُقسمون على ذلك، أو أن الشهادة ذاتها تعتبر قَسَمًا ويمينًا وهم لم يقولوا: «نعلم»، وإنما صرحوا بلفظ: الشهادة: {نَشْهَدُ }.
والشهادة: إقرار بالشيء كأنه يشاهده بعينه من شدة يقينه، وهم يؤكِّدون الشهادة بحرف «إنَّ»، وباللام، وبالقَسَم.
{وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ }، ولأن الآية وصفتهم بالنفاق ابتداءً، فإن السياق يعتني بالفصل بين كون الرسالة حقيقة من عند الله، وبين كون ادِّعائهم أنهم يشهدون كذبًا بما ليس في قلوبهم المنطوية على الكفر.
فألغى شهادتهم، وكذَّبهم فيما نسبوه لأنفسهم، وأثبت الرسالة بعلمه المحيط، وهو الذي أرسله، وعبَّر بلفظ العلم؛ تنويعًا، كما عبَّر بلفظ: الشهادة في «سورة آل عمران» في ابتداء الوحدانية: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ } [آل عمران: 18].
* {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُون }:
تعريض بعبد الله بن أُبَيٍّ ابن سَلُولَ، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف بالله أنه ما قال هذا، وزعم أن زيدًا رضي الله عنه كاذب فيما نسب إليه.
والجُنَّة- بضم الجيم-: الدِّرع أو التُّرس الذي يضعه الإنسان على جسده أو بعض جسده ليقيه من السلاح، فهم جعلوا أَيْمانهم وقاية من أن يُعاقبوا أو يُؤاخذوا أو تُقام عليهم الحدود والعقوبات.
والأَيْمان جمع: يمين، وهو الحلف، فهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم.
وقُرئ بكسر الهمزة: (إِيْمَانَهُمْ)، أي: أنهم تظاهروا بالإيمان لا صدقًا ولا رغبة فيما عند الله، بل لأجل عرض زائل من الدنيا، ومنه حماية أنفسهم، والحصول على ميزات اجتماعية يخافون فقدها.
{فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ } أي: صدُّوا أنفسهم عن سبيل الله، وكأنهم استمرؤوا هذا وظنوا أن المسلمين لا يدركون حيلهم وأحابيلهم، وكذبوا وصدَّقوا الكذبة؛ ولهذا استمروا على كذبهم وتلبيسهم.
أو يكون المعنى: صدُّوا غيرهم عن سبيل الله، وهذا ظاهر من أفعالهم؛ فهم يحلفون ليغرُّوا غيرهم ويخدعوهم بتظاهرهم بالصدق {إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُون }.
* {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُون }:
والآية تحتمل أنهم آمنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا عند أصحابهم وشياطينهم الذين يثقون بهم، كما قال: {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُون } [البقرة: 14]. والشياطين هؤلاء هم مدرسوهم من اليهود وغيرهم.
وتحتمل أنهم آمنوا ظاهرا بألسنتهم، ثم كفروا باطنًا بقلوبهم وأعمالهم.
وتحتمل أن ناسًا من اليهود آمنوا بموسى، ولما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم كفروا به: {فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ } [البقرة: 89].
والاحتمال الرابع: أن يكون ذلك إشارة إلى بعضهم الذين وقع منهم شيء من الإيمان ثم تركوه، كما في صدر «سورة البقرة»: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ } [البقرة: 17].
فيكون المقصود أنهم أول ما سمعوا القرآن وقع عندهم شيء من الإيمان ولما رجعوا إلى أصحابهم غسلوا أدمغتهم وعقولهم وزيَّنْوا لهم الباطل وصرفوهم؛ ولهذا قال تعالى: {فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ }، فكفروا بعد ما وقع منهم شيء من الإيمان.
ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها، والله أعلم.
{فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ }: والطبع على القلب أن يصبح أعمى، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، كالكُوز مُجَخِّيًا، كما قال صلى الله عليه وسلم، فالقلب المطبوع بخلاف القلب الحي السليم.
والطَّبع من الله، فهو الذي طبع على قلوبهم، ولكن هذا الطبع بسبب أنهم استكبروا عن الإيمان والإذعان لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذوا أَيْمانهم جُنَّةً، يؤمنون أول النهار ويكفرون آخره؛ ولم يريدوا الحق ولا أصغوا إليه، ولا توجَّهوا إلى ربهم بسؤال الهداية.
{فَهُمْ لاَ يَفْقَهُون }: والفقه: المعرفة القلبية التي تميز بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، والمعروف والمنكر.
* ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾:
{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ }: ليس المقصود المنافقين كلهم، ففيهم الطويل والقصير والسمين والنحيف، بل هو إشارة إلى مجموعة خاصة منهم، وعلى رأسهم عبدُ الله بنُ أُبَيٍّ ابنُ سَلُولَ شيخُ النفاق؛ ولذا قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «كان عبدُ الله ابنُ أُبَيٍّ وَسِيمًا جَسِيمًا صَحِيحًا صَبِيحًا ذَلْق اللِّسان».
فكان الرجل فيه خصال القوة في جسده، وهذا ليس مدحا في أصله وليس ذمًّا؛ لأن الله قال عن طالوت: {وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ } [البقرة: 247]. ولكن معناه أن هذه الأجساد خواء؛ وقد لقي أحد الشيوخ شابًّا فأعجبه، فقربه منه وسأله، فوجده لا يفقه شيئًا، فقال: ياله من بيت لو كان فيه سكان! فالجسم بيت جميل، ولكن لا روح فيه ولا عقل.
وبسطة الجسم صفة محايدة ليست صفة نقص ولا كمال، فهو يوجد في بعض المؤمنين وفي بعض المنافقين، وقد أثنى الله على جمال يوسف وقوة موسى عليه السلام وكان محمد صلى الله عليه وسلم حسن الصورة والقامة، كأن وجهه القمر بأبي هو وأمي.
{وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ }: في ذلك إشارة إلى الفصاحة، وهي بحد ذاتها معنى جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُوصف بأنه أُوتي جوامع الكَلِم، وأفصح مَن نطق بالضاد، وقال موسى عن هارون عليهما السلام: {هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي } [القصص: 34].
في كلام هؤلاء المنافقين كثير من التقعر والتفيهق والتكلُّف وزخرفة القول دون طائل، وأنت تجد خطيبًا أو شاعرًا يحسن الكلام والتصريف، وليس من وراء كلامه معنى، ولو كانت الفصاحة لنصرة الحق وهداية الناس أو للمعاني الجميلة لكانت محمودة.
{كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ }: و{خُشُبٌ } بضم الخاء والشين، جمع: خشبة.
وفي قراءة: (خَشَبٌ) بفتحتين. فوصفهم الله بحسن الصُّور، وإبانة النُّطق، ثم أعلم أنهم في ترك التفهم والاستبصار بمنزلة الخُشُب.
و{مُّسَنَّدَةٌ }: ممالة إلى الجدار، فهم لا يسمعون الهُدى، ولا يقبلونه، كما لا تسمعه الخشب المسندة.
ولو كانت هذه الخشب في الأشجار لكانت حية مخضرَّة نامية ينتفع بها، ولو كانت مما يستفاد منه في البناء أو الإيقاد فكذلك، لكنها مسنَّدة مركونة على جدار تضر ولا تنفع، ولا يستفاد من طولها وعرضها وكثرتها إلا شغل المكان وتعويق الطريق!
ويحتمل أن يكون شبَّههم بالخشب عند ما يكونون في ناديهم أو مجلسهم، وكل واحد منهم في زاوية وقد اتَّكأ على الجدار يقول الزور ويغشى الفجور.
لقد خسر المنافقون نبيل الصفات الإنسانية، وهي الصدق، والصدق محمدة حتى عند عرب الجاهلية، إذ كانوا يستقبحون الكذب، وفي قصة غَوْرث بن الحارث أنه قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: مَن يمنعك مني؟ قال: «الله». فسقط السيفُ من يده، فأخذه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَن يمنعك مني؟». قال: كن كخير آخذ، قال: «أتشهدُ أن لا إله إلا الله؟». قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلَّى سبيله.
فهذا مع جهله لم يحقن دمه بالكذب، ولا اتخذ إيمانه جُنَّة؛ لأن فيه كرامة الإنسان وصدقه ووضوحه.
{يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ }: كلما سمعوا صائحًا في المدينة لا يعرفون مصدره ظنوا أنهم المستهدَفون المقصودون، وأنه ينادي لمحاربتهم؛ لأنهم أصحاب مكائد ومؤامرات ودسائس، اجتمع لهم خبث نواياهم وقبح أعمالهم وإضمارهم العداوة والحقد والبغضاء للمؤمنين، وفي كل لحظة يتوقعون أنهم افتضحوا وبانت حقيقتهم، فلذا يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا من خورهم وجبنهم.
{هُمُ الْعَدُوُّ }: إشارة إلى شدة عداوتهم، وكأنه لا عدوّ غيرهم، كما قيل:
فمنهم عدوٌّ كاشرٌ عن عدائه * ومنهم عدوٌّ في ثياب الأصادقِ
ومنهم قريبٌ أعظمُ الخَطْب قربُه * له فيكم فعلُ العدوِّ المفارقِ
أردتم رضا الرحمن قلبًا وقالبًا * ولم يطلبوا إلا حقيرَ الدوانقِ
فسدَّد في درب الجهاد خطاكُمُ * وجنَّبكم فيه خفيَّ المزالقِ
وخصَّهم بذلك؛ لتلبسهم ومخالطتهم المؤمنين بالمدينة، واطلاعهم على عورات المسلمين، {فَاحْذَرْهُمْ }: ونلحظ هنا أن الله لم يقل: «فاقتلهم»، أو: «فانفهم من الأرض»، وإنما أمره بالحذر، وهذا أصل عظيم في التعامل مع المنافقين، فقد كانوا يُصلُّون مع المسلمين ويصومون، وقد يقع لبعضهم الخروج للجهاد، وكانوا يُعاتَبون على القعود عن الجهاد، كما في قصة تبوك: {وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ } [التوبة: 90]، وجاءوا واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم عذرهم.
وليتنا نعامل بعضنا بعضًا مثلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، ففي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، أنه لما جاء المنافقون واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ منهم علانيتهم وكفَّ عنهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله.
وإن استغفرت لأخيك المسلم فبها ونعمت، وإن لم تستغفر فهذا شأنك، يكفي أنك تكف عنه شرَّك، ولا تفسِّر أعماله تفسيرًا سيِّئًا، وأوكلت سريرته إلى الله.
إن المنافقين تنظيم سري متآمر متغلغل في الأمة وعدو لها، وهذا يقتضي الحذر والتيقظ، وبخاصة أنهم من البيئة نفسها ويتكلمون اللغة ذاتها، وينتمون إلى المكونات عينها، ويتظاهرون بأنهم من الطينة نفسها، وربما زادوا وزايدوا وحاولوا هدم الإسلام باسم حمايته والغيرة عليه.
{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُون }: وهذه صيغة دعاء تستعمل حتى مع مَن يخطئ، فيقال: قاتل الله فلانًا، كيف فعل كذا، أو قال كذا!
ويجوز أن يكون المعنى: أن الله تعالى هو الذي يتولَّى قتالهم ويحبط مخططاتهم، ولم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قاتلهم.
وهذا يلقي مزيدًا من الضوء على قوله تعالى في الآية الأخرى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ } [التحريم: 9].
إن مجاهدة المنافقين تختلف عن مجاهدة الكفار، وليس قتالهم موكولًا إلى الناس.
ثم تعجب منهم كيف يصدفون عن الحق على رغم وضوحه وبيانه، وأنهم يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، فقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وخالطوا المسلمين ورأوا العبر والآيات، ولكن السبب هو ما سبق من الطبع على قلوبهم، لمَّا صدوا وأعرضوا.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: