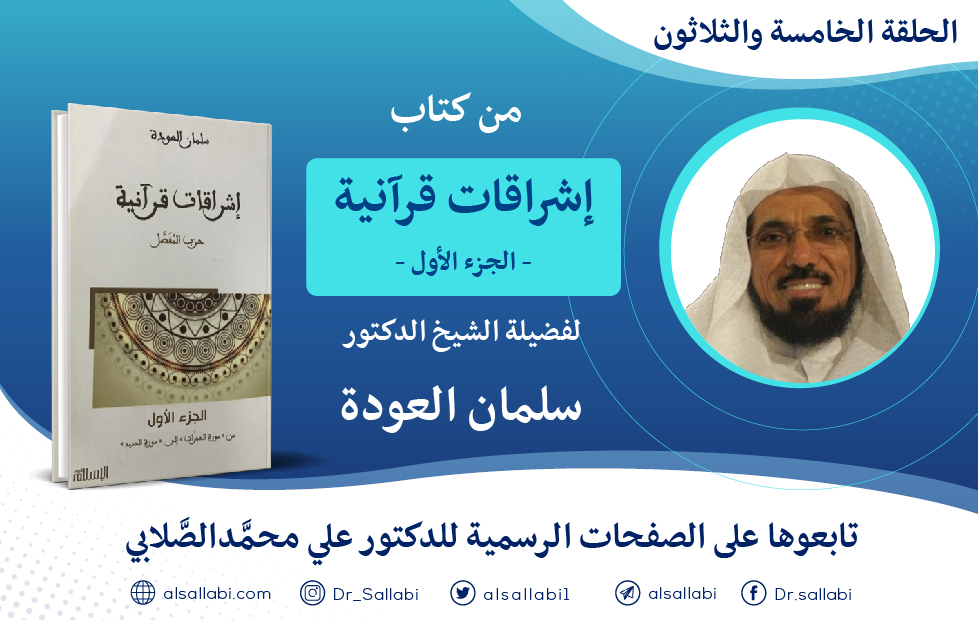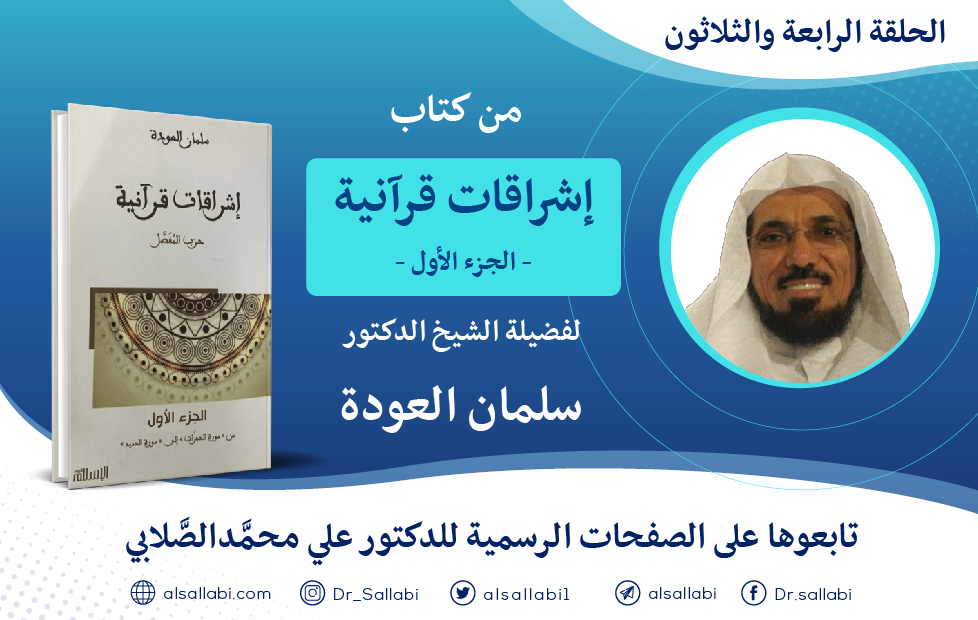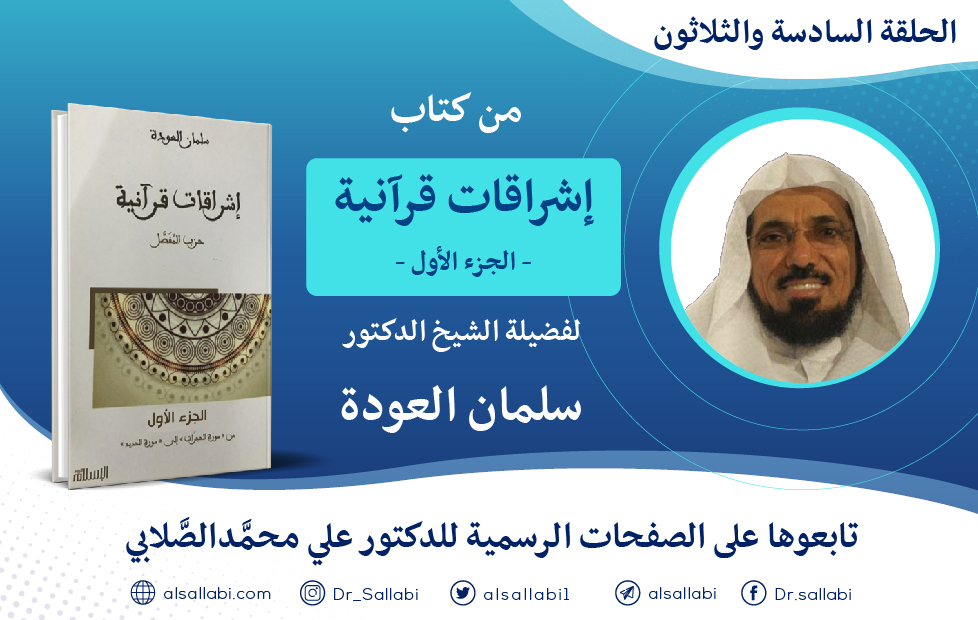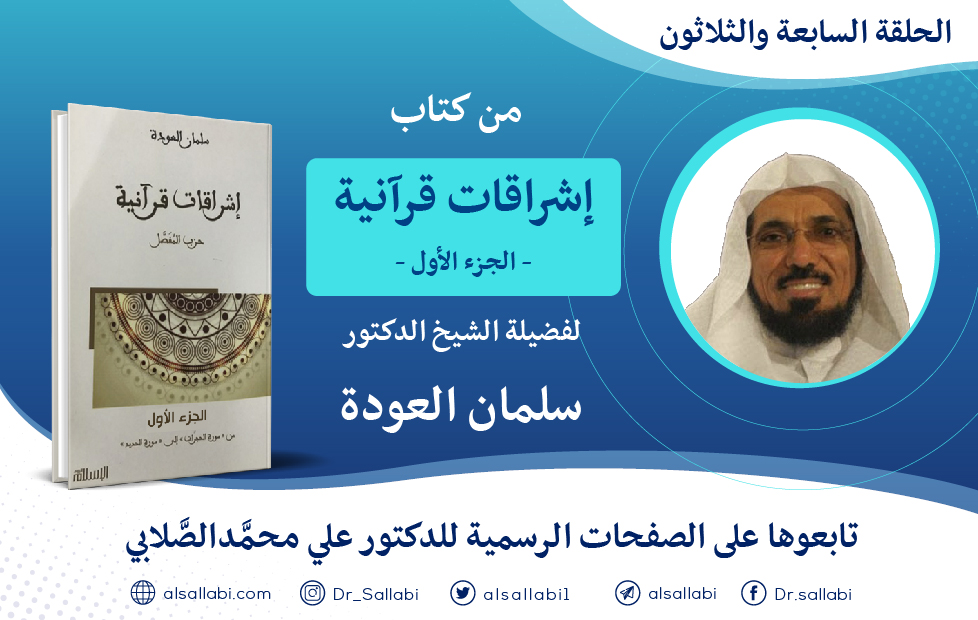من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الصف)
الحلقة الخامسة والثلاثون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ ديسمبر 2020
* {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإِسْلاَمِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين }:
أي: لا أحد أشدُّ ظلمًا من هذا، ويحتمل أن يكون المقصود: كفار العرب الذين كذَّبُوا وحي الله سبحانه، وقالوا: {مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ } [الأنعام: 91]، وهم يُدْعَون إلى الإسلام.
والأقرب أن المقصود: أهل الكتاب؛ وذلك لسياق الآية أولًا، وأنه في قوم عيسى، وثانيًا: لأنهم الأقرب أن يقال عنهم: إنهم افتروا على الله الكذب؛ لأنهم أهل كتاب، وتمكنهم من الكتاب يجعلهم يحاولون أن يلتمسوا من كتابهم ما يدفعون به الحقَّ، ويردُّون به الصواب، ويخدعون به دَهْماء الناس، ولذا كذَّبُوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يُدعون إلى الإيمان بها.
{وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين }: وخَتْم الآية بهذا مناسب؛ لأنهم بَلَغُوا في الظلم مبلغه؛ إذ ظلموا عقول الناس وحالوا بينهم وبين الإيمان والهدى، وحَرَّفُوا الدين السماوي، وأدخلوا عليه المفاهيم الفلسفية الفاسدة المتناقضة، وتجاهلوا تعليمات الكتب المقدسة الحقيقية.
* {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون }:
{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ }: اللام هنا للتوكيد، وأي شيء يريدون إطفاءه؟ إنه نور الله! وهل شيء أعظم من نور الله؟ {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ } [النور: 35]، فمن نور الله سبحانه ما خلقه من الأنوار في الكون، كالشمس والقمر، ومَن ذا الذي يستطيع أن يطفئ نور الشمس؟ إنه لأمر مثير للسخرية، وبماذا يحاولون إطفاءه.. بأفواههم! فإذا كان هذا نور الشمس، فكيف بنور الحقِّ ونور الوحي ونور الإيمان؟!
وتأمَّل منذ أن بعث اللهُ نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كم من المكائد والمؤامرات والعداوات عادى بها الكفار أجمعون الإسلام، فما زاده ذلك إلا انتشارًا وقوةً وظهورًا، فالحمد لله ربِّ العالمين.
{وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ } فهو نور تام كامل وسيظل كذلك، وفيها معنى الغلبة والنصر وتحقيق المقاصد الربَّانية للبعثة المحمدية ولا بدَّ.
{وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون }: وكأن الحديث هنا عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالغالب أنهم يُوصفون بالكفر، في حين وصف غيرهم بالشِّرك.
* {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون }:
الهُدى: القرآن، ودين الحقِّ: الإسلام.
وقيل: الهُدى: العلم النافع، ودين الحقِّ: العمل الصالح، فأرسله الله سبحانه بالعلم والعمل.
{لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون }: أي: ليعليه وينصره على سائر الأديان، ولو كرهوا ظهور الإسلام.
والظُّهور له معنيان:
الأول: ظهور القوة والحجة، والبيان والبلاغة، والرسالة والدعوة، والتربية والتعليم، وهذا بيِّنٌ.
والثاني: ظهور الغلبة والسلطان، وقد تحقَّق قدر كبير منه؛ لكن لا يلزم من هذا الوعد أن يتحقَّق بكماله في كل وقت؛ لأن هذا خلاف مقتضى الحكمة والابتلاء، وخلاف مقتضى السنة الإلهية في ابتلاء بعض الناس ببعض، وأن الدهر دُوَل، وأن النصر والهزيمة، والقوة والضعف، والكثرة والقلة؛ بل والتمدن والحضارة، والتخلُّف والجهل تنتقل وتتأثر بظروف ومعطيات كثيرة، وأن الله امتحن الناس بالعمل والتخطيط والدأب ليحصلوا على النتائج، وتوعدهم إن هم فرَّطوا أو قصَّروا بأن يروا عاقبة ذلك عيانًا.
وهذا الوعد الإلهي محفّز للمسلمين لتحقيقه، ومعنى أنه سيظهره على الدين كله: أن الأديان المشار إليها ستكون موجودة ولن تندرس؛ بل ستبقى، ولكن سيظهر الإسلام عليها بالقوة وبالغلبة وبالحجة، وهذا بواسطة مَن يُسخِّرُهم الله تعالى من المؤمنين، ففيه حفز للمؤمنين أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله تعالى، وفي التأثير على الناس.
وكم يشعر المرء بالأَسَى في هذا العصر أنه لم يكن المسلمون على مستوى المسؤولية في إظهار دينهم، وفي إظهار صور قوته وبلاغته، وإعجازه وتأثيره، لا في قولهم ولا في فعلهم، فعلى صعيد السلوك والممارسة والواقع الاجتماعي تجد في المجتمعات الإسلامية ألوانًا من الضعف والخلل الأخلاقي، ونقصًا في الانضباط والذوق، ربما تَفُوقهم كثيرٌ من أمم الأرض، حتى إن بعض الذين أسلموا من الغربيين إذا جاؤوا إلى البلاد العربية والإسلامية حمدوا الله أنهم أسلموا قبل أن يروا واقع المسلمين في بلادهم.
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم }:
كأنه ذكر التجارة هنا؛ لأن بعض المسلمين صدَّتهم التجارة عن الجهاد في سبيل الله، فذكر تعالى لهم الأفضل والأبقى والأربح؛ وهو الإيمان والجهاد.
واستخدم أسلوب العرض والاستفهام بـ{هَلْ }.. وكأنه يقول: أنتم تبحثون عن الأرباح الطائلة، وهذا الله يعرض عليكم أن يرشدكم إلى ما هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
{تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم }: وفي ذلك إشارة إلى أن كثيرًا من التجارات الدنيوية تكون سببًا في العذاب الأليم يوم القيامة؛ فإن من الناس مَن يكون ماله عذابًا ووبالًا عليه، وشغلًا له عن الفرائض وطاعة الله.
وكما ذكر الله تعالى عن عدد من أهل الكتاب وغيرهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؛ فأشار عليهم ربهم الذي يحبهم بالتجارة الرابحة الطيبة المباركة التي تُنجي من العذاب الأليم؛ وهي الإيمان بالله ورسوله.
* {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون }:
{تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ }، ولا يصلح عمل إلا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
{وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ }، فالجهاد بالمال بصرفه في مجالات الخير كلها.
وقدَّم المال؛ لأنه أول مصرف وقت التجهيز، وأن به قِوام الأنفس وحمايتها، ولنفاسته ولعزَّته في ذلك الزمان.
وقيل: للترقِّي من الأدنى إلى الأعلى.
والجهاد بالنفس هو: أن يبذل الإنسان نفسه في ذات الله عز وجل، بالجهاد الأعظم الذي هو مقاتلة الأعداء، أو بما دون ذلك من ألوان بذل النفس في ذات الله عز وجل، وألوان الكرم والجود التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون من أصحابه، ومن ذلك تحمُّل العنت والأذى في سبيل الله بصبر وطيب نفس واحتساب، دون أن يقول الإنسان: كيف يصيبني هذا وأنا معي الحق؟ لماذا لم يدفع الله عني؟
{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون } أي: خير لكم مما أنتم متشاغلون به.
* والدليل على أنه خير لكم نتيجة ذلك: {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم }:
وكأنه ذكر المساكن والجنات إشارة إلى أن كثيرًا من الناس تحرمهم أعمال الخير والدعوة والجهاد وخدمة الناس والإحسان إلى الخلق من الاشتغال بالتجارة، أو من طول المكث والبقاء في بيوتهم ومساكنهم، في حين أن غيرهم يملكون بيوتًا مرفَّهة جميلة، فالمؤمنون حُرموا من هذا الترفه، أو من بعضه، أو لم يستقر بهم مقام بين أهليهم بسبب تبعات العمل والدعوة والتعليم والإحسان والإصلاح، وما يترتب على معاناة ذلك من السفر والغربة والحبس والانشغال بأحوال الناس، لكنهم عُوِّضوا بسعادة صدورهم، وبالعطاء الذي يجدونه مضاعفًا يوم القيامة.
* {وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين }:
{وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا } أي: شيء مما جُبلت النفوس على محبته، والنفس مُولعة بحبِّ العاجل.
فما هذه العِدَةُ الأخرى؟ إنها {نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ }: قيل: فتح مكة. وقيل: فتح بلاد فارس والروم.
واللفظ شامل لذلك كله، ومن أوله فتح مكة؛ لأن السورة- والله أعلم- نزلت قبل فتح مكة بسنة أو سنتين؛ فتحقق بدء النصر والفتح في حياته صلى الله عليه وسلم بدينونة الجزيرة العربية له، ووضع الأساس لهذه الدولة الفتيَّة العظيمة.
ووصف «الفتح» بأنه قريب، أما «النصر» فهو عام، وهكذا يمكن أن يكون كما في «سورة {إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح }»، فيكون مؤذنًا بفتح مكة، ويحتمل أن يكون «الفتح» فتح مكة، وهو قريب تحقَّق قبل موته صلى الله عليه وسلم، أما النصر فما جرى بعد ذلك من انتصارات الدولة الإسلامية.
{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين }: وهذا من إعجاز القرآن، فإن إسلام العرب، وفتح مكة، والنصر، ودخول الناس في دين الله أفواجًا كله من الغيب الذي وقع، كما أخبر به سبحانه.
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِين }:
هذا النداء دعوة صريحة للمؤمنين من هذه الأمة أن يجعلوا شعارهم نصرة الله، بنصرة دينه وشريعته وأمته، وليس نصرة شخص أو طائفة أو جماعة أو أسرة أو دولة أو نِحْلة...
ثم ذكَّرهم بقول عيسى عليه السلام للحواريين: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ }.
والحواريون هم: أصحاب عيسى عليه السلام، وكانوا اثني عشر رجلًا.
والكلمة حبشية. وقيل: هي عربية، من: الحَوَر؛ وهو شدة البياض، وقد كانوا شديدي بياض الثياب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بالاعتناء بنظافة الثياب، وكان عمر رضي الله عنه يعجبه من القارئ والطالب أن يكون حسن الثياب، طيب الرائحة.
وعيسى عليه السلام قال لهم ولغيرهم هذا القول: مَن الذين سوف يكونون أنصارًا لي في طريقي إلى الله وفي سعيي إلى نصرة الله وإقامة دينه؟
{قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ }، وأجابوا عيسى عليه السلام إلى ذلك.
ويلحظ هنا اختلاف الصيغة والتركيب، فعيسى عليه السلام قال: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ }؟ فأضاف النصرة إليه، لكنها ليست نصرةً لشخصه؛ لأنه فلان، ولكن لأنه يدعوهم إلى الله، والفارق واضح بين الصيغتين؛ فالصيغة العيسوية تناسب بني إسرائيل، بل النخبة المختارة منهم: الحواريين، والذين التزموا بالنصرة، ومع ذلك وجد من بعضهم التردد والتساؤل.
أو أن تلك الصيغة تناسب بعثة عيسى إليهم خاصة في زمان محدود، فكان وجود النبي بينهم من أهم ضمانات الاستمرار على الحق وعدم النكوص، وكأن الحواريين بقولهم: {نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ } أظهروا تجردًا تامًّا وديمومةً على النصرة أكثر مما في مكنتهم وطاقتهم، والله أعلم.
أما {كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ }، فلهذه الأمة التي يقوم وجودها أصلًا على الارتباط بمنهج الله وحده، سواءً وجد الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم أم لم يوجد، فهي أمة خاتمة وليست مؤقتة، ولهذا خُوطبت بمثل قوله سبحانه: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ } [آل عمران: 144].
كما أن دعوته صلى الله عليه وسلم لم تكن خاصةً محصورةً في فريق أو قبيل أو جنس، بل هي دعوة للعالمين، ولذا فالإيمان والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ». وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضًا: «الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة: الأجرُ والمغنمُ».
ومثله حديث: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحقِّ، لا يضرُّهم مَن خذلهم، حتى يأتيَ أمرُ الله وهم كذلكَ». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
لذا نُوديت الأمة أن تربط نصرتها بالله لا بغيره، علمًا بأن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصرة لله، ونصرة للمؤمنين كذلك، ولكن الملمح المهم هو عدم ربط النصرة بوضع معين، بل هي نصرة باقية ما بقي الليل والنهار، وأنه في حال القوة والضعف والغنى والفقر والكثرة والقلة والعزة والذلة، و{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}.
ولكل قوم أئمة وسادة، ولكن هؤلاء الأئمة إنما يستحقون هذا اللقب الشريف بالتزامهم المنهج وصدقهم مع الله ورسوله، فإذا فرَّطوا أو قصَّروا حُرموا منه، واستبدل بهم غيرهم، وهذا لا يحدث إلا في أمة واعية يقظة حية، لا تبني دينها على التقليد والتبعية والهوى الأعمى، وإنما تبني دينها على العلم والهدى والنص والدليل، فهي ليست قطيعًا يُساق دون وعي لا يدري من أمره شيئًا إلا الثقة العمياء بمَن ينعق به، كلا إنها الأمة التي نُوديت بأن تنصر الله وحده، ونصرتها لمَن دونه إنما هي مشروطة بأن يكونوا من أنصار الله، فمتى أخلُّوا بهذه النصرة لم يكونوا جديرين بأن يُتَّبعوا أو يُقتدى بهم.
إن الله تعالى حين قرَّر قانون الانتصار الراسخ العظيم، أبرز فيه هذا المعنى بقوله: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز }.
وكل أحد من فرد أو جماعة أو حزب قد يدَّعى نصرة الله ونصرة دينه، وأنه ما قام بذلك طمعًا ولا منافسة، ولذلك كان التعقيب الرباني لتحديد مَن هم الذين ينصرون الله؟ هل هم المدَّعون؟
كلا، إنهم {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُور }.
وأنت تلحظ جيدًا أن الله تعالى أعطاهم صفات لا تبين إلا في المستقبل {إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ } وكم من مدَّعٍ ينكث وعده ويتخلَّى عن عهده وينهمك في دنياه.
إن الكثيرين ينساقون مع الأحلام الوردية الجميلة، ويرسمون المستقبل بريشة مبدعة خيالية خالية من المآخذ، لكن حين يصبح هذا المستقبل واقعًا مشهودًا، وليس حُلمًا منشودًا، تتغير المعالم وتختلف القلوب وتتحرك المطامع، ويصبح الجمع شتيتًا، وتبدأ التُّهم.
إن الصيغة لم تُربط لنصر بالذين يعدون أنهم سيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكن بالذين علم الله من حالهم المستقبلي أنهم إن مُكِّنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
{فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ }، بعضهم آمن بعيسى، وبعضهم كفر، {فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ }: أيدهم بالحجة، وبالتوفيق، وبالقدر، {فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِين }: ظاهرين بالحجة منصورين.
هذا متناسب مع الإشارة إلى ظهور الإسلام، {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون }، {وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون }، ومتناسب مع قوله سبحانه في أول السورة: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم }، فهو أظهر أولياءه ونصرهم وأيَّدهم ولو كانوا قليلًا، و {كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِين } [البقرة: 249].
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: