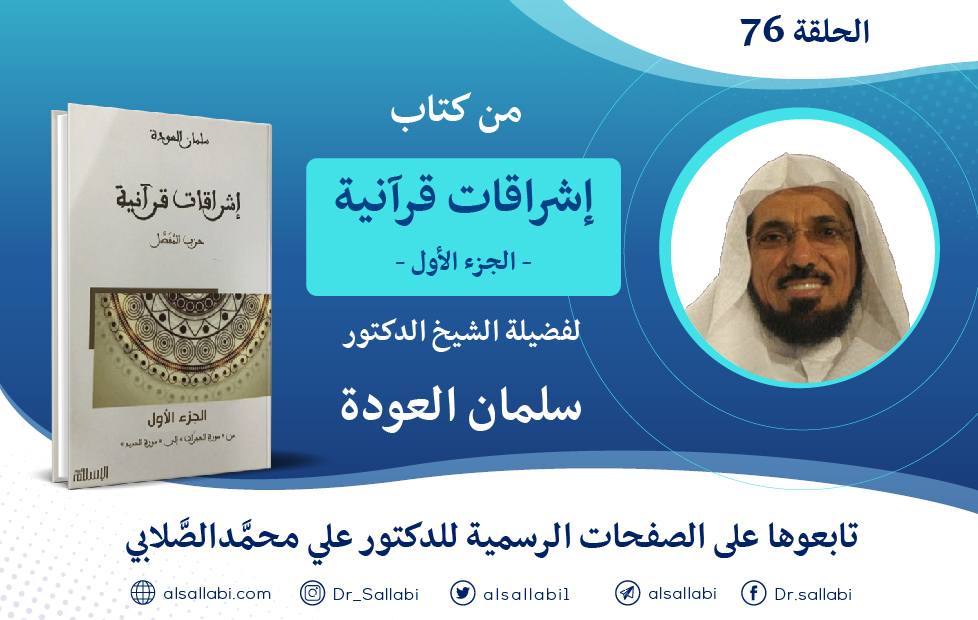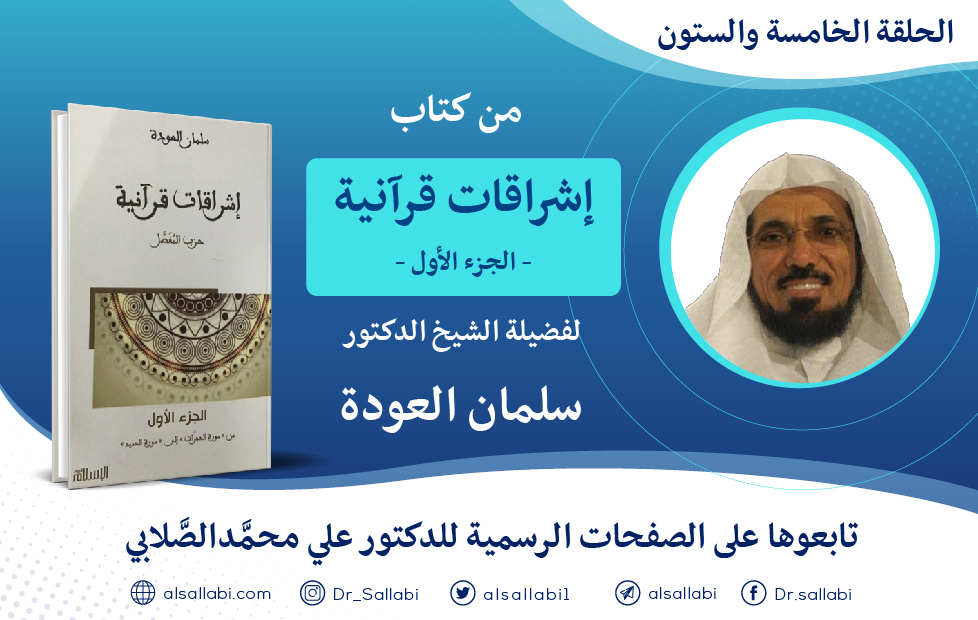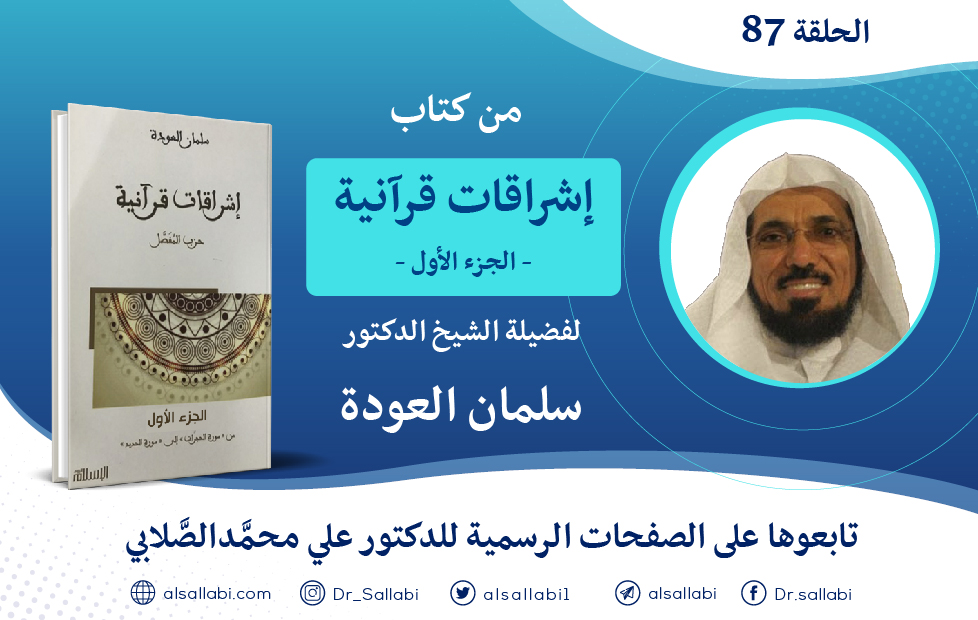*من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان: (سورة الجن)*
الحلقة: السابعة والسبعون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الآخر 1442 هــ/ فبراير 2021
{وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا}: الملتحد: الملجأ، ومنه اللَّحْد، وهو القبر الذي يهرب إليه الإنسان.
والمعنى: ليس ثمة أحد يجيرني من الله، ولا مكان أختبئ فيه، وكل شيء في قبضته وقدرته، والله تعالى يأمر نبيه أن يبيِّن للناس هذه الحقيقة، ومن قبل كان الجنُّ يقولون في حديثهم: {وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا}.
* {إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}:
{إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ} أي: لا شيء ينفعني ويحميني، إلا أن أُبلغ رسالات ربي، فقوله: {إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللَّهِ} أي: عن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بلِّغُوا عنِّي، ولو آيةً».
{وَرِسَالاَتِهِ} أي: بلاغ رسالاته، بمعنى أن يُبلِّغ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رسالات ربه بنصوصها وحروفها؛ ولهذا قال له ربه: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، فالله يعصمك من الناس، والناس لا يعصمونك من الله، ولن يجيرك من الله أحد، ولن تجد من دونه ملتحدًا إلا بالبلاغ، فإذا بلَّغت فلا يضرك هؤلاء الذين كادوا يكونون عليك لبدًا، فالله يحميك منهم ويصرف عنك كيدهم.
{وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}: ومن المعصية: رفض التبليغ عن الله، ورفض رسالته ودعوته أصلًا، ولعله المقصود هنا بقرينة السياق، وبضميمة ما بعده.
وليس المقصود مطلق المعصية؛ فإنما يُتوعد بالخلود الأبدي في نار جهنم الكفار الذين ردُّوا دعوة الرسل والأنبياء، وأصرُّوا على الكفر والشرك، وأما عصاة المؤمنين ممن يقع منهم ما يقع من الذنوب أو الكبائر التي هي دون الشرك، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48]، وهذا متواتر في النصوص، وظاهر في سياقات القرآن الكريم والسنة النبوية، وعليه إجماع الأمة.
* {حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا}:
{حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ}: لم يحدِّد السياق ما الذي يوعدون، بل ترك المعنى مفتوحًا، فهل هو ما يوعدون من الخيبة والهزيمة في الدنيا، كما حصل لهم يوم بدر؟ أو هو ما يوعدون عند النَّزْع والاحتضار؟ أو هو ما يوعدون في الدار الآخرة؟ أو هو كل ذلك؟
وقد كانوا دائمًا يتعزَّزون بعددهم وقوّتهم، أو بأنصارهم وحلفائهم، فالله سبحانه يؤكِّد لهم: {فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا}.
ولم يبيِّن مَن هو «الأضعف»، ومعروف من السياق أن المشركين الظالمين سيكونون هم الأضعف ناصرًا والأقل عددًا، كما قال سبحانه: {فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِر} [الطارق: 10].
والناصر: الحليف أو المعين المساعد، فسيكون ضعيفًا، وهي إشارة تعني أن لا ناصر لهم مطلقًا، كما في آية «سورة الطارق»، حتى الشيطان يتبرأ منهم في ذلك الموقف، ويتبرأ بعضهم من بعض، ويتخلَّى القوي عن الضعيف، والضعيف عن القوي.
أما الأقل عددًا، فالمقصود عديدهم الذاتي، فهم كانوا يقولون: {نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِر} [القمر: 44]، أي: عدد كبير مجتمعون، غالبون فائزون، مستنصرون بحلفائنا وأعواننا.
* {قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا }:
وهذا من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لهم أنه لا يدري: أقريب ما يوعدون أم لا؟! فـ{إِنْ } هنا نافية.
{أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا } أي: مسافة طويلة، والأَمَد مقابل القريب، أي: أمدًا طويلًا أو بعيدًا، كما حكى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ } [الأحقاف: 9]، وفي الآيات الأخرى: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب } [الشورى: 17]، {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا } [الأحزاب: 63]، {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ } [القمر: 1]، {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ } [الأنبياء: 1]، فهذه كلها سياقات يُعزِّز بعضها بعضًا، ويوضِّح بعضها بعضًا، وكل سياق منها يُحمل على المناسب له، يكون المقصود النظر إلى مقاييسهم هم، فقد كانوا يستبعدون هذه الأشياء، ولو وُعدوا بها في الآخرة لرأوا أن الآخرة شأنها بعيد وأنها مؤجَّلة؛ ولهذا لا يهمهم كثيرًا أن يوعدوا بشيء في الآخرة في وقت كفرهم.
ولذا جعل الأمر محتملًا؛ فقد يصيبكم شيء قريب، وقد يكون مفاجئًا، كما في يوم بدر وما بعده، وفيه إظهار البراءة من هذا الأمر، وأنه إلى الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة محارَب مطارَد مؤذَى، وأصحابه يُقتلون ويُعذَّبون، ومع ذلك ينزل عليه صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، فيعلم أنه لا يُنجِّيه إلا البلاغ عن الله وتبليغ رسالاته، فيبلِّغ هذا الوحي كما أُنزل إليه، مهما كانت الوقائع، ومن ذلك أن يقول: {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا }، ويقول: {قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا }، ويقول: {قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }، ويقول: {إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ }.
فحين يعلن أنه لا يدري إن كان موعودهم قريبًا أم بعيدًا كما هنا، وكما في قوله: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُون } [الأنبياء: 109]، فقد يكون المقصود: أجل كل فرد منهم بعينه؛ لأنهم يستعجلون العقاب العام، فأشار إلى أن كل فرد منهم له أجله المضروب، فإذا جاء أجله قامت قيامته.
وهذا أولى من القول بأنه لم يكن يدري ثم تجدَّدت له المعرفة بذلك فيما بعد، والله أعلم.
والمهم أن الله يلقِّنه لفظ: «لا أدري» كما ألهم الجنَّ أن يقولوا: {لاَ نَدْرِي }، وهو درس بليغ لكل داعية وكل متعلِّم أَلَّا يستحي من قول: «لا أدري»، ولا يظنَّ أن جاهه ينكسر أو مكانته تتراجع، أو أن أتباعه ينتقصونه، و«مَن ترك لا أدري أصيبت مَقَاتِلُهُ».
وتكرر لفظ {رَبِّي }؛ إشارة إلى إن الله تعالى يحفظه، وهو الذي يحميه وينجيه وينصر دعوته، وهو الذي يجيره، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: «اللهمَّ أعوذُ برضاك من سخطكَ، وبمعافاتكَ من عقوبتكَ، وأعوذُ بك منكَ، لا أحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك».
فما دام الله حافظه وحاميه، فلا يبالي ما وراء ذلك، ولو اجتمع الناس عليه.
* {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا }:
أي: هو وحده {عَالِمُ الْغَيْبِ }، فلا يعلم الغيب إلا هو.
و{الْغَيْبِ } هو ما يقابل الشهادة، {وَالشَّهَادَةِ } هي: ما تراه العيون أو تحسه الحواس، و{الْغَيْبِ} ما وراء الحس، سواءً كان من عالم الآخرة، أو كان من عالم الملائكة، أو كان ماضيًا مما لا يعلمه الناس... أو نحو ذلك مما لا سبيل للناس إلى معرفته بوسائل المعرفة التي منحهم الله.
{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا }، وهذا له علاقة باستراق الجنِّ للسمع، والكهنة والعرَّافين الذين كانوا يأخذون «الكلمة» ويضيفون إليها مئة كذبة.
فهو وحده الذي يعلم الأجل المضروب لكم، وهل هو قريب أو بعيد؟
* {إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا }:
{إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ }: استثناء، فهو يستثني الرُّسل الذين ارتضاهم الله، وفي ذلك إشارة إلى أن الرُّسل إنما كانوا لأن الله ارتضاهم واختارهم واصطفاهم، ويشمل ذلك الرسول البشري؛ كالأنبياء عليهم السلام، والرسول الملائكي الذي ينزل بالوحي؛ كجبريل عليه السلام، فهؤلاء ارتضاهم الله تعالى وأطلعهم على شيء من غيبه، وهناك من {الْغَيْبِ } ما لا يعلمه إلا الله.
والأَوْلَى أخذ الآية بعمومها، خلافًا لما مال إليه الفخر الرازي، فإنه ذكر أن المقصود بقوله: {فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا } أي: الساعة. واحتج بأن من الناس من قد يعلم شيئًا من الغيب.
وهذا غلط؛ فهذه من الآيات التي يجب أن تُؤخذ على عمومها وإطلاقها، إلا في المقامات التي ورد فيها الاستثناء.
{فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا } أي: أن هذا الرسول البشري أو الملائكي سوف يحيطه الله بحرس من أمامه ومن خلفه أشداء أقوياء أن ينالهم أحد بشيء.
ومن ذلك أن الله إذا أراد أن يُظْهِر أحدًا منهم على شيء من غيبه بالمعاينة، جعل معه {رَصَدًا} أمامه وخلفه، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج.
ومن ذلك أن الله حين يختار ويرتضي أحدًا ليكون رسولًا، فإنه يجعل عليه حَفَظَةً وحَرَسًا يحمونه لأداء المهمة التي أُنيطت به.
* {لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا }:
من الإعجاز أنه لم يذكر مَن هو الفاعل الذي يُراد أن يعلم، وفي بعض القراءات: {لِّيُعۡلَمَ} بضم الياء؛ فيشمل كل مَن يصح أن يُسند إليه الفعل، فيصدق هذا الكلام على الله سبحانه وتعالى: ليعلم الله عز وجل، وهو العالم، ولكن ليتحقَّق علمه بواقع الحياة، وهذا كثير في القرآن، كما في قوله سبحانه: {وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا} [آل عمران: 166-167] ، فالله تعالى يعلم كل شيء، لكن ليتحقَّق علمه في الأرض.
وليعلم الرسل {أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ }، فالنبيُّ محمد صلى الله عليه وسلم لما يرى الملائكة والرَّصَد يدري أنه هو المختار، وأنهم قد أُرسلوا إليه دون غيره، وأُرسلوا بهذا، فالأمر فيه ضبط وتوثيق وإحكام، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وكذلك ليعلم الرَّصَدُ بأن الرسل قد بلَّغوا رسالات ربهم، وكأنهم شهود على الأداء يوافون بشهادتهم يوم القيامة.
{وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ } أي: الله تعالى، فإنه {بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيط } [فصلت: 54].
فالوحي محاط بسِياج، لا يقتحمه إلا مَن شاء الله، وفي حدود معينة، أما ما يتعلَّق بما يمكن معرفته بالوسائل الطبيعية؛ كالفهم أو القياس أو الإدراك، أو بالوسائل الروحية؛ كالرُّؤْيا الصالحة والتفرُّس، فهذا ممكن، وهو باب آخر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم عَدَّ الرُّؤْيا من المبشِّرات ومما بقي من آثار النبوة.
لكن هذه لا يُقطع بها، وإنما هي من باب التوقع والالتماس، وكذلك الإلهام والتحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم: «قد كان في الأمم قبلكم محدَّثُونَ؛ فإن يكن في أمتي منهم أحدٌ، فإن عمرَ بنَ الخطاب منهم».
فقد يقع لأحد أن يظنَّ الشيء فيكون كما ظنَّ وتوقَّع، كما حدث لعمر رضي الله عنه، وهو يَحْدُث لأصناف من الناس، وقد يقع هذا بسبب فرط الذكاء، وشدة الخبرة، وحِدَّة العقل والتجربة، فالإنسان ربما يتوقع بعض الأشياء توقعًا يقرب من اليقين، وهذا كله ليس من الاطلاع على علم الغيب؛ فإن الغيب لا يعلمه إلا الله أو مَن أطلعه الله تعالى على شيء منه لحكمة يعلمها.
{وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا } والإحصاء متصل بالعدد، كما قال سبحانه: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا } [الكهف: 49]، وقال: {لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 94- 95].
فقررت الآية شمول العلم الإلهي، وإحاطته بكل شيء، وإحصاءه كل شيء، وهل يمكن أن يقال- أخذًا بظاهر الآية-: إن الماديات كلها عبارة عن أعداد؟ الله أعلم.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: