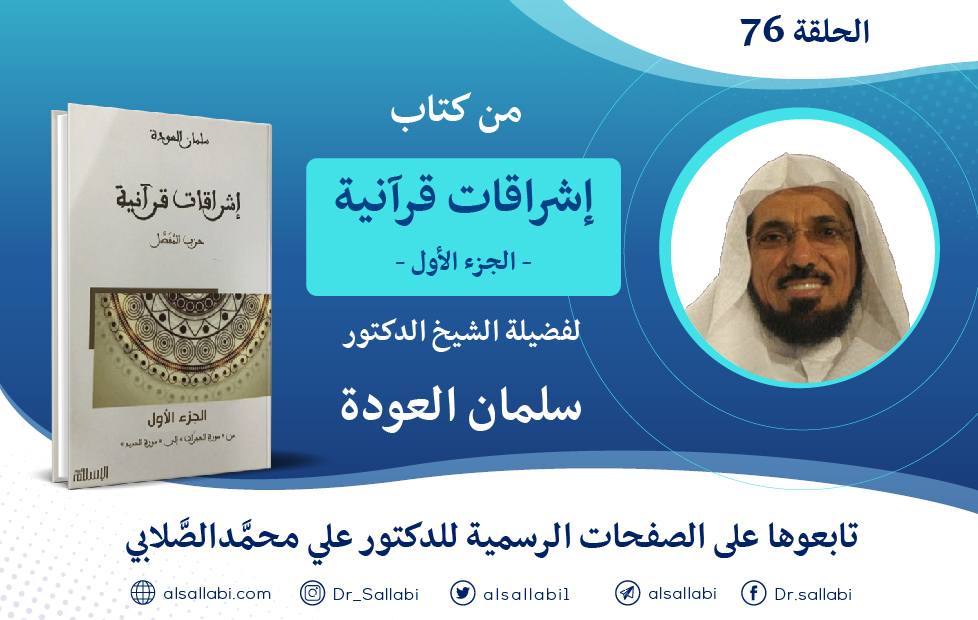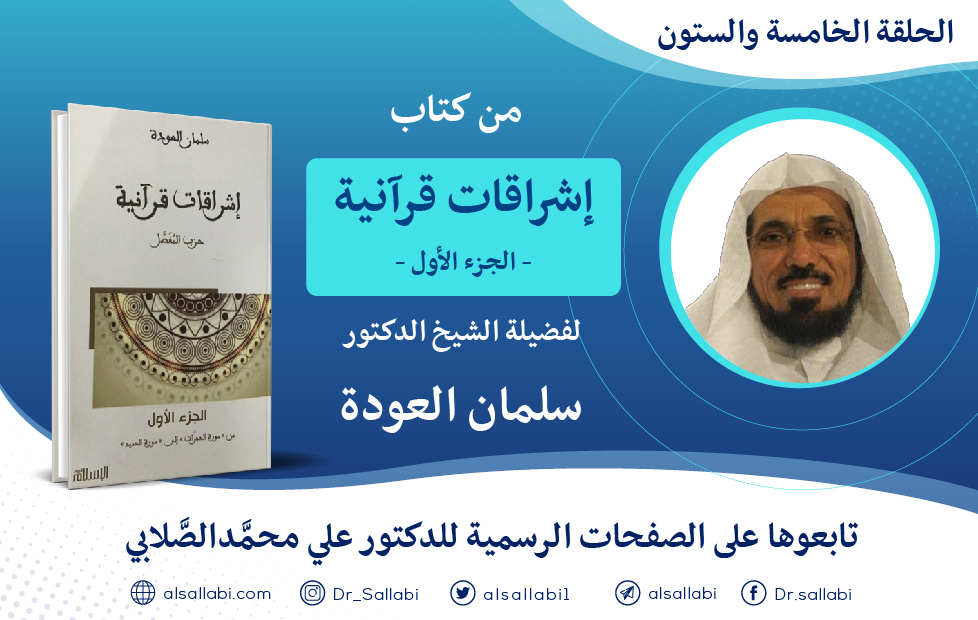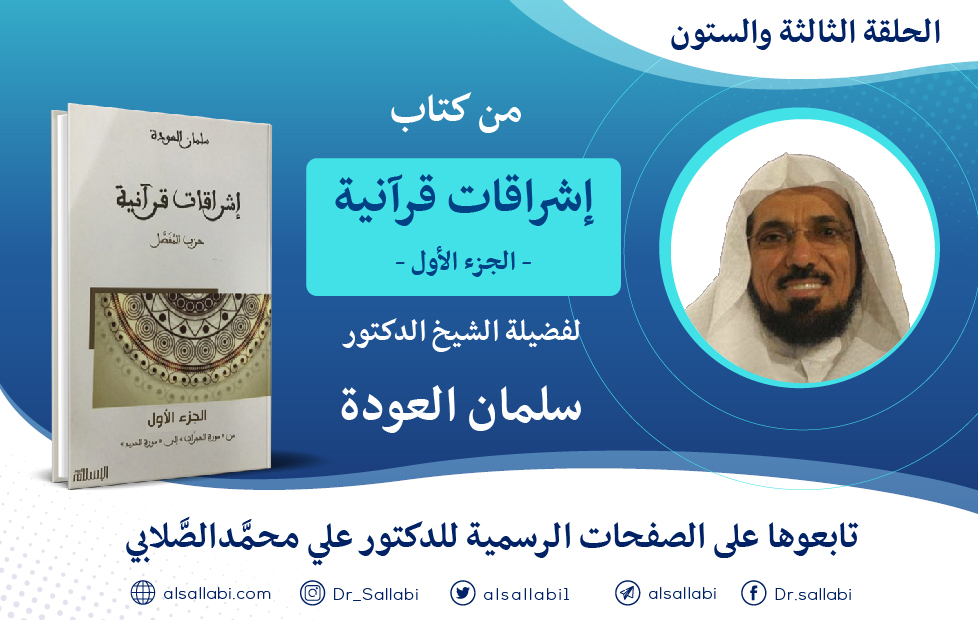من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الجن)
الحلقة السادسة والسبعون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الآخر 1442 هــ/ فبراير 2021
{فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا } أي: الذين أسلموا منهم بحثوا وحاولوا واجتهدوا، وتلمَّسوا والتمسوا، حتى وصلوا إليه.
والتحرِّي: التدقيق في البحث، ومنه: تحرِّي رؤية الهلال، أي: ترقُّب الهلال في خروجه وعدمه، وتلمُّس مواضعه.
ومن معاني {تَحَرَّوْا رَشَدًا }: انتظروا وتوقَّعوا توفيقًا من الله تعالى، وجزاءً وشكورًا ونعمة في الجنة.
* {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا }:
وهذا من تمام كلام الجنِّ على القول الصحيح، وهو دليل على أنهم عرفوا أن ثمة جنة ونارًا، لا سيما أنهم يعرفون موسى عليه السلام، كما في حكاية الجنِّ في «سورة الأحقاف».
أشاروا إلى أن هؤلاء الكافرين الذين استحقوا العقوبة والنار مثل الحطب يُلقون في جهنم إلقاءً، كما قال سبحانه: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } [البقرة: 24].
فهم وإن كانوا بشرًا في الدنيا، إلا أنهم كالخُشُب، كما قال الله تعالى عن المنافقين: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ } [المنافقون: 4]، ومن ذلك قول القائل:
ترى الفتيانَ كالنَّخْلِ، وما يدريكَ ما الدَّخْلُ
أي: قد ترى الإنسان بمظهره، ولا تدري ما مخبره:
تَرى الرَّجُلَ النَّحيفَ فَتَزدَريهِ * وفي أَثوابِهِ أَسَدٌ هَصُورُ
ويُعجِبُكَ الطَّريرُ فتَبتَليهِ * فيُخلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّريرُ
لَقَد عَظُمَ البَعيرُ بِغَيرِ لُبِّ * فَلَم يَستَغنِ بالعِظَمِ البَعيرُ
والإنسان ليس بجسمه وقوته، ولا بماله، وإنما بصفاء قلبه وصدق نيته وعمله وإيمانه، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «قيمة كل امرئ ما يحسنه».
* {وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا }:
هذا إنشاء من كلام الله، وليس على لسان الجنِّ.
والطريقة هي الإسلام والإيمان، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسَعِيد بن جُبير، وقتادة، ومجاهد، وجماعة من علماء التفسير واللغة.
والمعنى: أن الناس لو استقاموا على الإسلام وآمنوا بالله لسقاهم ماءً غدقًا.
والغَدَق: الكثير الطيب، والمقصود هنا ليس الماء فقط، وإنما الخير كله، فالماء ما يكون تعبيرًا عن الرزق والنعمة.
وهذا المعنى مثل قول الله سبحانه: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ } [الأعراف: 96]، وقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم } [المائدة: 66]، وهذا هو أحد معاني الآية الكريمة.
والاستقامة على الطريقة هي: الالتزام بأحكام الديانة وآدابها في النفس والمجتمع، فهي بمجموعها أساس بناء المجتمع السليم الرغيد، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فالصلة بالله صلاةً ودعاءً وتسبيحًا وذكرًا تورث التقوى، وتكون خير رقيب على السلوك، وتفعل فعلها داخل النفس بالراحة والسكينة والهدوء والأمل والصبر والتسامح وقوة الاحتمال، وهذه خلائق وصفات لا بد منها لنجاح الحياة واستمرار السير في الطريق الموصل للمقصود.
وهنا تلحظ أنه بعدما انتهى كلام الجنِّ في قوله: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا }، أنشأ كلامًا جديدًا، هو كالقاعدة الكونية القدرية التي يقرِّرها ربُّ البشر؛ وهي أن طاعته أساس الفلاح والنجاح في الدارين.
وذهب جمع من المفسرين إلى أن المقصود: لو استقاموا على الكفر، وأجمعوا وأصروا عليه، لصببنا عليهم النعمة والرزق فتنة لهم، وهو منقول عن محمد بن كعب القُرَظي، وابن قُتيبة، وجماعة من علماء التفسير واللغة.
وزعم بعضهم أن الأمرين مقصودان معًا، وكأن المعنى: أن الناس لو اجتمعوا كلهم، أولهم وآخرهم؛ إنسهم وجِنَّهم، على طريقة واحدة من إيمان أو كفر، لسقاهم الله تعالى {مَّاء غَدَقًا}، وهذا في الدنيا؛ وذلك لأنه قال: {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ }، وهم إما أن يكونوا مؤمنين، فيكون المقصود: لنختبرهم، فنعلم مَن يثبت منهم على الإيمان، ومَن لا يثبت، ومَن يشكر ومَن يكفر، وإما إن يكونوا كافرين، فيكون المعنى: حتى يملي لهم الله، كما قال سبحانه: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِين } [آل عمران: 178].
وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يزال في هذه الدنيا البَر والفاجر، والمؤمن والكافر، وهذا سرٌّ من أسرار الابتلاء الإلهي، واختلاف الناس؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: 118-119] ، ولو فرض أن الناس أجمعوا كلهم على طريقة من الطرق، إما إيمان أو كفر، هُدى أو ضلال، لسقاهم الله تعالى ماءً غدقًا، وبذلك يجتمع القولان المنقولان عن السلف في تفسير هذه الآية.
وهذا جيد، ولا يعَكِّر عليه إلا لفظ: الاستقامة؛ فإنه أليق بالاستقامة على الخير والهُدى، ولم يرد في القرآن والسنة إلا كذلك، والله أعلم.
* {وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا }:
أي: حتى لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم، ثم مدَّ الله لهم في الرزق والعطاء والماء الغدق، فإن هذا فتنة لهم، ومَن يعرض منهم عن ذكر الله، فسوف يسلكه ربه عذابًا صَعَدًا، فلا ينفعه هذا الماء الغدق؛ لأن في قلبه من الشقاء والقلق والهمِّ والغمِّ والضيق ما يُنغِّص عليه لذاته، ويحرمه من النعيم، كما في قوله: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124]، فالعذاب الصَّعَد يشبه المعيشة الضنك، وهو متصل- والله أعلم- بقوله سبحانه: {وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء } [الأنعام: 125].
والصَّعَد: هو العذاب المتزايد المتصاعد، فيشمل ذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومنه قوله سبحانه: {سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا } [المدثر: 17]، أي: عذابًا شديدًا مرهقًا شاقًّا عليه، وهو يزداد ولا ينقص: {كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا } [الإسراء: 97].
* {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }:
هذا خطاب للناس كلهم؛ إنسهم وجِنِّهم، فالمساجد هي بيوت الله، وهي مواضع الصلاة، ومنها المسجد الحرام الذي لم يكن يومئذ مسجد عامر يُصلَّى فيه إلا هو، وكان المشركون يجعلون فيه الأوثان، ويمنعون أهل الإيمان من الصلاة، فعاتبهم الله تعالى أن جعلوا هذه المساجد للأوثان، وأقاموا فيها النُّصُب، فكان في الكعبة ثلاثمئة وستون صنمًا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
ويحتمل أن {الْمَسَاجِدَ } هي أعضاء السجود، فالمعنى: لا تسجدوا إلا لله، وقد جاء في الحديث: «أقرَبُ ما يكونُ العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ». وفيها إلماح إلى أن الأمر سيتسع وتكثر المساجد ويمكِّن اللهُ للمؤمنين.
{فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } أي: لا تسجدوا لغير الله، كما قال سبحانه:
{لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون } [فصلت: 37].
والمقصود هنا: إما العبادة؛ فـ«الدعاءُ هو العبادةُ»، كما في حديث النعمان بن بَشِير رضي الله عنهما، أو يقصد الدعاء بخصوص الذي هو سؤال الله بقدرته تحصيل خير أو دفع شر مما هو ليس من شأن البشر، بل من شأن الخالق القدير الرحيم.
* {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا }:
المقصود بـ{عَبْدُ اللَّهِ }: محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما سماه: {عَبْدُ اللَّهِ }، واختار له هذا الاسم، كما اختاره له في «سورة الإسراء»، في قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً }، وكما اختاره له في وقت تنزل الوحي عليه فقال: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ } [الفرقان: 1]، وهي تسمية تشريف.
وممَّا زادني شَرَفًا وتيهًا * وكِدْتُ بأَخْمُصـي أطَأُ الثُّرَيَّا
دُخولي تحتَ قولك: {يَاعِبَادِيَ} * وأن صيَّرتَ أحمدَ لي نبيًّا
وغاية العبودية: التحرر من سلطان النفس، فإذا عبد الإنسان ربه، فهو مَدِينٌ لهذا الإيمان بالتحرر من سلطة النفس والهوى والشهوة، فضلًا عن سلطة العباد.
والمعنى: أنه لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه بالصلاة، كاد الكفار أن يكونون عليه لِبدًا، والمقصود: كفار قريش، حيث تألَّبوا عليه، على سبيل المضايقة والتهديد والتخويف.
وهل اجتمعوا في مكان واحد، أم أن هذا حدث في مناسبات متفرقة، كما قال أبو جهل: هل يُعفِّرُ محمدٌ وجهَه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللَّاتِ والعُزَّى، لئن رأيتُه يفعلُ ذلك لأطأنَّ على رقبته، أو لأعفرنَّ وجهه في التراب. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطأ بعقبه على رأسه، فمنعه الله من ذلك وحجبه.
ولعل الأمر أوسع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بما أمره به ربه، رمته العرب عن قوس واحدة، وتجمَّعوا في مواجهته.
واللِّبد: الشيء المتلبِّد المتجمِّع بعضه على بعض، ومنه: لِبْدة الأسد.
وبعض المفسِّرين حملوا الآية على الجنِّ؛ بدلالة السياق والقصة.
ويعزِّزه أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كادوا يركب بعضهم بعضًا من كثرتهم.
والمعنى الأول أوسع وأقرب، ويؤيِّده ما يأتي بعده من إصراره على دعوته ورفض الشرك.
ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتوحيده ولو رغمت أنوف المعاندين، ولو اجتمعوا على كيده والمكر به، فكل ذلك لا يجوز أن يصرفه عن دعوته.
* {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا }:
فأنا لم آت حُوبًا ولا زورًا، وإنما عبدت الله تعالى وحده، ولم أشرك به أحدًا، وهذا ديني ودعوتي.
* {قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا }:
أمره أن يقول لهم هذه الحقيقة؛ ليعلموا حدود ما يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يجوز أن يُعبد أو أن يُدعى من دون الله.
والآية فيها ما يسميه العلماء بالاحْتِباك، أي: الاختصار.
وكأن المعنى: لا أملك لكم ضرًّا ولا نفعًا، ولا ضلالًا ولا رَشَدًا؛ لأن الضرَّ يقابله النفع، والرَّشَد يقابله الضلال، فأتى بالطرفين وترك الوسط؛ لأنه معروف.
والمقصود هنا: أنه لا يملك لهم التوفيق والإلهام، وإنما يحملهم على ذلك بهداية الإرشاد والتبليغ؛ ولهذا قال له ربه: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم } [الشورى: 52]، فهو صلى الله عليه وسلم يهدي بخُلُقِه وبلسانه وبعمله، كل ذلك هداية، لكن ليس بيده التوفيق أو الخذلان، أو الإلهام أو الحجب والحرمان، أو جعل الإيمان في قلوب الناس، وإنما هذا إلى الله.
* {قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }:
أي: لن يحميني من الله تعالى أحدٌ لو أراد تعذيبي أو إهلاكي، فأنا عبده، فكيف بكم أنتم أيها المكذِّبون المتمرِّدون على ألوهيته؟
وفي الخطاب التنصل من الحول والطَّوْل والقوة، والتواضع لله، وبيان حقيقة النبوة والدعوة، وأنها ليست مكاسب أو انتفاعات أو مراكز أو استعلاء على الخلق.. فمَن يستطيع أن يقول مثل هذا القول إلا رسول الله؟!
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: