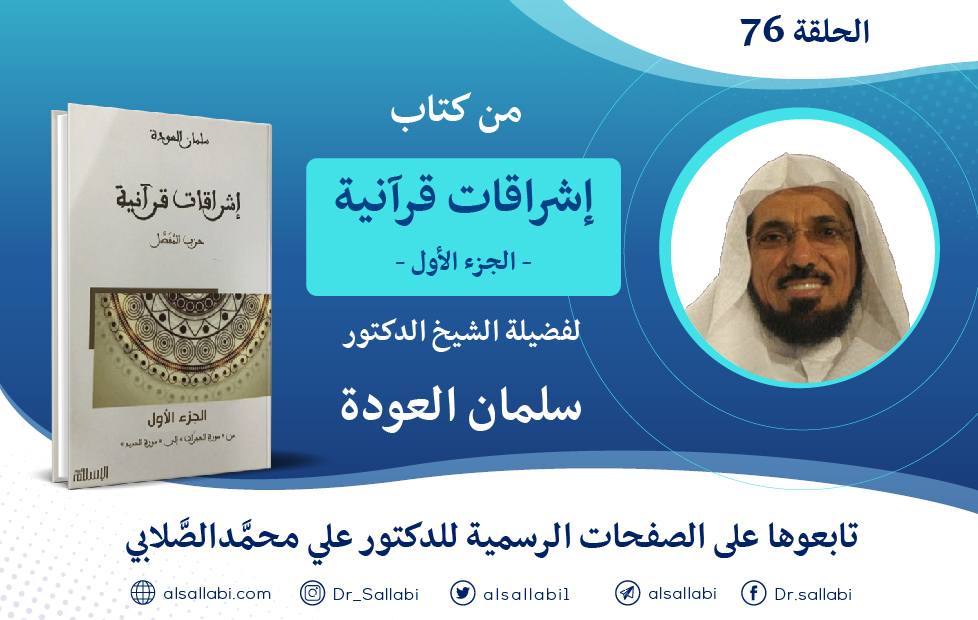من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة المعارج)
الحلقة الخامسة والستون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الآخرة 1442 هــ/يناير 2021
* {وَنَرَاهُ قَرِيبًا }:
أي: في الوقت؛ ولهذا قال تعالى: {يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً } [الأحقاف: 35]، وقال: {يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } [النازعات: 46]، وحكى أنهم يتساءلون ويتخافتون فيما بينهم: كم لبثنا في الدنيا؟ فيقول بعضهم: {إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا } [طه: 103]، فيقول سبحانه: {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا } [طه: 104]، فأعقلهم يؤكِّد أن لبثهم لم يكن سوى يومٍ واحدٍ، فإذا جاء يومُ القيامة تغيَّرت الموازين والحسابات تغيرًا كبيرًا، وقد كانوا من قبل يستعجلون به، فهم الآن يقولون كلامًا آخر، وقد كانوا في الدنيا ينظرون إلى الآخرة المستقبلة بسخرية واستبطاء، فإذا هم في الآخرة ينظرون إلى الدنيا الماضية بتعجب وتقليل!
* {يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْل }:
المُهْل: المعدن المذاب، دُرْدِيُّ الزيت المذاب، أي: ما يبقى في أسفل الزيت من البقايا والحُثالة.
فهذا أحد تشبيهات السماء يومئذ، أنها تكون كالمعدن المذاب.
وقد جاءت صفات أخرى في شأن السماء؛ كقوله سبحانه: {فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَان } [الرحمن: 37]، أي: مالت إلى الحمرة، ولعل المقصود بالدِّهان هنا مثل قوله: {كَالْمُهْل} أي: الزيت أو دُرْدِي الزيت.
ويحتمل أن يكون المقصود أن هذا يقع مرة بعد أخرى، فيوم القيامة يوم طويل، مقداره خمسون ألف سنة، فتقع تحولات في أحوال السماء وألوانها وشكلها وهيئتها، وكذلك الأرض.
* {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْن }:
العِهْن: الصوف، وغالبًا ما يُطلق على الصوف الملون المصبوغ، وقال سبحانه: {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوش } [القارعة: 5]، أي: المفرَّق.
والجبال في الدنيا ملونة، كما قال تعالى: {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُود } [فاطر: 27]، فمنها الأبيض والأحمر والأسود، فهكذا يوم القيامة تتغير حقيقتها وتذهب كثافتها وتصبح كالصوف المنفوش، ويكون فيها ألوان وطرائق مختلفة.
والمرء ينظر من حوله، فيرى الجبال من أعظم ما خلق الله، وبها يُضرب المثل في الشدة والقوة والرسوخ، ويرفع رأسه فيرى السماء في سموقها وإحكامها وجمالها.. ففي ذلك اليوم تتفتت الجبال، فتبدو كالقطن أو الصوف، وتضعف السماء، فتغدو كالمُهْل، فما بالك بالإنسان الضعيف الذي هو المقصود من وراء كل تلك الحوادث؟!
وعادة ما يلجأ الناسُ بعضهم لبعض عند حلول الحوادث، ويتبادلون الحديث مع معارفهم وأصدقائهم، ويقلِّبون وجوه الرأي، وطرائق الحياة، ولكن هيهات ذلك في موقف القيامة.
* {وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا }:
فكل إنسان مشغول بنفسه؛ لما يرى من الهول، ولا يعنيه أن يسأل عن حال أقرب قريب.
وقد أخذ هذا المعنى أبو العلاء المعري لما مات أبوه، ورثاه بقصيدة، فيها:
فيا ليتَ شِعري هل يخفُّ وقارُه * إذا صار أُحْدٌ في القيامة كالعِهْنِ؟
وهل يَرِدُ الحوضَ الرَّويَّ مبادرًا * مع الناس أم يأبَى الزّحامَ فَيَستأني؟
يقول: هل سيزاحم مع الناس من أجل الحوض، أم أنه لا يريد أن يزاحم فيستأني؛ لأنه كان في الدنيا وقورًا قليل المخالطة للناس؟
والحَمِيم: الصديق اللَّصيق الوثيق، والحَمِيم أيضًا: الماء الحار، وكلاهما يرد في القرآن في حديثه عن الآخرة، في فرار الحَمِيم من حَمِيمه، وفي الماء الحَمِيم الذي يشربه أهل النار، وقد جمع المعنيين الشاعر فقال:
لا تَغْتَرِرْ ببني الزَّمان ولا تَقُلْ * عند الشَّدائد: لي أخٌ ونَدِيمُ
جرَّبتُهم فإذا المُعاقِرُ عاقرٌ * والآلُ آلٌ والحَمِيمُ حَمِيمُ
والمعنى ظاهر، ففي يوم القيامة لهول المطلع وكرب الموقف وانشغال كل امرئ بنفسه، يقول كل امرئ منهم: نفسي نفسي، ولا يسأل الصديقُ صديقَه عن حاله ولا عن شيء مما يجري: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيه } [عبس: 37]، ولم يبيِّن سبحانه متعلّق السؤال، أي: لا يسأل أي سؤال، لا عن نفسه، ولا عن أحد، ولا عما يجري.
ويحتمل أن يكون المعنى: لا يطلب منه شيئًا من باب المسألة، فلا مجال لمساعدة أو دعم أو إسناد أو شفاعة.
* {يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيه }:
كأن بعض الناس قال: كيف يسأله وهو لا يراه أصلًا؛ لكثرة الخلق المحشورين للعرض والحساب في صعيد واحد.
فكانت هذه الآية جواب التساؤل، أي: يجعل الله بعضهم يُبصر بعضًا على رغم ذلك، فيتمكنون من رؤيتهم، وقد يكون هذا من المؤمنين وهذا من الكفار، أو هذا في الجنة وهذا في النار، وهذا في مكان وهذا في مكان آخر، ومع ذلك يراه ويُبصره، ويتعمَّد أن يصد عنه، ولا يسأله عن شيء.
ولا غرابة، فمع بُعد العهد وحدوث الحوادث العظيمة والتحولات الجسيمة، إلا أن ذلك الموقف كما وصفه الله: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد } [الحج: 2]، حتى الوالد لا يسأل ولده، والزوج لا يسأل زوجته، والأم لا تسأل ولدها، قال تعالى: {لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ } [الأنعام: 94]، {ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ } [العنكبوت: 25].
إنه تأكيد لمسؤولية الفرد عن نفسه، فلا يسأل أحدٌ عن أحد، ولا ينفع أحدٌ أحدًا، إلا بما أخبر الله به من الشفاعة.
هنا الفرد في مواجهة صارمة مع ذاته، كما كان في الدنيا مسؤولًا عنها؛ ولكنه مشغول عنها بالآخرين، حتى يصل الحال إلى أن المستحق للعقوبة يتمنى أن تنزل بأقرب قريب وأحب حبيب لينجو منها هو!
{يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيه }: هذا المجرم هو الذي كان في الدنيا يستعجل العذاب، ويسأل: متى هو؟ فها هو في يوم القيامة يود لو يفتدي العذاب بأخلص أصدقائه وأقرب الناس له رحمًا، وربما هؤلاء الناس الذين يراهم ويبصرهم في عَرَصات يوم القيامة قد كانوا في الدنيا من أسباب ضلاله، وربما كان يستعرض أمامهم قوته وذكاءه وكبرياءه وسخريته، ومن أجلهم كذَّب أو كفر، لم يعد يلتفت إليهم، بل وَدَّ لو يفتدي نفسه بهؤلاء جميعًا، يود أن يخلص من العذاب، ويدفع فدية مقابل تخليصه من العذاب، ولو {بِبَنِيه } الذين خُلقوا من صلبه، وبدأ بالبنين؛ لأنهم أشد الناس علاقة به؛ فإن الولد بَضْعة من أبيه، وموضع حبه.
وثمة فرق بين النسب الذي تعزَّز وترسَّخ بالتقوى والإيمان، وما ليس كذلك، فكل نسب ينقطع يوم القيامة، إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه، كما قال صلى الله عليه وسلم.
* {وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه }:
والصاحبة: الزوجة، وهي أقرب من الأخ لقلب الإنسان بعد بنيه؛ ولذا بدأ بها، ثم عطف عليها الأخ.
* {وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويه }:
قال مالك: {وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويه }: أمه؛ لأنه يأوي بعد أن انفصل عنها.
والأكثرون على أن المقصود بـ«فَصِيلته التي تُؤْويه»: أفراد القبيلة القريبة منه، كما يقولون: القبيلة والفخذ والفصيلة، فهم الأقارب المحيطون بالرجل، مثل العم وابن العم، وهذا أقرب، فيكون السياق بدأ متسلسلًا بالبنين، ثم بزوجته، ثم بأخيه، ثم بفصيلته، وهي الدائرة الأوسع.
والترتيب في «سورة عبس» عكس هذا؛ لأنه هنا يريد أن يفتدي بهم، فناسب أن يبدأ بالأقرب والأحب؛ إظهارًا لشدة حاجته واستعداده للفداء، ولذا قدَّم بنيه، ثم زوجته، ثم أخاه، ثم قبيلته، ثم الناس جميعًا، على معنى أن تقول: فلان قد هجر حتى أقربَ الناس إليه، فهم مضرب المثل، وهو لم يعد يبالي بأحد من الناس.
وجاء في «سورة عبس» عكس ذلك؛ لأن الأمر هناك أمر فرار: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه }، فبدأ بالأخ، وانتقل إلى مَن هو أقرب: {وَأُمِّهِ وَأَبِيه }، ثم انتقل إلى الأقرب: {وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه }. والفرار قد يعني التنصل من المساعدة التي جرت عليها العادة في الدنيا، أن الإخوة يساعد بعضهم بعضًا، وكثيرًا ما يحتاج الأبوان إلى المساعدة من الأبناء، أما الزوجة والأولاد فهم محل الضرورة، فكان الفرار تدريجيًّا، يبدأ بالأخ، ثم الأبوين، وأخيرًا يفر حتى من بنيه وزوجه، وقد يكون الاختلاف بين الموضعين للتنويع، ففيما يتعلق بالفرار بدأ بالأبعد ثم الأقرب، وفيما يتعلق بالافتداء بدأ بالأقرب، وهم الأبناء، ثم الصاحبة، ثم الأخ، ثم الفصيلة.
* {وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيه }:
فليس عنده تردد أن يفتدي بالناس كلهم، فيعذّبوا من أجل أن ينقذ نفسه، وهذا الكافر كان يمكنه في الدنيا أن يفتدي بأقل من ذلك، ولكن كانت السخرية والاستعجال تهكمًا وتحديًا يمنعه من ذلك.
وهل يقول الإنسان هذا الكلام بلسانه، أم بقلبه، ويدل عليه لسان حاله؟
السياق تعبير عما يود أن يكون، لكن لم يصرِّح بأنه يقول ذلك تلفظًا، وفي سياقات أخرى ما يدل على أنه يقول ذلك عند مناسبته، كما في قوله: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ [الحاقة: 28-29]. وفي بعض نصوص السنة ما يرشد إلى ذلك.
إن كشف هذا الموقف الجليل لا يحمل المؤمن على جفاء القرابة والتنكر لها في الدنيا، فالصلة والخُلُق الكريم قربة إلى الله، وسبيل إلى النجاة في الموقف العصيب، و«الرَّاحمونَ يرحمهم الرحمنُ»، ومَن وصل رحمًا وصله الله، ولكنه يحمل على تقديم الحق والصواب ومرضاة الله على كل حبيب أو قريب؛ ليكون فراره إلى الله، ونعم بالله، وليس فراره إلى نفسه التي هي الأخرى تفر منه.
{ثُمَّ يُنجِيه }: ولم يقل: «فينجيه»، وإنما قال: {ثُمَّ }، وهي تدل على الاستبعاد، أي: مع هذا كله يا ليت الأمر ينفع! ويا ليته ينجو، لكن هيهات!!
* {كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى }:
{كَلاَّ } كلمة تقال للردع والزجر، تدل على النفي، أي: لن يُنجيه قريب ولا بعيد ولا حميم ولا صديق ولا شفيع.
والضمير ليس إلى مذكور سابق، والعرب يقولون: هذا ضمير الشأن، ويقصدون به الإشارة إلى أنه إذا جاء أمر جَلَل، فإنه يُورد ضميره قبله، فقوله تعالى: {إِنَّهَا لَظَى } أي: إن الأمر أو القصة أو الخبر أو الشأن يتعلق بشيء عظيم.
و{لَظَى } من أسماء النار، أو دَرَكة من دَرَكاتها، وهي مأخوذة من التلظِّي، وهو شدة الاشتعال، كما قال سبحانه: {فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى } [الليل: 14]، أي: تتوقَّد وتشتعل وتتلمَّظ، تريد هؤلاء الناس.
* {نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى }:
أي: تنزع الشَّوَى، فتأخذه أخذًا قويًّا شديدًا.
والشَّوَى: جلدة رأس الإنسان، وقيل: الأطراف؛ فالصياد إذا ضرب ولم يصب الصيد في مقتل، وإنما أصاب أطرافه، يقولون: أشوى، أي: أصاب الأطراف، ومنه قول العامة إذا كان الأمر المَخُوف أهون مما ظنوا قالوا: أشوى.. يعني: أسهل وأهون.
والذي يظهر أن المراد ليس أنها تنزع الجلدة من الإنسان، وإنما المقصود أنها تنزع الإنسان بجلدته وتنزعه بأطرافه، كما قال ربنا سبحانه: {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَام } [الرحمن: 41]، أي: يُحمل بأطراف يديه ورجليه وجلدة رأسه، ويلتقط التقاطًا.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: