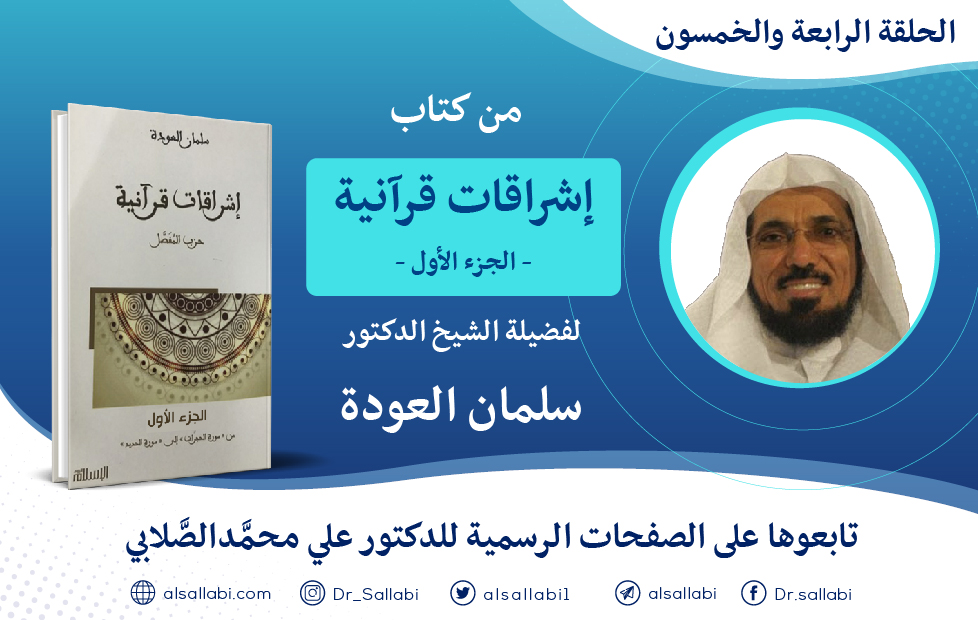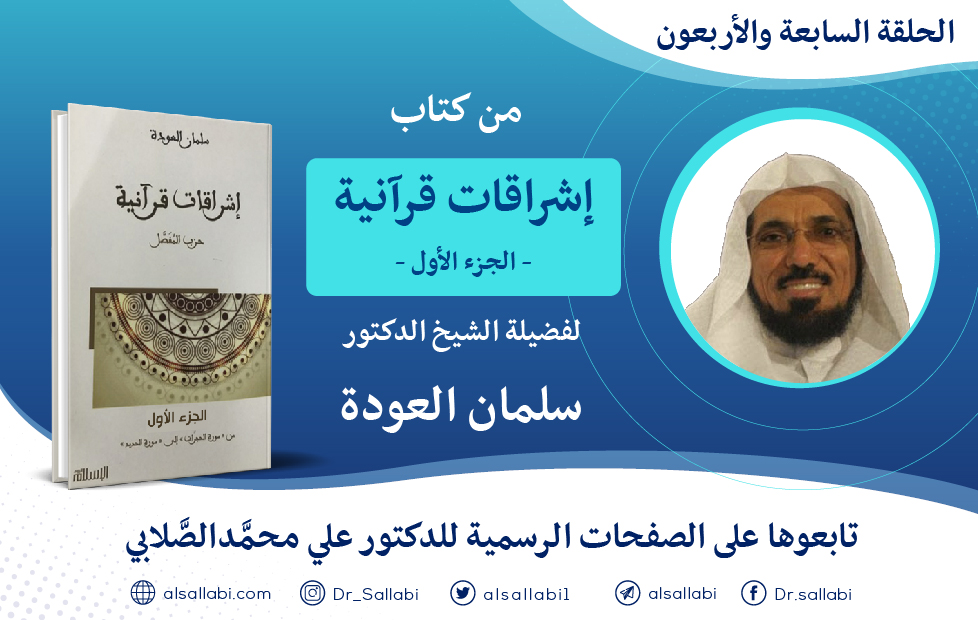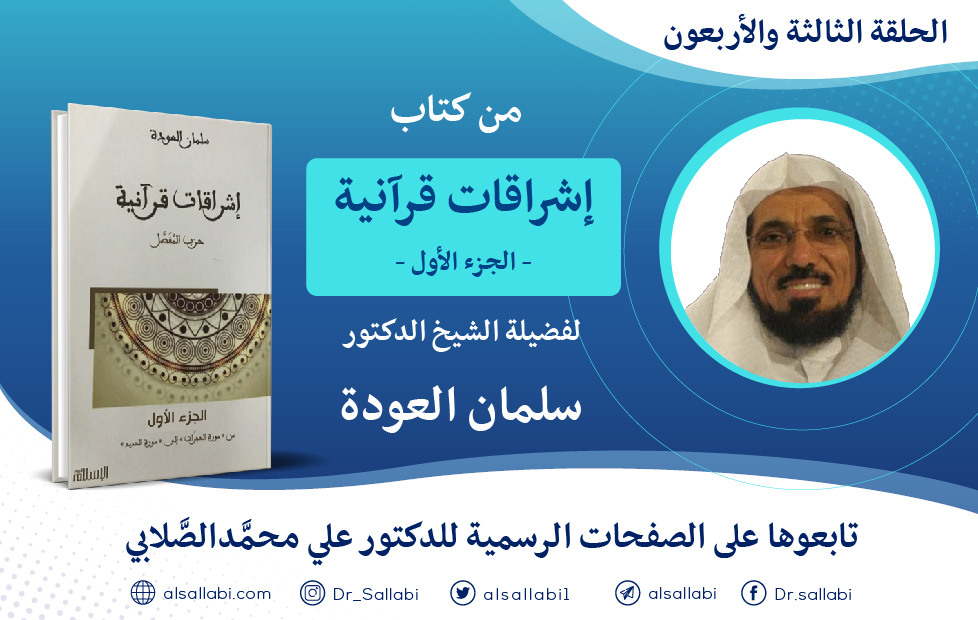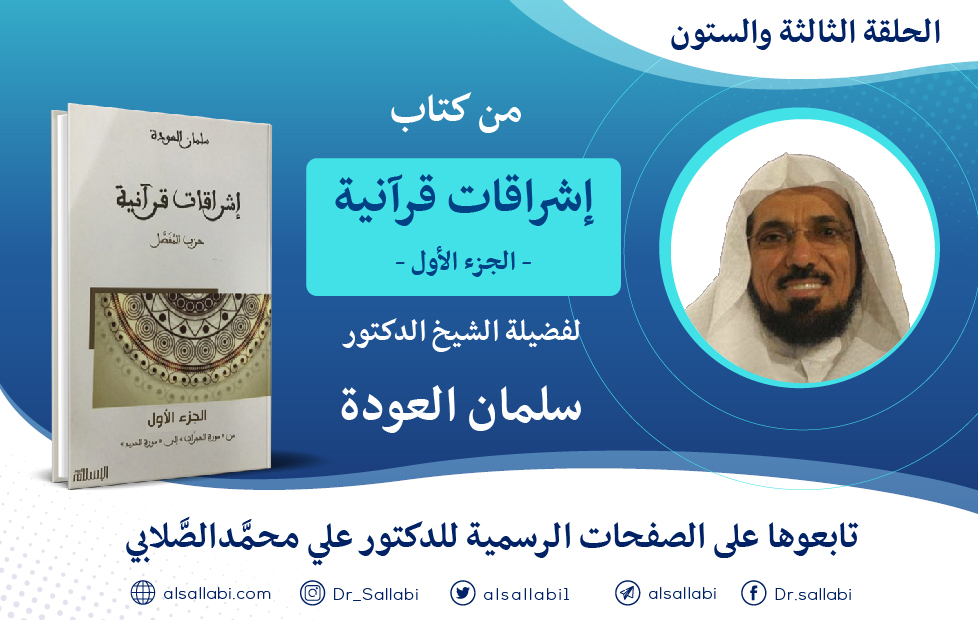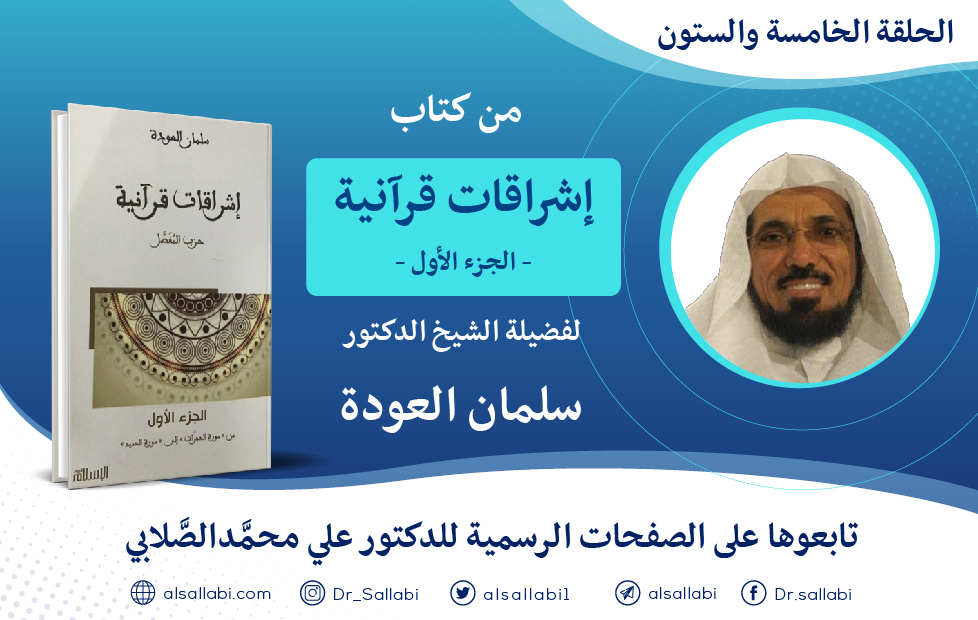من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة القلم)
الحلقة الرابعة والخمسون
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
جمادى الأول 1442 هــ/ يناير 2021
* {مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون }:
وهنا تناسب رائع، فيقسم اللهُ تعالى بالعلم والمعرفة والقلم واللغة والمعاني الحكيمة على ضلال ما يدَّعيه المشركون من التُّرَّهات، التي لا تستند إلى برهان، ولا إلى علم، ولا إلى هدى، ولا إلى كتاب منير، ويزكِّي عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه.
والأمر المقتضِي للقَسَم: أن المشركين لما كفروا بالدعوة، طاروا كل مُطَيَّر، وقالوا كل ما يخطر على بال، مما لا تقبله العقول ولا الأذواق ولا الأخلاق.
ومن ذلك أنهم وصموا محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذه الفرية البذيئة، فقالوا- كما سيأتي-: {إِنَّهُ لَمَجْنُون }، وأن هذا الذي يقوله محمد هذيان تمليه عليه الجن، قصدًا إلى صرف الناس عنه وعن دينه، حتى إن بعضهم وضع القطن في أذنيه؛ خشية أن يسمع شيئًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكثرة ما سمع عنه.
{مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ } أي: بما أنعم الله به عليك، فهي مثل قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ } [الحجر: 98]، أي: وأنت متلبِّس بما أنعم به عليك من العلم والمعرفة والوحي والرسالة والفضل، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية كلها بإجماع العقلاء والمنصفين من المؤمنين وغيرهم، وقد فضَّله الله تعالى على جميع ولد آدم، وهو أول مَن يدخل الجنة.
وهم إنما وصفوه بالجنون بعد الوحي، فكأن المعنى: إن هذه الرسالة التي اختصك الله تعالى بها وميَّزك لست فيها بمجنون، وإنما هي نعمة تفضَّل الله بها عليك.
وكان هؤلاء القوم يستكبرون أن يعترفوا بأنه يُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: إن الذي يأتيه الشيطان، فقال سبحانه: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} [الشعراء: 210-212].
وليس المقصود هنا مجرد نفي الجنون، بل نفي كل ما لا يليق بمقامه الشريف، والدفاع عن كمال عقله وعلمه وصدقه ومنزلته صلى الله عليه وسلم في جميع المقامات، وكفى بذلك فخرًا.
والرد والنفي هنا جاء بوحي منزَّل؛ لأن الأمر لا يتعلق بمنزلة إنسان عادي، بل هو متعلِّق بصميم الرسالة والإيمان والتوحيد، مثلما نفى الله عن ذاته العلية ما تقوَّله المتجرِّئون من ادِّعاء الصاحبة له والولد والتعب والبخل، وما زيَّنت لهم الشياطين من الكذب، كما قال سبحانه: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ } [المؤمنون: 91]، فيكون من كمال إيضاح الرسالة وبيانها وإقامة الحجة أن ينص على نفيها، ويثبت ضدها.
* {وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون }:
بُدئت السورة بالتأكيد بالقَسَم، ثم النفي القاطع لدعوى النقص، وهو الجنون، ثم إثبات للفضيلة هنا، مؤكَّدة بـ«إنَّ»، واللام، وبالتنكير الدال على سعة الأجر وعظمته، وأنه يفوق الوصف، ثم تقرير لديمومته دون انقطاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم له الأجر في الدنيا وفي الآخرة، وله الرفعة والثواب والجنة والرضوان.
فـ{غَيْرَ مَمْنُون } تحتمل أن هذا الأجر ليس من الناس، فيمنُّون به عليك، ويتبعون ما يقدمونه بالمَنِّ والأَذَى، كما كان الناس يفعلون في الجاهلية، فقد كانوا يمدحون أنفسهم بما تفضَّلوا به على غيرهم، كما قال النابغة:
عليَّ لعمروٍ نعمةٌ بعدَ نعمةٍ * لوالِده ليستْ بذات عقاربِ
أي: لا يتبعها المَن والأذى والقيل والقال، فالله سبحانه يذكر أنها نعمة من الله، ليس فيها منٌّ ولا أذى، أو أن هذا الأمر غير مقطوع، بل هو أجر دائم.
وهذا من الإعجاز بالإخبار بالغيب الذي صار شهادة، فحين نزلت عليه هذه السورة كان أتباعه يعدون على الأصابع، لكننا اليوم نرى مظان هذا الأجر غير المنقطع، فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى الهُدى؛ فله من الأجر مثل أجور مَن تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وسَنَّ سُننًا حسنة، فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة، ولا أحد من المسلمين يمنّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنة لله ورسوله، كما قالت الأنصار عند ما سألهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
فالله تعالى هو الذي مَنَّ علينا أن هدانا للإيمان، وللنبي صلى الله عليه وسلم في أعناقنا مِنن بعد مِنن، بما علَّمنا وأرشدنا، وسنَّ لنا السُّنن، وبيَّن لنا الطرائق، ونصحنا أصدق النصيحة وأكملها وأوفاها، فالمنة لله ورسوله.
وهو غير مقطوع ما بقي في الأرض مَن يقول: الله الله. ولأجر الآخرة خير وأكمل وأوفى، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى سبب ليجود ويغدق، وقد وعد نبيه بما هو خير وأبقى، حتى أنه أعظم الناس منزلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ثم سَلُوا اللهَ ليَ الوسيلةَ، فإنها منزلةٌ في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سأل ليَ الوسيلةَ حلَّت له الشفاعةُ». فيُشرع عقب كل أذان أن يقول السامع: «اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامَّة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقامًا محمودًا الذي وعدته».
* {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم }:
تأكيد آخر بـ«إنَّ»، وباللام، وبحرف «على»، فلم يقل: «إنك لذو خُلق عظيم»، وإنما قال: {لَعَلى }، و«على» تعني التمكن، كما تقول: فلان راكب على الفرس، يعني أنه متمكِّن فوقها، فكأن الخلق العظيم شيء مجسَّد، والنبي صلى الله عليه وسلم متمكِّن عليه.
إن خُلقه العظيم صلى الله عليه وسلم ليس شيئًا متكلَّفًا مصطنعًا، أو في حال دون حال، كأن يكون على خُلق عظيم في حال الضعف والمسكنة، حيث لا يستطيع شيئًا فوق ذلك، ولهذا يقول الحكماء: «الأخلاق تبين عند القدرة»، ولقد وصفه ربه بذلك، وهو ما يزال في مكة يعاني ظلم ذوي القربى وإيذاء كفار قريش وسخريتهم، ثم لما نصره الله وتمكَّن من التشفِّي والانتقام يوم فتح مكة قال لمشركي قريش: «اذهبوا فأنتم الطُّلَقاءُ». وهكذا كان خُلقه صلى الله عليه وسلم لا يغيِّره اختلاف الأحوال ولا تعاقب الزمان.
إن من الناس مَن ترى أخلاقه في غاية الدَّماثة والحسن، لكنه مع أهله وولده وخدمه سيِّئ الخلق، ضيِّق العَطَن، سريع الغضب، أما هو صلى الله عليه وسلم فكان خير الناس لأهله، يخصف نعله، ويرقِّع ثوبه، ويكون في مهنة أهله، وما ضرب امرأةً ولا خادمًا ولا أحدًا، إلا أن يُقاتلَ في سبيل الله، وكانت المرأة من نسائه ترفع صوتها عليه، وقد تهجره إلى الليل، فما تتغير أخلاقه، وهو بذلك رسم للمؤمنين سبيل التعامل مع أهلهم وذويهم.
ومن الناس مَن يكون على خُلق عظيم مع الموافق من أصحابه وأصدقائه، لكن إذا اختلف مع أحد تغيَّر حاله وتنكَّر ونسي جميله، أما هو صلى الله عليه وسلم فكان عنوان الوفاء، كما في قصة خَدِيجة رضي الله عنها، وكما في شهادته لأبي العاص بن الرَّبيع رضي الله عنه، وفي حفاوته بأصحابه، وتعاهدهم في السفر والحضر، والغنى والفقر، والقوة والضعف، والحياة والموت.
وكان صلى الله عليه وسلم من خُلقه العظيم أن يصبر عليهم حين قالوا عنه: {شَاعِرٌ }.. {سَاحِرٌ}..
{كَاهِنٍ }.. {مَجْنُون }، بل كان يدعوهم إلى الله ويتحمَّل الأذية، فربه سبحانه يعزيِّه عن ذلك.
وهذا فيه إشارة إلى أن الأخلاق من المعاني التي عظَّمها الإسلام وأولاها اهتمامًا منذ أول البعثة؛ ولهذا كان من خُلقه العظيم صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الأخلاق، كما قال: «إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاق». وفي رواية: «لأُتَمِّمَ صالحَ الأخلاق»، ولما سُئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: «كَان خُلُقُهُ القرآنَ».
ومن الناس مَن قد يتكلم عن الخُلق بلسانه، لكن عند ما تسأل عنه المحيطين به؛ تجدهم يشتكون من فظاظته وغلظته وسرعة غضبه ونَزَقِه وبخله وكذبه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد زيَّنه الله تعالى بالأمرين معًا، فجاء دينه يحث على معالي الأخلاق، وكان في سلوكه وتطبيقه العملي خير قدوة لذلك.
وفي هذا حجة علينا نحن المسلمين، أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، كما نقتدي به في صفة صلاته ونسكه، وهذا الخلق العظيم واسع لا يمكن قصره على بعض الأخلاق والأحوال؛ ولهذا يقول ربنا: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون *} [الحج: 77]، فجزء كبير من الخير يعرفه الناس بالفطرة، ولا يلزم فيه تفصيل وبيان؛ لأنه مما توارثه الخلق من أصول الأخلاق؛ كالكرم والصدق والعفاف والشجاعة والإحسان والوفاء والعدل.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: