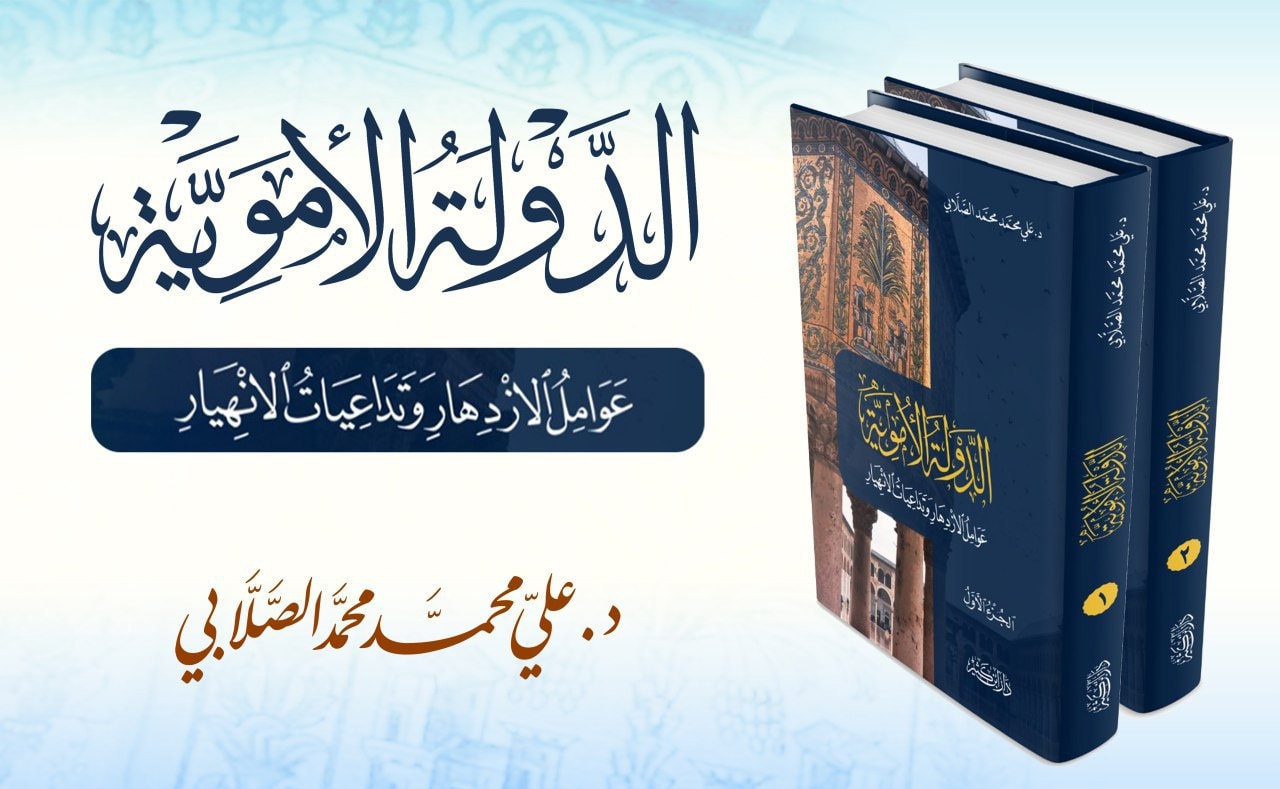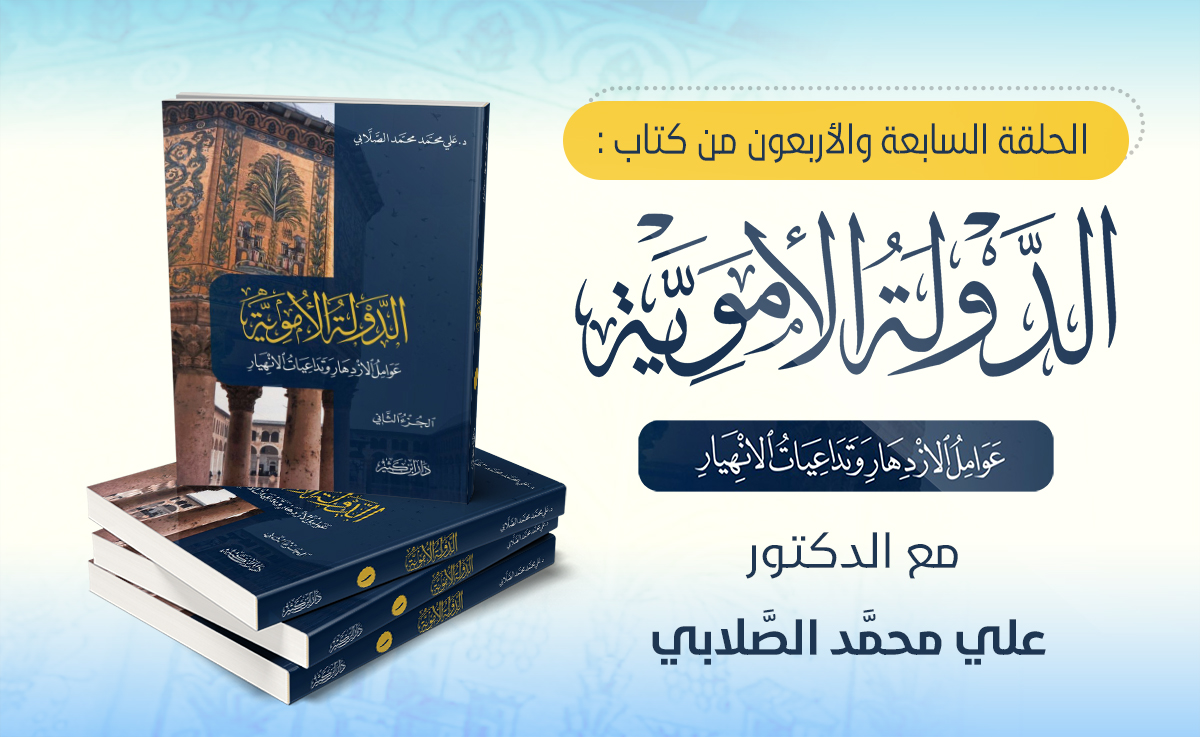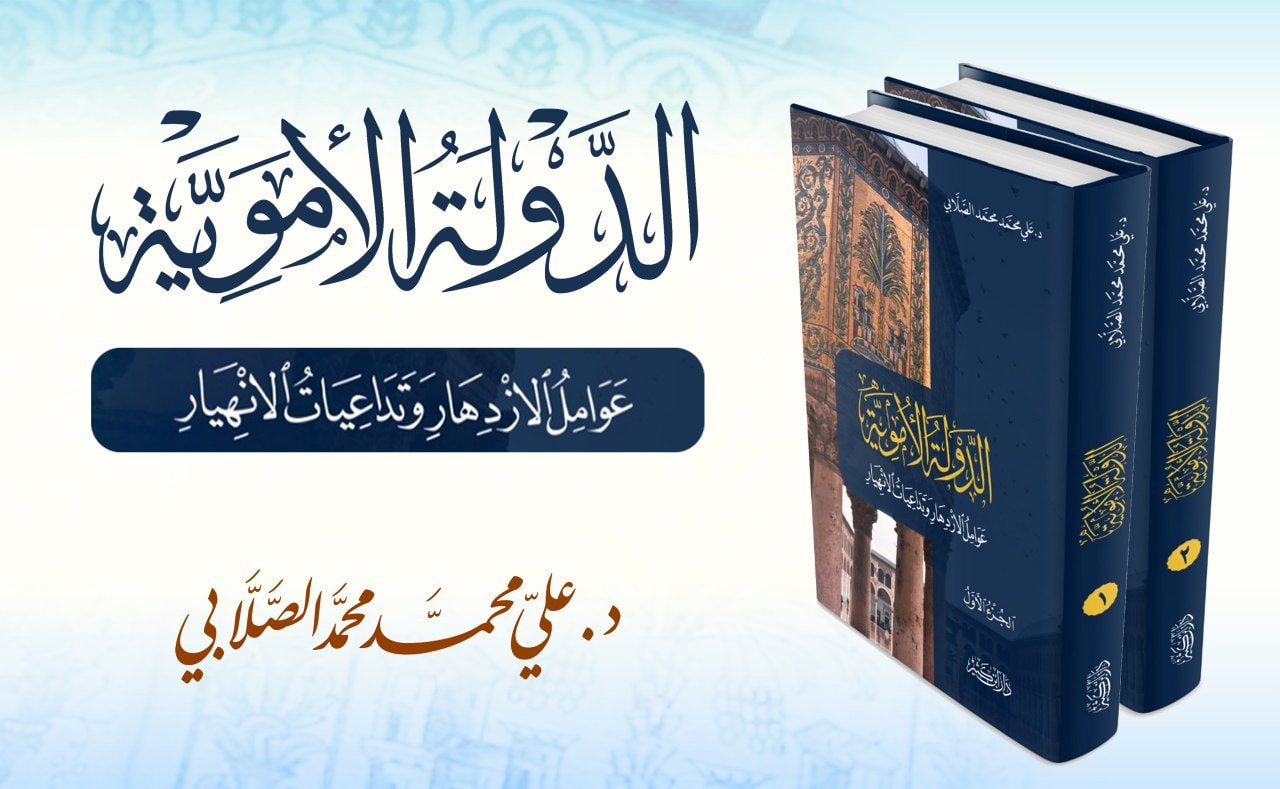من كتاب الدولة الأموية: خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
أشهر ولاة البصرة في عهد معاوية رضي الله عنه
الحلقة: السادسة والأربعون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
1 ـ بسر بن أبي أرطأة رضي الله عنه (41 هـ):
تولى الولاية عام 41 هـ ، وجاءت روايات لم تصل إلى درجة الصحة تشير إلى تعرض بسر لأبناء زياد بن أبيه، ثم عزل وعين بدله عبد الله بن عامر.
2 ـ عبد الله بن عامر رضي الله عنه (41 ـ 44 هـ):
ففي هذه السنة ـ أي 41هـ ولى معاوية عبد الله بن عامر البصرة ، وحرب سجستان، وخراسان. ولم يكن تعيين عبد الله بن عامر على البصرة لأسباب شخصية ، لأنه لم ترد رواية صحيحة تؤكد ذلك ، ولكن اختيار معاوية رضي الله عنه له كان نتيجة خبرته السابقة في ولاية البصرة وحرب سجستان وخراسان أيام عثمان ، فما كان من معاوية إلا أن أسند الأمر إلى أهله ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وبعد أن أمضى ابن عامر ثلاث سنوات تمكن فيها من تثبيت الفتح في سجستان وخراسان، واستفاد المسلمون من خبرته العسكرية ، ثم دعت الحاجة إلى تغييره ، فعزله معاوية وولى الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة في أول سنة خمس وأربعين ، فأقام بالبصرة أربعة أشهر ، ثم عزله وولاها زياداً.
3 ـ زياد بن أبيه (45 ـ 53 هـ):
أ ـ نسبه:
يعتبر نسب زياد المكنى بأبي المغيرة ، من أكثر القضايا غموضاً في حياته ، فقد كانت أمه أمة اسمها سمية، ولم يتفق المؤرخون من هو أبوه ، وبالتالي هم مختلفون في ذكر نسبه؛ فقد ذُكر اسمه في المصادر ، تارة زياد بن سمية، وتارة زياد بن عبيد ، ومرة زياد الأمير ، وأخرى زياد بن أبي سفيان ، وفي أغلب الأحيان عرف بابن أبيه، وذلك لما وقع في أبيه من الشك.
ب ـ صلح زياد مع معاوية:
كان زياد بن أبيه والياً على خراسان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وكان مخلصاً له غاية الإخلاص ، وحاول معاوية أن يكسب زياد ويضمه إلى صفه في عهد علي رضي الله عنه ، إلا أنه فشل في ذلك ، وبعد مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وجد معاوية فرصة طيبة لإعادة النظر في مساعيه الهادفة إلى استمالة زياد بأقل التكاليف، واستخدم معاوية لغة التهديد والترغيب مع زياد ، ولكن زياداً اعتصم بفارس بقلعة عرفت باسمه ، فخافه معاوية وهو من أكثر الناس معرفة بصلابته ، ولا شك أن اعتصام زياد بفارس مع علمه بأنه الوحيد الذي لم ينزل على حكم معاوية ، ويدخل فيما دخل فيه الناس ، إنما يدل على ثقته بنفسـه أولاً ، وبإمكانيات إقليم فارس الاقتصاديـة والبشرية ثانياً ، إلا أن هذه الأمور وحدها ليست كافية لمواجهة معاوية إذا ما لجأ إلى استخدام القوة ، الأمر الذي دفع زياد في المرحلة التالية في علاقته بمعاوية إلى تبديل موقفه الرافض بموقف أكثر إيجابية.
وبعد صلح الحسن حاول معاوية الاتصال بزياد وسمح للمغيرة بن شعبة أن يتدخل لحل هذا المشكل ، واستطاع المغيرة بن شعبة أن ينجح في إقناع زياد ببيعة معاوية والدخول في طاعته ، وكان هذا النجاح من المغيرة من أعظم ما قدمه لمعاوية من خدمات ، فقد كان من الصعب على معاوية أن يصل إلى زياد أو يوفق في إخضاعه إلا بعد قتال عنيف ، لا يدري أحد من سيكون الرابح في مثل ذلك الموقف الخطير ، وقد تمّ لمعاوية احتواء حركة اعتصام زياد بفارس ، ولم يستعجل في الأمر ، وابتعد عن استخدام القوة ، وأعطى للزمن فرصته، واستعـان بداهيـة من دهاة العرب في إقناع زياد، وهذا من حكمته رضي الله عنه.
جـ حول استلحاق معاوية زياد بن أبيه:
قال الطبري في عام 44 هـ: في هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه أبي سفيان فيما قيل، وقال الطبري: ... زعموا أن رجلاً من عبد القيس كان مع زياد لما وفد على معاوية ، فقال لزياد: إن لابن عامر عندي يداً ، فإن أذنت لي أتيته ، قال: على أن تحدثني ما يجري بينك وبينه ، قال: نعم ، فأذن له فأتاه ، فقال له ابن عامر: هيه هيه ! أو ابن سمية يقبح آثاري ، ويعرض بعمالي ؟! لقد هممت أن اتي بقسامة من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير سمية ، قال: فلما رجع سأله زياد ، فأبى أن يخبره ، فلم يدعه حتى أخبره ، فأخبر ذلك زياد معاوية، فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى الأبواب ، ففعل ذلك به ، فأتى ابن عامر يزيداً ، فشكا إليه ذلك ، فقال له: هل ذكرت زياداً؟ قال: نعم ، فركب معه يزيد حتى أدخله ، فلما نظر إليه معاوية قام فدخل ، فقال يزيد لابن عامر: اجلس؛ فكم عسى أن تقعد في البيت عن مجلسه ، فلما أطال خرج معاوية ، وفي يده قضيب يضرب به الأبواب ، ويتمثل:
لنا ســــياق ولكـــم ســــياق قـــد عـلمت ذلكـــم الرفــاق
ثم قعد فقال: يا بن عامر ، أنت القائل في زياد ما قلت ؟! أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية، وإن الإسلام لم يزدني إلا عزاً ، وإني لم أتكثر بزياد من قلة ، ولم أتعزز به من ذلة ، ولكن عرفت حقاً له فوضعته موضعه.
وقد اتهم معاوية رضي الله عنه عندما استلحق زياد بن أبيه إلى أبيه بأنه خالف أحكام الإسلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر».
وقد ردّ على هذا الاتهام الدكتور خالد الغيث في رسالته (مرويات خلافة معاوية) بقوله: .. أما اتهام معاوية رضي الله عنه باستلحاق نسب زياد ، فإني لم أقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك ، هذا فضلاً عن أن صحبة معاوية رضي الله عنه ، وعدالته ودينه وفقهه تمنعه من أن يرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاسيما وأن معاوية أحد رواة حديث: «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر». ووجه التهمة إلى زياد بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنسب أبي سفيان ، واستدل برواية أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي عثمان قال: لما ادعى زياد ، لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه؛ يعلم أنه غير أبيه؛ فالجنة عليه حرام». فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال النووي رحمه الله معلقاً على هذا الخبر: ... فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة ، وذلك أن زياداً هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان ، ويقال فيه: زياد بن أبيه ، ويقال: زياد بن أمه ، وهو أخو أبي بكرة لأمه... فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟! وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياداً وحلف أن لا يكلمه أبداً ، ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حيث قال هذا الكلام ، أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم؟! أي: هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة.
وبذلك يكون زياد هو المدَّعي ، وفي حقيقة الأمر فإن مسألة استلحاق معاوية زياد هي مسألة اجتهادية، ويذهب الكثير من المؤرخين بأن هناك دلائل عديدة تثبت أن أبا سفيان قد باشر سمية ـ جارية الحارث بن كلدة الثقفي ـ وكانت من البغايا ذوات الرايات ـ في الجاهلية ، فعلقت منه بزياد ، وذكروا بأن أبا سفيان اعترف بنفسه بذلك أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه واخرين بعدما شب ونبغ في عهد عمر بن الخطاب. وقال ابن تيمية بأن أبا سفيان كان يقول: زياد من نطفته.
فلما كانت خلافة معاوية شهد لزياد بذلك النسب أبو مريم السلولي؛ وهو صحابي كان يعمل في الجاهلية خماراً بالطائف ، وهو الذي جمع بين أبي سفيان وسمية ، وكان ذلك أمراً مألوفاً آنذاك.
ويبدو أن هذا النسب قد شاع أمره حتى لقد شهد بذلك أحد رجال البصرة لزياد قبل استلحاق معاوية إياه، فهي دعوة قديمة إذن ولم تكن كما يزعم الرواة نتيجة مشورة المغيرة بن شعبة على معاوية كجزء من صفقة متبادلة بين معاوية وزياد أو غير ذلك من التفاصيل التي اخترعها الرواة.
وبعد عقود من السنين نجد الإمام مالك بن أنس ـ إمام أهل المدينة ـ يذكر زياداً في كتابه الموطأ بأنه زياد بن أبي سفيان ، ولم يقل زياد بن أبيه ، وذلك في عصر بني العباس ، والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ، ولا أنكروا ذلك منه ، لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلف الناس فيها ، فمنهم من جوزها، ومنهم من منعها ، فلم يكن لاعتراضهم عليها سبيل ، وفي نسبة الإمام مالك لزياد إلى أبي سفيان فقه بديع لم يفطن له أحد، وهو أنها لما كانت مسألة خلاف ونقد الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع؛ فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها والله أعلم.
وأما تعارض هذا الاستلحاق مع نص الحديث الشريف ، فمن اعتذر لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياداً لأن أنكحة الجاهلية كانت أنواعاً ، وكان منها أن الجماعة يجامعون البغي ، فإذا حملت وولدت ألحقت الولد لمن شاءت منهم فيلحقه ، فلمّا جاء الإسلام حرّم هذا النكاح ، إلا أنّه أقر كل ولد كان يُنسب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم على نسبه ، ولم يفرّق بين شيء منها ، فتوهم معاوية أنّ ذلك جائز له ، ولم يفرّق بين استلحاق في الجاهلية والإسلام.
وأجاز الإمام مالك أن يستلحق الأخ أخاً له ويقول: هو ابن أبي ، ما دام ليس له منازع في ذلك النسب. فالحارث بن كلدة (الذي كانت سمية جارية له) لم ينازع زياداً ، ولا كان إليه منسوباً ، وإنما كان ابن أمة بغي ولد على فراشه ـ أي في داره ـ فكل من ادعاه فهو له ، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه ، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز ، بل فعل الحق على مذهب مالك ، فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهاد...
والحوادث تثبت أن معاوية كان مقتنعاً بحق زياد في ذلك ، ولابد أنه كان قد سمع من أبيه؛ ولهذا فإن معاوية كان مؤمناً بأن عمله لم يكن عملاً موضوعياً وواجباً ضرورياً من باب وضع الشيء في محله ، ولا ريب أن هذا كان معروفاً عند الناس؛ غير أن معاوية أراد أن يثبته.
د ـ خطبة زياد المعروفة بالبتراء بالبصرة:
لما تولى زياد ولاية البصرة، عام 45 هـ، خطب خطبة بتراء، لم يحمد الله فيها، وقيل: بل حمد الله فقال: «الحمد لله على أفضاله وإحسانه، ونسأله المزيد من نعمه، اللهم كما رزقتنا نعماً، فألهمنا شكراً على نعمتك علينا.
أما بعد ، فإن الجهالة الجهلاء ، والضلالة العمياء ، والفَجر الموقد لأهله النار ، الباقي عليهم سعيرها ، ما يأتي سفهاؤكم ، ويشتمل عليه حلماؤكم ، من الأمور العظام ، ينبت فيها الصغير ، ولا يتحاشى منها الكبير ، كأن لم تسمعوا باي الله ، ولم تقرؤوا كتاب الله ، ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته ، والعذاب الأليم لأهل معصيته ، في الزمن السرمد الذي لا يزول.
أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا ، وسدت مسامعه الشهوات ، واختار الفانية على الباقية ، ولا تذكروا أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا به ، من ترككم هذه المواخير المنصوبة ، والضعيفة المسلوبة ، في النهار المبصر ، والعدد غير قليل: ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار ؟! قربتم القرابة ، وباعدتم الدين ، تعتذرون بغير العذر ، وتغطون على المختلس ، كل امرئ منكم يذبُّ عن سفيهه ، صنيع من لا يخاف عقاباً ، ولا يرجو معاداً ، ما أنتم بالحلماء ، ولقد اتبعتم السفهاء ، ولم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم ، حتى انتهكوا حرم الإسلام ، ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الريب.
حُُرِّم عليّ الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً ، إني رأيت اخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوله ، لين في غير ضعف ، وشدة في غير جبرية وعنف.
وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى ، والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم.
إن كذبة المنبر تبقى مشهورة ، فإذا تعلقتم عليّ بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. من بُيِّت منكم ، فأنا ضامن لما ذهب له ، إياي ودلج الليل ، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه ، وقد أجلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إلي ، وإياي ودعوى الجاهلية ، فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه.
وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن ، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ، فمن غرَّق قوماً غرقته ، ومن حرَّق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه ، ومن نبش قبراً دفنته حياً ، فكفوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي ، لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضرب عنقه.
وقد كانت بيني وبين أقوام إحن ، فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي ، فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً ، ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته.
إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً ، ولم أهتك له ستراً ، حتى يبدي لي صفحته، فإذا فعل لم أناظره.
فاستأنفوا أموركم ، وأعينوا على أنفسكم ، فرب مبتئس بقدومنا سيسر ، ومسرور بقدومنا سيبتئس.
أيها الناس ، إنا أصبحنا لكم ساسة ، وعنكم ذادة ، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا ، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ، ولكم علينا العدل فيما ولينا ، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم.
واعلموا أني مهما قصرت فإني لا أقصِّر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل ، ولا حابساً رزقاً ولا عطاءً عن إبَّانه ، ولا مُجمِّراً لكم بعثاً (مبقياً جيشاً في أرض العدو) أكثر من أربعة أشهر، فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم ، فإنهم ساستكم المؤدبون لكم ، وكهفكم الذي إليه تأوون ، ومتى تصلحوا يصلحوا ، ولا تشربوا قلوبكم بغضهم ، فيشتد لذلك غيظكم ، ويطول له حزنكم ، ولا تدركوا حاجتكم ، مع أنه لو استجيب لكم كان شراً لكم ، أسأل الله أن يعين كلاًّ على كل ، وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على أذلاله ، وايم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة ، فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي».
فقام عبد الله بن الأهتم فقال: اشهد أيها الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب ، فقال: كذبت ، ذاك نبي الله داود عليه السلام.
قال الأحنف: قد قلت فأحسنت أيها الأمير ، والثناء بعد البلاء ، والحمد بعد العطاء ، وإنا لن نُثني حتى نبتلي ، فقال زياد: صدقت.
وهذه الخطبة تعتبر من الخطب المشهورة في التاريخ ، وعلى الرغم من كثرتها وكثرة المصادر التي أوردتها إلا أنها لم تأت بإسناد صحيح يجعل القارئ يطمئن إلى صحة ما ورد فيها، لاسيما أنها تحتوي على مآخذ عديدة ، وتناقضات واضحة تقلل من صحة نسبة جميع ما جاء فيها إلى زياد، وقد نبه إلى هذه المآخذ والتناقضات الدكتور خالد الغيث حفظه الله.
تحدثت الخطبة عن انتشار الفجور في البصرة وكثرة بيوت الدعارة فيها ، ويستفاد ذلك من قول زياد: .. من ترككم هذه المواخير المنصوبة ، وقوله: ... حُرِّم عليّ الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً.
وهذا الكلام المنكر عن حال البصرة عند قدوم زياد ، يرده حقيقة ما كانت عليه البصرة منذ تأسيسها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث بنيت لتكون قاعدة تنطلق منها الجيوش الإسلامية لمواصلة الفتح ونشر الإسلام في ربوع البلاد المفتوحـة ، ومن أجل هذه الغاية استوطن البصرة أكثر من خمسين ومئة صحابي ، حملوا على عواتقهم مهمة الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم ، فأنَّى لهذه المنكرات أن تنبت وتنتشر في مجتمع عماده الصحابة والتابعون دون أن ينكروه ويلزموه ، كذلك فـإن وجود الخوارج في البصرة وما عرف عنهم من الاستعجال والاندفاع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل اخر على انتفاء وجود هذه المنكرات في مجتمع البصرة وبالحجم الذي ورد في خطبة زياد.
ـ ومن التناقضات الواردة في الخطبة: ورد قول زياد: وإياي ودعوى الجاهلية ، فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه. مع أنه ذكر في موضع اخر من الخطبة نقيض ذلك وهو قوله: وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والصحيح منكم بالسقيم.
وورد في الخطبة قول زياد: إياي ودلج الليل ، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه. لكنه عاد في موضع اخر من الخطبة لينقض ما ذكره انفاً فقال: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل.
وهذه التناقضات الواردة في الخطبة يستغرب صدورها من زياد مع ما عرف عنه من البلاغة والفصاحة ، وهذا يقودنا إلى قضية أخرى وهي احتمال كون النص الذي بين أيدينا عن خطبة زياد عند مجيئه إلى البصرة عبارة عن أكثر من خطبة تم دمجها في سياق واحد ، ويؤيد ذلك ثناء عبد الله بن الأهتم والأحنف بن قيس على زياد بعد انتهاء الخطبة من أن الخطبة تستوجب النقد وليس الثناء ، لما فيها من تقديم حكم الجاهلية على حكم الله.
وعن الشعبي ، قال: ما سمعت متكلماً قد تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفاً أن يسيء إلا زياداً ، فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلاماً. وهذا الثناء من الشعبي على زياد يقوي الشك حول خطبة زياد البتراء التي سبق الحديث عنها في الرواية السابقة.
هـ استعانة زياد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استعان زياد بعددٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم: عمران بن الحصين الخزاعي ، ولاه قضاء البصرة ، والحكم بن عمرو الغفاري ، ولاه خراسان ، وسمرة بن جندب ، وأنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن سمرة ، فاستعفاه عمران فأعفاه ، واستقضى عبد الله بن فضالة الليثي ثم أخاه عاصم بن فضالة ، ثم زرارة بن أوفى الحرشي ، وكانت أخته لبابة عند زياد.
و ـ من سياسة زياد في العراق:
يعتبر زياد بن أبي سفيان عامل معاوية على البصرة والكوفة بعد عبد الله بن عامر والمغيرة بن شعبة ، هو الذي قام بمعظم الإصلاحات الضرورية في ذلك الجناح الشرقي من الدولة الأموية ، وكان هذا الرجل يتمتع بقدرة إدارية فائقة.
وقد استن زياد عدة قوانين وتنظيمات ، وقام بكثير من الإصلاحات في البصرة أولاً (45 ـ 50 هـ) ، ثم في الكوفة بعد أن جُمعت المدينتان تحت إمرته في ولاية واحدة؛ وذلك منذ سنة 50 هـ ، وحتى سنة 53 هـ. فبنى دار الرزق في البصرة ، وهي شبيهة بمخزن المؤن في أيامنا هذه ، فكان الأهالي يتمونون منها ، وعيَّن أشخاصاً يشرفون عليها؛ منهم: عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وروَّاد بن أبي بكرة.
كما عيَّن الجَعْد بن قيس النّمري مشرفاً على السوق ومراقباً على أسعار المواد الغذائية فيه. وكان يعطي قروضاً للتجار إذا ما ارتفعت الأسعار كي يحثهم على المحافظة على سعر السلعة أو بزيادة بسيطة. وإذا ما تحقق ذلك وتوفرت الحاجات: ارتجع ماله.
وترك زياد الناس في البصرة أخماساً؛ أما الكوفة فقد قسمهم إلى أرباع، بدل الأسباع. واختار عريفاً لكل قسم يقوم بمهمة توزيع الأعطيات على أفراد عشيرته ، كما أنه كان مسؤولاً أمام زياد عما يحدث في ناحيته ، فيقوم بإرسال التقارير بما حصل فيها أولاً بأول إلى زياد ، واستطاع أن يضبط الأمور في المدينتين برجال من أهلها.
وأصدر زياد أوامره بألاَّ يدخل أو يخرج أحد من الكوفة أو البصرة بعد صلاة العشاء ، وأوقع القصاص بالسارق وقاطع الطريق ، فعمَّ الأمن والطمأنينة بحيث إن المرأة كانت تنام وباب بيتها مفتوحاً ، وأن الشيء ليسقط على الأرض فيظل ملقى دون أن يحركه أحد.
ونظم العطاء من الديوان؛ فحذف منه أسماء الذين توفوا، ومن كان غائباً عن قطره، ومن كان عابثاً بالأمن، فكان: إذا جاء شعبان أخرج أعطية المقاتلة فملؤوا بيوتهم من كل حُلْو وحامض ، واستقبلوا رمضان بذلك ، وإذا كان ذو الحجة أخرج أعطية الذرية، ويشير البلاذري إلى أنه: كان لكل عيِّل جريبان ومئة درهم ، ومعونة الفطر خمسين، ومعونة الأضحى خمسين.
واختار زياد حوالي خمسمئة رجل من أهل البصرة ليعملوا كحرس خاص له ، وكذلك حماية الأماكن الهامة، وأعطى لكل واحد منهم ما بين ثلاثمئة إلى خمسمئة درهم ، وأسند قيادتهم إلى شيبان بن عبد الله السعدي.
وبنى زياد مساجد عديدة ، منها: مسجد بني عدي ، ومسجد بني مجاشع ، ومسجد الأساورة. وكان لا يدع أحداً يبني بقرب مسجد الجماعة مسجداً ، فكان مسجد بني عدي أقربها منه. ويذكر ابن الفقيه: أن زياداً بنى سبعة مساجد؛ فلم يُنسب إليه شيء منها ، وأن كل مسجد بالبصرة كانت رحبته مستديرة فإنه من بناء زياد.وزاد زياد في مسجد البصرة زيادة كثيرة ، وبناه بالآجر والجص ، وسقفه بالساج ، وبنى منارته بالحجارة.
وكان يهتم بنظافة المدينة ويعتبر الأفراد مسؤولين عن نظافة بيوتهم ويعاقب من يهمل ذلك ، فقد كان يأخذ صاحب كل دار بعد المطر إذا أضحت برفع ما بين يدي فنائه من الطين ، فمن لم يفعل أمر بذلك الطين فألقي في مجلسه، وكان يأخذ الناس بتنظيف طرقهم من القذر والكناسات ، ثم إنه اشترى عبيداً ووكلهم ، فكانوا يلمونه؛ فهذه الرواية تشير إلى وجود موظفين مهمتهم مراقبة النظافة من ناحية ، كما تشير إلى أن زياداً تنبه إلى أن نظافة الطرق أمر يجب أن يتولاه أشخاص معينون ، فاشترى عبيداً وكَّل إليهم تنظيف الطرق من القذر والكناسات.
واهتم زياد بتقدم الزراعة وتنظيم طرق الري: فبنى السدود ، وحفر القنوات ، كما أنه كان يمنح المزارع قطعة من الأرض الزراعية ، مساحتها 60 جريباً ، ثم يدعه عامين؛ فإن عمّرها أصبحت له، وإلا استردها منه، وأعطاها اخرين ينتظرونها.
ولكي يسهل الاتصال بين ضفتي نهر الفرات ، فقد أصلح زياد قنطرة الكوفة وأعاد بناءها باللبن والطوب المقوّى ، بعد أن كانت من أخشاب القوارب المتهالكة. وأصبحت تعرف بعد ذلك بجسر الكوفة.
وأما عن كيفية تصرف زياد في موارد بيت مال الولاية؛ فيشير البلاذري إلى: أن زياداً كان يجبي من كُوَر البصرة ستين ألف ألف ، فيعطي المقاتلة من ذلك ستة وثلاثين ألف ألف ، ويعطي الذرية ستة عشر ألف ألف درهم ، وينفق من نفقات السلطان ألفي ألف ، ويجعل في بيت المال للبوائق والنوائب ألفي ألف درهم ، ويحمل إلى معاوية أربعة الاف ألف درهم ، وكان يجبي من الكوفة أربعين ألف ألف ، ويحمل إلى معاوية ثُلثي الأربعة الالاف ألف؛ لأن جباية الكوفة ثلثا جباية البصرة. كما أن عبيد الله بن زياد ، والذي خلف أباه على ولاية العراق حمل إلى معاوية ستة آلاف ألف درهم ، فقال معاوية: اللهم ارض عن ابن أخي.
4 ـ ولاية سمرة بن جندب رضي الله عنه (54 هـ):
عن جعفر بن سليمان الضبعي ، قال: أقر معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر ، ثم عزله ، فكذبوا على سمرة وزعموا أنه قال: لعن الله معاوية ! والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبداً. هذا الخبر المنسوب إلى سمرة بأنه شتم معاوية خبر مكذوب على هذا الصحابي الكريم، وفي ذلك يقول ابن كثير: وهذا لا يصح عنه، كما أن معرفة ميول مصدِّر الخبر جعفر بن سليمان الضبعي، والذي قال عنه ابن حجر: صدوق زاهد؛ لكنه يتشيع، تبين أثر التشيع في تشويه التاريخ الإسلامي.
5 ـ ولاية عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي (54 ـ 55 هـ):
قال الطبري: وفي هذه السنة ـ 54 هـ كان عزل معاوية بن أبي سفيان لسمرة بن جندب عن البصرة ، واستعمل عبد الله بن عمرو بن غيلان.
6 ـ ولاية عبيد الله بن زياد خراسان ثم البصرة (55 ـ ...):
قال الطبري: وفي هذه السنة ولى معاوية عبيد الله بن زياد خراسان، وفي عام 55 هـ عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة ، وولاها عبيد الله بن زياد ، وأوصى معاوية عبيد الله بن زياد بهذه الوصية: إني قد عهدت إليك مثل عهدي إلى عمالي ، ثم أوصيك وصية القرابة لخاصتك عندي ، لا تبيعن كثيراً بقليل ، وخذ لنفسك من نفسك ، واكتف فيما بينك وبين عدوك بالوفاء تخفّ عليك المؤونة وعلينا منك ، وافتح بابك للناس تكن في العلم منهم أنت وهم سواء ، وإذا عزمت على أمر فأخرجه إلى الناس ، ولا يكن لأحد فيه مطمع ، ولا يرجعن عليك وأنت تستطيع ، وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يغلبونك على بطنها ، وإن احتاج أصحابك إلى أن تواسيهم بنفسك فاسيهم.
وفي رواية قال له: اتق الله ولا تؤثرن على تقوى الله شيئاً ، فإن في تقواه عوضاً ، وقِ عرضك من أن تندسه ، وإذا أعطيت عهداً فوف به ، ولا تبيعنَّ كثيراً بقليل ، ولا تخرجن منك أمراً حتى تُبرمه ، فإذا خرج فلا يردن عليك ، وإذا لقيت عدوك فكن أكثر بمن معك ، وقاسمهم على كتاب الله ، ولا تطمعن أحداً في غير حقه ، ولا تؤيسن أحداً من حق له. ثم ودعه.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي: