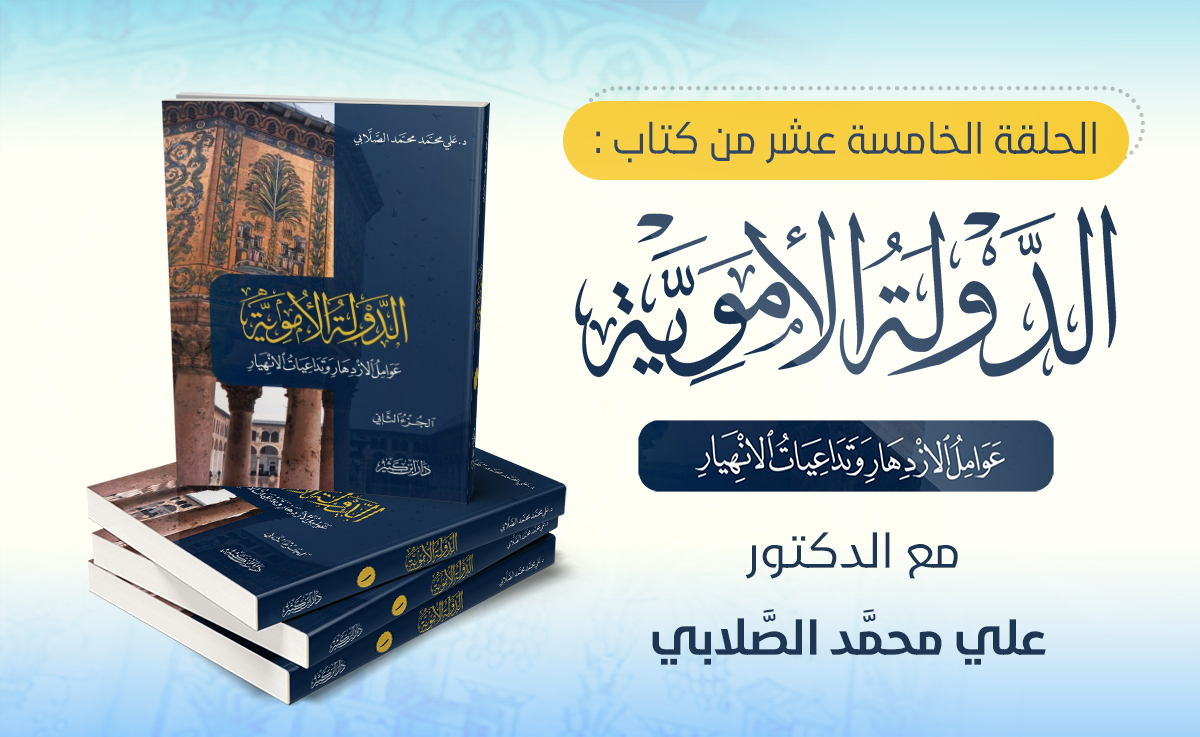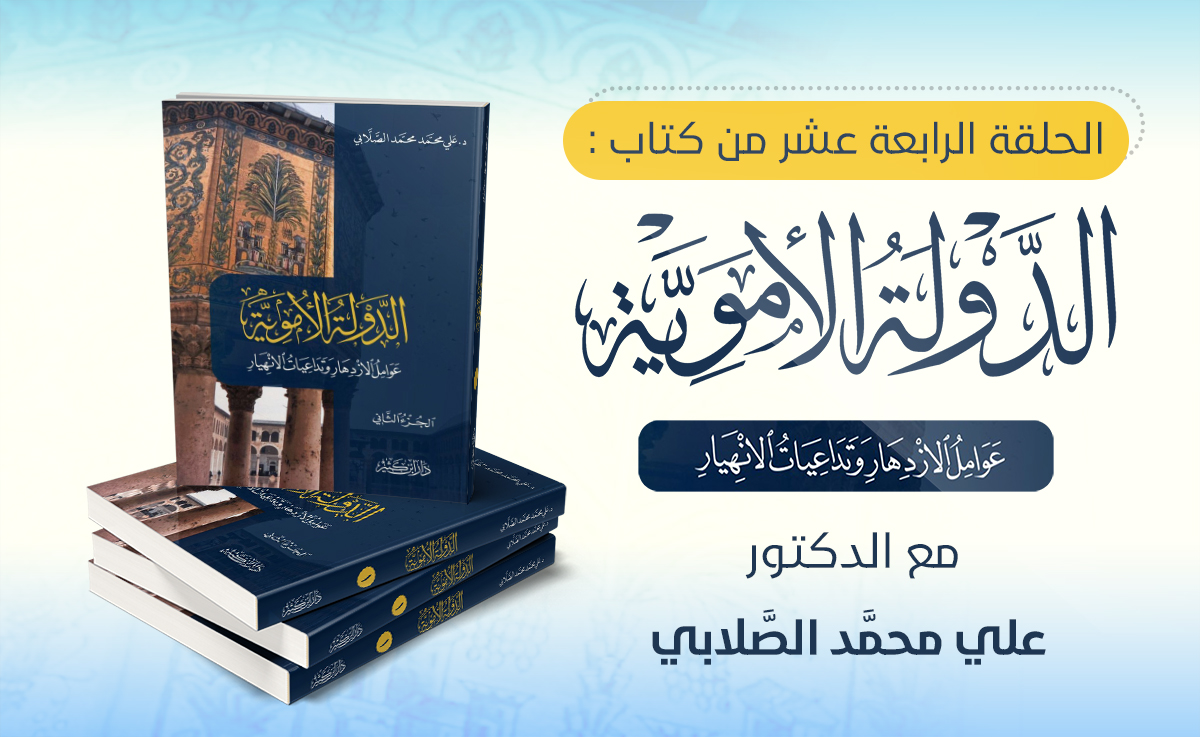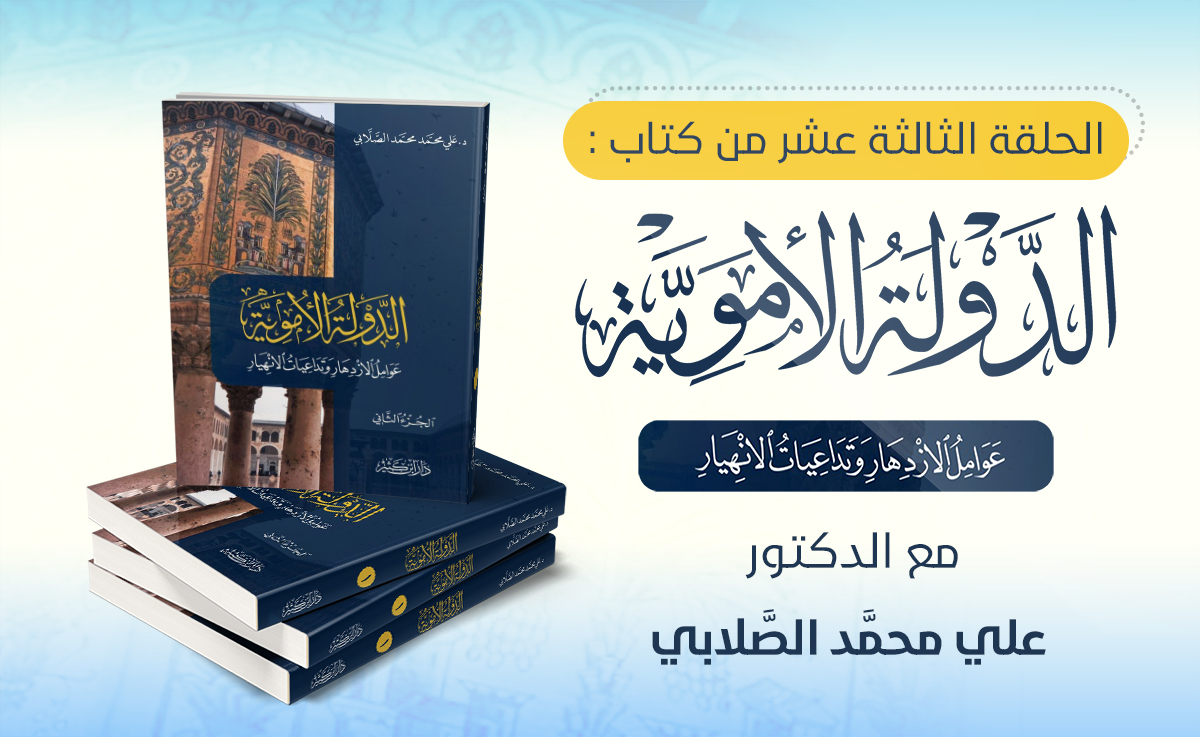معاوية بن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
الحلقة: الخامسة عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
محرم 1442 ه/ سبتمبر 2020
كان معاوية رضي الله عنه والياً على الشام في عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولما تولى علي رضي الله عنه الخلافة أراد عزله ـ ويبدو أن هناك ضغوطاً على علي رضي الله عنه من قبل الغوغاء لكي يعزل معاوية، وخصوصاً أن الغوغاء يعرفون معاوية جيداً، والذي جعلني أقول ذلك أن العلاقة بين علي ومعاوية قبل خلافة علي، لا يوجد ما يشوبها، بل كانت جيدة، كما أن الغوغاء فيما بعد ضغطوا على أمير المؤمنين علي في عزل قيس بن سعد من مصر ونجحوا في ذلك وترتب على ذلك ضياع مصر، وقد فصلت ذلك في كتابي أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
هذا وقد اختار أمير المؤمنين علي بدلاً من معاوية عبد الله بن عمر فأبى عليه عبد الله قبول ولاية الشام واعتذر في ذلك، وذكر له القرابة والمصاهرة التي بينهما، ولم يلزمه أمير المؤمنين علي، وقبل منه طلبه بعدم الذهاب إلى الشام، وأما الروايات التي تزعم أن علياً قام بالتهجم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لاعتزاله وعدم وقوفه إلى جانبه، ففي ذلك الخبر تحريف وكذب، وأقصى ما وصل إليه الأمر في قضية عبد الله بن عمر وولاية الشام ما رواه الذهبي من طريق سفيان بن عيينة: عن ابن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: بعث إليَّ علي قال: يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر فقد أمَّرْتك عليهم، فقلت: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله ، وصحبتي إياه، إلا ما أعفيتني، فأبى علي، فاستعنت بحفصة فأبى، فخرجت ليلاً إلى مكة. وهذا دليل قاطع على مبايعة ابن عمر، ودخوله في الطاعة، إذ كيف يوليه علي وهو لم يبايع ؟!.
وفي الاستيعاب لابن عبد البر، من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر: أنه قال حين احتضر: ما آسى على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية مع علي رضي الله عنه، وهذا مما يدل أيضاً على مبايعته لعلي، وإنه إنما ندم على عدم خروجه مع علي للقتال، فإنه كان ممن اعتزل الفتنة، فلم يقاتل مع أحد، ولو كان قد ترك البيعة، لكان ندمه على ذلك أكبر وأعظم ولصرح به، فإن لزوم البيعة والدخول فيما دخل الناس فيه واجب، والتخلف عنه متوعد عليه برواية ابن عمر نفسه: أن النبي قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية».
وهذا بخلاف الخروج للقتال مع علي، فإنه مختلف فيه بين الصحابة، وقد اعتزله بعض الصحابة، فكيف يتصور أن يندم ابن عمر على ترك هذا القتال، ولا يندم على ترك البيعة لو كان تاركاً لها، مع ما فيه من الوعيد الشديد، وبهذا يظهر بطلان قول بعض المؤرخين في زعمهم من ترك ابن عمر البيعة لعلي رضي الله عنه؛ حيث ثبت أنه كان من المبايعين له، بل من المقربين منه الذين كان يحرص على توليتهم، والاستعانة بهم، لما رأى فيه من صدق الولاء والنصح له، وبعد اعتذار ابن عمر عن قبول ولاية الشام، أرسل أمير المؤمنين علي سهيل بن حنيف بدلاً منه، إلا أنه ما كاد يصل مشارف الشام حتى أخذته خيل معاوية، وقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع، وكانت بلاد الشام تغلي غضباً على مقتل عثمان ظلماً وعدواناً.
أولاً: اختلاف الصحابة في الطريقة التي يؤخذ بها القصاص من قتلة عثمان:
إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهة، وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جهة أخرى، ثم بعد ذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؛ لم يكن سببه ومنشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة أمير المؤمنين علي وإمامته، وأحقيته بالخلافة والولاية على المسلمين، فقد كان هذا محل إجماع بينهم، قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل عليّ، واستحقاقه الخلافة، ولكنَّ اجتهاده أدّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان.
وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يدّعِ الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل علياً، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقرُّ بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا علياً وأصحابه بالقتال، ولا فعلوا، وقال أيضاً: وكل فرقة من المتشيعين مقرّة مع ذلك بأن معاوية ليس كفؤاً لعلي بالخلافة، ولا يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي، فإن فضل علي وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته، وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معلومة، كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
إن منشأ الخلاف لم يكن قدحاً في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وإنما اختلافهم في قضية الاقتصاص من قتلة عثمان، ولم يكن خلافهم في أصل المسألة، وإنما في الطريقة التي تعالج بها هذه القضية، إذ كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موافقاً من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، وإنما كان رأيه أن يرجئ الاقتصاص من هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة، وهذا هو الصواب.
قال النووي: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغٍ، فوجب عليهم نصرته، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده، وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدتهم وقتال الباغي عليه، وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية، وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين، وأن الحق معه، لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه.
ثانياً: معركة صفين 73هـ:
تسلسل الأحداث التي قبل المعركة:
1 ـ أم حبيبة بنت أبي سفيان ، ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية وأهل الشام:
لما قُتل عثمان رضي الله عنه: أرسلت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى أهل عثمان: أرسلوا إليّ بثياب عثمان التي قُتل فيها، فبعثوا إليها بقميصه مضرّجاً بالدم، وبخصلة الشعر التي نتفت من لحيته، ثم دعت النعمان بن بشير، فبعثته إلى معاوية، فمضى بذلك وبكتابها.
وجاء في رواية: خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بالدماء، ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين دافعت عنه بيدها، وكانت نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوج عثمان كلبية شامية، فورد النعمان على معاوية بالشام، فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس، وعلق الأصابع في كم القميص يرفع تارة ويوضع تارة، والناس يتباكون حوله، وحث بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره.
وجاء شرحبيل بن السمط الكندي وقال لمعاوية: كان عثمان خليفتنا، فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا، والى رجال الشام ألاَّ يمسوا النساء ولا يناموا على الفرش، حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهم، وكان ذلك ما يريده معاوية، فقد كانت الصورة التي نقلها النعمان بن بشير إلى أهل الشام كانت بشعة: مقتل الخليفة، سيوف مصلتة من الغوغاء على رقاب الناس بالمدينة، بيت المال منتهكاً مسلوباً، وأصابع نائلة مقطوعة، فهاجت النفوس والعواطف، واهتزت المشاعر، وتأثرت بها القلوب، وذرفت منها العيون. ولذلك كان إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام على المطالبة بدم عثمان، وتسليم القتلة للقصاص قبل البيعة. وهل تتصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد المسلمين من حاقدين محتالين متآمرين، ولا يتماوج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه للقصاص من أصحاب هذه الجريمة البشعة ؟!.
2 ـ دوافع معاوية رضي الله عنه في عدم البيعة:
كان معاوية رضي الله عنه والياً على الشام في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولما تولى الخلافة عليّ رضي الله عنه أراد عزله وتولية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاعتذر ابن عمر، فأرسل عليّ سهل بن حنيف بدلاً منه، إلا أنه ما كاد يصل مشارف الشام ـ وادي القرى ـ حتى عاد من حيث جاء، إذ لقيته خيل لمعاوية عليها حبيب بن مسلمة الفهري، فقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع.
لقد امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة، ورأوا أن يقتصّ علي رضي الله عنه من قتلة عثمان رضي الله عنه ثم يدخلون البيعة، وقالوا: لا نبايع من يؤوي القتلة. وتخوّفوا على أنفسهم من قتلة عثمان رضي الله عنه الذين كانوا في جيش علي، فرأوا أن البيعة لعلي لا تجب عليهم قبل القصاص، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا: لأن عثمان قتل مظلوماً باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوكة، فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا وضاع دم عثمان، وكان معاوية رضي الله عنه يرى أن عليه مسؤولية الانتصار لعثمان والقود من قاتليه، فهو ولي دمه، والله يقول: {وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣} [الإسراء: 33]
لذلك جمع معاوية الناس، وخطبهم بشأن عثمان، وأنه قتل مظلوماً على يد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام، إذ سفكوه في الشهر الحرام في البلد الحرام، فثار الناس، واستنكروا وعلت الأصوات، وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله ، فقام أحدهم واسمه مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله ما تكلمت.
وذكر الفتن وقربها، فمر رجل متقنع في ثوب، فقال: «هذا يومئذ على الهدى»، فقمت إليه، فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: «نعم».
وهناك حديث آخر له تأثيره في طلب معاوية القود من قتلة عثمان، ويعد منشطاً ودافعاً قوياً للتصميم على تحقيق الهدف، وهو: عن النعمان بن بشير، عن عائشة رضي الله عنهما، قالت: أرسل رسول الله .. فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه، فقال: «يا عثمان! إن الله عسى أن يلبسك قميصاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني». ثلاثاً، فقلت لها: يا أم المؤمنين! فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته، قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان، فلم يرضَ بالذي أخبرته، حتى كتب إلى أم المؤمنين: أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتاباً.
لقد كان الحرص الشديد في تنفيذ حكم الله في القتلة السبب الرئيسي في رفض أهل الشام بزعامة معاوية بن أبي سفيان بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ورأوا أن تقديم حكم القصاص مقدم على البيعة، وليست لأطماع معاوية في ولاية الشام فضلاً عن طلبه للخلافة، إذ كان يدرك إدراكاً تاماً أن هذا الأمر في بقية الستة من أهل الشورى، وأن علياً أفضل منه وأولى بالأمر منه، فعن أبي مسلم الخولاني: أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً، وأنا ابن عمه، والطالب بدمه، فأتُوه، فقولوا له، فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا علياً فكلموه، فلم يدفعهم إليه.
وأما ما شاع بين الناس قديماً وحديثاً أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان سببه طمع معاوية في الخلافة، وأن خروج هذا الأخير على عليّ وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام، فهذه روايات لا تصح ولا تثبت، فقد جاء في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري، وهو لا يثبت له وإنما صاحبه ذو أنفاس شيعية رافضية، فقد ذكر أنَّ معاوية ادّعى الخلافة، وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعلم أن معاوية طليق الإسلام، وأنا أباه رأس الأحزاب، وأنه ادعى الخلافة من غير مشورة، فإن صدقك فقد حلّ خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه. وهذا كلام لا يثبت عن أمير المؤمنين علي وإنما من كلام الشيعة الروافض، وسيأتي الحديث عن كتاب الإمامة والسياسة وبيان كذبه وزوره ودوره في تشويه حقائق التاريخ في موضعه بإذن الله، وقد امتلأت كتب التاريخ والأدب بالروايات الموضوعة والضعيفة التي تزعم أن معاوية اختلف مع علي من أجل الملك والزعامة والإمارة.
والصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان حول مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده، وليس هذا في أمر الخلافة في شيء، فقد كان رأي معاوية رضي الله عنه ومن حوله من أهل الشام أن يقتص عليّ رضي الله عنه من قتلة عثمان، ثم يدخلون بعد ذلك في البيعة.
يقول القاضي ابن العربي: إن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما؛ فهؤلاء ـ أي: أهل العراق ـ يدعون إلى عليّ بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء ـ أي: أهل الشام ـ يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يؤوي القتلة.
ويقول إمام الحرمين في (لمع الأدلة): إن معاوية وإن قاتل عليّاً، فإنه لا ينكر إمامته ولا يدّعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانَّاً منه أنه مصيب، وكان مخطئاً.
ويقول الهيثمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنَّ ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب، لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعليّ، فلم تهج الفتنة بسببها، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ابن عمّه أراد من علي تسليمه قتلة عثمان للاقتصاص منهم، فامتنع علي.
لقد تضافرت الروايات وأشارت إلى أنّ معاوية رضي الله عنه اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمان، وأنه صرح بدخوله في طاعة علي رضي الله عنه إذا أقيم الحد على قتلة عثمان، ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي وطمعاً في السلطة، فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحد على من قتل عثمان؟! حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له، لأنه التزم بذلك في موقفه من تلك الفتنة، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على قتلة عثمان، على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه، سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة، ولا يمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع.
إن معاوية رضي الله عنه كان من كتّاب الوحي، ومن قادة الصحابة، وأكثرهم حلماً، فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويهرق دماء المسلمين من أجل مُلك زائل؟! وهو القائل: والله لا أخيَّر بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وقد ثبت عن رسول الله أنه قال فيه: «اللهم اجعله هادياً مهدياً، واهد به»، وقال: «اللهم علمه الكتاب وقه العذاب».
وأما وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثمان رضي الله عنه، فيظهر في رفضه أن يبايع لعلي رضي الله عنه قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان، ويضاف إلى ذلك خوف معاوية على نفسه لمواقفه السابقة من هؤلاء الغوغاء، وحرصهم على قتله، بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم، مع العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، بل يدخل في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم، ويطلب الحق عنده، وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد ويأخذ حقه دون السلطان، أو من نصبه السلطان لهذا الأمر، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة وإشاعة الفوضى.
ويمكن القول: إن معاوية رضي الله عنه كان مجتهداً، متأولاً يغلب على ظنه أن الحق معه، فقد قام خطيباً في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكّرهم أنه ولي عثمان ـ ابن عمه ـ وقد قتل مظلوماً، وقرأ عليهم الآية الكريمة: {وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣} [الإسراء: 33].
ثم قال: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان، فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه على ذلك، وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم.
وإذا قارنّا بين طلحة والزبير رضي الله عنهما، ومعاوية؛ لاحظنا أنهما أقرب إلى الصواب من معاوية رضي الله عنه ومن معه من أربعة أوجه:
أولها: مبايعتهما لعليّ رضي الله عنه طائعين مع اعترافهما بفضله، ومعاوية لم يبايعه وإن كان معترفاً بفضله.
والثاني: منزلتهما في الإسلام وعند المسلمين وسابقتهما على معاوية ، ولا شك أن معاوية دونهما فيها.
الثالث: أنهما أرادا قتل الخوارج على عثمان فقط، ولم يتعمدا محاربة علي ومن معه في وقعة الجمل، بينما أصر معاوية على حرب عليّ ومن معه في صفين.
والرابع: لم يتهما عليّاً بالهوادة في أخذ القصاص من قتلة عثمان ، ومعاوية ومن معه اتهموه بذلك.
ونضيف نقطة خامسة: أن طلحة والزبير اقتنعا بصواب موقف علي ودخلا في الطاعة عندما اتفقا مع القعقاع بن عمرو، وإنما الحرب كانت بإثارة الغوغاء والسبئية لها.
3 ـ معاوية يرد على أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما:
بعث علي رضي الله عنه كتباً كثيرة إلى معاوية، فلم يرد عليه جوابها، وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان رضي الله عنه في صفر، ثم بعث معاوية طُوماراً مع رجل، فدخل به على عليٍّ رضي الله عنه، فقال له علي: ما وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القوَدَ، كلهم موتور، تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان، وهو على منبر دمشق ، فقال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية من بين يدي عليٍّ، فهمَّ به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله، فما أفلت إلا بعد جهد.
4 ـ تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام:
بعد وصول رد معاوية لأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما، عزم الخليفة على قتال أهل الشام، وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم، وإلى أبي موسى الأشعري بالكوفة، وبعث إلى عثمان بن حنيف بالبصرة بذلك، وخطب الناس فحثهم على ذلك، وعزم على التجَهُّز، وخرج من المدينة، واستخلف عليها قثم بن العباس، وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس، وجاء إليه ابنه الحسين رضي الله عنهما فقال: يا أبتِ دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين، ووقع الاختلاف بينهم، فلم يقبل منه ذلك، بل صمم على القتال، ورتّب الجيش، فدفع اللواء إلى محمد ابن الحنفية، وجعل ابن عباس على الميمنة، وعمر بن أبي سلمة على المسيرة، وقيل: جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأسد، وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخ أبي عبيدة، واستخلف على المدينة قثم بن العباس، ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصداً الشام، جاءه ما يشغله عن ذلك، وقد تمَّ تفصيل ذلك من خروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلى البصرة إلى معركة الجمل، فليرجع إليه في كتاب: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
5 ـ إرسال أمير المؤمنين علي جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة الجمل:
ذُكر أن المدة بين خلافة أمير المؤمنين عليّ إلى فتنة السبئية الثانية، أو ما يسمى البصرة، أو معركـة الجمل، خمسة أشهر وواحد وعشرون يوماً، وبين دخوله الكوفة شهر، وبين ذلك وخروجه إلى صفين ستة أشهر، وروي شهران أو ثلاثة، وقد كان دخول أمير المؤمنين الكوفة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين، فقيل له: انزل بالقصر الأبيض. فقال: لا؛ إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله، فأنا أكره لذلك، فنزل في الرحبة وصلَّى بالجامع الأعظم ركعتين، ثم خطب الناس فحثهم على الخير، ونهاهم عن الشر، ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه، ثم بعث إلى جرير بن عبد الله، وكان على همدان من زمان عثمان، وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان يأمرهما أن يأخذا البيعة له على من هنالك ثم يُقبلا إليه، ففعلا ذلك ، فلما أراد علي أن يبعث إلى معاوية يدعو إلى بيعته، قال جرير بن عبد الله البجلي: أنا ذاهب إليه يا أمير المؤمنين، فإنَّ بيني وبينه وُدَّاً، فاخذ لك البيعة منه، فقال الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه.
فبعثه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ويخبره بما كان في وقعة الجمل، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس، فلمَّا انتهى إليه جرير بن عبد الله، أعطاه الكتاب، وطلب معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام، فاستشارهم، فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان، أو يسلم إليهم قتلة عثمان، وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم.
فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا، فقال الأشتر: ألم أَنْهك يا أمير المؤمنين أن تبعث جريراً؟! فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية باباً إلا أغلقته. فقال له جرير: لو كنت لقتلوك بدم عثمان. فقال الأشتر: والله لو بعثتني لم يعنني جواب معاوية ولأعجلنَّه عن الفكرة، ولو أطاعني فيك أمير المؤمنين، لحبستك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمَّة.
فقام جرير مغضباً فأقام بقرقيسياء وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل له، فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه. وهكذا كان الأشتر سبباً في إبعاد الصحابي جرير بن عبد الله ، الذي كان والياً على قرقيسياء وعلى غيرها، ورأساً في قبيلته بجيلة، ويضطره إلى مفارقة أمير المؤمنين علي، وهذا الصحابي جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله إلا تبسم في وجهي، وقال : «يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحة مَلَك».
6 ـ مسيرة أمير المؤمنين علي إلى الشام:
استعد أمير المؤمنين علي لغزو الشام، فبعث يستنفر الناس، وجهز جيشاً ضخماً اختلفت الروايات في تقديره، وكلها روايات ضعيفة، إلا رواية واحدة حسنة الإسناد ذكرت أنه سار في خمسين ألفاً.
وكان مكان تجمع جند أمير المؤمنين بالنخلة، وهو على ميلين من الكوفة آنذاك، فتوافدت عليه القبائل من شتى أقاليم العراق، واستعمل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري، وبعث من النخيلة زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف مقاتل، وبعث شريح بن هانئ في أربعة آلاف، ثم خرج علي رضي الله عنه بجيشه إلى المدائن (بغداد)، فانضم إليه من فيها من المقاتلة، وولى عليها سعد بن مسعود الثقفي، ووجه منها طليعة في ثلاثة آلاف إلى الموصل، وسلك علي رضي الله عنه طريق الجزيرة الرئيسي على شط الفرات الشرقي حتى بلغ قرب قرقيسياء، فأتته الأخبار بأن معاوية قد خرج لملاقاته وعسكر بصفين، فتقدم علي رضي الله عنه إلى الرقة، وعبر منها الفرات غرباً ونزل على صفين.
7 ـ خروج معاوية إلى صفين:
كان معاوية جادَّاً في مطاردة قتلة عثمان رضي الله عنه؛ فقد استطاع أن يترصد جماعة ممن غزا المدينة من المصريين أثناء عودتهم، وقتلهم؛ ومنهم: أبو عمرو بن بديل الخزاعي، ثم كانت له أيد في مصر، وشيعة في أهل (خربتا) تطالب بدم عثمان رضي الله عنه، وقد استطاعت هذه الفرقة من إيقاع الهزيمة بمحمد بن أبي حذيفة في عدة مواجهات عام 36هـ، كما استطاع أيضاً أن يوقع برؤوس مدبري ومخططي غزو المدينة من المصريين مثل: عبد الرحمن بن عديس، وكنانة بن بشر، ومحمد بن حذيفة، فحبسهم في فلسطين، وذلك في الفترة التي سبقت خروجه إلى صفين، ثم قتلهم في شهر ذي الحجة عام 36هـ.
وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق نحو صفين جمع مستشاريه من أعيان أهل الشام، وخطب فيهم وقال: إن عليَّاً نهد إليكم في أهل العراق، .. فقال ذو الكلاع الحميري: عليك أم رأي وعلينا أم فعال.
وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية على الطلب بدم عثمان رضي الله عنه والقتال، وقد قام عمرو بن العاص رضي الله عنه بتجهيز الجيش وعقد الألوية، وقام في الجيش خطيباً يحرضهم، فقال: إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم، وفلوا حدَّهم، ثم إن أهل البصرة المخالفين لعلي قد وترهم وقتلهم، وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل، وإنما سار في شرذمة قليلة، ومنهم من قد قتل خليفتكم، فالله الله في حقكم أن تضيعوه، وفي دمكم أن تبطلوه.
وسار معاوية في جيش ضخم، اختلفت الروايات في تقديره وكلها روايات منقطعة أسانيدها، وهي عين الروايات التي قدرت جيش علي رضي الله عنه، فقدر بمئة ألف وعشرين ألفاً، وقدر بسبعين ألف مقاتل، وقدر بأكثر من ذلك بكثير؛ إلا أن الأقرب للصواب أنهم ستون ألف مقاتل، فهي وإن كانت منقطعة الإسناد إلا أن راويها صفوان بن عمرو السكسكي، حمصي من أهل الشام ولد عام 72هـ وهو ثبت ثقة، وقد أدرك خلقاً ممن شهد صفين، كما تبين من دراسة ترجمته، والإسناد إليه صحيح.
وكان قادة جيش معاوية على النحو التالي: عمرو بن العاص على خيول أهل الشام كلها، والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهم، وذو الكلاع الحميري على ميمنة الجيش، وحبيب بن مسلمة على ميسرة الجيش، وأبو الأعور السلمي على المقدمة، هؤلاء هم القادة الكبار، وتحت كل قائد من هؤلاء قادة وزعوا على حسب القبائل، وكان هذا الترتيب عند مسيرهم إلى صفين، ولكن أثناء الحرب تغير بعض القادة وظهر قادة آخرون مما اقتضته الظروف، ولعل هذا يكون السبب في اختلاف أسماء القادة في بعض المصادر.
وبعث معاوية أبا الأعور السلمي مقدمة للجيش، وكان خط سيرهم إلى الشمال الشرقي من دمشق، ولما بلغ صفين أسفل الفرات، عسكر في مكان سهل فسيح، إلى جانب شريعة ماء في الفرات، ليس في ذلك المكان شريعة غيرها، وجعلها في حيزه.
8 ـ القتال على الماء:
وصل جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صفين، حيث عسكر معاوية، ولم يجد موضعاً فسيحاً سهلاً يكفي الجيش، فعسكر في موضع وعر نوعاً ما؛ إذ أغلب الأرض صخور ذات كدى وأكمات، ففوجئ جيش العراق بمنع معاوية عنهم الماء، فهرع البعض إلى علي رضي الله عنه يشكون إليه هذا الأمر، فأرسل علي إلى الأشعث بن قيس فخرج في ألفين، ودارت أول معركة بين الفريقين، انتصر فيها الأشعث واستولى على الماء، إلا أنه قد وردت رواية تنفي وقوع القتال من أصله؛ مفادها: أن الأشعث بن قيس جاء إلى معاوية فقال: الله الله يا معاوية في أمة محمد ! هبوا أنكم قتلتم أهل العراق، فمن للبعوث والذراري؟! إن الله يقول: { وَإِن طَآئِفَتَانِ
مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ } [الحجرات: 9]. قال معاوية: فما تريد؟ قال: خلوا بيننا وبين الماء، فقال لأبي الأعور: خل بين إخواننا وبين الماء.
وقد كان القتال على الماء في أول يوم تواجها فيه في بداية شهر ذي الحجة فاتحة شر على الطرفين من المسلمين، إذا استمر القتال بينهما متواصلاً طوال هذا الشهر، وكان القتال على شكل كتائب صغيرة، فكان علي رضي الله عنه يخرج من جيشه كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميراً، فيقتتلان مرة واحدة في اليوم في الغداة أو العشي، وفي بعض الأحيان يقتتلان مرتين في اليوم ، وكان أغلب من يخرج من أمراء الكتائب في جيش علي: الأشتر، وحجر بن عدي، وشبت بن ربعي، وخالد بن المعتمر، ومعقل بن يسار الرياحي، ومن جيش معاوية أغلب من يخرج: حبيب بن مسلمة، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وعبيد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو الأعور السلمي، وشرحبيل بن السمط، وقد تجنبوا القتال بكامل الجيش خشية الهلاك والاستئصال، وأملاً في وقوع صلح بين الطرفين تصان به الأرواح والدماء.
9 ـ الموادعة بينهما ومحاولات الصلح:
ما إن دخل شهر المحرم، حتى بادر الفريقان إلى الموادعة والهدنة، طمعاً في صلح يحفظ دماء المسلمين، فاستغلوا هذا الشهر في المراسلات بينهم، ولكن المعلومات عن مراسلات هذه الفترة ـ شهر المحرم ـ وردت من طرق ضعيفة، مشهورة، إلا أن ضعفها لا ينفي وجودها.
كان البادئ بالمراسلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأرسل بشير بن عمرو الأنصاري، وسعيد بن قيس الهمداني، وشبت بن ربعي التميمي إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه كما دعاه من قبل إلى الدخول في الجماعة والمبايعة، فرد معاوية عليه برده السابق المعروف، بتسليم قتلة عثمان أو القود منهم أولاً، ثم يدخل في البيعة، وقد تبين لنا موقف علي من هذه القضية.
كما أن قُرَّاء الفريقين قد عسكروا في ناحية من صفين، وهم عدد كبير، قد قاموا بمحاولات للصلح بينهما، فلم تنجح تلك المحاولات لالتزام كل فريق منهما برأيه وموقفه، وقد حاول اثنان من الصحابة ـ وهما: أبو الدرداء، وأبو أمامة رضي الله عنهما ـ الصلح بين الفريقين، فلم تنجح مهمتهما، فتركا الفريقين ولم يشهدا معهما أمرهما، وكذلك حضر مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين وخطب الناس في محاولة منه لرأب الصدع بينهم؛ فقال: أيها الناس أنصتوا.. ثم قال: أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم مطيعيه، قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بذلك جبرائيل على محمد.. فما زال يأتي من هذا. ثم تلا: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩} [النساء: 29]. ثم انساب في الناس فذهب.
وقد انتقد ابن كثير التفصيلات الطويلة التي جاءت في روايات أبي مخنف ونصر بن مزاحم، بخصوص المراسلات بين الطرفين فقال: ... ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلاً جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه، وأنهم إنما دخلوا في الإسلام ولم يزلا في تردد فيه، وغير ذلك، وأنه قال في غضون ذلك: لا أقول إن عثمان قُتل مظلوماً ولا ظالماً، وهذا عندي لا يصح من علي رضي الله عنه. وموقف علي رضي الله عنه من قتل عثمان رضي الله عنه واضح، وقد بينته في كتابي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي هذا الكتاب.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي: