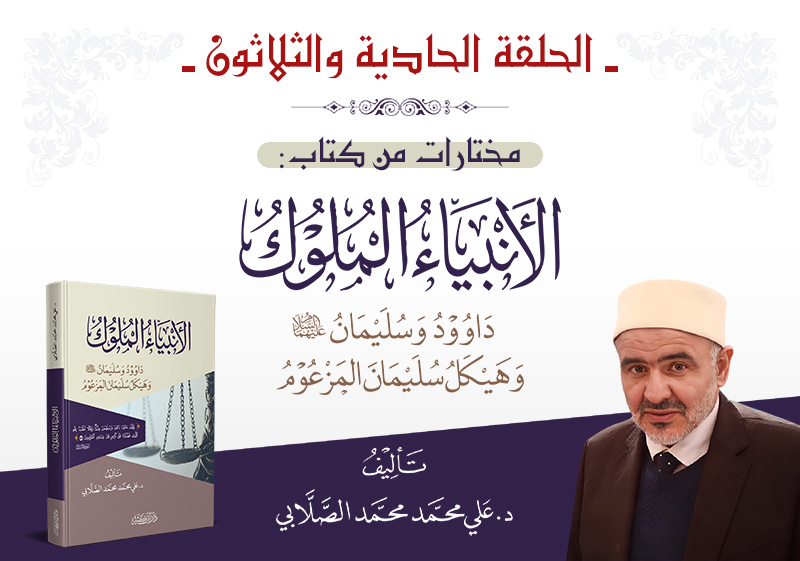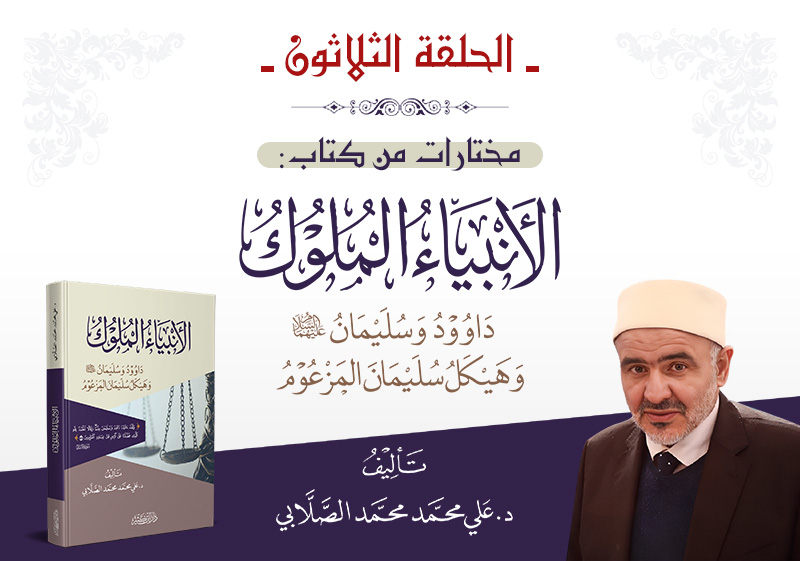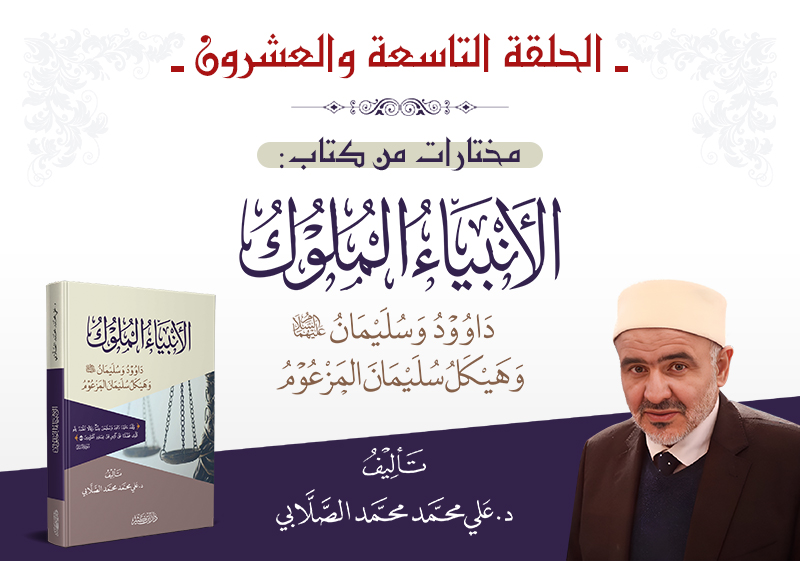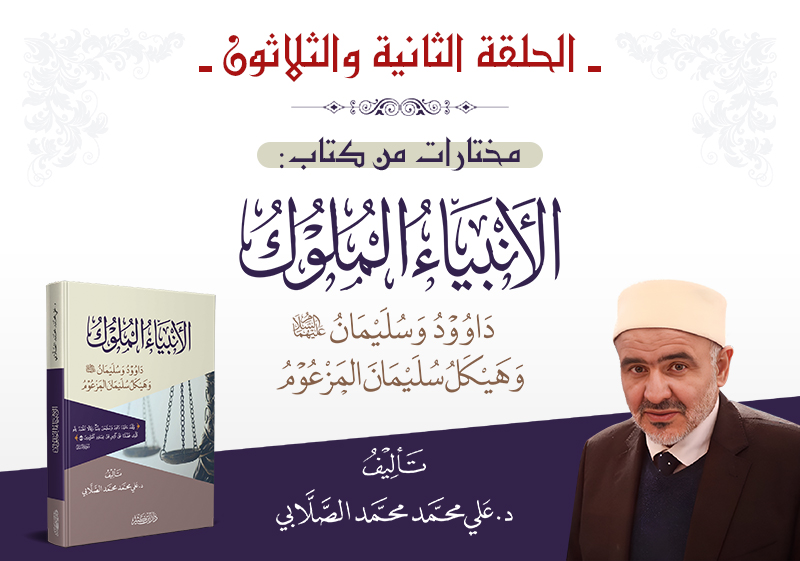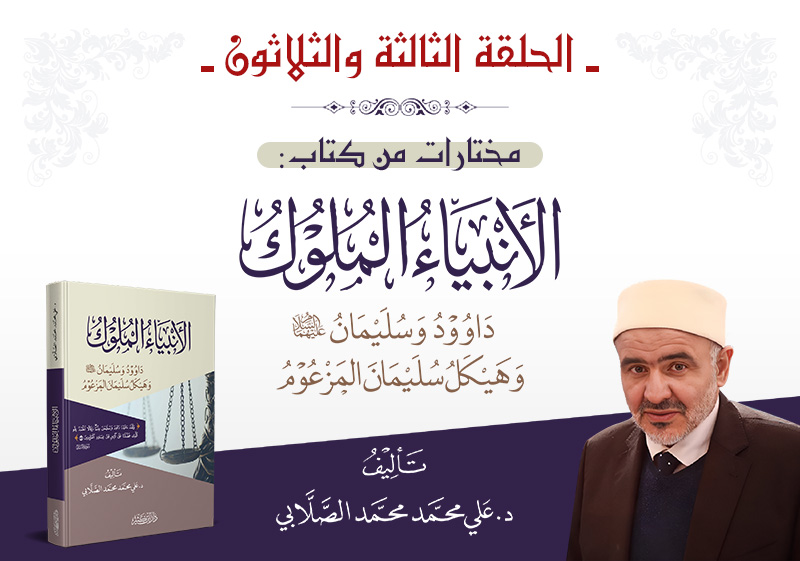سليمان عليه السلام والخيل: ذكر النعم موجبٌ لحمد الله تعالى وشكره ...
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك ...
بقلم د. علي محمد الصلابي ...
الحلقة (31)
قال تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33)﴾:
ولما عرضت الصافنات الجياد بحيويتها وجمالها وسرعتها، وقت العشي على سليمان (عليه السلام)، حمد الله على ما أنعم به عليه وقال: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾.
﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ بِمَعْنى أنَّ هَذِهِ المَحَبَّةَ الشَّدِيدَةَ إنَّما حَصَلَتْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وأمْرِهِ لا عَنِ الشَّهْوَةِ والهَوى، وهَذا الوَجْهُ أظْهَرُ الوُجُوهِ.
فكأنه ذاكر لربه عندما يحب الخيل، وحبه لها ذكر منه لله، إذ يحمد الله ويشكره على إنعامه عليه بها، فكلما يراها يشكر ربه ويذكره، كما أن إعداده لها وإشرافه عليها صورة من صور عبادته وذكره لربه.
- ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾: الكلام عن الخيل التي أحبها، ومعنى ﴿تَوَارَتْ﴾ اختفت. والحجاب: هو شيء كان يحجبها عن سليمان، كأن يكون جبلاً أو تلّاً. وتدل الجملة على أن سليمان (عليه السلام) كان يراقب خيلاً ويشرف عليها، ويمرنها على الجري والعدو، لتكون دائماً جاهزة للجهاد.
ويبدو أنه أمر بركض الخيل وعَدْوها، فلما رآها تجري وتسبح في الميدان حمد الله على ذلك واعتبر حبه للخيل صورة من صور ذكره وشكره لله، وقال: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾:
وبقي ينظر إلى الخير السابحة في الميدان معجباً، حتى توارت واختفت وراء الجبل الذي حجبها. ولما تورات وغابت عن ناظريه، قال: ﴿رُدُّوهَا عَلَىَّ﴾، ومعنى ذلك: أعيدوها إليّ، فأعادوها له، ولما رآها أمامه صار يمسح عليها: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ﴾.
وإنّ السوق جمع ساق، والمراد بها سيقان الخيل، والأعناق جمع عنق. والمعنى أنّ سليمان صار يمسح على سيقان وأعناق الخيل، ويمرر أصابعه عليها برقّة. ملاعبة منه للخيل وتكريمًا لها، وإظهارًا لاهتمامه بها ومحبته لها. ومعلوم أن الخيل تحب هذه الحركة اللطيفة من صاحبها، وتأنس به عندما يمسح على سوقها وأعناقها وأعرافها وجسمها، فتزداد وفاءً له وتعلقًا به، كما تزداد إقدامًا في الجهاد.
Top of Form
هذه حادثة سليمان (عليه السلام) مع الخيل الصافنات الجياد، وهذا فهم الحادثة كما عرضتها آيات القرآن عندما نستبعد الإسرائيليات التي سجلت الاتهام لسليمان (عليه السلام)، بانشغاله بالخيل عن ذكر الله، ثم ندمه بعد ذلك وقتله لتلك الخيل!
أ- ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾: هناك من العلماء من يقول إن الخيل هي التي تورات بالحجاب، وهناك من يقول إن التي تورات بالحجاب هي الشمس.
- القول الأول: اختاره ابن جرير والرازي وغيرهما وهو أنه: ما فاتته صلاة ولا شيء أبداً، وإنما عرضت عليه الخيل وسلامه عليه، وتوارت أي: الخيل. وتبقى هنا إشكالية ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ قالوا: عن بمعنى من، فهي من ذكر ربي، واستدلوا على هذه بأدلة منها.
أولاً: قالوا: الخيل مذكورة: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾. والصافنات الجياد هي الخيل، ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي: الخيل ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أيضاً الخيل. ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ أيضاً الخيل، فأين ذكرت الشمس، لا ذكر للشمس في الآيات أبداً فمن أين أتيتم بقصة الشمس؟
ثانياً: لا يليق بالأنبياء أن يؤخّروا الصلاةَ، وتشغلهم الدنيا أو النظر في الخيل عن أداء الواجبات.
ثالثاً: الأصل بأن يعود الضمير إلى أقرب مذكور: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ﴾ الخيل ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ الخيل ﴿عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ﴾ المفروض: الخيل. ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ الخيل.
رابعاً: إذا فاتته الصلاة فلماذا يعاقب الخيل ويقتلها؟ وما ذنب الخيل؟ لأنه هو الذي فاتته الصلاة، بل كان عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى.
خامساً: وأما مسحه عليها تشريفاً لها، وتكريماً، أو أنه مسح صلوات الله وسلامه عليه لتواضعه مع أنه الملك، أو أنه كان عليماً بأحوال الخيل، فكان ينظر إليها ويتفقدها هل هي مريضة حتى يطمئن عليها.
القول الثاني: قالوا: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ الخيل، ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ الخيل، ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ﴾ أي الشمس، ﴿بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ أيّ: الخيل، ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ فقتل الخيل. واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾؛ ذكرُ العشي له معنى، والعشي وقت الزوال، فلما ذكر العشي ثم تورات بالحجاب إذن هي الشمس، لارتباط الشمس بالعشي، ثم كذلك قوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ﴾ (عن) على ظاهرها، والأصل أنها عن ذكر ربي وليس من ذكر ربي، فهي شغلته عن ذكر ربه تبارك وتعالى، قالوا: ويحتمل أنها صلاة العصر، ويحتمل أيّ وِرْدٍ من الذكر كان له، وليس شرطاً أن يكون ترك واجباً، لكن ممكن أن يكون ترك أمراً مستحباً.
وإن الأصل بأن تؤخذ الآية على ظاهرها: ﴿عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ ولماذا قتلها إذن؟ قالوا: قتلها وأمر الناس أن يأكلوها، ولماذا فعل ذلك؟ قالوا: لئلا تشغله مرة ثانية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما تأخر عن الصلاة تبرع ببستانه لئلا يشغله مرة ثانية عن الصلاة، قالوا: وقد يكون هذا سائغاً في شريعتهم، لأن الشرائع تختلف، بل قد جاء في شريعتنا ما يؤيد ذلك، وذلك لما ذهب النبي ﷺ إلى تبوك ومروا بمدائن صالح طبخوا في القدور فأمر بكسر القدور وإراقة الطعام صلوات الله وسلامه عليه، حتى قالوا له: أو نغسلها ولا نكسرها؟ فقال: اغسلوها لكن أمر بإراقة الطعام، لأنهم لا يجوز لهم أكله، ومع هذا أمر بكسر تلك القدور.
ودليل على ذلك بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولذلك جاءت الآية التي بعدها أن الله عوضه بالريح: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ﴾. فلما ترك الخيل لله عز وجل عوضه الله بالريح وهي أقوى من الخيل وأسرع، ولا تحتاج مؤونة ولا كلفة ولا عناية ولا شيء، فعوضه الله خيراً من الخيل لما تركها لله جل وعلا. وقد قال الشيخ عثمان الخميس: فالقصد أن كلا الأمرين محتمل، يحتمل أنه أراده حتى توارت بالحجاب الشمس، ويحتمل حتى توارت بالحجاب الخيل، والعلم عند الله عز وجل.
وذهب الدكتور صلاح الخالدي إلى ترجيح بأن الخيل هي التي توارت بالحجاب، فقال: إننا نعلم أن سليمان (عليه السلام) كان رجل جهاد، وأنه خاض معارك إيمانية ضد الكفار، وكانت الخيل من أسلحة الحرب، المعروفة. ولذلك كان سليمان محباً للخيل، لهذا الهدف الجهادي العظيم، الذي يحقق له الخير، وكان يعتبر حبه للخيل وإعدادها للجهاد صورة من صور ذكره لربه.
4- القول الراجح في المسح بالسوق والأعناق:
إنّ ما ورد عن نبي الله سليمان (عليه السلام) من روايات تنسب إليه أنه قطع أعناق الخيل وأرجلها، لا يثبت منها شيء بالدليل من الكتاب والسنة. ويقول صاحب كتاب محاسن التأويل: إن الإمام ابن حزم سبق الإمام الرازي في هذا الرأي؛ يقول ابن حزم: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة، خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت أفانين من القول؛ لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها، والتمثيل بها، وإتلاف مال منتفع به بلا معنى، ونسبة تضييع الصلاة إلى نبيّ مرسل، ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخير، وذلك من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجابها، ثم أمر بردها، فطفق مسحاً بسوقها وأعناقها بيده، برّاً بها وإكراماً لها، وإن هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره. وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين. فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ؟
إن المسح بالسوق والأعناق يجب صرفه على الحقيقة لا المجاز، فالمسح كان باليد حبًّا لها وتكريماً؛ لأنه الأليق بأنه يعد لأعدائه ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل ليحمي دين الله ويرهب عدوه. وهذا القول فيه بعد، عن نسبة الظلم إلى سليمان (عليه السلام)، بذبح الخيل بدون ذنبٍ جَنَتْه، كما أننا لا نجد فيما ورد من كتب التفسير حديثاً مسنداً إلى النبي ﷺ أو أثراً معتمداً عن بعض أصحابه رضي الله عنهم.
وقد تحدث الإمام الرازي -رحمه الله- عن هذه المسألة، فقال:... أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين محمد ﷺ. ثم إن سليمان (عليه السلام) احتاج إلى الغزو، فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله (عن ذكر ربي)، ثم إنه (عليه السلام) أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره، ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها، والغرض من ذلك المسح أمور؛ الأول: تشريفًا لها وإبانةً لعزّتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. والثاني: أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. والثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقا، ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات.
وأرى تبرئة سليمان (عليه السلام) من الغفلة عن ذكر الله أو الصلاة كما قال بعض المفسرين، وكذلك تبرئته من قتل الخيل لعدم صحة الحكايات الواردة سنداً، وكذلك بطلانها متناً؛ لتنافيها مع عظمة الأنبياء. والله أعلم.
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 161-167.
- تفسير مفاتيح الغيب، للرازي، (13/188).
- القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، صلاح الخالدي، دار القلم، دمشق - الدار الشامية، بيروت، ط1، 1419ه - 1998م، ص (3/487).
- فبهداهم اقتده: "قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء"، عثمان محمد الخميس، دار إيلاف الدولية، الكويت، ط1، 1431ه - 2010م، ص313.
- مسند أحمد، رقم 5948.
- الفصل في الملل، والنِّحل والأهواء، لابن حزم، مكتبة السَّلام العالميَّة، ط1، 2010م، ص (4/20).
- تفسير الرازي، (23/204).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي:
https://www.alsalabi.com/salabibooksOnePage/689