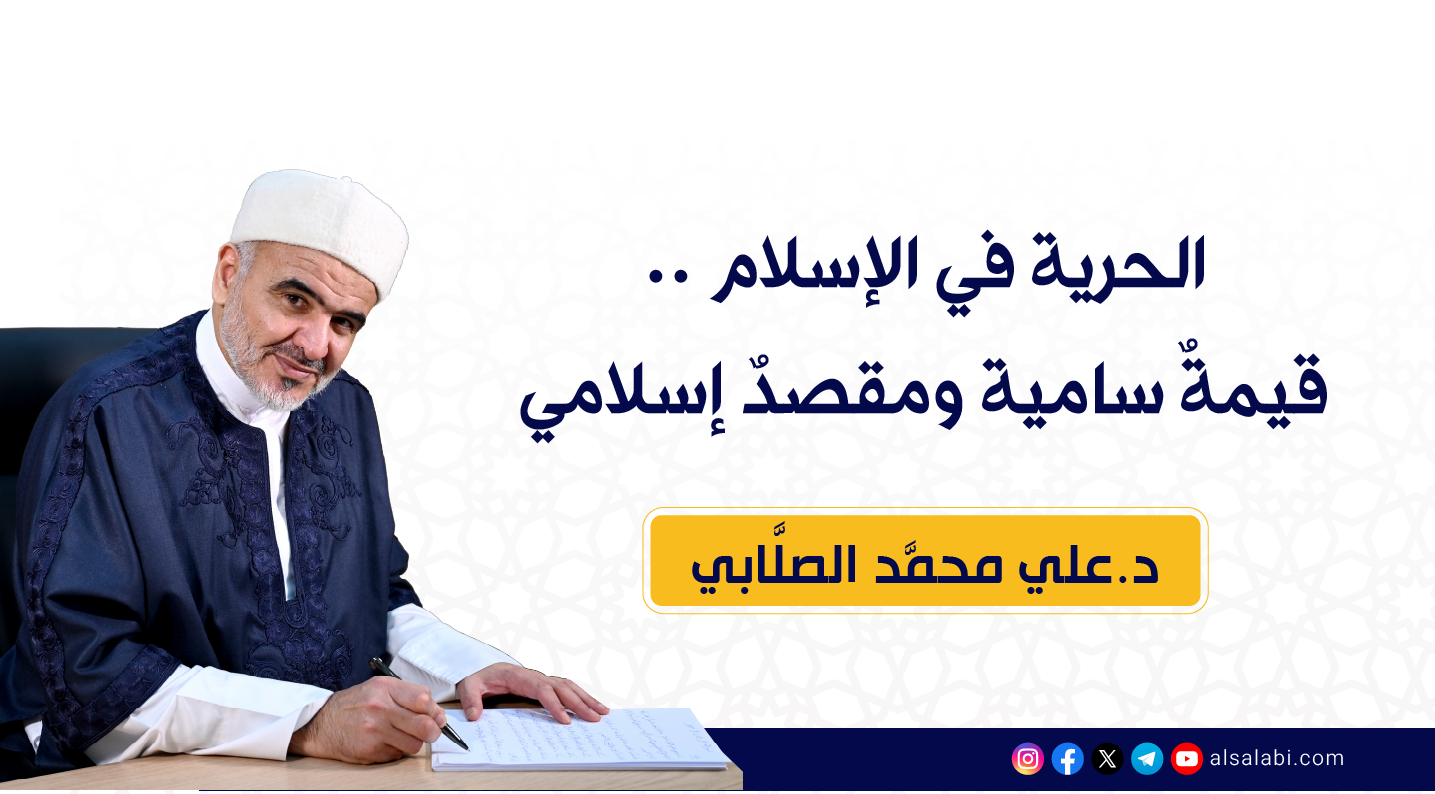الحرية في الإسلام .. قيمةٌ سامية ومقصدٌ إسلامي
بقلم: د. علي محمد الصلابي
إن أعلى صور الحرية هي حرية العبودية لله تعالى، فإن توحيد الله عز وجل وعبادته هو أسمى معنى لحرية الإنسان، حيث تتحرر النفس البشرية والعقل الإنساني من القيود الوثنية وعبادة الفرد لغير الله، والحرية في الإسلام هي ضد عبودية الخلق للخلق، وضد الرق والوثنية والظلم، وهي حرية الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، فلا حرية للفرد على حساب المجتمع، ولا حرية للمجتمع على حساب الفرد، فهي حرية الفكر المنطلِق إلى طريق الحق وإلى الإبداع والتجدد والاجتهاد، ويأتي مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي منطلقاً من أن الإسلام أشار لتحرر الفرد من كل خوف، وإعلاءً له عن كل شرك (1). ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما والأمة من بعده أن يرفعوا الأغلال عن عقولهم، لأن الآجال والأرزاق والنفع والضر بيد الخالق، فقال صلى الله عليه وسلم: "" يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفَّت الصحف"".
كما نهى الإسلام عن التبعية المقيتة والسلبية القاتلة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة رضي الله عنه: "" لا تكونوا إمَّعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنَّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا». وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضي الله عنهما قولته المشهورة: "" متى استعبدْتُمُ الناس وقد ولدتْهم أمهاتُهم أحراراً؟! "". وجعل ربعي بن عامر رضي الله عنه تحرير الناس هو جوهر الإسلام لما سأله رستم عن سبب مجيء المسلمين إلى الفرس، فقال: "" الله ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله "" (2).
إن الحرية في المفهوم الإسلامي قيمة كبرى تحتل من سلَّم المقاصد الدينية الدرجات العليا، وهي قيمة ثابتة تتصف بالديمومة في الزمان والمكان. والحرية من صميم أصول الدين وليست من فروعه، ولعل أول ما يبدو ذلك في عقيدة التوحيد، فجوهر هذه العقيدة هو أن يكون الإنسان مسلماً نفسه فيما يأتي وما يذر لله تعالى وحده، وهو ما يقتضي أن يكون متحرراً من كل ما سواه، فعقيدة الوحدانية تنفي أن يكون المؤمن بها خاضعاً لأي سلطان سوى الأمر الإلـهي، سواء تمثَّل في سلطان داخلي في شهوات النفوس وأهوائها، أو في سلطان خارجي من عادات وتقاليد الآباء أو سطوة الحكام ورجال الدين، أو أوهام العناصر الطبيعية، فالحرية التي جاء الإسلام يشرعها للناس هي هذه الحرية التي تتضمنها عقيدة التوحيد (3).
- الإسلام وتحرير الإنسان:
بدأ الإسلام بتحرير الإنسان من داخله، فحرره من العبودية لغير الله، وجعل العبودية لله وحده، ووفق ذلك لا يهون ولا يذل ما دامت عزته بالله، فمن أراد العزة بغير الله فقد أذلَّه الله، فهذه الحرية هي الأساس لعزة المؤمنين المستمدة من عزة الله سبحانه وتعالى، وقد حقق الإسلام ذلك للناس حين حررهم من الخوف على الحياة والرزق والمنصب، وحرره من التبعية للآخر ومن الخضوع لشهواته ومن نوزاع النفس الأمارة بالسوء كالكبر والغرور والحسد والطمع وغيرها، وهناك الكثير من الآيات الدالة على هذه المعاني:
قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ [فاطر: 10]، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [سورة آل عمران: 145]، ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]، ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]، ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [القصص: 60]. كل تلك الآيات تزرع في النفس الإنسانية معاني العزة والأنفة والاستغناء بالخالق عن الخلق، وتجعل الإنسان المسلم حراً عزيزاً في ذاته وأمام الآخرين، وهذا العلم اليقين يغنيه عن غير الله، وينزع من قلبه خوف سواه، فلا يطأطئ رأسه أمام أحد من الخلق، ولا يتضرع إليه ولا يتكفف له، ولا يرتعب من كبريائه وعظمته (4).
- الإسلام وحرية المجتمع:
الإسلام يكفل للمجتمع الإسلامي حريته، فمن الضروري أن يكون المجتمع الإسلامي حرّاً، وأن يشعر الفرد بحريته، ليس داخل المجتمع فحسب بل لابد أن يشعر أيضاً أن مجتمعه الذي يعيش فيه حرّ، فحرية الفرد من حرية المجتمع كلاهما متلازمان، فالمجتمع الذي يعيش تحت وصاية دخيل أو تسلط أجنبي لا تكون إرادة أبنائه نابعة من أنفسهم. وإن المجتمع الإسلامي في طبيعته لا يقبل العيش تحت ضغط مستبد، أو تحت قبضة سلطان جائر، فإن ذلك يشله ويُخرجه عن رسالته وعن الصبغة التي أرادها الله له وميَّزه بها عن سائر المجتمعات، فالمجتمع الإسلامي يحقق رغبات أبنائه وسعادتهم وأمنهم، فكيف يعيش في خضوع وخنوع وتحت سيطرة وعبودية الأخرين وهو قائم لتحقيق الحرية في مشارق الأرض ومغاربها، وتأسيس الكرامة الإنسانية، ويسعى لتحقيق شروط الإيمان التي جاءت في قول الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [ النور: 55] (5)، كما يكفل الإسلام للفئات الاجتماعية المختلفة والأقليات الدينية حرياتها الأساسية وكرامتها الإنسانية، كحرية الاعتقاد والتدين وممارسة الشعائر والحقوق المدنية والقضائية الخاصة بهم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
- الأصل في الإنسان الحرية، والأصل في الأشياء الإباحة:
الأصل في الناس الحرية، وقد تواتر ذكر هذا الضابط والنص عليه في أقوال الفقهاء، وعللوا لهذا الأصل بأن: الحرية هي الظاهر ، والرق طارئ. وإن الناس - جميع الناس - أحرار بلا بيان، حتى في الشهادة والقصاص والحدود والديات، لإلغاء الرق عالميّاً، والفقهاء لم يدعوا إلى الرق ، وإنما نظموا أحكامه وقت وجوده؛ لأن الناس احتاجوا إلى وقت ليفيئوا إلى أصل الحرية (6). ونظم للرق الأحكام والقواعد الخاصة بالتعامل معه كظاهرة موجودة بحكم الأمر الواقع، ولكنها ظاهرة لا يقرها كأصل وكحالة طبيعية وإنما يدعو المسلمين إلى تحرير الناس منها، وعتق رقابهم. فحق الحرية مقرّر على أوسع نطاق، ومقيد أيضاً بأنفع ما يمكن من قيود الحق، والمصلحة العامة والخاصة المشروعة، وهناك آيات عديدة فيها إباحة للمسلمين وحرية لهم بممارسة أمور متنوعة نزلت في مناسبات واستفتاءات وأسئلة، ومنها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: 168]، وهذا أمر بالإباحة والحِلِّ لما في الأرض إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القران ، وهذا يمثل طلاقة العقيدة وتجاوبها مع فطرة الناس ، فالله خلق ما في الأرض للإنسان ، ومن ثم جعله له حلالاً لا يقيده إلا أمر خاص بالحظر ، وألا تتجاوز دائرة الاعتدال والقصد ، ولكن الأمر في عمومه أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة ، واستجابة للفطرة بلا حرج ولا تضييق.. كل أولئك بشرط واحد هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق، لا من إيحاء الشيطان الذي لا يوحي بخير لأنه عدو للناس بيِّنُ العداوة (7).
المصادر والمراجع:
1. محمد نجيب أبو عجوة، المجتمع الإسلامي دعائمه وآدابه في ضوء القرآن الكريم، ص 176.
2. علي محمد الصلابي، الحريات من القرآن الكريم، الطبعة الأولى، 2013، ص 6-7.
3. عبدالمجيد النجار، مراجعات في الفكر الإسلامي، ص 169-170.
4. أبو الأعلى المودودي، مبادئ الإسلام، ص 92.
5. محمد نجيب أبو عجوة، المجتمع الإسلامي دعائمه وآدابه في ضوء القرآن الكريم، ص 194.
6. محمد محمود الجمال، الحرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، ص 51-52.
7. سيد قطب، في ظلال القرآن، ص 1/219.