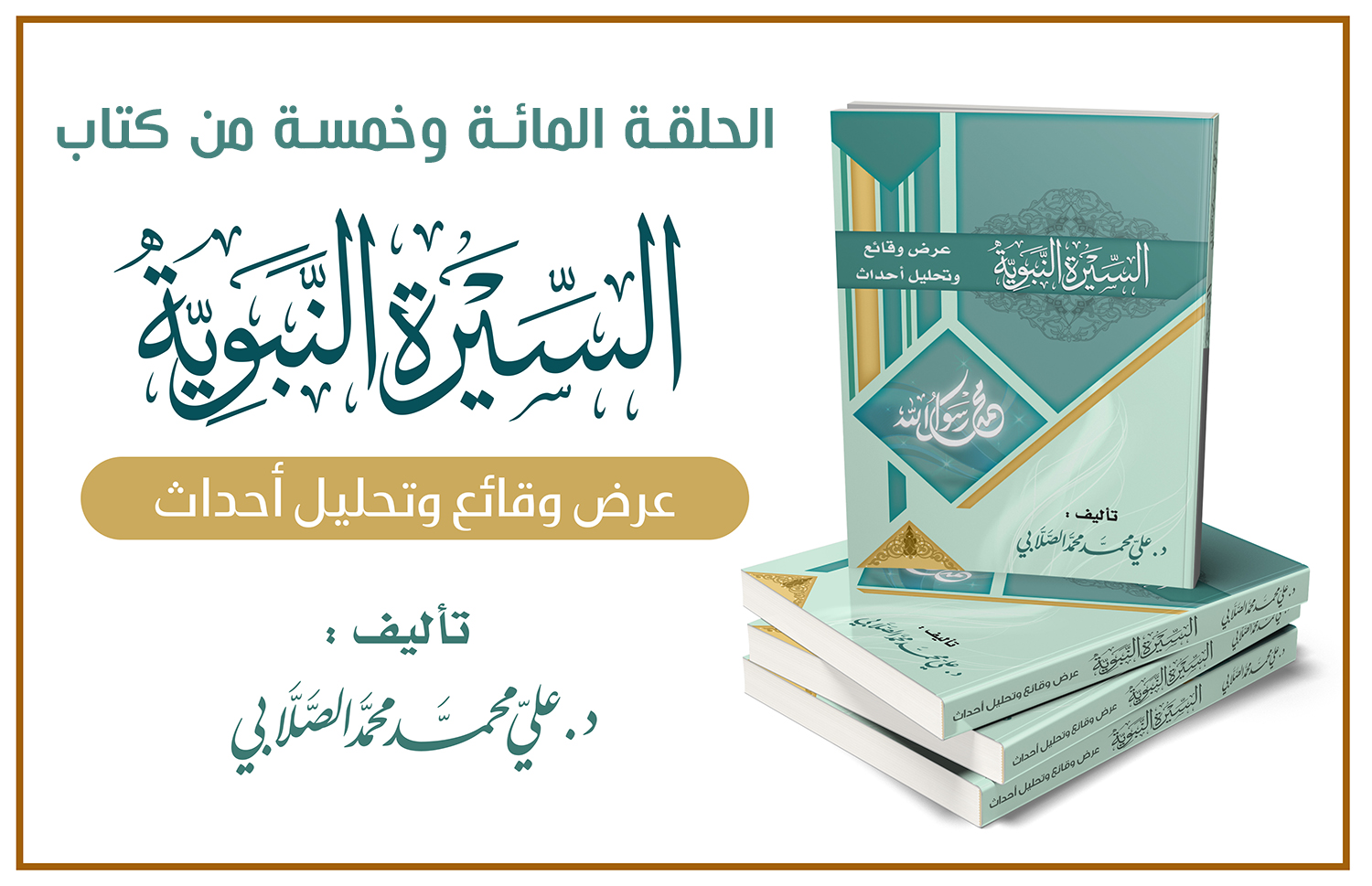الحلقة الخامسة بعد المئة (105)
في غزوة الحديبية .. دروسٌ, وعبرٌ, وفوائد
كانت غزوة الحديبية غنيَّة بالدُّروس العقائديَّة, والفقهيَّة, والأصوليَّة, والتَّربويَّة... إلخ, وسوف أذكر منها بعض الدُّروس على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: أحكام تتعلَّق بالعقيدة:
1 - حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس:
في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالسَّيف - ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد - سنةٌ يقتدى بها عند قدوم رسل العدوِّ من إظهار العزِّ, والفخر, وتعظيم الإمام, وطاعته, ووقايته بالنُّفوس, وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين, وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين, وليس هذا النَّوع الَّذي ذمَّه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «مَنْ أحبَّ أن يتمثَّل له الرِّجال قياماً؛ فليتبوأ مقعده من النَّار». [أبو داود (5229), والترمذي (2755)].
كما أنَّ الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النَّوع المذموم في غيره, ويشبه هذا ما فعله أبو دجانة في غزوة أحدٍ, فكلُّ ما يدلُّ على التكبُّر، أو التجبُّر في المشي ممنوع شرعاً، ولكنَّه جائزٌ في حالة الحرب بخصوصها, بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عن مشية أبي دُجانة: «إنَّها مشيةٌ يكرهها الله إلا في هذا الموضع». [الطبراني في المعجم الكبير (65085), ومجمع الزوائد (6/109)].
2 - استحباب الفأل, وأنَّه مغاير للطِّيرة:
لـمَّا جاء سُهيل بن عمروٍ لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال رسول الله «سهَّل أمركم». ففي الحديث استحباب التفاؤل, وأنَّه ليس من الطِّيرة المكروهة.
وقد جـاءت أحاديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تبيِّن معنى الفـأل، قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا طيرة، وخيرُها الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟! قال: «الكلمة الصَّالحة يسمعُها أحدُكم» [البخاري (5754 و5755)، ومسلم (2223/110)].
والفرق بين الفأل، والطِّيرة: أنَّ الفأل من طريق حسن الظَّنِّ بالله، والطِّيرة لا تكون إلا في السُّوء، فلذلك كُرِهَتْ.
وقد ذُكِرَتِ الطِّيرة عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنها الفأل، ولا تردُّ مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فليقل: اللّهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السَّيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوَّة إلا بك». [أبو داود (3919)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/139)].
3 - بيان كفر من اعتقد: أنَّ للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر:
قال خالدٌ الجهنيُّ رضي الله عنه: صلَّى لنا - أي: من أجلنا، أو بنا - رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصُّبح بالحديبية - على أثر سماءٍ كانت من اللَّيلة - فلـمَّا انصرف؛ أقبل على النَّاس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله، ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي، وكافر، فأمَّا مَنْ قال: مُطِرنا بفضل الله، ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب، وأمَّا مَنْ قال: بِنَوْءِ كذا، وكذا؛ فذلك كافرٌ بي، ومؤمنٌ بالكوكب». [البخاري (846)، ومسلم (71)].
وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقاديِّ، أو كفر النِّعمة بحسب حال القائل. فمن قال: مُطرنا بنوء كذا معتقداً: أنَّ للكوكب فاعلية، وتأثيراً في إيجاد المطر فهو كافرٌ كفراً مخرجاً من الملَّة، قال الشَّافعيُّ: مَنْ قال: مطرنا بنوء كذا، وكذا على ما كان أهل الجاهليَّة يعنون من إضافة المطر إلى أنَّه بنوء كذا، فذلك كفرٌ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنَّ النَّوء وقتٌ، والوقت مخلوقٌ لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في وقت كذا؛ فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحبُّ إليَّ منه.فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقاديَّ.
4 - هل يجوز التبرُّك بفضلات الصَّالحين، وآثارهم؟
ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله؛ قال: فو الله ما تنخَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامةً إلا وقعت في كف رجلٍ منهم، فدلك بها وجهه وجلدَه... وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون على وضوئه.
وقد علق الشَّاطبيُّ على هذا الحديث، وأحاديث أخرى تماثله، فقال: فالظَّاهر في مثل هذا النَّوع أن يكون مشروعاً في حقِّ مَنْ ثبتت ولايتُه، واتِّباعه لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يُتبرَّك بفضل وضوئه، ويُتدلَّك بنخامته، ويُستشفى باثاره كلِّها، إلا أنَّه عارضنا في ذلك أصلٌ مقطوعٌ به في متنه مشكلٌ في تنزيله، وهو أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحدٍ منهم في شيءٍ من ذلك بالنِّسبة إلى مَنْ خَلَفَه؛ إذ لم يترك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد موته، أفضل من أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه، فهو كان خليفتُه، ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه وهو كان أفضل الأمَّة بعده، ثمَّ كذلك عثمان، ثمَّ عليٌّ، ثمَّ سائر الصحابة الَّذين لا أحد أفضل منهم في الأمَّة، ثمَّ لم يثبت لواحدٍ منهم من طريقٍ صحيحٍ معروفٍ أنَّ متبرِّكاً تبرك به على أحد تلك الوجوه، أو نحوها؛ بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال، والأقوال، والسِّير الَّتي اتَّبعوا فيها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.
وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ؛ قال: حدَّثني رجلٌ من الأنصار: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ، أو تنخَّم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه، ونخامته، فشربوه، ومسحوا به جلودهم، فلـمَّا راهم يصنعون ذلك؛ سألهم: «لم تفعلون هذا؟» قالوا: نلتمس الطَّهور، والبركة بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كان منكم يحبُّ أن يحبَّه الله، ورسولُه؛ فَلْيَصْدُقِ الحديث، ولْيُؤَدِّ الأمانة، ولا يؤذِ جاره». [عبد الرزاق في المصنف (19748)، وذكره الألباني في الصحيحة (2998)].
وهذا الحديث أفاد أنَّ الأَوْلى ترك التبرُّك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعلَّ سكوت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك يوم الحديبية ليرى عروةُ بن مسعود رسولُ قريشٍ مدى تعلُّق الصَّحابة رضي الله عنهم بالنَّبي صلى الله عليه وسلم وحبِّهم له، لا سيَّما وقد قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : إنِّي لأرى أشواباً من النَّاس خليقاً أن يفرُّوا، ويدعوك [سبق تخريجه]. هذه بعض المسائل العقائديَّة.
ثانياً: أحكام فقهيَّة وأصوليَّة:
1 - قصَّة كعب بن عجرة، ونزول آية الفدية:
قال كعب بن عُجرة رضي الله عنه: وقف عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأسي يتهافت قملاً، فقال: «أيؤذيك هوامُّك؟» قلت: نعم. قال: «فاحلق رأسك». أو قال: «احلق» قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196] فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : «صم ثلاثة أيامٍ، أو تصدَّق بفَرَقٍ بين ستَّةٍ، أو انْسُكْ بما تيسَّر» [البخاري (1815)، ومسلم (1201/82)].
وفي رواية مسلمٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ به؛ وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكَّة، وهو مُحْرِمٌ، وهو يُوقِدُ تحت قِدْرٍ، والقملُ يتهافتُ على وجهه، فقال: «أيؤذيك هوامُّك هذه؟» قال: نعم. قال: «فاحْلِقْ رأسَك، وأطْعِمْ فَرَقاً بين سِتَّةِ مساكينَ - والفَرق: ثلاثةُ اصُعٍ - أو صُمْ ثلاثة أيامٍ، أو انسُكْ نسيكة» [مسلم (1201/83)، والترمذي (2974)]. وايـة البقرة المذكـورة تبيِّن حـكم مَنْ كان محرماً وبه أذى من رأسه، وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصَّة، وأصبح لكلِّ مسلمٍ يمرُّ بالحالة نفسِها.
2 - مشروعية الصَّلاة في الرِّحال:
روى ابن ماجه عن أبي المليح بن أسامة؛ قال: خرجت إلى المسجد في ليلةٍ مطيرةٍ تماماً، فلـمَّا رجعت استفتحتُ، فقال أبي: مَنْ هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماءٌ لم تبلَّ أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلُّوا في رحالكم» [أبو داود (1059)، والنسائي (2/111)، وابن ماجه (936)]. وهذا الحديث صحيحٌ، فسنده متَّصلٌ برواية الثِّقات، وقد صحَّحه ابن حجر.
3 - انصراف المسلمين من الحديبية، ونومهم عن صلاة الصُّبح:
كانت مدَّة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً، ويقال: عشرين ليلةً على قول الواقديِّ، وابن سعدٍ.
وعن ابن عائذٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في غزوته هذه شهراً ونصفاً.
والَّذي يبدو: أنَّ الواقديَّ، وابن سعدٍ أرادا تحديد مدَّة إقامته صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أما ابن عائذٍ فقصد الزَّمن الَّذي استغرقته غيبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها.
وبعد أن تحلَّل المسلمون من عمرتهم تلك؛ قفلوا راجعين إلى المدينة، فلـمَّا كان من اللَّيل عدلوا عن الطَّريق للنَّوم، ووكَّلوا بلالاً بحراستهم، فنام بلالٌ، ولم يوقظهم إلا حرُّ الشَّمس، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يكلؤنا؟». فقال بلالٌ: أنا. فناموا حتَّى طلعت الشَّمس، واستيقظ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» [أبو داود (447)، والنسائي في السنن الكبرى (8802)، وأحمد (1/386 و391)].
وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أنَّ قصَّة نومهم عن صلاة الصُّبح وقعت في غير الحديبيـة، وحاول بعض العلماء التَّوفيق بين هـذه النُّصوص، وذهب الدُّكتور حافظ الحكمي إلى أنَّ ما ورد من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود في قصَّة الحديبية وغيره محمولٌ على تعدُّد القصَّة، كما رجَّح ذلك النَّوويُّ، وجنح إليه ابنُ كثيرٍ، وابن حجرٍ، والزُّرقانـيُّ، بل قال السُّيوطيُّ: لا يجمع إلا بتعدُّد القصَّة.
4 - مشروعية الهدنة بين المسلمين، وأعدائهم، ومقدار المدَّة التي تجوز المهادنة عليها:
استدلَّ العلماء، والأئمَّة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنةٍ بين المسلمين، وأهل الحرب من أعدائهم إلى مدَّةٍ معلومةٍ، سواءٌ أكان ذلك بعوضٍ يأخذونه منهم، أم بغير عوضٍ، أمَّا بدون عوض فلأنَّ هدنة المدينة كانت كذلك، وأما بعوضٍ فبقياس الأولى؛ لأنَّها إذا جازت بدون عوضٍ، فلأن تجوز بعوض أقرب، وأوجه.
وأمَّا إذا كانت المصالحة على مالٍ يبذله المسلمون، فهو غير جائزٍ عند جمهور المسلمين، لما فيه من الصَّغَار لهم؛ ولأنَّه لم يثبت دليلٌ من الكتاب، أو السُّنَّة على جواز ذلك، قالوا: إلا إنْ دعت إليه ضرورةٌ لا محيص عنها، وهو أن يخاف المسلمون الهلاك، أو الأسر؛ فيجوز، كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال.
وقد ذهب الشَّافعيُّ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئمَّة إلى أنَّ الصُّلح لا ينبغي أن يكون إلا إلى مدَّةٍ معلومةٍ، وأنَّه لا يجوز أن تزيد المدَّة على عشر سنواتٍ مهما طالت؛ لأنَّها هي المدَّة الَّتي صالح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قريشاً عليها عام الحديبية.
وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة، وهو قول أبي حنيفة.
والتَّحقيق: أنَّ القول الأول هو الرَّاجح لظاهر الحديث، وإنْ وُجِدت مصلحةٌ في الزيادة على العشر جدَّد العقد، كما قال الشَّافعي.
وقال بعض المتأخِّرين: يجوز عقد صلحٍ مؤبَّد غير مؤقَّتٍ بمدَّةٍ معيَّنةٍ، واستدل بقوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 90].وهذا قولٌ مبنيٌّ على أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بالكفَّار هي السَّلم، لا الحرب، وأنَّ الجهاد إنَّما شرع لمجرد الدِّفاع عن المسلمين، فحسب(5).
وهذا القول مردودٌ لما يلي:
أ - أنَّ صاحب هذا القول قد خرق الاتِّفاق بعد أن حكاه بنفسه؛ حيث قال: اتَّفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدوِّ لابدَّ من أن يكون مقدوراً بمدَّة معيَّنةٍ، فلا تصح المهادنة مطلقةً إلى الأبد من غير تقديرٍ بمدَّة.
ب - الآية الَّتي استدل بها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 5].
فقد نقل ذلك ابن جرير عن عكرمة، والحسن، وقتادة، وابن زيد، وحكاه القرطبيُّ عن مجاهدٍ. ثمَّ قال: وهو أصحُّ شيءٍ في معنى الآية.
ج - الأصل الَّذي انبنى عليه هذا القول مردودٌ بآية براءة السَّابقة، وبواقع سيرة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وخلفائه مع أعدائهم.
د - أمَّا فكرة: أنَّ الجهاد إنَّما شرع للدِّفاع عن المسلمين، فهي فكرةٌ دخيلةٌ، وقد تصدَّى لها سيِّد قطب رحمه الله، ففنَّدها، وبيَّن: أنَّ سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين، وعدم الفهم لمرحليَّة الدَّعوة.
5 - المُطْلَق يجري على إطلاقه:
هذه قاعدةٌ أصوليَّةٌ يؤيِّدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد: أنَّه قال: إنَّ بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لـمَّا قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله! إنَّك تدخل مكَّة آمناً؟ قال: «بلى! أفقلتُ لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا، قال: «فهو كما قال لي جبريلُ عليه السلام». [ابن هشام (3/341)].
وفي هذا الأثر تبشير المؤمنين بفتح مكَّة في المستقبل، وإيماءٌ بالوحي الصَّادق إلى ذلك النَّصر، ولفتٌ لهم إلى وجوب التَّسليم لأمره بإطلاقٍ كلَّما ورد مطلقاً دون تحميله زياداتٍ وقيوداً تصرفه عن إطلاقه.
6 - وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ، والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس، أو كرهته النُّفوس:
جاء في قصَّة الحديبية: أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وبعضَ الصَّحابة رضي الله عنهم كرهوا الصُّلح مع قريش(1)؛ لما رأوا في شروطها من الظُّلم، والإجحاف في حقِّهم، لكنَّهم ندموا بعد ذلـك على صنيعهم، ورأوا: أنَّهم وقعوا في حرجٍ؛ إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وظلَّت تلك الحادثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم، وكانوا يحذِّرون غيرهم من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرَّأي، فكان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول: (أيها النَّاس! اتهموا الرَّأي على الدِّين، فلقد رأيتُني أردُّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهاداً، فو الله! ما الو عن الحقِّ، وذلك يوم أبي جندل) [البزار (1813)، ومجمع الزوائد (6/145 - 146)].
وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: اتَّهموا رأيكم؛ رأيتُني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردَّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لرَدَدْتُه.
ولقد بقي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه برهةً من الزَّمن متخوفاً أن يُنزل الله به عقاباً لِلَّذي صنع يوم الحديبية، فكان رضي الله عنه يتحدَّث عن قصَّته تلك، ويقول: فما زلت أصوم، وأتصدَّق، وأعتق مِنَ الَّذي صنعت مخافة كلامي الَّذي تكلَّمت به يومئذٍ؛ حتَّى رجوت أن يكون خيراً. [ابن هشام (3/331)].
قال ابن الديبع الشَّيباني تعليقاً على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصَّة من وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرُ ذلك مقتضى القياس، أو كَرِهَتْهُ النُّفوس، فيجب على كلِّ مكلَّفٍ أن يعتقد: أنَّ الخير فيما أمر به، وأنَّه عين الصَّلاح المتضمِّن لسعادة الدُّنيا والآخرة، وأنَّه جاء على أتمِّ الوجوه وأكملها، غير أنَّ أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته، وعاقبة أمره.
ثالثاً: أنموذج من التَّربية النَّبويَّة:
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنيَّة ثَنيَّة المُرَارِ؛ فإنَّه يُحَطُّ عنه ما حُطُّ عن بني إسرائيل؟» [سبق تخريجه].
يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيمٌ من جوانب التَّربية النَّبويَّة يستحقُّ التأمُّل والتَّدبُّر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشجِّع أصحابه على صعود الثَّنيَّة، ثمَّ يخبرهم: أنَّ الذي يجتازها سينال مغفرةً من الله تعالى، وحين نتأمَّل هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمةٌ منها:
1 - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كلِّ لحظةٍ من لحظات حياتهم.
2 - أنَّه يريد لفت أنظارهم إلى أنَّ كلَّ حركةٍ يتحرَّكونها، وكلَّ عملٍ يقومون به - حتَّى ما يرون: أنه من العادات أو من دواعي الغريزة - يجب استغلاله للتَّزوُّد لذلك اليوم، وكان صلى الله عليه وسلم يسعى دائماً لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصَّحابة، فنراه يقول في موطنٍ اخر: «وفي بُضْعِ أحدكم صدقةٌ» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدُنا شهوته؛ ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجرٌ». [أحمد (5/167 و168)، ومسلم (1006)، وأبو داود (5243) و(5244)].
ويقول في موطنٍ ثالث: «وإنَّك مهما أنفقت من نفقةٍ فإنَّها صدقةٌ، حتَّى اللُّقمة الَّتي ترفعُها إلى في امْرَأتك». [البخاري (2742)، ومسلم (1628)].
إنَّ تلك المعاني - إذا تمكَّنت في قلب المسلم - لكَفِيْلةٌ بأن تصبُغَ حياته كلَّها بصبغة العبودية لله وحده، وإذا شملت العبادة كلَّ نواحي حياة المسلم؛ فإنَّ لهذا الشُّمول اثاراً مباركةً سوف يشعر بها الفرد في نفسه، ثم يلمسها فيمن حوله.
ومن أبرز تلك الآثار أمران:
أ - أن يصبُغ حياة المسلم وأعماله بالصِّبغة الرَّبَّانيَّة، ويجعله مشدوداً إلى الله في كلِّ ما يؤدِّيه، فهو يقوم به بنيَّة العابد الخاشع، وروح القانت المخبت، وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كلِّ عملٍ نافعٍ، وكلِّ إنتاجٍ صالحٍ، وكلِّ ما ييسِّر له، ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة، على أمثل وجوهها، فإنَّ ذلك يزيد رصيده من الحسنات، والقربات عند الله تعالى، كما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدُّنيويِّ، وتجويده، وإتقانه، ما دام يقدِّمه إلى ربِّه سبحانه ابتغاء رضوانه، وحسنِ مثوبته.
ب - أنَّه يمنح المسلم وحدة الوُجهة، ووحدة الغاية في حياته كلِّها، فهو يرضى رباً واحداً في كلِّ ما يأتي، ويدع، ويتَّجه إلى هذا الرَّبِّ بسعيه كلِّه الدِّينيِّ والدُّنيويِّ، لا انقسام، ولا صراع، ولا ازدواج في شخصيته، ولا في حياته.
ولقد عاش الصَّحابة الكرام تلك المعاني، وحوَّلوها إلى حقائق ملموسةٍ في حياتهم كلِّها، وما حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتديَ بهم في حياتنا، وتكونَ حجَّةً على كلِّ مَنْ جاء بعدهم.
يمكن النظر في كتاب السِّيرة النَّبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ