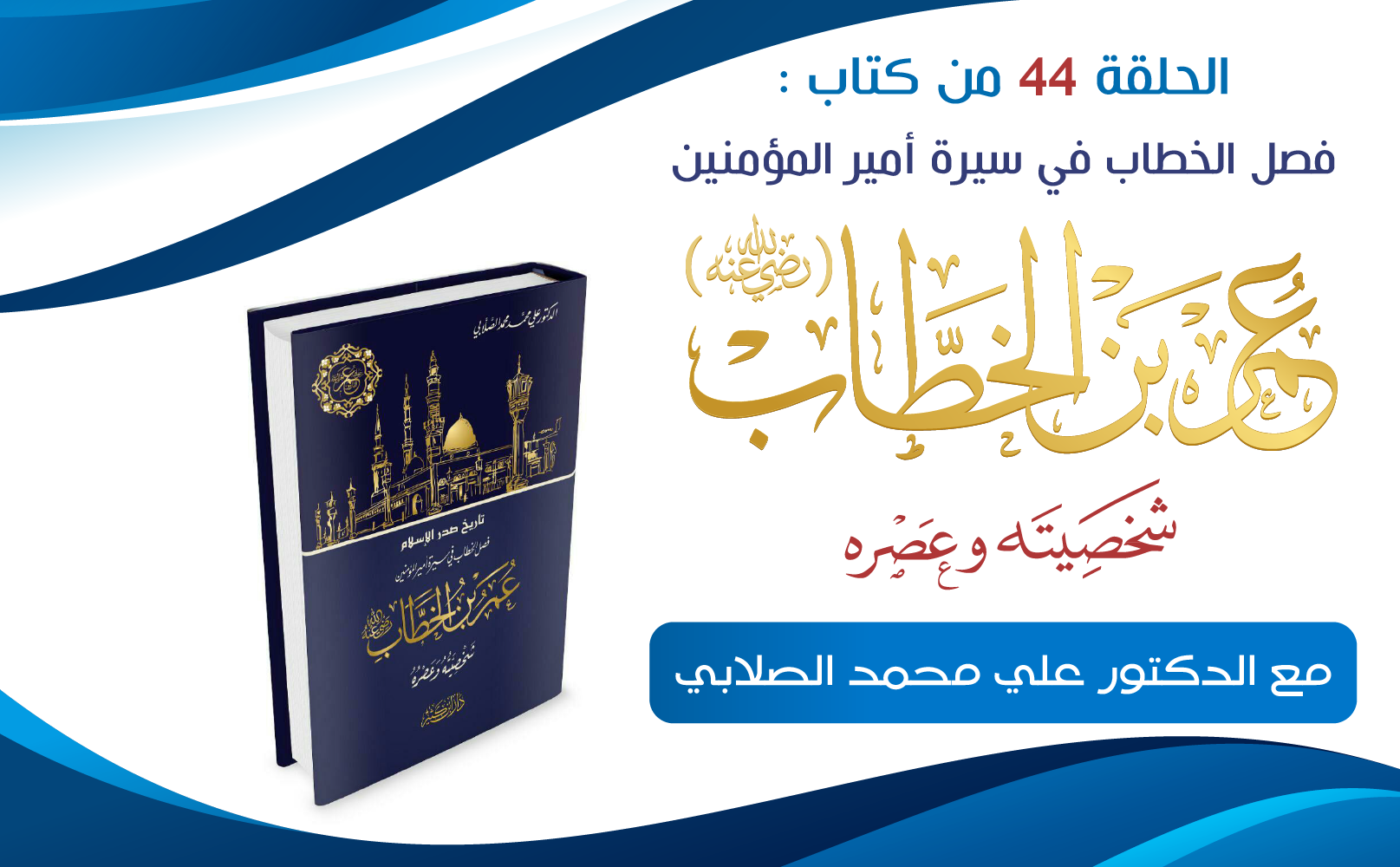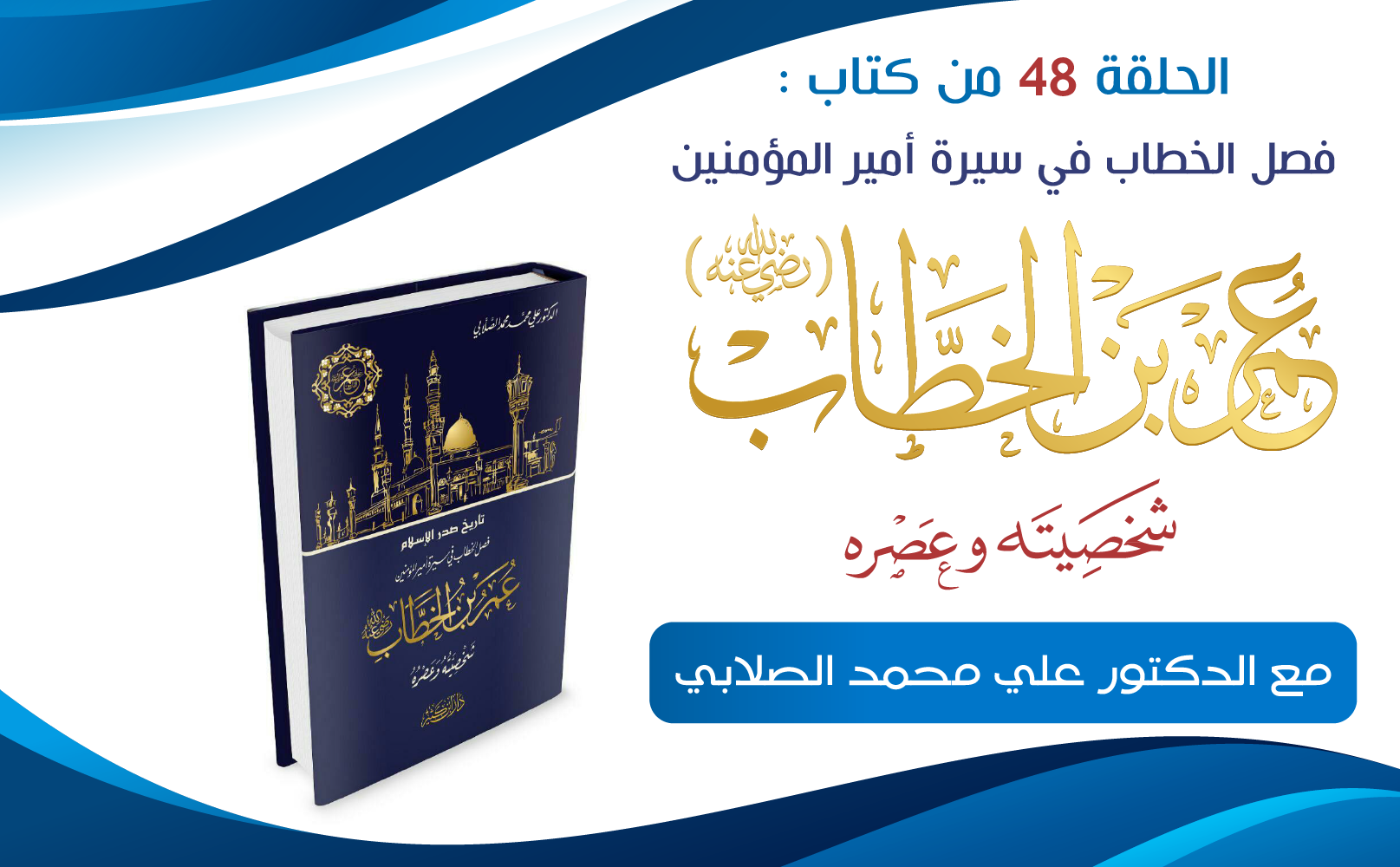مسألة الخراج زمن الخليفة الفاروق رضي الله عنه؛ الحيثيات والأبعاد
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة السادسة والأربعون
الخراج له معنيان: عامٌّ، وهو كلُّ إِيرادٍ وصل إِلى بيت مال المسلمين من غير الصَّدقات، فهو يدخل في المعنى العامِّ للفيء، ويدخل فيه إِيراد الجزية، وإِيراد العشور، وغير ذلك، وله معنىً خاصٌّ: وهو إِيراد الأراضي الَّتي افتتحها المسلمون عنوةً، وأوقفها الإِمام لمصالح المسلمين على الدَّوام، كما فعل عمر بأرض السَّواد من العراق، والشَّام. والخراج ـ كما قال ابن رجب الحنبلي ـ لا يُقاس بإِجارةٍ، ولا ثمنٍ، بل هو أصلٌ ثابتٌ بنفسه لا يُقاس بغيره.
عندما قويت شوكة الإِسلام بالفتوحات العظيمة وبالذَّات بعد القضاء على القوَّتين العظيمتين الفرس، والروم؛ تعدَّدت موارد المال في الدَّولة الإِسلاميَّة، وكثرت مصارفه، وللمحافظة على كيان هذه الدَّولة المترامية الأطراف وصون عزِّها وسلطانها، وضمان مصالح العامَّة، والخاصَّة كان لا بدَّ من سياسةٍ ماليَّةٍ حكيمةٍ، ورشيدةٍ، فكَّر لها عمر ـ رضي الله عنه ـ ألا وهي إِيجاد موردٍ ماليٍّ ثابتٍ، ودائمٍ للقيام بهذه المهامِّ، وهذا المورد هو: الخراج، فقد أراد الفاتحون أن تقسم عليهم الغنائم من أموالٍ وأراضٍ وفقاً لما جاء في القران الكريم خاصَّاً بالغنائم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *} [اللأنفال: 41].
وقد أراد عمر ـ رضي الله عنه ـ في بداية الأمر تقسيم الأرض بعدد الفاتحين، لكن عليَّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ رأى عدم التَّقسيم، وشاركه الرأي معاذ بن جبل، وحذَّر عمر من ذلك، وقد روى أبو عبيد قائلاً: قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأراضي بين المسلمين، فقال معاذ: والله إِذاً ليكونن ما تكره، إِنَّك إِن قسمتها صار الرَّيع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إِلى الرَّجل الواحد، أو المرأة، ثمَّ يأتي من بعدهم قومٌ يسدُّون من الإِسلام مسدَّاً، وهم لا يجدون شيئاً فانظر أمراً يسع أوَّلهم، واخرهم.
لقد نبَّه معاذ بن جبلٍ ـ رضي الله عنه ـ أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ إِلى أمرٍ عظيم، جعل عمر يتتبَّع ايات القران الكريم، ويتأمَّلها مفكراً في معنى كلِّ كلمة يقرؤها حتَّى توقف عند ايات تقسيم الفيء في سورة الحشر، فتبيَّن له: أنها تشير إِلى الفيء للمسلمين في الوقت الحاضر، ولمن يأتي بعدهم، فعزم على تنفيذ رأي معاذٍ ـ رضي الله عنه ـ فانتشر خبر ذلك بين النَّاس ووقع خلاف بينه وبين بعض الصَّحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فكان عمر، ومؤيدوه لا يرون تقسيم الأراضي الَّتي فتحت، وكان بعض الصَّحابة، ومنهم بلال بن رباح، والزُّبير بن العوَّام يرون تقسيمها، وكما تقسم غنيمة العسكر، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فأبى عمر ـ رضي الله عنه ـ التقسيم وتلا عليهم الآيات الخمس من سورة الحشر من قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *} [الحشر: 6] حتى فرغ من شأن بني النَّضير.
ثمَّ قال: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ *} [الحشر: 7] ثم قال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ *} [الحشر: 8].
ثمَّ لم يرض حتَّى خلط بهم غيرهم، قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *} [الحشر: 9] فهذا في الأنصار خاصَّة، ثم لم يرض حتَّى خلط بهم غيرهم، فقال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *} [الحشر: 10]، فكانت هذه عامَّةً لمن جاء بعدهم، فما من أحدٍ من المسلمين إِلا له في هذا الفيء حقٌّ.
قال عمر: فلئن بقيت ليبلغنَّ الرَّاعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء؛ ودمه في وجهه، وفي روايةٍ أخرى جاء فيها: قال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت، وورثت عن الاباء وحيزت، ما هذا برأيٍ، فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إِلا مما أفاء الله عليهم، فقال عمر: ما هو إِلا كما تقول، ولست أرى ذلك، والله لا يُفتح بعدي بلدٌ فيكون فيه كبير نيلٍ بل عسى أن يكون كلاًّ على المسلمين، فإِذا قسمتُ أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها، فما يسدُّ به الثُّغور ؟ وما يكون للذرِّيَّة، والأرامل لهذا البلد، وبغيره من أراضي الشَّام، والعراق ؟ فأكثروا على عمر، وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قومٍ لم يحضروا، ولم يشهدوا، ولأبناء القوم، وأبناء أبنائهم، ولم يحضروا ! فكان عمر ـ رضي الله عنه ـ لا يزيد على أن يقول: هذا رأيٌ. قالوا: فاستشر، فأرسل إِلى عشرة من الأنصار من كبراء الأوس، والخزرج، وأشرافهم، فخطبهم، وكان ممَّا قال لهم: إِنِّي واحدٌ كأحدكم، وأنتم اليوم تقرُّون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتَّبعوا هذا الذي هواي. ثمَّ قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الَّذين زعموا: أنِّي أظلمهم حقوقهم، ولكن رأيت أنَّه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنَّمنا الله أموالهم، وأرضهم، وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموالٍ بين أهله، وأخرجت الخمس فوجَّهته على وجهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها واضعاً عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية، يؤدُّونها فتكون فيئاً للمسلمين، المقاتلة والذُّرِّيَّة، ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتم هذه الثُّغور لا بدَّ لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام لا بدَّ لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إِذا قُسمت الأرض، والعلوج ؟ فقالوا جميعاً: الرأي رأيك فنعم ما قلت، ورأيت، إِن لم تشحن هذه الثُّغور وهذه المدن بالرِّجال، وتجري عليهم ما يتقوَّون به؛ رجع أهل الكفر إِلى مدنهم.
وقد قال عمر فيما قاله: لو قسمتها بينهم لصارت دُولةً بين الأغنياء منكم، ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيءٌ، وقد جعل الله لهم فيها الحقَّ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] ثمَّ قال: فاستوعبت الآية النَّاس إِلى يوم القيامة. وبعد ذلك استقرَّ رأي عمر، وكبار الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ على عدم قسمة الأرض.
وفي حواره مع الصَّحابة يظهر أسلوب الفاروق في الجدل، وكيف جمع فيه قوَّة الدليل، وروعة الصُّورة، واستمالة الخصم، في مقالته الَّتي قال للأنصار عند المناقشة في أمر أرض السَّواد، ولو أنَّ رئيساً ناشئاً في السِّياسية، متمرِّساً بأساليب الخطب البرلمانيَّة أراد أن يخطب النُّواب (لينال موافقتهم) على مشروعٍ من المشروعات لم يجأى بأرقَّ من هذا المدخل، أو أعجب من هذا الأسلوب. وامتاز عمر فوق ذلك بأنَّه كان صادقاً فيما يقول، ولم يكن فيه سياسيّاً مخادعاً، وأنَّه جاء به في نمطٍ من البيان يسمو على الأشباه والأمثال.
ـ هل كان الفاروق مخالفاً للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حكم أرض الخراج ؟
مَنْ قال: إِنَّ الفاروق خالف الرَّسول صلى الله عليه وسلم بفعله في عدم تقسيم أرض الخراج؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، وقال: إِنَّ الإِمام إِذا حبس الأرض المفتوحة عنوةً؛ نُقِض حكمُه لأجل مخالفة السُّنة، فهذا القول خطأٌ، وجرأةٌ على الخلفاء الرَّاشدين ـ إِذا فعلوا هذا الفعل ـ فإِنَّ فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إِنما يدلُّ على جواز ما فعله، ولا يدلُّ على وجوبه، فلو لم يكن معنا دليلٌ على عدم وجوب ذلك؛ لكان فعل الخلفاء الرَّاشدين: عمر، وعثمان، وعليٍّ ـ رضي الله عنهم ـ دليلاً على عدم الوجوب، فكيف وقد ثبت: أنَّه فتح مكَّة عنوةً، كما استفاضت به الأحاديث الصَّحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل المغازي، والسير ؟! فإِنَّه قدم حين نقضوا العهد، ونزل بمرِّ الظهران، ولم يأت أحدٌ منهم يصالحه، ولا أرسل إِليهم أحداً يصالحهم، بل خرج أبو سفيان يتجسَّس الأخبار، فأخذه العبَّاس، وقدم به كالأسير، وغايته أن يكون العبَّاس أمَّنه، فصار مستأمناً، ثمَّ أسلم، فصار من المسلمين، فكيف يتصوَّر أن يعقد صلح الكفار ـ بعد إِسلامه ـ بغير إذنٍ منهم ؟ مما يبيِّن ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّق الأمان بأسبابٍ، كقوله: « من دخل دار أبي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن أغلق بابه فهو امن »، فأمَّن من لم يقاتله، فلو كانوا معاهدين؛ لم يحتاجوا إلى ذلك. وأيضاً: سمَّاهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم طلقاء؛ لأنَّه أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره. وأيضاً: فإِنَّه أذن في قتل جماعةٍ منهم من الرِّجال والنِّساء، وأيضاً: فقد ثبت عنه في الصحاح: أنَّه قال في خطبته: « إِن مكَّة لم تحل لأحدٍ قبلي ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي، وإِنَّما أُحلَّت لي ساعةً».
ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، ولم يدخلها بإِحرامٍ، فلو كانوا صالحوه؛ لم يكن قد أحلَّ له شيء، كما لو صالح مدينةً من مدائن الحلِّ؛ لم تكن قد أحلَّت، فكيف يحلُّ له البلد الحرام، وأهله مسالمون له، صلحٌ معه ؟! وأيضاً فقد قاتلوا خالداً، وقَتَل طائفةٌ من المسلمين طائفةً من الكفار.
وفي الجملة فَإِنَّ من تدبَّر الاثار المنقولة، علم بالاضطرار: أنَّ مكَّة فتحت عنوةً، ومع هذا فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يقسم أرضها، كما لم يسترق رجالها، ففتح خيبر عنوةً وقسمها، وفتح مكَّة عنوة ولم يقسمها، فعُلم جواز الأمرين، وبذلك لم يكن الفاروق مخالفاً للهدي النَّبويِّ في عدم تقسيمه للأراضي المفتوحة، وقد كان سنده فيما فعل أموراً منها:
1 ـ اية الفيء في سورة الحشر.
2 ـ عمل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة عنوةً، فتركها لأهلها، ولم يضع عليها خراجاً.
3 ـ قرار مجلس الشُّورى الَّذي عقده عمر لهذه المسألة بعد الحوار، والمجادلة، وقد أصبح سنَّةً متَّبعةً في أرضٍ يظهر عليها المسلمون، ويقرُّون أهلها عليها، وبهذا يظهر: أنَّ عمر حينما ميَّز بين الغنائم المنقولة وبين الأراضي كان متمسِّكاً بدلائل النُّصوص، وجمع بينها، وأنزل كلاًّ منها منزلته الَّتي يرشد إِليها النَّظر الجامع السَّديد، يضاف إِلى ذلك: أنَّ عمر كان يقصد أن تبقى لأهل البلاد ثرواتهم، وأن يعصم الجند الإِسلامي من فتن النِّزاع على الأرض، والعقار، ومن فتن الدَّعة، والانشغال بالثَّراء، والحطام.
إِنَّ الفاروق ـ رضي الله عنه ـ كان يلجأ إِلى القران الكريم يلتمس منه الحلول، ويطوف بين مختلف اياته، ويتعمَّق في فهم منطوقها، ومفهومها، ويجمع بينها، ويخصِّص بعضها ببعضٍ حتَّى يصل إِلى نتائج تحقِّق المصالح المرجوَّة منها، مستلهماً روح الشَّريعة، غير واقفٍ مع ظواهر النُّصوص، وقد أسعفه في قطع هذه المراحل إِدراكُه الدَّقيق لمقاصد الشَّريعة بتلكم النُّصوص، وهي عمليَّة مركَّبةٌ ومعقَّدةٌ لا يحسن الخوض فيها إِلا من تمرَّس على الاجتهاد، وأُعطيَ فهماً سديداً، وجرأةً على الإِقدام حيث يحسن الإِقدام، حتَّى خُيِّلَ للبعض: أنَّ عمر كان يضرب بالنُّصوص عرض الحائط في بعض الأحيان، وحاشا أن يفعل عمر ذلك، لكنَّه كان مجتهداً ممتازاً، اكتسب حاسَّةً تشريعيَّةً لا تُضاهى، حتى كان يرى الرَّأي فينزل القران على وفقه.
والنَّتيجة الَّتي نخرج بها من هذه القضيَّة هي: أنَّ القران يفسِّر بعضه بعضاً، ومثله في السنَّة، فعلى المجتهد وهو يبحث عن الحكم الشَّرعي أن يستعرض جميع النُّصوص الَّتي تساعد على الحلِّ دون الاقتصار على بعضها، وإِلا عدَّ مقصراً في اجتهاده، ويكون ما توصَّل إِليه لاغياً.
ـ كيف تمَّ تنفيذ مشروع الخراج في عهد الفاروق ؟
لمَّا انتهى كبار الصَّحابة، ورجال الحلِّ، والعقد إِلى إِقرار رأي الخليفة عمر ـ رضي الله عنه ـ يتحبيس الأرض على أهلها، وتقسيم الأموال المنقولة على الفاتحين؛ انتدب شخصيَّتين كبيرتين هما: عثمان بن حنيف، وحذيفة بن اليمان، وذلك لمسح أرض سواد العراق، وحين بعثهما لهذه المهمَّة زوَّدهما الخليفة بنصائحه، وتوجيهاته الثَّاقبة، وأمرهما بأن يلاحظا ثروة الأفراد، وخصوبة الأرض، وجدبها، ونوع النَّباتات والشَّجر، والرِّفق بالرَّعيَّة، فلا تحمل الأرض ما يتحمَّله المكلَّفون، بل يتركا لهم ما يجبرون به النَّوائب، والحوائج، ولكي ينطلق قرار عمر ـ رضي الله عنه ـ على أساسٍ عادلٍ، رغب أن يعرف الحالة الَّتي كان عليها أهل العراق قبل الفتح، وطلب من الصَّحابيَّيْن: عثمان بن حنيف، وحذيفة بن اليمان أن يرسلا إِليه وفداً من كبار رجال السَّواد، فبعثا إِليه وفداً من دهاقنة السَّواد، فسألهم عمر ـ رضي الله عنه ـ: كم كنتم تؤدُّون إِلى الأعاجم في أرضهم ؟ قالوا: سبعة وعشرين درهماً، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: لا أرضى بهذا منكم.
وهذا يدلُّ على أنَّ الفتح الإِسلاميَّ كان عدلاً على النَّاس الَّذين فتحت بلادهم، وكان عمر يرى: أنَّ فرض خراج على مساحة الأرض أصلح لأهل الخراج، وأحسن ردَّاً، وزيادةٌ في الفيء من غير أن يحمِّلهم ما لا يطيقون، فقام عثمان بن حنيف، وحذيفة بن اليمان بما وكل إِليهما خير قيام، فبلغت مساحة السَّواد (000 , 36000) ستة وثلاثين ألف ألف، ووضعا على جريب العنب عشرة دراهم، وعلى جريب النَّخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب ستَّة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربع دراهم، وعلى جريب الشَّعير درهمين، وكتبا إِلى عمر بن الخطَّاب بذلك، فأمضاه، وقد حرص عمر ـ رضي الله عنه ـ على العناية بأهل تلك الأرض والبلاد، وما يوفِّر العدل، ويحقِّقه خوفاً أن يكون عثمان، وحذيفة ـ رضي الله عنهما ـ حمَّلا النَّاس والأرض ما لا يطيقون أداءه من خراجٍ، فسألهما: كيف وضعتما على الأرض، لعلَّكما كلَّفتما أهل عملكما ما لا يطيقون ؟ فقال حذيفة: لقد تركت فضلاً، وقال عثمان: لقد تركت الضّعف، ولو شئت؛ لأخذته. فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ عند ذلك: أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق، لأدعنَّهم لا يفتقرون إِلى أميرٍ بعدي!
وهذه الطَّريقة الَّتي نُفِّذت في سواد العراق هي ذاتها الَّتي نُفِّذت في الأراضي المصريَّة، لكن الذي تولاها هو عمرو بن العاص، وكانت وحدة المساحة الَّتي ربط على أساسها الخراج الفدَّان. وكذلك فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ بأرض الشَّام، كما فعل بأرض السَّواد، ولم يذكر المؤرخون معلوماتٍ صريحةً واضحةً عن المساحة، ونوع الزُّروع، والثِّمار الَّتي فرض عليها الخراج، ولا مَنْ قام بعملية مسح أراضي الشَّام، وكان الخليفة عمر ـ رضي الله عنه ـ بهذا الصَّدد عمل إِحصاءً دقيقاً لثروة الولاية قبل الولاية عليها، ثمَّ إِلزام الولاة عند اعتزالهم أعمالهم بمصادرة بعض الأموال الَّتي جمعوها لأنفسم في أثناء ولايتهم؛ إِذ تبين له: أنَّ أعطياتهم لا تسمح لهم بادِّخار هذه الأموال كلِّها، وسيأتي تفصيل ذلك بإِذن الله عند حديثنا عن الولاة.
وقد كثرت الممتلكات الخاصَّة للدَّولة التي اصطفاها عمر ـ رضي الله عنه ـ لبيت المال في العراق، والشَّام، ومصر، فكانت هذه الأملاك تدرُّ دخلاً عظيماً، ووفيراً على خزانة الدَّولة، خاصَّةً في مصر لاتّساع الأراضي الزِّراعيَّة الَّتي يملكها التَّاج في العصور القديمة.
ـ ما القيم والمصالح الأمنيَّة في عدم تقسيم أراضي الخراج ؟
هناك جملةٌ من المصالح الأمنيَّة الَّتي استند إِليها الخليفة، والذين وافقوه على رأيه في اتخاذ هذا القرار يمكنني تصنيفها إِلى صنفين:
أوَّلهما: المصالح الدَّاخلية، وأهمُّها سدُّ الطَّريق على الخلاف والقتال بين المسلمين، وضمانُ توافر مصادر ثابتةٍ لمعايش البلاد، والعباد، وتوفير الحاجات المادِّيَّة اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين.
وثانيهما: المصالح الخارجيَّة، والَّتي يتمثَّل أهمُّها في توفير ما يسدُّ ثغور المسلمين، ويسدُّ حاجتها من الرِّجال والمؤن، والقدرة على تجهيز الجيوش، بما يستلزمه ذلك من كفالة الرَّواتب، وإدرار العطاء، وتمويل الإِنفاق على العتاد والسِّلاح، وترك بعض الأطراف لتتولَّى مهامَّ الدفاع عن حدود الدَّولة، وأراضيها اعتماداً على ما لديها من خراج.
والَّذي يجب ملاحظته في هذه المصالح: أنَّ الخليفة أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتةً لأمن المجتمع السِّياسي، ليس في عصره فقط، بل وفيما يليه من عصورٍ بعده، وعباراتُه مِنْ مثل: (فكيف بمن يأتي من المسلمين)، و(كرهت أن يُترك المسلمون) الَّتي توحي بنظرته المستقبليَّة لهذا الأمن الشَّامل تشهد على ذلك، وقد أثبت تطور الأحداث السِّياسيَّة في عصر الخليفة الثَّاني صوابَ، وصدقَ ما قرَّره.
ـ إِنَّ تعدُّد أطوار اتِّخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد أكَّد أمرين:
أوَّلهما: أنَّ بعض القرارات المهمَّة الَّتي تمسُّ المصالح الجوهريَّة للمسلمين قد تأخذ من الجهد والوقت الكثير، كما أنَّها قد تتطلَّب قدراً من الأناة في تبادل الحجج والبراهين، دون أن يتيح ذلك مجالاً للخلاف، وتعميق هوَّة الانقسام أحياناً، أو يفوِّت باباً من أبواب تحقيق بعض المصالح الخاصَّة بأمن الأمَّة في حاضرها، ومستقبلها.
والأمر الثَّاني: أنَّ بعض القرارات المهمَّة الَّتي قد تخرج بعد عسر النِّقاش، والحوار، والبداية المتعثِّرة لها، يفرض على الحاكم الشَّرعيِّ أن يكون أوَّل المسلمين واخرهم جهداً في السَّعي إِلى تضييق هوَّة الخلاف، والتَّقريب بين وجهات النَّظر المتعارضة لكي يصل بالمسلمين إِلى الحكم الشَّرعيِّ فيما هو متنازعٌ بشأنه.
ـ إِنَّ تبادل الرَّأي والاجتهاد بين الخليفة، والصَّحابة؛ الَّذين لم يوافقوه على رأيه، واستناد الكُلِّ في ذلك إِلى النُّصوص المنزَّلة في الاجتهاد يثبت: أنَّ الفيصل في إِبداء الآراء في القرارات السِّياسيَّة عامَّةً، والَّتي تمسُّ مصالح المسلمين بصفةٍ مباشرةٍ خاصَّةً، وهو أن تجيء هذه الآراء مستندةً إِلى النُّصوص المنزَّلة، أو ما ينبغي أن يتفرَّع عنها من مصادر أخرى، لا تخرج عن أحكامها في محتواها، ومبرِّراتها.
ـ إِنَّ لجوء الخليفة إِلى استشارة أهل السَّابقة من كبار الصَّحابة العلماء في فقه الأحكام، ومصادر الشَّرع، واستجابتهم بإِخلاصِ النُّصح له، يؤكِّد: أنَّ أهل الشُّورى لهم مواصفاتٌ خاصَّةٌ تميِّزهم، فالَّذين يُستشارون هم أهل الفقه، والفهم، والورع، والدِّراية، الواعون لدورهم، إِنَّهم ـ بعبارةٍ أدقَّ ـ الَّذين لا إِمَّعيَّة في آرائهم، ومن دأبهم توطين أنفسهم على قول الحقِّ، وفعله، غير خائفين في ذلك لومة لائم من حاكمٍ، أو غيره.
ـ ثمَّ يبقى القول: إِنَّ ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي يظلُّ نموذجاً عالياً سار عليه الصَّحابة في كيفية التَّعامل وفق اداب الحوار، وأخلاقيَّات مناقشة القضايا، وتقليب أوجهها المختلفة ابتداءً بمرحلة التَّفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي ـ بصفةٍ مباشرةٍ، أو غير مباشرةٍ ـ وعلى رأسهم الخليفة؛ الَّذي لم يخرج عن هذه الاداب رغم اختلاف اجتهاداتهم بشأنه.
بل إِنَّ الفاروق ـ رضي الله عنه ـ بيَّن بأنَّ الحاكم مجرَّد فردٍ في هيئة الشُّورى، وأعلن الثِّقة في مجلس شورى الأمَّة، خالفته، أو وافقته، والردَّ إِلى كتاب الله، فقد قال رضي الله عنه: إِنِّي واحدٌ منكم، كأحدكم، وأنتم اليوم تقرُّون بالحق، خالفني مَنْ خالفني، ووافقني مَنْ وافقني، ومعكم من الله كتابٌ ينطق بالحقِّ.
ـ أهمُّ الاثار الدَّعويَّة في هذا القرار:
من أهمِّ هذه الاثار: القضاء نهائياً على نظام الإِقطاع، فقد ألغى عمر ـ رضي الله عنه ـ كلَّ الأوضاع الإِقطاعيَّة الظَّالمة؛ الَّتي احتكرت كلَّ الأرض لصالحها، واستعبدت الفلاحين لزراعتها مجاناً، فقد ترك عمر ـ رضي الله عنه ـ أرض السَّواد في أيدي فلاحيها، يزرعونها مقابل خراج عادلٍ يطيقونه، يدفعونه كلَّ عامٍ، وقد اغتبط الفلاحون بقرار عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ بتمليكهم الأرض الزِّراعيَّة، يزرعونها مقابل دفع الخراج؛ الَّذي يستطيعونه ممَّا يجعلهم يشعرون لأوَّل مرَّة في حياتهم: أنَّهم أصحاب الأرض الزِّراعية لا ملك للإِقطاعيِّين من الطبقة الحاكمة، وكان الفلاحون مجرد أجراء يزرعونها بدون مقابل، وكان تعبهم، وكدُّهم يذهب إِلى جيوب الطَّبقة الإِقطاعيَّة، طبقة ملاك الأرض، ولا يتركون لهم إِلا الفتات.
ـ قطع الطريق على عودة جيوش الرُّوم، والفرس بعد طردهم:
لقد أدَّت سياسة عمر ـ رضي الله عنه ـ في تمليك الأرض لفلاحي الأمصار المفتوحة عنوةً إِلى شعورهم بالرِّضا التَّامِّ، كما تقدَّم، وهذا ممَّا جعلهم يبغضون حكَّامهم من الفرس، والرُّوم، ولا يقدِّمون لهم أيَّة مساعداتٍ، بل كانوا على العكس من ذلك يقدِّمون المساعدات للمسلمين ضدَّهم، حتَّى إِنَّ رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة، فقال: يا أعداء الله فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا، وكنتم عيوناً لهم علينا، وقوَّيتموهم بالأموال.
ـ مسارعة أهل الأمصار المفتوحة إِلى الدُّخول في الإِسلام:
فقد ترتَّب على ما تقدَّم من تمليك الأرض للفلاحين أن سارعوا إِلى الدُّخول في الإِسلام؛ الَّذي انتشر بينهم بسرعةٍ مدهشةٍ، لم يسبق لها مثيلٌ، فقد لمسوا العدل، وتبيَّن لهم الحقُّ، وأحسُّوا بكرامتهم الإِنسانيَّة من معاملة المسلمين لهم.
ـ تدبير الأمور لحماية الثُّغور:
فقد امتدَّت الدَّولة الإِسلاميَّة صوب جهاتها الأربع، وانتقلت أسماء الثُّغور إِلى ما وراء حدود الدَّولة في عصورها الأولى، من أهم هذه الثُّغور، ما كان يعرف بالثُّغور الفراتيَّة، والَّتي كانت تمتد على طول خطٍّ استراتيجيٍّ يفصل ما بين الدَّولة الإِسلاميَّة، والامبراطورية البيزنطيَّة، وغيرها من الثُّغور.
وقد اتَّخذ عمر في كل مصرٍ على قدره خيولاً، وقد وصلت قوَّات الفرسان المرابطين في الأمصار إِلى أكثر من ثلاثين ألف فارسٍ، وهذا بخلاف قوَّات المشاة، وأيِّ قواتٍ أخرى كالجَمَّالة، وخلافه، وهذه خصَّصها عمر كجيشٍ منظَّمٍ لحماية ثغور المسلمين، وكفل أرزاقهم، وصرفهم عن الاشتغال بأيِّ شيءٍ إِلا بالجهاد في سبيل نشر الدَّعوة الإِسلاميَّة، فكان الخراج من الأسباب الَّتي ساقها المولى عزَّ وجلَّ لتجهيز هذه القوَّات، وكفالة أرزاق أجنادها.
إِنَّ الفاروق ـ رضي الله عنه ـ وضع قواعد نظام الخراج، باعتباره مورداً من الموارد الماليَّة الهامَّة لخزينة الدَّولة، وكان يهدف من ورائه إِلى أن يكون بيت المال قائماً بما يجب عليه من تحقيق المصالح العامَّة للأمَّة، وحفظ ثغورها، وتأمين طرقها، ولا يتأتَّى ذلك إِلا بإِبقاء أصحاب الأرض الَّتي تملَّكها المسلمون عنوةً لقاء نسبةٍ معيَّنةٍ ممَّا تنتجه الأرض، وهذا أمرٌ شأنه أن يزيدهم حماساً في العمل، ورغبةً في الاستغلال، والاستثمار، ومقارنة ذلك بما كانوا يرهقون به من الضَّرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول المسلمين.
للاطلاع على النسخة الأصلية للكتاب راجع الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي، وهذا الرابط:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book172(1).pdf