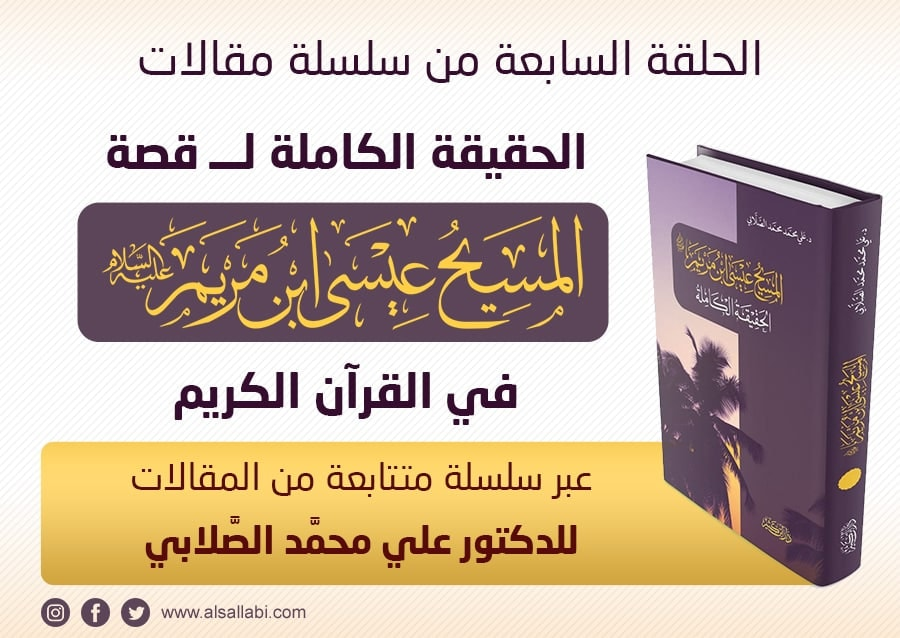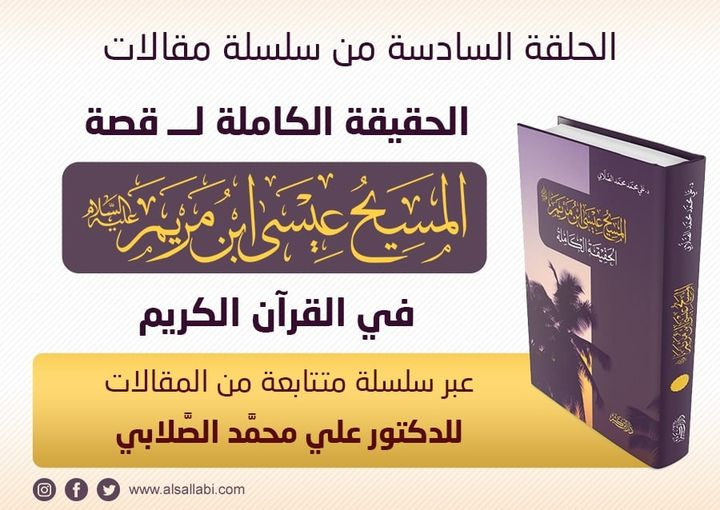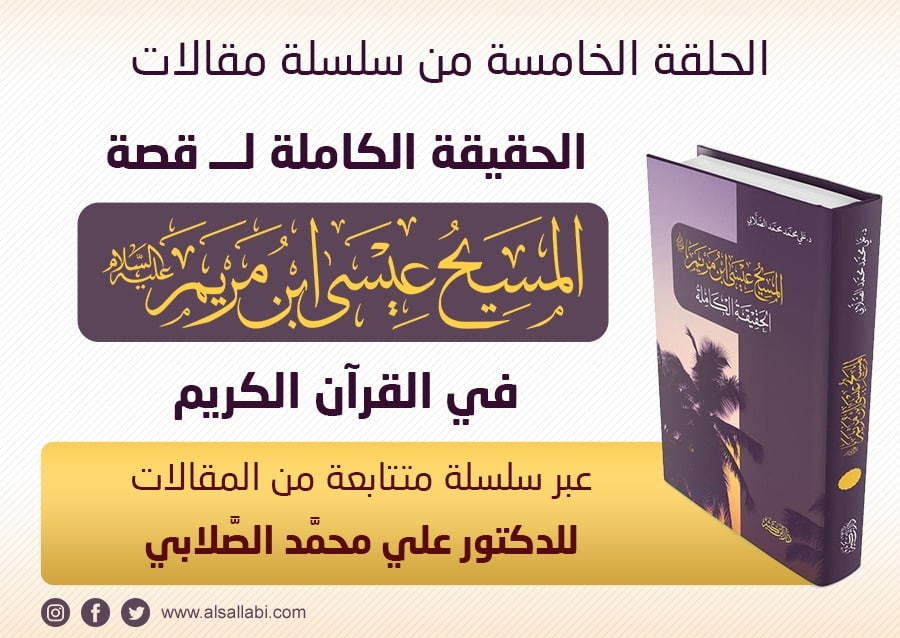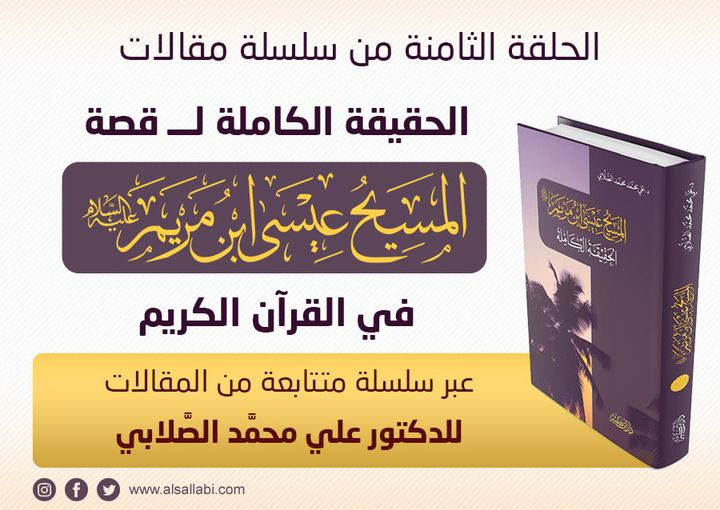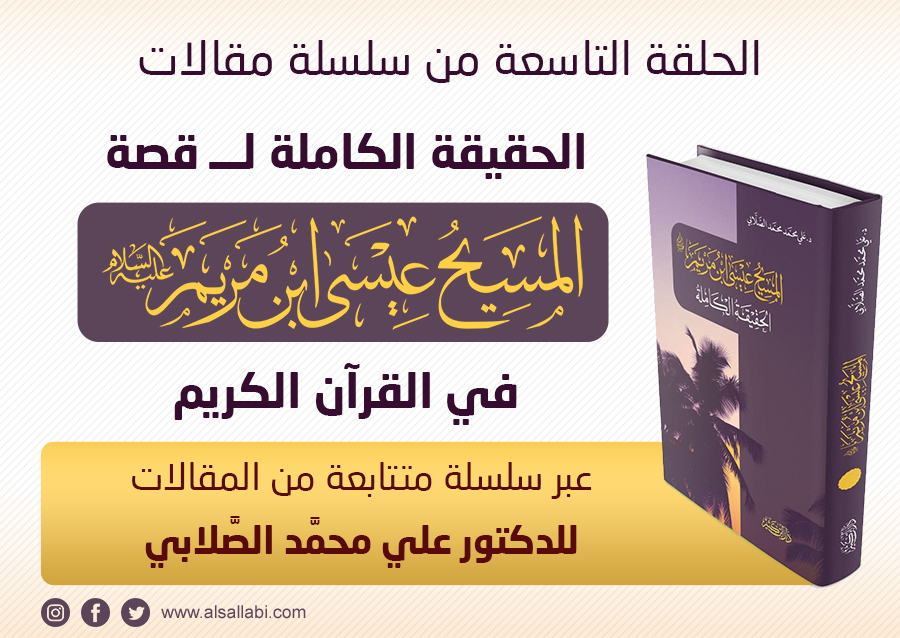من كتاب المسيح ابن مريم عليه السلام : الحقيقة الكاملة
(بشرية عيسى عليه السلام)
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الأولى 1442 ه/ يناير 2021
بعث الله عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبياً ورسولاً، وقامت رسالته على توحيد الله وإفراد الألوهية والربوبية، ودعوة بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده، ومطالبتهم بالإيمان بأنه عبد الله ورسوله، وأنه ابن مريم، فهو رسول بشر عليه الصلاة والسلام.
هذه هي خلاصة دعوة عيسى عليه السلام ورسالته، وهذه هي النصرانية الموحِّدة التي دعا إليها عيسى عليه السلام، وعلى هذا الأساس آمن به الحواريون، واتَّبعه النصارى الموحدون.
وبما أن نبوّة عيسى عليه السلام جاءت متممة مكمِّلة لنبوة موسى عليه السلام، فمن البديهي أن تكون قائمة على التوحيد، فالنصرانية الحقَّة لا تقول بوجود إله آخر غير الواحد الأحد، وما يناقض ذلك إنما هو انحراف عن حقيقة دعوة المسيح عليه السلام التي بيَّنها القرآن الكريم.
جلَّى القرآن الكريم هذه النقطة أوضح تجلية، وبيَّنها أحسن بيان، وقطع حجَّة النصارى، بالاستدلال السليم، والنظر القويم، والمنطق الواضح، والدليل الساطع.
أ- عيسى كآدم في خلق الله لهما:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (آل عمران: 59).
وسبب نزول هذه الآية مخاصمة وفد نجران من النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم، في أمر عيسى عليه السلام، فإنهم سألوا عن أب عيسى، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم، فأنزل الله تعالى في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها هذه الآية: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ) في قدرة الله، حيث خلقه من غير أب (كمثل آدم)، خلقه من غير أب ولا أم (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون). فالذي خلق آدم من غير أبوين قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأَولى والأحرى، وإن جاز ادّعاء النبوة في عيسى، لكونه مخلوق من غير أب فجواز ذلك من آدم بطريق الأَولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فالدعوى في عيسى أشدُّ بطلاناً وأظهر فساداً.
إنَّ ولادة عيسى عليه السلام عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر، ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر؟ وأهل الكتاب الذي كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ بغير أب، أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من تراب وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنسانيّ، دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول عيسى، ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتيَّة، على أن العنصر الذي به صار آدم إنساناً هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب، عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك، وإن هي إلا الكلمة (كن)، تنشئ ما تراد له النشأة (فيكون).
وهكذا تتجلّى بساطة هذه الحقيقة، حقيقة عيسى، وحقيقة الخلق كلِّه، وتدخل إلى النفس في يسر وفي وضوح حتى ليعجب الإنسان كيف ثار الجدل حول هذا الحادث وهو جارٍ وِفق السنة الكبرى، سنة الخلق والنشأة جميعاً.
وهذه هي طريقة (الذكر الحكيم) في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط، في أعقد القضايا التي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور.
ب- كونوا ربانيين:
قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ أب(آل عمران: 79).
جاء هذا رداً على نصارى نجران الذين زعموا أن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباً، فقال لهم سبحانه: ما ينبغي لبشر اختاره الله للنبوة وآتاه الكتاب والحكمة، والعلم والفهم، أن يكذب على الله ويأمر الناس بعبادته من دون الله، ولكن جائز أن يقول لهم: كونوا ربانيين أي: علماء معلمين: بسبب مثابرتكم على تعليم الكتاب ودراسته.
والآية الكريمة تُبين أن النبي عبد وأن الله وحده هو الرب، الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم، فما يمكن أن يدَّعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية، فلن يقول نبي للناس (كونوا عباداً لي من دون الله).
ولكن قوله لهم (كونوا ربانيين) منتسبين إلى الرب، عباداً له وعبيداً، توجَّهوا إليه وحده بالعبادة، وخذوا عنه وحده منهج حياتكم حتى تخلصوا له وحده فتكونوا (ربانيين)، كونوا (ربانيين) بحكم علمكم بالكتاب وتدارسكم له، فهذا مقتضى الكتاب ودراسته.
ج- النهي عن الغلو في الدين:
قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا * لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ (النساء: 171- 172).
في الآيتين الكريمتين السابقتين يخاطب القرآن الكريم النصارى من أهل الكتاب، وينهاهم عن الغلو وتجاوز الحدّ في دينهم، وذلك بإسباغ صفة الألوهية على عيسى ابن مريم عليه السلام، إذ هو عبد مجتبى لرسالة ربه، خلقه بكلمة (كن)، فكان، وهو روحٌ من عند الله؛ لأن الله تعالى أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم، ثمَّ يأتي القرآن لتصحيح إحدى أهمِّ عقائد أهل الكتاب، وهي عقيدة التثليث.
والثابت من التتبُّع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية أن عقيدة التثليث، لم تصاحب النصرانية الأولى، إنما دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ، مع الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية، وهم لم يبرؤوا بعدُ من التصورات الوثنية، والآلهة المتعددة، والتثليث بالذات يغلب أن يكون مقتبساً من الوثنيات القديمة.
وما تزال فكرة التثليث تصدم عقول المثقفين من النصارى، فيحاول رجال الكنيسة أن يجعلوها مقبولة لهم بشتى الطرق، ومن بينها الإحالة إلى مجهولات، لا ينكشف سرُّها للبشر إلا يوم يتكشَّف سرٌّ من الأسرار، على كل ما في السماوات وما في الأرض.
إن عقيدة التثليث سرّ من الأسرار، بل هي أمر مناقض للعقل يحاول النصارى إثبات أنه فوق العقل، فهم يقولون: إن الله تعالى ذو طبيعة ثلاثية لكنه واحد، وإنه ثلاثة "أشخاص"، لهم نفس الطبيعة ونفس الرتبة، ومع ذلك فهم متحدون الذات لا يقبلون التقسيم، وفي الوقت نفسه فإن الإله الابن نجم عن الإله الأب، وعنهما نجم روح القدس.
وتمضي الآيات الكريمة لتقدير حقيقة الوحدانية، وتبيين أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق، فعيسى عليه السلام ليس ابن الله، ولن يأنف ويستكبر أن يكون عبداً لله، ومثله الملائكة المقربون، ومن يأنف ويستكبر فإن مصيره إلى الله وسيحاسبه على كفره وعصيانه.
إن الغلو وتجاوز الحدّ والحق هو ما يدعو أهل الكتاب إلى أن يقولوا على الله غير الحق، فيزعمون له ولداً - سبحانه - كما يزعمون أن الله الواحد ثلاثة وقد تطورت عندهم فكرة النبوة وفكرة التثليث حسب رقيّ التفكير وانحطاطه، ولكنهم اضطروا - أمام الاشمئزاز الفطري من نسبة الولد لله والذي ترفضه الثقافة العقلية - أن يفسروا الإله الواحد في ثلاثة، بأنها صفات لله تعالى في حالات مختلفة، وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة إلى الإدراك البشري، فهم يحيلونها إلى معميَّات غيبية لا تنكشف إلا بانكشاف حجاب السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى عن الشراكة، وتعالى عن المشابهة، ومقتضى كونه خالقاً يستتبع بذاته أن يكون غير الخلق، وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق، والمالك والملك، وإلى هذا يشير النص القرآني ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (النساء: 171).
وإذا كان مولود عيسى عليه السلام من غير أب عجيباً في عرف البشر، خارقاً لما ألفوه فهذا العجب إنما تنشئه مخالفة المألوف، والمألوف للبشر ليس هو كل الوجود، والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي كل سنة الله، والله يخلق السنة ويجريها، ويعرفها حسب مشيئته ولا حدَّ لمشيئته والله سبحانه يقول - وقوله الحق - في المسيح ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (النساء: 71).
- فهو على وجه القصد والتحديد (رسول الله) شأنه في هذا الشأن بقية الرسل، شأن نوح وإبراهيم وموسى ومحمد، وبقية الرهط الكريم من عباد الله المختارين للرسالة على مدار الزمن.
- (وكلمته ألقاها إلى مريم): وأقرب تفسير لهذه العبارة، أنه سبحانه، خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر، الذي يقول عنه في مواضع شتى من القرآن إنه (كن فيكون).
فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها من غير نطفة أب - كما هو المألوف في حياة البشر غير آدم - والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم، لا عجب في أن تخلق عيسى عليه السلام في بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله (وروح منه).
- (وروح منه) وقد نفخ الله في طينة آدم من قبل من روحه فكان إنساناً.
كما يقول الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (ص: 71- 72) والروح هنا هو الروح هناك.
ولم يقل أحد من أهل الكتاب - وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله - إن آدم إله، ولا أقنوم من أقانيم الإله - كما قالوا عن عيسى تشابه الحال- من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث الخلقة كذلك، بل إن آدم خلق من غير أب وأم، وعيسى خلق مع وجود أم.
وكذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (آل عمران: 59).
ويشهد بذلك العقل البشري ذاته، فالقضية في حدود إدراكه، فالعقل لا يتصور خالق يشبه مخلوقاته، ولا ثلاثة في واحد، ولا واحد في ثلاثة. والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل، والله الباقي غير عن الامتداد في صورة الفانين، وكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه.
- (له ما في السماوات وما في الأرض):
ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود، وهو يرعاهم أجمعين، ولا حاجة لافتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم، فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة.
- (وكفى بالله وكيلاً):
وهكذا لا يكتفى القرآن ببيان الحقيقة وتقريرها في شأن العقيدة، إنما يضيف إليها إراحة شعور الناس من ناحية رعاية الله لهم، وقيامه - سبحانه - عليهم، وعلى حوائجهم ومصالحهم، ليوكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة.
ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة نبوّة كنبوّة عيسى أو شرعاً في الألوهية كشرعته في الألوهية ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (النساء: 172- 173).
لقد عني - الرسل والأنبياء - ومنهم عيسى عليه السلام بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه، وحدانية لا تلتبس بشبهة شرك، أو مشابهة لصورة من الصور، وعنوا بتقرير أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة، ولا خاصيَّة.
وهذه الحقيقة جاء بها الرسل أجمعون، فقررها في سيرة كل رسول وفي دعوة كل نبي، وجعلها محور الرسالة في عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية -وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة- يكون منهم من يعرف هذه الحقيقة، وينسب لله سبحانه البنين والبنات، أو ينسب لله سبحانه الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم، اقتباسات من الوثنيات التي عاشت في الجاهليات.
إنه لا تستقيم تصورات الناس، ولا تستقر مشاعرهم إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم، هو إله لهم، وهم عبيده، هو خالق لهم، وهم مخاليق، هو مالك لهم، وهم مماليك، وهم كلهم سواء في هذه الصلة، لا بنوة لأحد، ولا امتزاج بأحد، ومن ثمَّ لا قرب لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد، ويوجه إرادته إليه فيبلغه: (التقوى والعمل الصالح). وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله، فأما البنوة والامتزاج فأنى بهما لكل أحد؟
ولا تستقيم حياتهم وارتباطهم ووظائفهم في الحياة إلا حين تستقرُّ في أخلادهم تلك الحقيقة: أنهم كلهم عبيد لرب واحد، ومن ثم موقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد، أما القربى إليه ففي متناول الجميع، عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان.
إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام، ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد، بالعبودية لرب العباد، ومن ثمَّ لم تقم في تاريخ الإسلام كنيسة تستذل رقاب الناس، بوصفها الممثلة لابن الله، أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم.
ولم يقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم (بالحق الإلهي) زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله، وقد ظلَّ (الحق المقدس) للكنيسة والبابوات في جانب، والأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقاً مقدساً كحق الكنيسة في جانب.
ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم الابن أو مركب الأقانيم، حتى جاء الصليبيون إلى أرض الإسلام مغيرين، فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على (الحق المقدس)، كانت فيما بعد ثورات "مارتن لوثر" و"كالفن" و"زنجلي" المسمَّاة بحركة الإصلاح على أساس من تأثير الإسلام ووضوح التصور الإسلامي، ونفي القداسة عن بني الإنسان، ونفي التفويض في السلطان؛ لأنه ليست هناك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام.
وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح ونبوته، وألوهية روح القدس "أحد الأقانيم"، وفي كل أسطورة عن نبوة أحد لله، أو ألوهية أحد مع الله، في أيِّ شكل من الأشكال.
يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى ابن مريم عبد الله، وأنه لن يستنكف أن يكون عبداً لله، وأن الملائكة المقربين عبيد لله، وأن جميع خلائقه ستحشر إليه، وأن الذي يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم، وأن الذي يقرُّون بهذه العبودية لهم الثواب العظيم.
- قال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (النساء: 172- 173).
إنَّ المسيح ابن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبداً لله؛ لأنه – عليه السلام- وهو نبي الله ورسوله خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان، وهو خير من يعرف أنه من خلق الله، فلا يكون خلق الله كالله، أو بعضاً من الله، وهو خير من يعرف أن العبودية لله – فضلاً على أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة – لا تنقص من قدره، فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء.
وهي المرتبة التي يصف الله بها رسله، وهم في أرقى حالاتهم وأكرمهم عنده، وكذلك الملائكة المقربون، وفيهم روح القدس جبريل، شأنهم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء، فما بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه، ويعرف حقَّ المعرفة؟
- (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا):
فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر الله لهم بسلطانه، سلطان الألوهية على العباد، شأنهم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين لله.فأما الذين عرفوا الحق، فأقروا بعبوديتهم لله، وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة، وهذا الإفراز، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.
- (وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا):
وما يريد الله من عباده أن يقروا له بالعبودية، وأن يعبدوه وحده لأنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم، ولا أنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء، ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، لتصحَّ تصوراتهم ومشاعرهم، كما تصح حياتهم وأوضاعهم، فما يمكن أن تستقرَّ التصورات والمشاعر، ولا أن تستقر الحياة والأوضاع، على أساسٍ سليم قويم إلا بهذه المعرفة، وما يتبعها من إقرارٍ وما يتبع الإقرار من آثار.
يريد الله سبحانه أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس، وفي حياتهم، ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا الكون، وفي هذه الأرض، فلا يخضعوا إلا له، ولمنهجه وشريعته للحياة، وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه، يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد، ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه، حين تعنو له وحده الوجوه والجباه، يريد أن يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة حين يخرون له راكعين ساجدين، يذكرون الله ولا يذكرون أحداً إلا الله، يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب، ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح، فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات فربى إلى الله، يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية.
إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة، وتحليق أنظار البشر لله وحده، وتعليق قلوبهم برضاه، وأعمالهم بتقواه، ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه.
إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية، وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به الأرض في هذه الحياة، فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقربين بالعبودية العاملين للصالحات في الآخرة فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر وفيض من عطاء الله.
وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة التي جاء بها الإسلام، وقرر أنها قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً، قبل أن يحرفها الأتباع، وتشوهها الأجيال، يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان، تتوافر له معه الكرامة والحرية، والعدل والصلاح، والخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر، وفي نظام الحياة سواء.
والذين يستنكفون من العبودية لله، يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي، يذلون لعبودية الهوى والشهوة، أو عبودية الوهم والخرافة، ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم، ويحنون لهم الجباه، ويحكِّمون في حياتهم، وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم من البشر، وهم سواء أمام الله، ولكنهم يتخذونهم آلهة من دون الله، هذا في الدنيا، أما في الآخرة (فيعذبهم عذاباً أليماً، ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً).
إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان، وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان.
يمكنكم تحميل كتاب المسيح ابن مريم عليه السلام : الحقيقة الكاملة من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
http://www.alsalabi.com/salabibooksOnePage/626
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
https://alsalabi.com