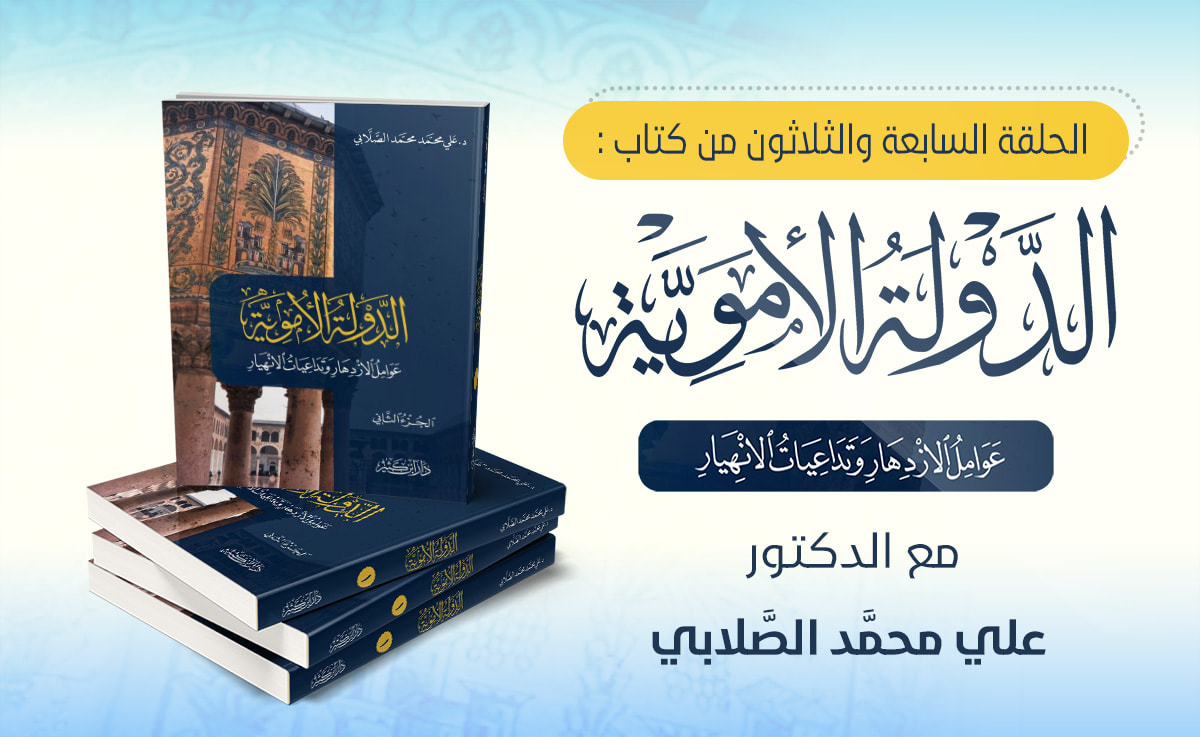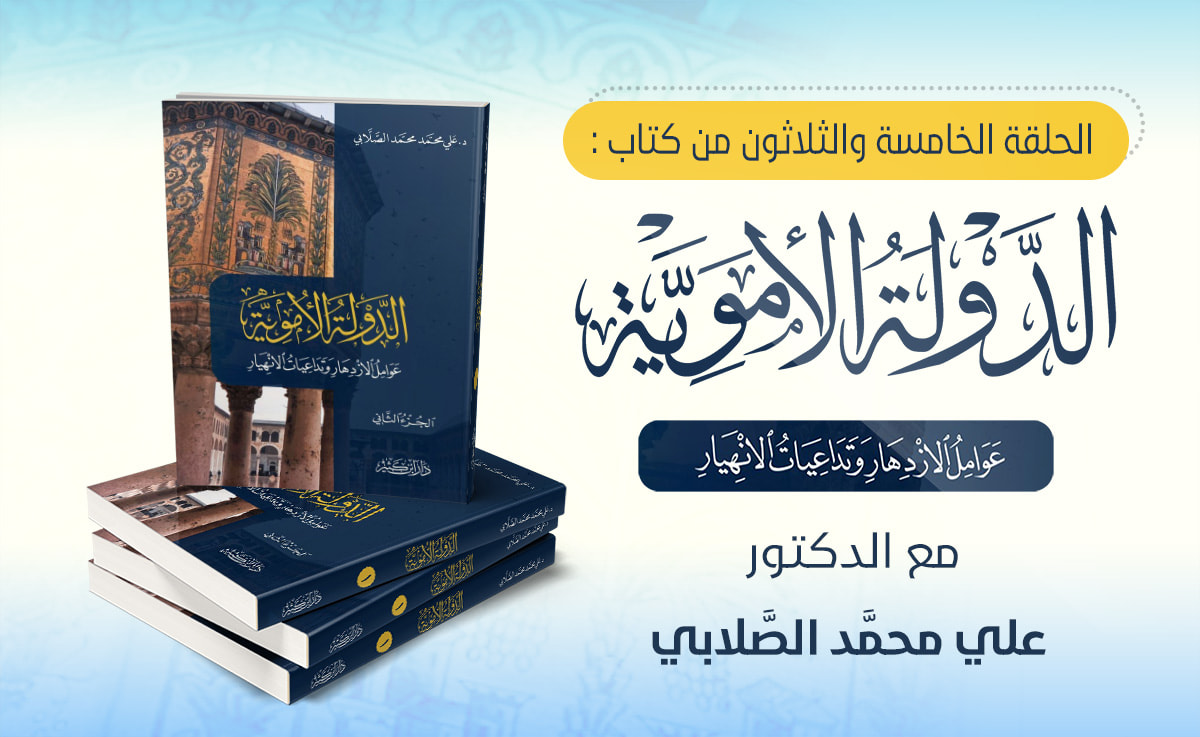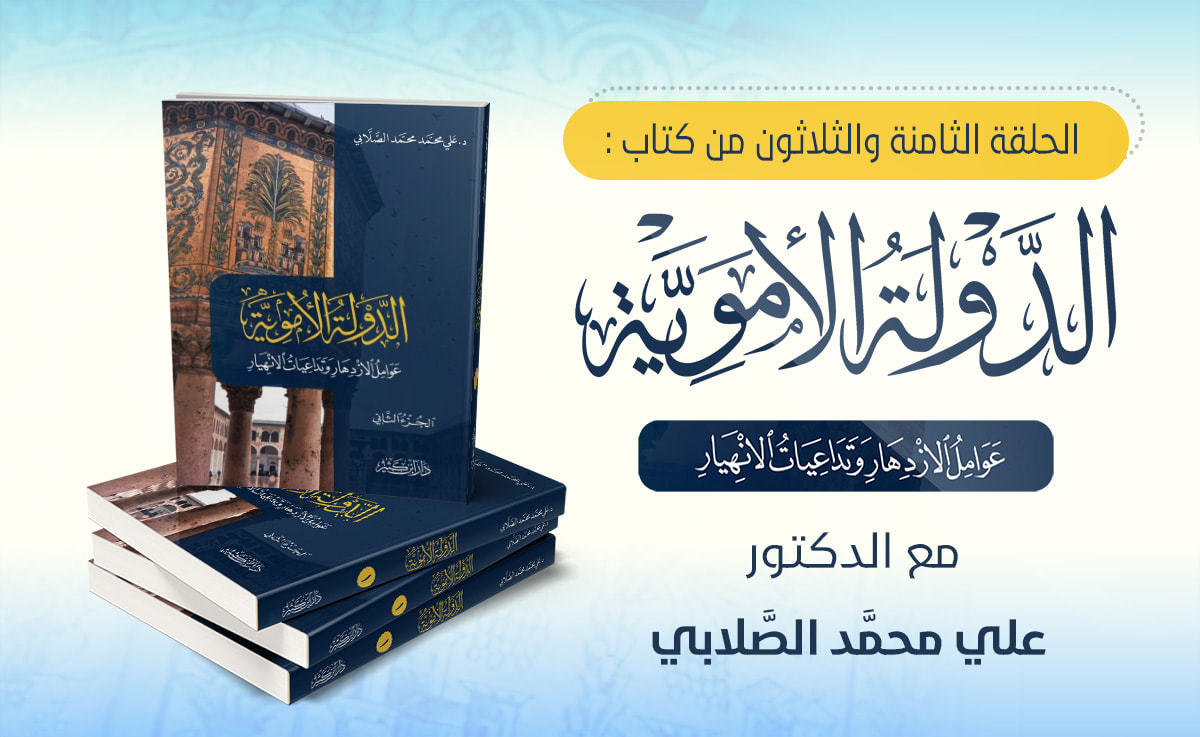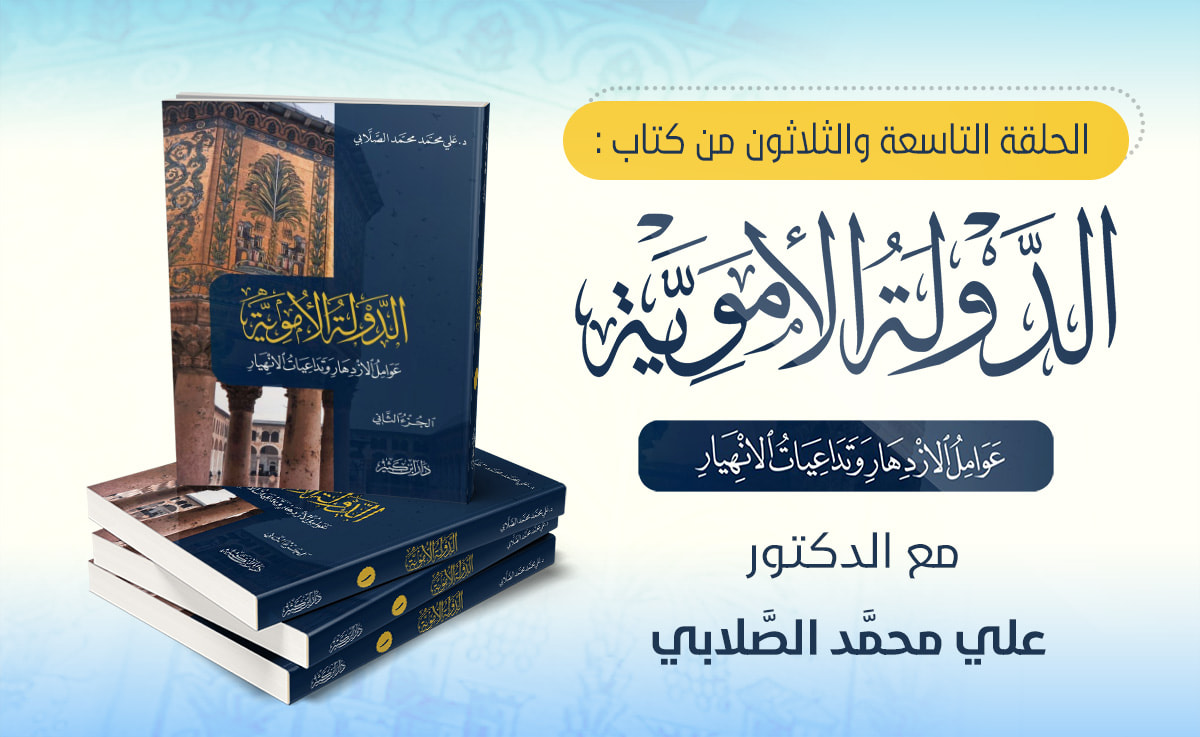من كتاب الدولة الأموية: خلافة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)
(مصادر دخل الدولة في عهد معاوية رضي الله عنه)
الحلقة: السابعة والثلاثون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ اكتوبر 2020
1 ـ الزكاة:
وهي أهم مكونات النظام المالي الإسلامي؛ وذلك لكونها ثابتة بالكتابة والسنة ، إذ يقول عنها سبحانه: {وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ٥} [البينة: 5]، كما أجمع المسلمون على وجوبها باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة ، ومن ذلك اتفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال مانعيها في عهد أبي بكر الصديق.
وقد أسند إلى السلطان مهمة تحصيلها وإنفاقها ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعها ويقوم على تفريقها ، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، أما في عهد عثمان لما كثرت الأموال فقد رأى أن يفوض الممولين فيما يتعلق بالأموال الباطنة كالوكلاء عن الإمام ، أما الأموال الظاهرة كالزروع والمواشي ونحوها ، فقد استمرت الدولة في جبايتها وإنفاقها ، وقد ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان أنهم كانوا يأخذون زكاة المال من عطاء الرجل. ثم اختلف بعد مقتل عثمان هل تدفع الزكاة إلى الولاة أم لا ؟. وهذا الخلاف بشأن الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة ظلت تحصلها الدولة ، وهذا يدل على سبب نقص حصيلة الزكاة بشكل عام في العصر الأموي ، لامتناع جماعة من الناس عن دفعها للولاة ، وتفريقها بمعرفتهم ، عدا عهد عمر بن عبد العزيز الذي ما إن سمع الناس بولايته حتى سارعوا إلى دفعها للدولة. كما أعاد كذلك أخذ الزكاة من العطاء ، أي: بالخصم عند المنبع، وهكذا يعكس تعاظم دور الزكاة كأحد مكونات الإيرادات العامة إبان عهد عمر بن عبد العزيز ، ولا يعني هذا إغفال دورها الهام طيلة العصر الأموي ، فبالرغم من عدم توافر أرقام عنه إلا أن الدلائل تشير إلى كبر أهميتها، وذلك لأنها كانت تحصل من قطاعين رئيسين من قطاعات الاقتصاد الأموي ، هما الزراعة وقطاع التجارة وخاصة في ظل نظام العشور.
ومنها أيضاً وجود ديوان خاص يسمى ديوان الصدقات ، وهو الديوان الذي يتولى النظر في أمور الزكاة والصدقات التي تجبى من القادرين والمتمكنين مالياً ، ليتم توزيعها على مستحقيها في الوجوه الشرعية التي ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وأشار إليه الجهشياري أول مرة في خلافة هشام بن عبد الملك، ويذكر أن: إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب كان يتقلد ديوان الصدقة للخليفة هشام بن عبد الملك.
وقد يعود عدم وجود أرقام عن حصيلة الزكاة لعدم تسجيل مقادير تلك الصدقات ، إذ كانت تدفع جميعها أو معظمها في الحال إلى مستحقيها.
وبصفة عامة يمكن القول: إن نظام الزكاة كان مطبقاً في العهد الأموي وفقاً للأسس الشرعية الخاصة به ، وإن قمة التطور بالنسبة لحصيلة الزكاة كان في عهد عمر بن عبد العزيز؛ حيث وثق الشعب في الدولة نتيجة حرصها على تطبيق الإسلام كواقع عملي ، فسارع إلى دفع الزكاة إليها ، وكذلك أخذ الزكاة من العطاء فيه تخفيف لتكاليف جباية الزكاة ، فزيادة الموارد مع قلة التكاليف أحدثت نمواً ملحوظاً في حصيلة الزكاة.
2 ـ الجزية:
وهي ما يؤخذ من أهل الذمة ، وهي ضريبة على الذمي المستوفي لشروطها مقابل الدفاع عنه ، وكانت تمثل أحد الموارد الثابتة للدولة الأموية ، عملاً بقوله تعالى: {قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩} [التوبة: 29].
وهي ثابتة في السنة: لما قاله المغيرة بن شعبة لترجمان عامل كسرى: .. فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤتوا الجزية.
وهي ثابتة أيضاً بالإجماع.
ولم يضف الأمويون شيئاً يذكر بالنسبة لتنظيم الجزية ، ويمكن القول بأن جبايتها خضعت لما استقر عليه تنظيمها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فمن حيث ضوابطها تمثلت في أربعة؛ هي: تحديد الشريحة التي تؤخذ منها الجزية متمثلة في الذكور العقلاء البالغين ، ثم تحديد الفئات المعفاة منها؛ وهم: الصبيان والنساء ، المرضى المزمنون ، العبيد ، المجانين ، العميان ، الشيوخ ، الرهبان الذين لا مورد لهم ، وكذلك مراعاة مستوى دخل الممول يساراً وإعساراً ، حيث كانت تفرض على الفرد الغني (48) درهماً سنوياً ، وعلى المتوسط (24) درهماً سنوياً ، وعلى ما دون ذلك (12) درهماً سنوياً بشرط أن يكون ذا حرفة.
وأما عن تصنيفها فيمكن تقسيم الجزية وفق المعيارين التاليين:
أ ـ معيار المسؤولية: وطبقاً له تنقسم الجزية إلى فردية وجماعية ، فالجزية الفردية هي التي تفرض على كل ذمي مستوفٍ لشروطها في صورة مبلغ محدد يسقط عنه حالة إسلامه ، أما الجماعية أو المشتركة فكانت تتم بوضع مبلغ إجمالي معين على أهل القرية أو المدينة ، ثم يتولون هم توزيعه بين أفرادهم ، ومثالها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم: صلحه صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح على مئة دينار في كل رجب. وكان غالب الجزية في العصر الأموي من هذا النوع.
ب ـ معيار النقدية والعينية: وطبقاً له انقسمت الجزية إلى ثلاثة أقسام: جزية نقدية ، جزية عينية ، جزية مشتركة ، وكانت جميع أصناف الجزية معمولاً بها في العصر الأموي ، ولم يوجد ما يشير إلى الخروج عن ذلك ، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تقتضي بالالتزام بعقود الصلح ، والوفاء بها ، لكن هذا لم يمنع من خروج بعض الولاة أحياناً عن الضوابط الشرعية.
وبالنسبة لحجم غلة الجزية ونسبتها إلى إجمالي الإيراد الكلي للدولة؛ فهذا مما يصعب تحديده ، لكن هناك مؤشرات تدل على عظم حجم إيراد الجزية وما يتضح من الدور الكبير الذي قامت به الدولة الأموية في نشر الإسلام في بلدان كثيرة تم فتحها وفرض الجزية على من لم يسلم من أهلها.
3 ـ الخراج:
كبقية المصادر المالية للدولة التي كان لعمر بن الخطاب الريادة في تنظيمها ، فقد استفادت الدولة الأموية من تنظيم عمر له ، إذ سارت في أغلب أقاليمها عليه ، إلا ما طرأ من تعديلات سوف يتم التعرض لها ، وللخراج معنى خاص: وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها الإمام لمصالح المسلمين على الدوام ، كما فعل عمر بأرض السواد من العراق والشام ، والخراج كما قال ابن رجب الحنبلي: لا يقاس بإجارة ولا ثمن ، بل هو أصل ثابت بنفسه لا يقاس بغيره ، وكان للخراج أهمية كبرى بالنسبة للدولة الأموية، وكانت غلة الخراج في منطقة السواد على سبيل المثال في عهد ابنه عبيد الله سنة (54 ـ 66 هـ) بلغت 135 مليون درهم.
وأما منطقة الجزيرة والشام: فقد استمر الخراج في هذه المنطقة وفقاً لما وضعه معاوية بن أبي سفيان ، الذي فرض ضرائب على أهل المدن ذات شقين ، شق منه جزية ، والاخر خراج؛ وهو كما يلي:
أ ـ على أهل قنسرين حوالي مليون وخمسمئة ألف درهم.
ب ـ على الأردن ستمئة ألف درهم.
جـ على فلسطين حوالي ستمئة ألف درهم.
وقد حدثت بعض الانحرافات في تحصيل الخراج في عدة صور؛ أهمها:
أ ـ فرض الخراج على أرض مستثناة منه بنص عقود الصلح ، فقد حدث ذلك في عهد يزيد بن معاوية (60 ـ 64 هـ) حيث فرض الخراج على أرض السامرة بالأردن وفلسطين.
ب ـ استخدام العنف في تحصيل الخراج ، في بعض الأقاليم ، باستثناء عهد عمر بن عبد العزيز ، حيث استخدمت الشدة في تحصيل الإيرادات بأنواعها.
جـ تحميل نفقات جباية الخراج على الممول ، ومن تلك النفقات : قيمة الورق الذي يكتب عليه مقادير الخراج، قيمة إيجار المستودعات التي يتم تخزين حصيلة الخراج العينية فيها ، أجرة الجابي الذي يقوم بالجباية ، وبقية نفقات تحصيل الخراج ، وقد حدث ذلك خاصة في إقليم العراق وكان قبل عهد عمر بن عبد العزيز ، فلما ولي الخلافة أبطلها ثم عادت بعد موته.
وكان للخراج في عهد الدولة الأموية ديوان خاص به ، يسمى ديوان الخراج: وهو الذي يتولى النظر في جباية ضريبة الخراج ، ويقوم بجمعها وتسجيلها ، ووضع تقديرات لها ، لأنها أعظم واردات الدولة.
وكان الأمويون قد فصلوا بين الولاية والجباية ، وعينوا مسؤولين عنها لكي يحصروا المسؤولية ، وقد ذكرت المصادر قائمة بأسماء الذين أسندت إليهم مهمة الجباية والإشراف على أعمال الديوان ، فمعاوية رضي الله عنه عين على خراج دمشق: سرجون بن منصور ، وعلى خراج فلسطين: سليمان المشجعي ، وعلى خراج حمص: ابن أثال النصراني ، وفي خلافة يزيد بن معاوية استمر على الديوان: سرجون بن منصور ، كما بقي عليه طوال حكم معاوية الثاني ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك ، حتى عزله.
وقد أولى معاوية رضي الله عنه وولاته في الأقاليم الأرض ومن عليها عناية متزايدة ، فاستصلح البطائح وهي أرض واسعة مغمورة بالمياه ، بقطع القصب وضخ الماء بالمسنيات ، مما أدّى إلى عمارة البلاد وزيادة الوارد العام بمقدار خمسة آلاف ألف درهم، وراعى معاوية حالة السكان وسعى لتطمينهم والتخفيف عن كاهلهم بمجموعة من الإجراءات يتعلق بعضها بضريبة الخراج ذاتها ، وبعضها الآخر يتعلق بالقائمين على الضريبة.
ومن ناحية أخرى ، فقد عمل معاوية على إنصاف دافعي الضريبة باختيار عماله ومتابعته لهم ، وإن كانوا من المقربين ، فقد عزل ابن أم الحكم وهو عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ـ وهو ابن أخته ـ لأنه اشتد في أمر الخراج ، ولم يقبل من عامل خراجه جباية الخراج قبل موعده الموجود.
وفي الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى استعمال الأعاجم في الخراج ، وصلاحهم لذلك لأسباب عبَّر عنها زياد بن أبيه بوضوح؛ منها: معرفتهم بأمور الخراج ، ودورهم في إعمار الأرض ، حيث يقول: وينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج ، ودعا زياد إلى مراعاة الدهاقين والإحسان إليهم: أحسنوا إلى الدهاقين ، فإنكم لن تزالوا سماناً ما سمنوا.
4 ـ العشور:
هي الأموال التي يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة الإسلامية؛ سواء داخلة أو خارجة من أرض الدولة ، وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر ، ويقوم بتحصيلها موظف يقال له: العاشر؛ أي: الذي يأخذ العشور ، وأول من وضعها في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد فرضها على الحربي بنسبة العشر ، وعلى الذمي نصف العشر ، وعلى المسلم ربع العشر ، وقد استمرَّ هذا النظام في العهد الأموي وفق القواعد التالية:
أ ـ إعفاء الحد الأدنى لرأس المال ، والذي قدر بالنسبة للمسلم بمئتي درهم، أما بالنسبة للحربي والذمي فقد اختلف فيه.
ب ـ لا تحصل العشور إلا مرة واحدة في السنة.
جـ يشترط لتحصيل العشر من النعم التي للمسلم أن تكون سائمة.
د ـ لا تؤخذ العشور من عبد ولا مكاتب ولا مضارب ولا بضاعة ، وإنما من رب المال نفسه.
هـ أن يكتب للتاجر سند بالمبلغ الذي دفعه ، وبمقتضاه لا تأخذ منه العشور إلا في السنة التالية.
و ـ أن لا يتم تفتيش التاجر ولا تعنيفه.
ز ـ أن من ادَّعى ديناً يستغرق ما معه من التجارة ، صُدق إن كان مسلماً ، وإن ارتاب في أمره استحلفه (على خلافٍ في ذلك) ، وأما الذمي فأقرب الأقوال فيه أن يشهد له شاهدان من المسلمين حتى يُعفى.
ح ـ أن العشور التي تؤخذ من المسلمين هي الزكاة، فلا يجمع على المال زكاة وعشور.
ط ـ أن غير المسلم إذا مر بما يوصف بالمالية عندهم وليس بمال عند المسلمين كالخمر والخنزير ونحوها ، يقومه أناس من غير المسلمين ، ويضاف إلى قيمة ما معه من تجارة ويؤخذ منه العشور.
وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن العشور كانت تشكل جزءاً مهماً في إيرادات الدولة ، من ذلك ما لمسه ابن الزبير من نقص في مواد الدولة حينما منع تحصيل العشور لمدة عام واحد، مما حمله على التراجع على ذلك القرار.
5 ـ الصوافي:
هو ما اصطفاه الإمام لبيت المال من أرض الفيء، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من البلاد المفتوحة عنوة بحق الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. ثم أقطعت أجزاء منها إلى بعض من كان يتولى استثمارها ، على أن يؤدي لبيت المال ما عليها ، وأول من أقطع: عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وذلك بدافع زيادة غلتها ، وقد اشترط على من يقطعه إياها حق الفيء، فبلغت غلتها آنذاك خمسين مليون درهم.
وانتبه معاوية بن أبي سفيان للصوافي في وقت مبكر، وكتب إلى الخليفة عثمان سأله أن يقطعه إياها، ليقوى بها على ما وصف في كتابه؛ يقول ابن عساكر: حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عثمان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم ، ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها. ووصف في كتابه هذه المزارع الصافية وسماها له ، وسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وصف له ، وأنها ليست من قرى أهل الذمة ولا الخراج ، فكتب إليه عثمان بذلك كتاباً، يضاف إلى تلك المزارع: مزارع وأراضٍ بني فوقا الذين لا وراث لهم ، فأخذ معاوية ما يليهم. ولما أفضى الأمر إليه ، جعل هذه الأراضي حبساً على فقراء أهل بيته والمسلمين ، وأشار المؤرخ الشيعي اليعقوبي إلى أن معاوية جعل هذه الأراضي ، وضياع الملوك في الشام والجزيرة واليمن والعراق خالصة لنفسه عندما أفضى الأمر إليه. فأقطع منها فقراء أهل بيته وخاصته ، واعتبر بذلك: أول من كانت له الصوافي في جميع أرجاء الدنيا. وهذه الإشارة من اليعقوبي تلفت الانتباه نظراً إلى الالتباس الواضح في لغتها ، فقد ذكرت الصوافي في الجزيرة واليمن؛ علماً بأن عمر بن الخطاب كان قد أصفى مجموعات خاصة في أراضي السواد وأراضي الشام لم يدخل فيها صوافي الجزيرة واليمن.
كما أشار اليعقوبي إلى أن معاوية جعل هذه الأراضي خالصة لنفسه ، فأقطع منها فقراء أهل بيته وخاصته، وبمقارنة هذا النص ، بنص ابن عساكر عن الموضوع نفسه ، يظهر مدى المبالغة في تلك الرواية؛ يقول ابن عساكر عن تلك الأراضي: فلم تزل بيد معاوية حتى قتل عثمان وأفضى إلى معاوية الأمر ، فأقرّها على حالها ، ثم جعل من بعده حبساً على فقراء أهل بيته والمسلمين ، أي أن معاوية لم يتصرف فيها ابتداء ، بل تركها على حالها، ولكن يبدو أن هناك ضرورات سياسية نشأت في الشام دفعت الدولة إلى اتخاذ ضرب جديد من التنظيم والسعي لخدمة مصالح الدولة ، ومن هذه الضرورات: محاولة إقامة توازن قبلي في بلاد الشام بين اليمانية وبين القيسية، ولذلك أقطع معاوية إقطاعات واسعة في هذا المجال.
ولقد أسيء فهم هذا الإجراء ، وفسر بعض المؤرخين كاليعقوبي ، موضوع مصالح الدولة بأنه يعني مصالح الأسرة الأموية وبالتحديد معاوية. ولا شك أن معاوية استخدم هذه الأموال في تثبيت دعائم الدولة ، وحفظ وحدة الأمة ، فكان يتصرف وفق ما يراه مناسباً للصالح العام، ولا يمنع ذلك الإحسان إلى أسرته والمقربين إليه بالمعروف، وقد أمر معاوية بإعادة مسح للصوافي في أمصار الدولة الأموية ، وأضاف أراضي واسعة بعد العثور على سجل الضياع الساسانية وأصبحت تحت تصرف معاوية المباشر؛ فكان يسد منها بعض حالات العجز في النفقات العامة ، فقد بلغ غلة صوافيه بالعراق وما يتبعه مئة مليون درهم ، وكذلك فعل بصوافي أرض الشام والجزيرة واليمن حتى فدك اصطفاها لنفسه ثم أقطعها لمروان بن الحكم ، وظلت كذلك طيلة العهد الأموي ، باستثناء عصر عمر بن عبد العزيز الذي أعادها للملكية العامة وشجع القطاع الخاص على استثمارها ، كما رد فدك لبيت المال ووضع ما يأتي منها في أبناء السبيل ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، كما أمر باستثمار أراضي الصوافي حين كتب إلى واليه على العراق: انظر ما قبلكم من أرض الصافية ، فأعطوه حتى تبلغ العشر؛ فإن لم يزرعها أحد فامنحها ، فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ، ولا تبتزن قبلك أرضاً ، ونلاحظ من هذا النص اهتمام عمر بن عبد العزيز بأمر الصوافي ، مما يدل على أهميته في موارد الدولة.. لكن أمر الصوافي ، عاد إلى ما كان عليه الأمر بعد عهد عمر بن عبد العزيز.
6 ـ خمس الغنائم:
تعرّف الغنيمة: ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة ، وقد نص عليها القران الكريم ، وفي العصر الأموي ازدادت حركة الفتوحات ، وبالتالي زادت الغنائم كأحد موارد بيت المال ، وقد اتبع الأمويون نفس النهج العمري بالنسبة للغنائم والأراضي المفتوحة ، فكان تخميس الغنائم وتقسيمها بين الفاتحين وترك الأرض فيئاً لمجموع المسلمين مع ضرب الخراج عليها ، هذه أهم المصادر المالية للدولة مع وجود مصادر أخرى كنظام خمس الركاز، ومال من لا ورث له؛ إذ ظل في العصر الأموي على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، إضافة إلى أن نسبة هذين العنصرين بسيطة جداً بالنسبة لغيرها من المصادر.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf