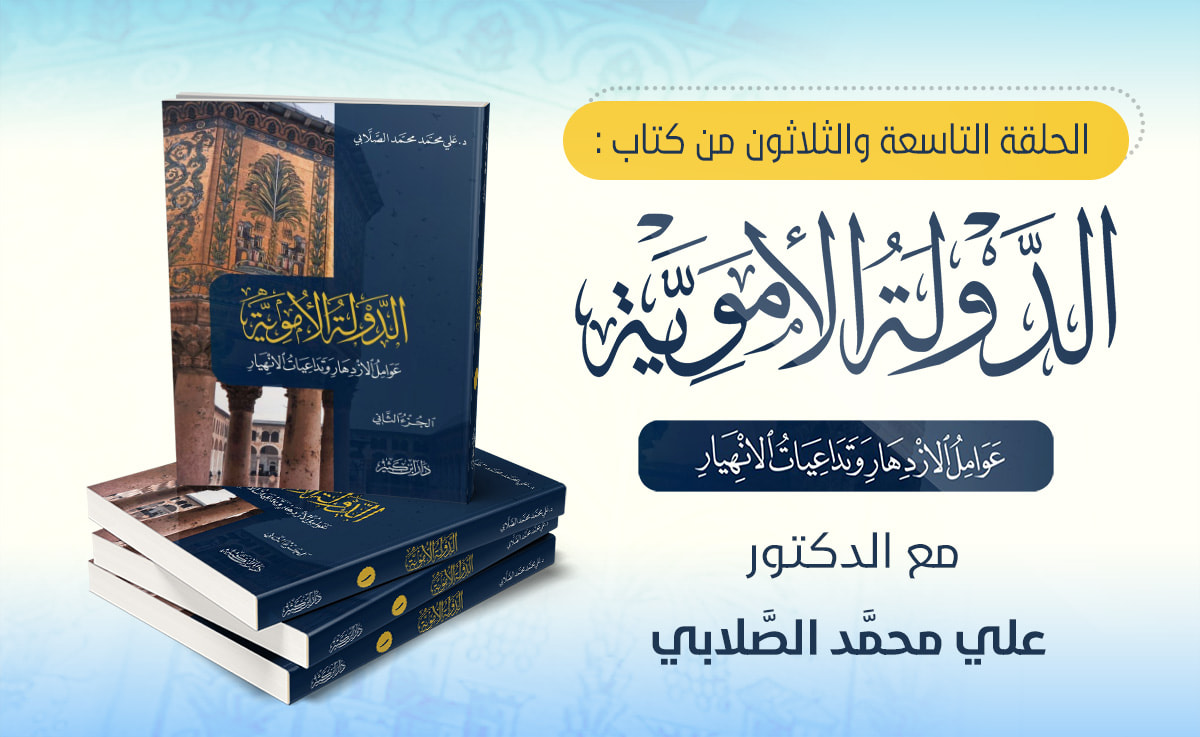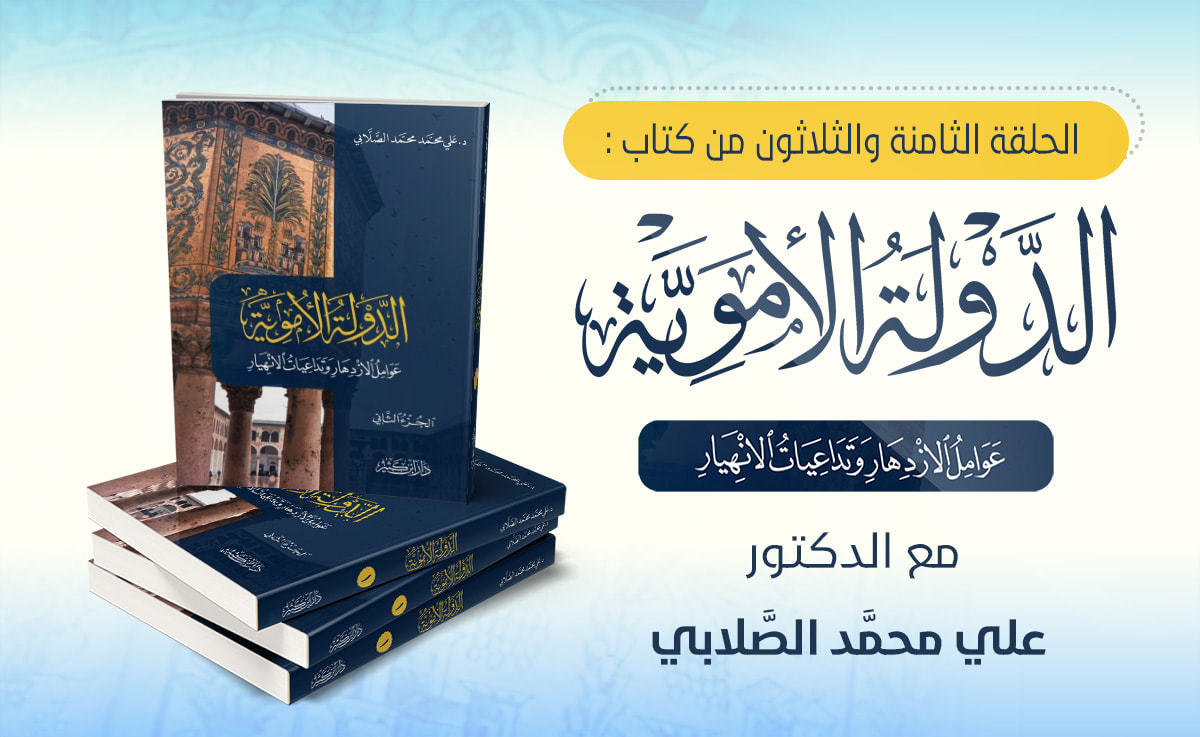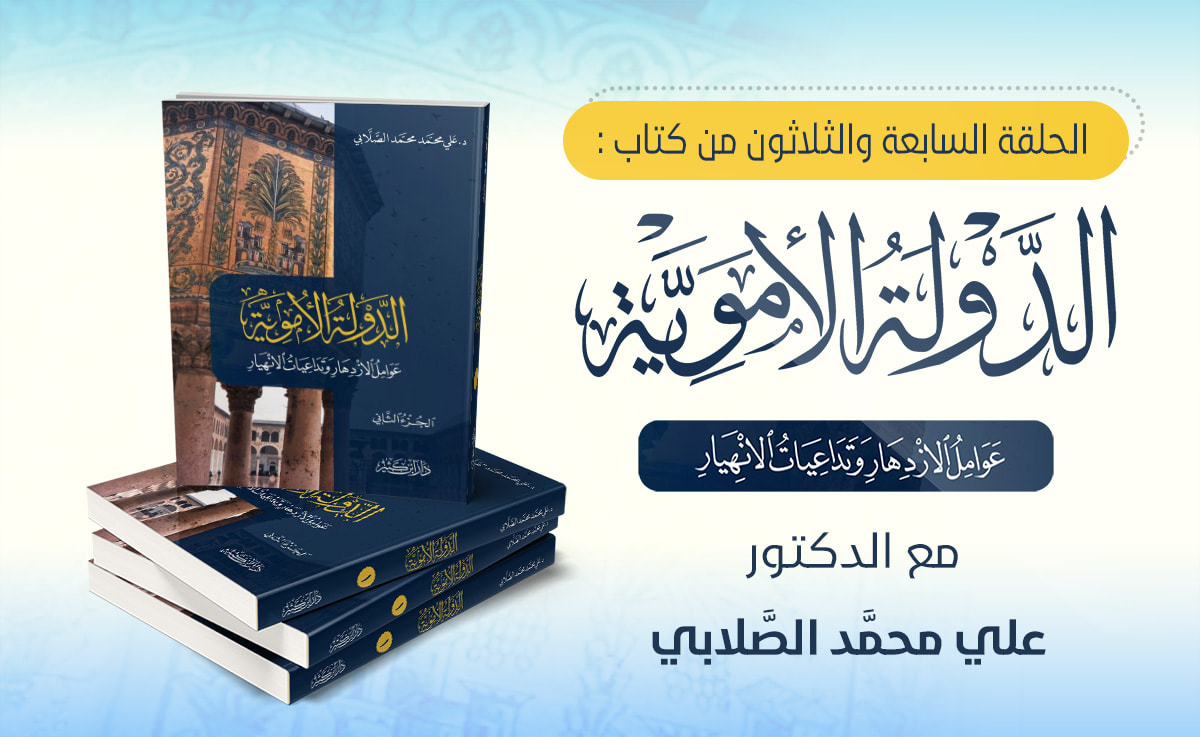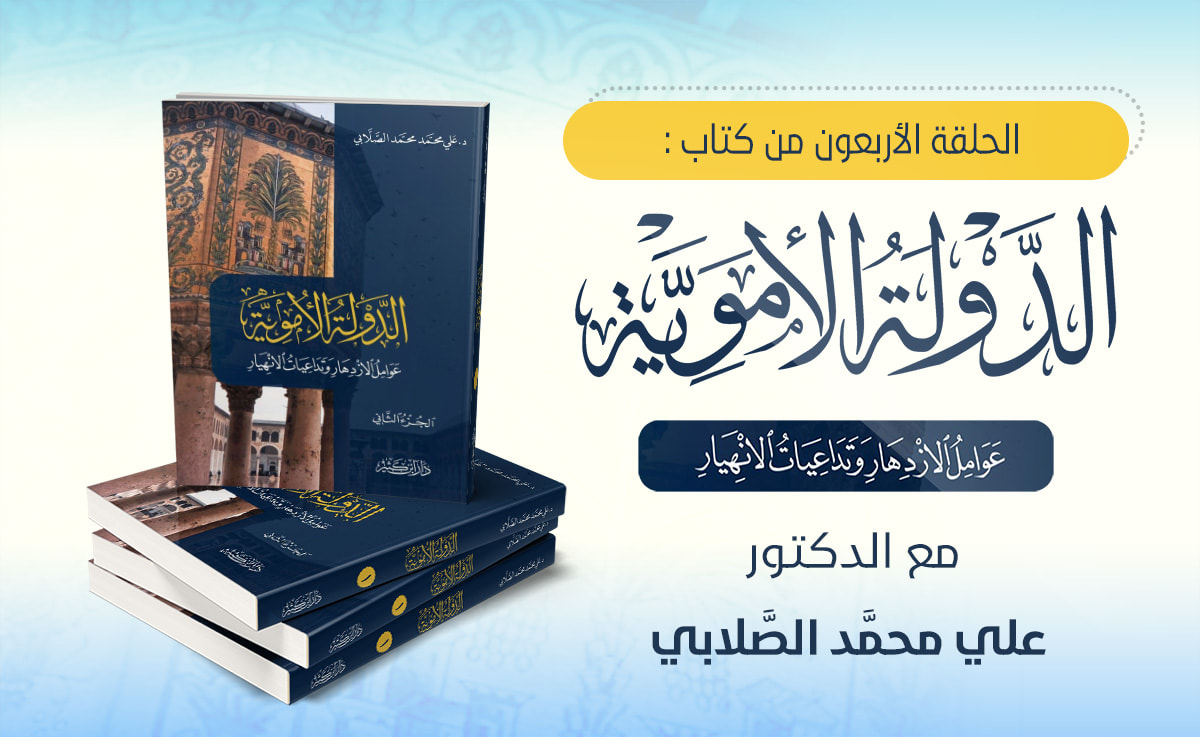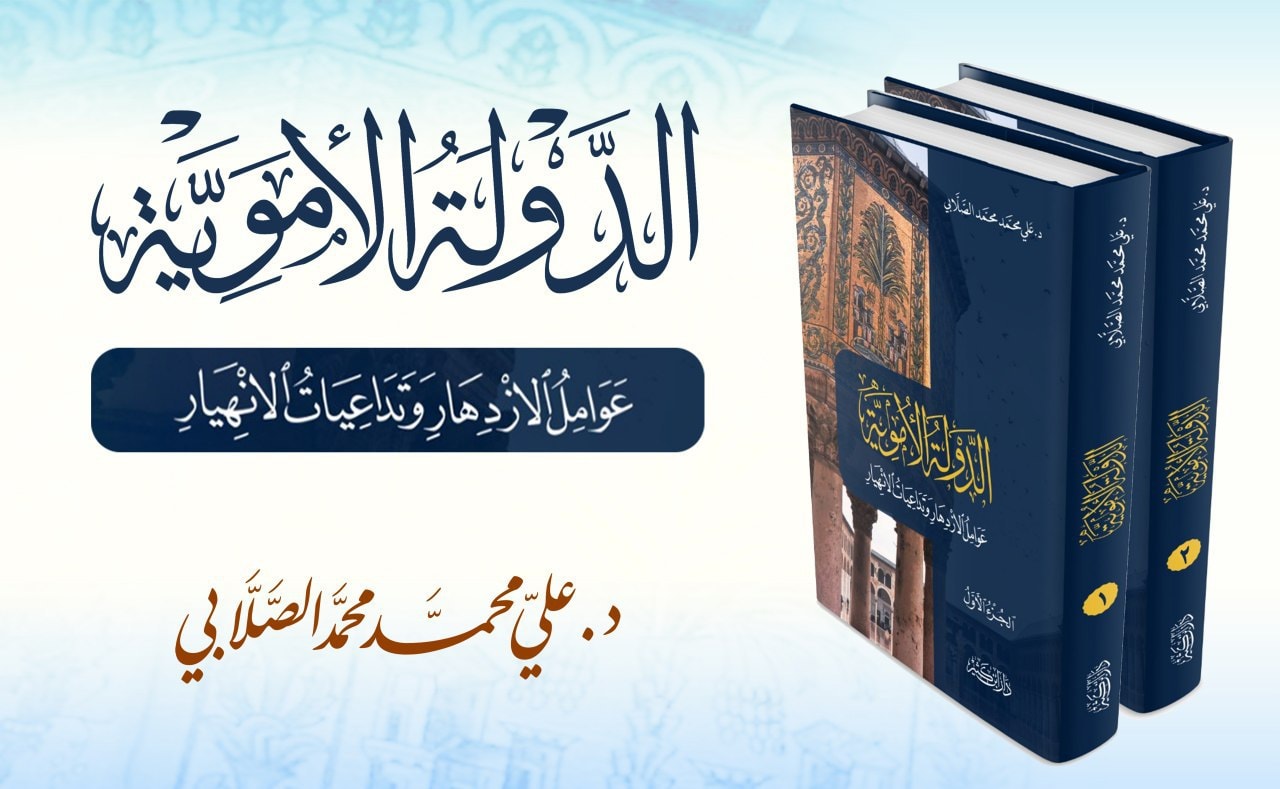من كتاب الدولة الأموية خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
(اهتمام الدولة الأموية بالزراعة)
الحلقة: التاسعة والثلاثون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ اكتوبر 2020
مع بداية الدولة الأموية ظهرت الملكيات الزراعية الكبيرة ، وذلك نتيجة لدخول الولاة والخلفاء في هذا الميدان، ولذلك اهتموا بإحياء الأرض الموات من أراضي الصوافي وغيرها ، من الأراضي المفتوحة الخصبة ، وبالذات إقليم العراق وما شابهه ، وقد ساعدهم في ذلك حجم السيولة التي يملكونها ، فقد أحيى والي معاوية رضي الله عنه على خراج العراق أرضين من البطائح لمعاوية ، حيث قام بقطع الماء عنها وتجفيفها وزراعتها ، وقد بلغت غلتها خمسة ملايين درهم ، وهذا مما يدل على عظم مساحتها ، ولم يكن معاوية رضي الله عنه يجعل ريعها كله داخلاً في نفقاته الخاصة ، وإنما كان يتدارك منها شيئاً من النقص في النفقات العامة ، ولم يدخل تلك الأرضين في ملكه يتوارثها من بعده ، بدلالة أن الأرض التي أحياها الحجاج فيما بعد لعبد الملك هي نفس الأرض التي أحياها معاوية رضي الله عنه ، إلا أنها عادت مواتاً لغلبة الماء عليها.
ومن الناحية الشرعية فإن إحياء الأرض بصفة عامة مباح، بل هو سبب من أسباب الملك لها، وذلك استناداً على الأحاديث الواردة في ذلك ، وهي إباحة عامة يستوي فيها الحاكم، والمحكوم ، إلا أنه في حق الحاكم ينبغي أن تكون هناك قيود إضافية؛ لعل من أبرزها:
أ ـ عدم استغلال الحاكم لسلطته ومكانته ، وإنما يدخل في عملية الإحياء كأي فرد من أفراد الشعب.
ب ـ عدم استخدام أموال المسلمين في عملية الإحياء ، بل يقوم بإحيائها من ماله الخاص.
جـ ألا يترتب على تملكه للأرض بطريق الإحياء ضرر على المسلمين ، الأفراد أو جماعة المسلمين ، وكذا من له ذمة ، وقد ساهم الإقطاع ـ أي الإقطاع بقصد الإحياء والإعمار ـ في تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة، فقد أقطع معاوية رضي الله عنه بعض إخوته الجزيرة التي بين النهرين ، فأرسل زياد بن أبيه الماء ، فلما نظر إلى المقطوعة له ظن أنها بطيحة ، فاشتراها منه زياد بمئتي درهم ، وقد أقطع زياد بعد ذلك من تلك الأرض غيره ، مما يدل على عظم حجمها ، حتى إنه أيضاً حفر لها أنهاراً وليس نهراً واحداً ، وأقطع زياد بن أبيه مرّة مئة جريب على نهر الأبلة، فحفر لها نهراً فسمي باسمه ، كما أقطع أيضاً كل بنت من بناته ـ أي بنات زياد ـ ستين جريباً.
واستمرت الملكيات الزراعية بالتوسع مع مجيء الخلفاء الأمويين بعد معاوية رضي الله عنه ، ولم ينحصر الإقطاع للأراضي على الأسرة الأموية وبعض وجهاء قريش ، وإن كان هو الغالب ، إذ كانت هناك إقطاعات لعامة الشعب ، ومثال ذلك: أن زياداً كان يقطع الرجل القطيعة ويتركه سنتين؛ فإن لم يعمرها أخذها منه. وقد كانت تقدر مساحات تلك الإقطاعات بين (60 ـ 100) جريب.
وقد كانت إقطاعات الدولة الأموية من الصوافي أو من الأراضي الموات ، ولكن بصفة عامة يؤخذ على القطاع في العصر الأموي عنصر المحاباة ، إذ إن أصحاب الملكيات الكبيرة كانوا إما من الأسرة الأموية ، أو من أشراف قريش، وبحثت الدولة عن أصحاب السيولة النقدية القادرين على استثمار تلك الأراضي ، لكن ترتب على ذلك السلوك تركز الثروة الكبيرة في أيدي قلة من أفراد المجتمع.
كانت الزراعة في العصر الأموي تعتمد بصفة رئيسة على مياه الأنهار ، ولذا نجد أن مراكز الإنتاج الزراعي الرئيسة كانت هي العراق ومصر والشام ، وبالذات حول الأنهار.
وكان للقطاع الخاص دوره في تطوير الزراعة في العهد الأموي ، وقد قام القطاع الخاص باستصلاح أراضٍ زراعية جديدة بمساحات واسعة، ومثال ذلك: أراضي البطائح التي كانت منذ عهد الفرس وحتى عهد الدولة الأموية أراضي مغمورة بالمياه ، فبدأت من بداية الدولة الأموية حركة استصلاحها بحجز المياه عنها وتجفيفها، وقد خرجت منها أراضٍ واسعة وخصبة وفيرة الإنتاج، وقد توسعت الملكيات الزراعية الخاصة، وترتب عليها زيادة في الإنتاج الزراعي، مما أدى إلى وجود أراضٍ بعيدة عن مصدر الري وهو النهر الأساسي، فحدث تطور في تقنية الري؛ حيث ظهرت حركة حفر الأنهار والقنوات الفرعية وفق طرق هندسية تسمح لتلك الأراضي بالاستفادة من ماء النهر دون أن يؤدي ذلك إلى إغراقها، وقد توسع القطاع الخاص في حفر هذه الأنهار والقنوات، فحدثت تنمية زراعية نتيجة استفادة الأراضي التي كانت تمر بجوارها تلك الأنهار والقنوات الفرعية.
وقد تمّ نقل التقنية الزراعية من البلاد المفتوحة حديثاً إلى مراكز الإنتاج الزراعي الرئيسة في الدولة الأموية.
إلا أن القطاع الزراعي تعرض للتدهور في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية بسبب عوامل متعددة؛ منها:
1 ـ الاضطراب السياسي ، وفقدان الأمن بالمنطقة ، فانعكس ذلك على مستوى الإنتاجية الزراعية ، ويبدأ هذا الاضطراب مع مجيء يزيد بن معاوية ، ومعاوية الثاني ، ومروان بن الحكم... إلخ.
2 ـ تركز الثروة في يد قلة من سكان المنطقة ، حيث كانت معظم التركيبة السكانية من الموالي، مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة ، فضعفت حركة تبادل السلع ، أي: حدوث كساد اقتصادي بالمنطقة.
3 ـ إعادة ضريبة النيروز والمهرجان التي روي أنها بدأت مع عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وكان السبب في إعادتها أن الناس اعتادوا دفعها على الرغم من منع الإسلام لها ، فأراد معاوية رضي الله عنه سحب مبالغها من غير المسلمين من الدهاقنة المسؤولين عن الجباية ، حتى لا يكونوا مراكز ثروة يتقوون بها ضد الدولة الإسلامية ، وكان ينفقها رضي الله عنه في مصالح الأمة الإسلامية ، لكن الدهاقنة والأمراء المحليين أخذوا فيما بعد في ابتكار ضرائب إضافية عديدة ، أرهقت كاهل المزارعين ، بالإضافة إلى ما صاحب تلك الضرائب من عنف في الجباية.
4 ـ إخضاع المشاريع الزراعية للضغوط السياسية ، فقد أدت محاربة الدولة لخصومها السياسيين إلى تخريب أو تحجيم مشاريعهم الزراعية ، فانعكس ذلك بنتائج سلبية على اقتصاد الدولة ككل ، ومن صور ذلك ما حدث في عهد الحجاج من أن بثوقاً انبثقت على الأرض المحياة من أرض البطائح ، فلم يعمل الحجاج ـ بوصفه والي المنطقة ـ على سد تلك البثوق مضارة لأهلها (لاتهامهم بمساعدة ابن الأشعث في الخروج عليه). فغرقت أراضيهم الزراعية وتحولت إلى موات.
5 ـ معاناة الدولة الأموية في بداية نشأتها من مجموعة من المهاجرين الذين قدموا إلى إقليم العراق ، وكانوا يعانون من البطالة ، حيث لم يكونوا مسجلين بالعطاء ، وليس لديهم أراضٍ يقومون بزراعتها ، فبدلاً من أن يقوموا بالعمل في مجال من المجالات الأخرى قامت فئة منهم بإحداث بثوق في نظام الري ، فأدى ذلك إلى تخريب المزارع وإغراقها ، فلما ولي زياد العراق قام بالقضاء على مثل تلك الأعمال.
6 ـ حدوث مواجهة عسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من الموالي والدولة الأموية، وذلك حينما حاول والي العراق ـ الحجاج بن يوسف ـ إعادتهم إلى أراضيهم بالقوة، وإعادة فرض الجزية عليهم، وقد وافق ذلك خروج ابن الأشعث على الدولة الأموية ، فانضموا تحت لوائه. ونتيجة لتلك العوامل وغيرها ، فقد بدت علامات تدهور القطاع الزراعي العام في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية.
ومع ذلك فقد كانت خلال تلك الفترة مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي خففت من حدة التدهور الزراعي بالمنطقة خلال هذه الفترة ، وكان من أبرزها ما يلي:
أ ـ إنشاء زياد بن أبيه جسراً يمنع طغيان الماء على الكوفة مما وفر الفرصة لاستغلال أراضٍ كانت تعطل فترة من السنة نتيجة فيضان الماء عليها ، وينتظر حتى تنتهي فترة الفيضان ، وتجف الأرض حتى يمكن إعادة زراعتها مرة أخرى ، كما أعطى هذا المشروع فرصة إدخال زراعة النباتات المعمرة إلى تلك الأراضي بدلاً من افتقار الزراعة فيها على المحاصيل الموسمية ، وبلغ من أهمية هذا الجسر أن الولاة ظلوا يتعاهدونه طيلة فترة العصر الأموي.
ب ـ عملية نقل الأيدي العاملة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى ، بهدف إحداث تنمية زراعية في الجهة المنقول إليها. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
جـ نقل زياد خمسين ألف أسرة من البصرة والكوفة من ذوي الخبرة الزراعية المشهورة إلى خراسان لتعميرها.
هذا وقد كانت الدولة الأموية تتولى مسؤولية إقامة منشآت الري الكبرى والعمل على صيانتها وتطهيرها ، كحفر الآبار ومجاري الأنهار ، وسد البثوق (التصدع) ، وفتح البريدات (مفاتيح الماء) ، وإقامة المسنيات (السدود) ، أما أصحاب الأراضي فكانوا يشاركون أحياناً في تطهير الأقنية الكبيرة ، وكذلك الأمر فإنه كان يقع على عاتقهم ، بطبيعة الحال مسؤولية إقامة الأقنية ووسائل الري داخل ممتلكاتهم الخاصة.
وقد حاول الحكام الأمويون استغلال ما أمكنهم من الأراضي ، فعملوا على توسيع نطاق الأراضي الزراعية، وبخاصة تجاه بلاد الشام ، عن طريق استصلاحها وتأمين المياه، ووسائل الري لها، حتى إن قصور الأمويين في الصحراء كانت مراكز مهمة للاستثمار الزراعي؛ حيث أقيمت حولها منشآت الري، من قنوات، وصهاريج، ومجارٍ، وتوسعوا بذلك في استصلاح الأراضي بواسطة توفير الري لها، وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان يبدي اهتماماً كبيراً بتنمية الزراعة ورفع مستوى إنتاجها ، فكان يولي عنايته لتطوير وسائل الري، وإخصاب الأراضي عن طريق الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من السكان المحليين، كما أن يزيد بن معاوية كان يلقب بالمهندس نظراً لخبرته الهامة في الشؤون الزراعية ، وإبداء اهتمامه بإصلاح أنظمة الري والعناية بها ، فقد أمر بحفر قناة سميت باسمه بنهر يزيد ، وكانت هذه القناة في الأساس رافداً صغيراً بالكاد يروي ضيعتين بالغوطة ، فقام يزيد بتوسيعها وتعميقها حتى أصبحت بعرض ستة أشبار ، وبعمق ستة أشبار كذلك ، الأمر الذي أدى إلى زيادة تدفق المياه وغزارتها ، بحيث أصبحت تكفي لري أراضٍ واسعة في الغوطة ، وبذلك أتيح المجال أمام المزارعين للقيام باستصلاح بعض أراضيهم المتروكة والعمل على استغلالها.
وكانت غالبية الأراضي في بلاد الشام تعتمد في ريها على مياه الأمطار التي تتساقط عليها خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول ونيسان، إلا أن أراضي واسعة كانت تروى سيحاً ، أي من المياه الجارية على سطح الأرض؛ حيث تأتي من مياه بعض الأنهار ومن مياه العيون في الجداول والقنوات ، وكذلك فإن قسماً اخر من الأراضي كانت تروى بواسطة الآلات التي ترفع المياه من منخفضات بعض الأنهر إلى سواقٍ أعلى لري الأراضي التي يعلو مستواها عن مجاري الأنهر ، أو التي ترفع المياه من الآبار والخزانات، وتعتبر مياه العيون مهمة في ري المزروعات، حيث كانت تروي قسماً كبيراً من الأراضي في أنحاء الشام، وكانت الغلات والمزروعات المتوفرة: القمح والشعير والرز والزيتون ، والنخيل والعنب والتين والفواكه والقطن ، وقصب السكر ، والبقول، والسمسم ، والرياحين ، وغير ذلك.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf