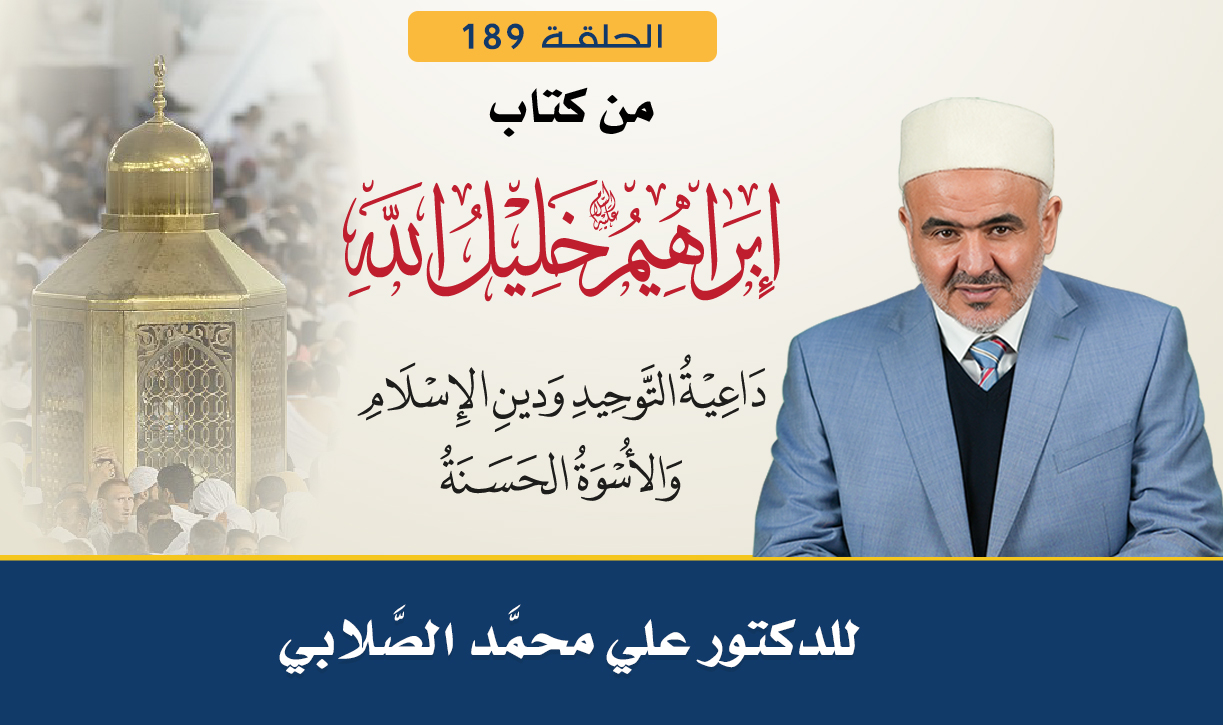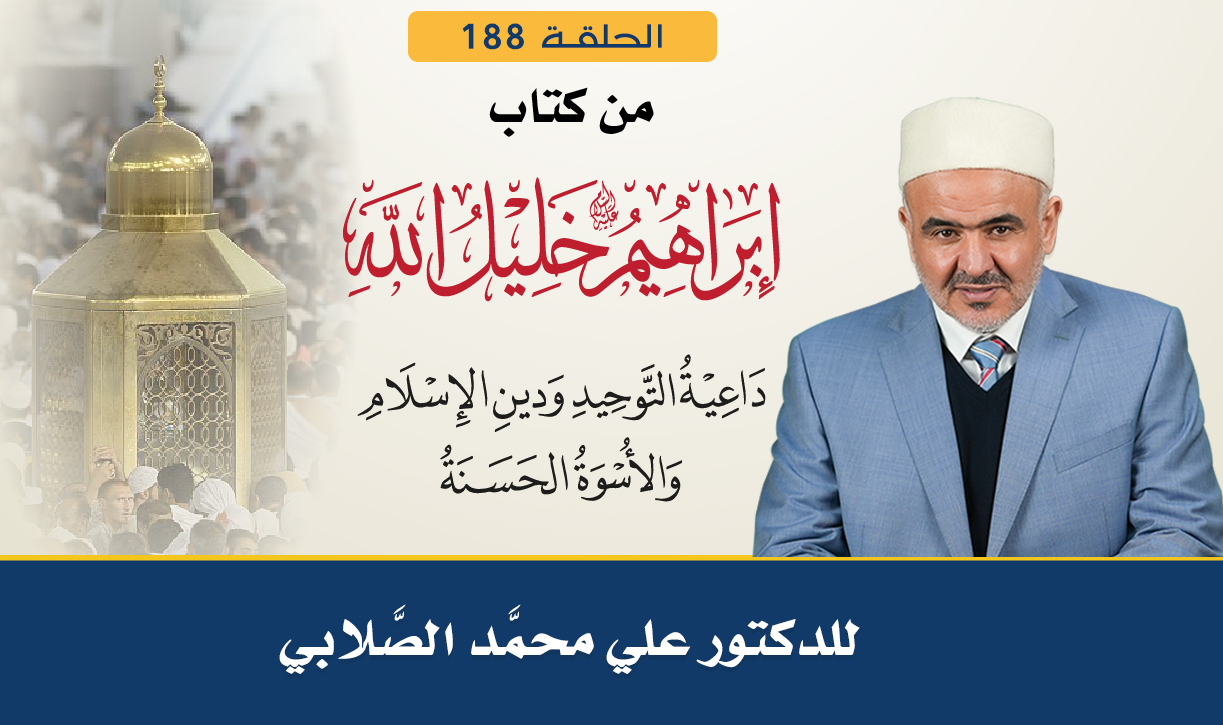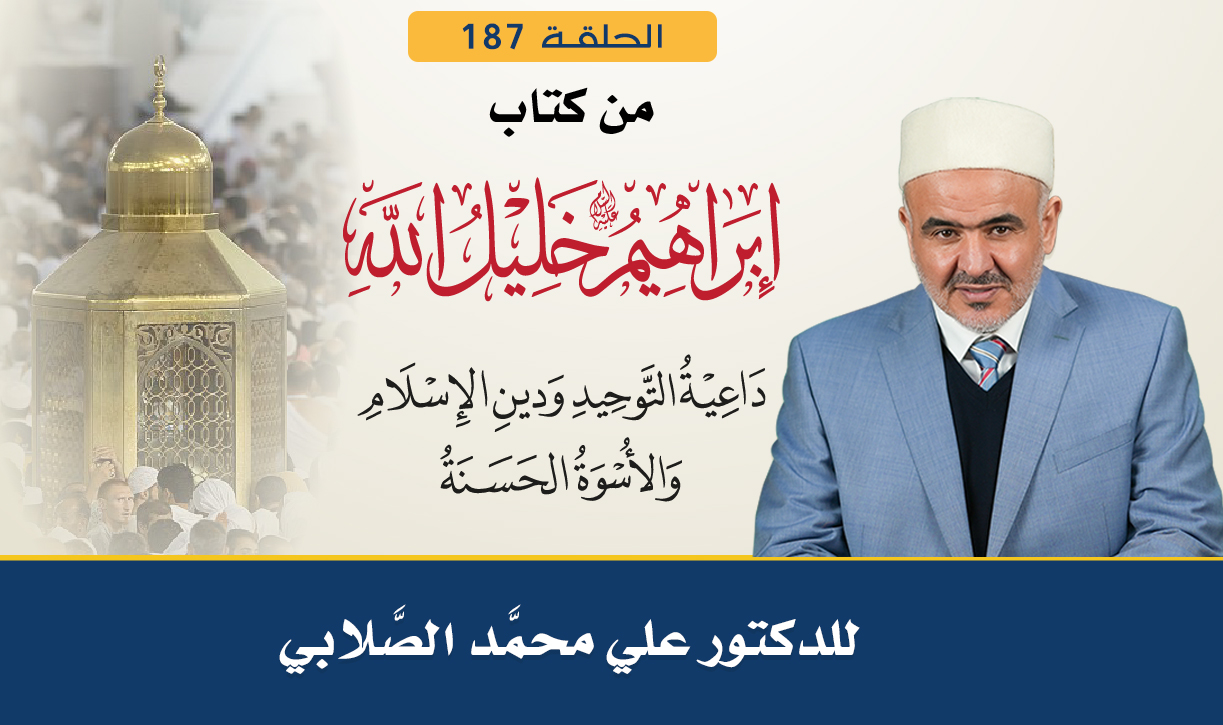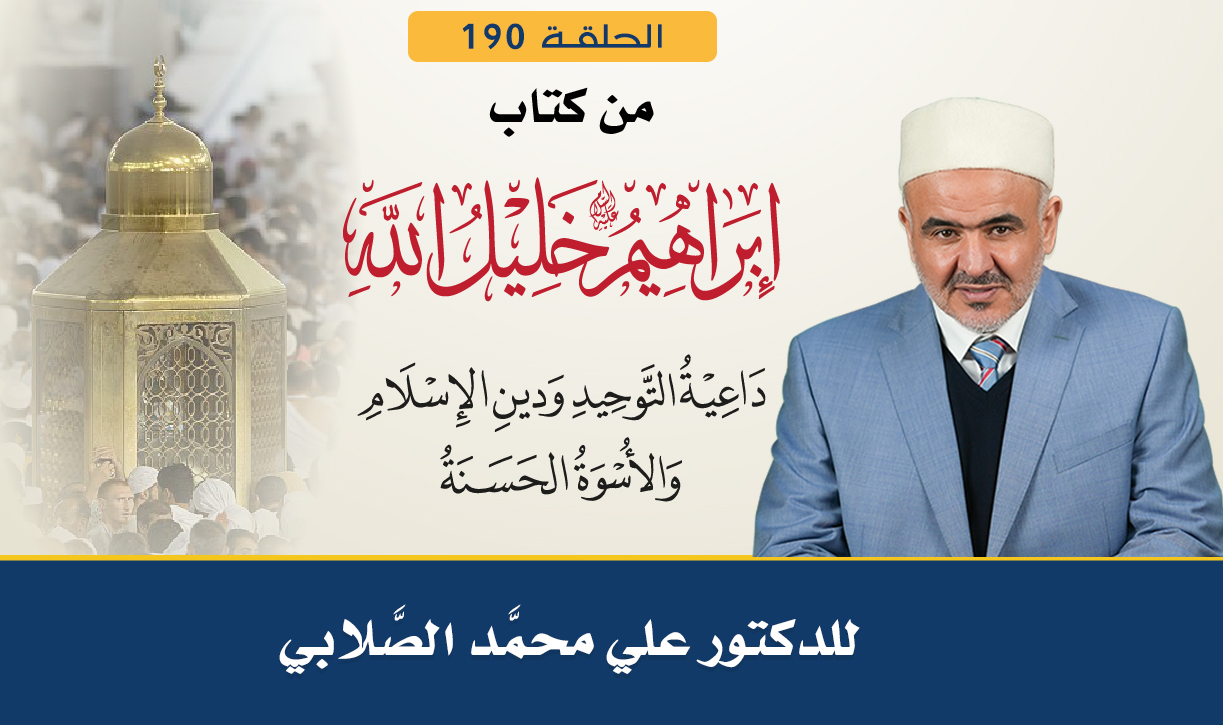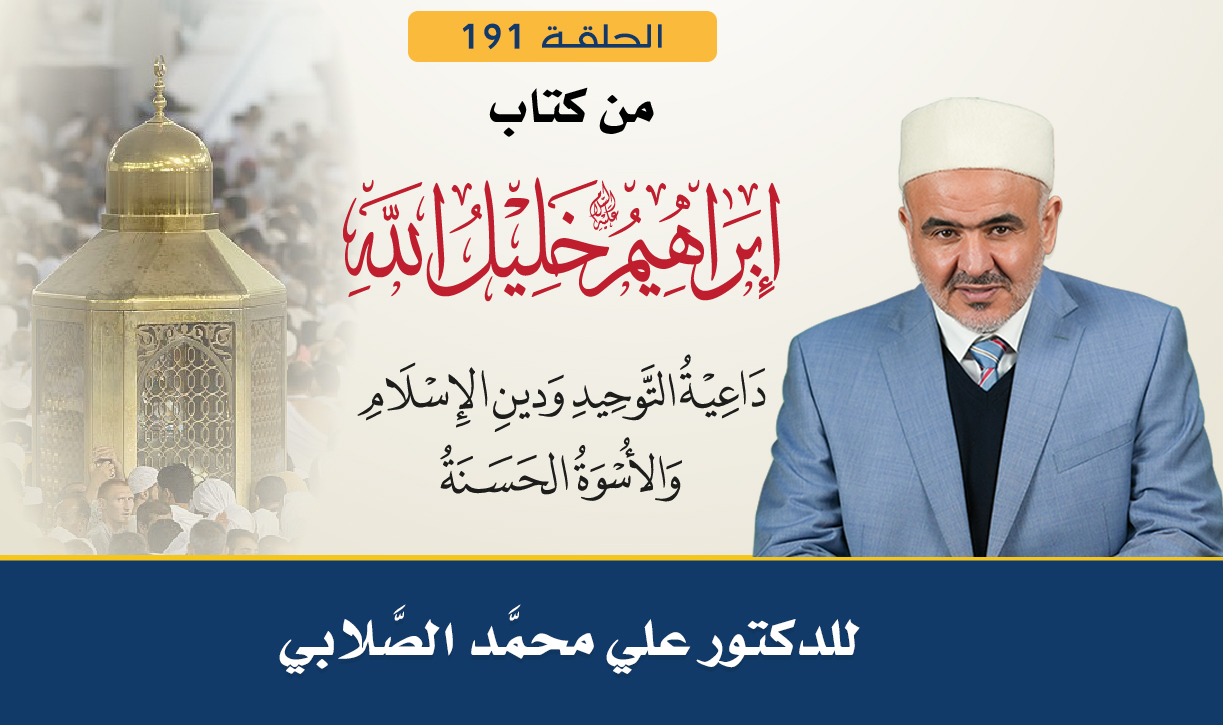(قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة التوبة)
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 189
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الآخرة 1444ه/ يناير 2023م
قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)} ]التوبة:113-114[:
1. قول ابن جرير الطبري:
اختلف أهل التأويل في السبب الذي نزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم: نزلت في شأن أبي طالب؛ لأنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يستغفر له بعد موته، فنهاه الله عن ذلك، وقال آخرون: بل نزلت في سبب أم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وذلك أنه أراد أن يستغفر لهم فمنع من ذلك، وقال آخرون: بل نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين فنهوا عن ذلك(1).
وفي تفسير الآيات قال ابن جرير: إنَّ الله قضى أن لا يغفر لمشرك، فلا ينبغي لهم "أي: المسلمين" أن يسألوا ربّهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله، فإن قالوا: فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك، فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعدها إيّاه(2).
وقال القرطبي: ودلّ على هذا الوعد: {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} ]مريم:47[، والمعنى يقول ابن عطية: لا حجّة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل لأبيه فإن ذلك لم يكن إلا عن موعدة(3).
وفي قوله: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ}، قال ابن العربي: يعني بموته كافراً تبرأ منه، وقيل تبيّن له في الآخرة والأول أظهر، قال عطاء: ما كنت لأمتنع من أمة حبلى حبشية من الزنا، فإني رأيت الله لم يحجب الصلاة إلا عن المشركين، فقال: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} وصدق عطاء؛ لأنّه تبيَّن من ذلك أن المغفرة جائزة لكل مذنب، فالصلاة عليهم والاستغفار لهم حسنة، وهذا ردّ على القدرية؛ لأنّهم لا يرون الصلاة على العصاة ولا يجوز عندهم أن يغفر الله لهم، فلم يصلّ عليهم، وهذا ما لا جواب لهم عنه(4).
2. قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ}:
جاء في معنى أوّاه: الأوّاه الكثير التأوّه، والمعنى: الخاشع المتضرع الطائع، وكلّ كلام يدلّ على حزن، يُقال له التأوّه، ومعنى حليم: أي كثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنب، ويصبر على الأذى، وأصل الحلم: ضبط النفس عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام، والحلم هو العقل(5).
وقال الرازي: واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقام؛ لأنّه تعالى وصفه بشدة الرّقة والشفقة والخوف والوجل، ومن كان كذلك فإنّه تعظم رقّته على أبيه وأولاده، فبيّن الله تعالى أنه مع هذه العادة تبرأ من أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفر، فأنتم بهذا المعنى أولى، وكذلك وصفه بأنه حليم؛ لأنَّ أحد أسباب الحلم رقّة القلب، وشدة العطف؛ ولأنّ المرء إذا كان حاله هكذا، اشتدَّ حلمه عند الغضب(6).
3. قول السعدي:
يعني: ما يليق ولا يحسن بالنبي والمؤمنين به {أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} أي: لمن كفر به وعبد معه غيره {وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو على أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب ووجب عليهم الخلود في النار ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين(7).
وأيضاً فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربّهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويغادروا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبيّن أنه من أصحاب النار منافٍ لذلك، مناقض له ولئن وجد الاستغفار من خليل الرّحمن إبراهيم لأبيه، فإنه {عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} في قوله: {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه.
فلما تبيّن لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينتفع فيه الوعظ والتذكير {تَبَرَّأَ مِنْهُ} موافقة لربه وتأدباً معه {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ} أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء، والاستغفار، والإنابة إلى ربه، {حَلِيمٌ} أي: ذو رحمة بالخلق، وصفح عمّا يصدر منهم إليه من الزّلات لا يستفزّه جهل الجاهلين(8).
4. ما ورد في السنة في النهي عن الاستغفار لأهل الشرك والكفر:
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لَمَّا حَضَرَتْ أبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بنَ أبِي أُمَيَّةَ بنِ المُغِيرَةِ، فَقالَ: أيْ عَمِّ قُلْ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لكَ بهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقالَ أبو جَهْلٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بنُ أبِي أُمَيَّةَ: أتَرْغَبُ عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَعْرِضُهَا عليه، ويُعِيدَانِهِ بتِلْكَ المَقالَةِ، حتَّى قالَ أبو طَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: علَى مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، وأَبَى أنْ يَقُولَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: واللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فأنْزَلَ اللَّهُ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ...} ]التوبة:113 [، وأَنْزَلَ اللَّهُ في أبِي طَالِبٍ، فَقالَ لِرَسولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} ]القصص:56[(9).
5. أبو إبراهيم يوم القيامة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يلقى إبراهيمُ أباه آزرَ يومَ القيامةِ، وعلى وجهِ آزرَ قَتَرَةٌ وغبَرَةٌ (10)، فيقولُ له إبراهيمُ: ألم أقلْ لك لا تعصِني ؟ فيقولُ أبوه: فاليومَ لا أَعصيك، فيقولُ إبراهيمُ: يا ربِّ! إنك وعدْتَني أن لا تُخزيَني يومَ يُبعثون، وأيُّ خزيٍ أخزى من أبي الأبعدِ؟ فيقولُ اللهُ: إني حرَّمتُ الجنةَ على الكافرينَ، فيقال: يا إبراهيمُ! انظُرْ ما بين رجلَيك! فينظر فإذا هو بذِيخٍ مُلْتَطِخٍ(11)، فيؤخذُ بقوائمِهِ، فيُلْقَى في النَّارِ(12).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا لما مات مشركاً لم ينفعه استغفار إبراهيم - عليه السّلام - مع عظم جاهه وقدره(13).
والحكمة في مسخه ضبعاً، أنَّ الضبع من أحمق الحيوانات، وآزر كان أحمق البشر؛ لأنّه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصرّ على الكفر حتى مات، واقتصر في مسخه على هذا الحيوان؛ لأنّه وسط التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلاً، ولأنَّ إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح، فأبى واستكبر وأصر على الكفر، فعومل بصفة الذل يوم القيامة، ولأنَّ للضبع عوجاً، فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن، بل استمر على عوجه في الدين(14).
وفي هذا الحديث دليل على أن شرف الولد لا ينفع الوالد إذا لم يكن مسلماً(15).
مراجع الحلقة التاسعة والثمانون بعد المائة:
(1) تفسير الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن"، (11/41-42).
(2) المرجع نفسه، (11/40-41).
(3) تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، (8/174).
(4) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي المالكي، (11/252).
(5) التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، (13/586).
(6) التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)، (16/217).
(7) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص353.
(8) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص353.
(9) صحيح البخاري، رقم (4772).
(10) قترة وغبرة: قترة أي: سواد الدخان وغيره أي: غبار، اجتماع الغبرة والسواد في الوجه، وقيل القترة: سواد وكآبة.
(11) بذيخ متلطخ: ذِيْخٍ: ذكر الضبع الكثير الشعر، متلطخ: أي بالرجيع أو بالطين أو بالدم.
(12) صحيح البخاري، رقم (3350)، صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، الألباني، رقم (8158).
(13) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مرجع سابق (1/146).
(14) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، (8/641).
(15) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، (7/310).
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي