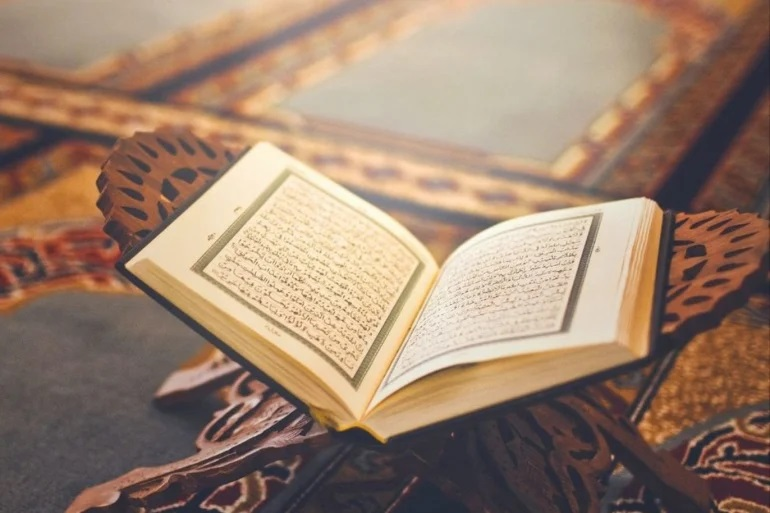السؤالأرجو منكم إعلامي بحكم المثل القائل (الشر يعم، والخير يخص) والذي أصبحت جميع مدرِّساتنا يرددنه، ويحفظنه عن ظهر قلب، ويتم العمل به دائما في مدرستي، وتكون الإدارة تعلم مجموعة من البنات المشاغبات، لكن تعمم العقاب ليتعظ الآخرون، ويتم ظلمنا ونحن لم نفعل شيئا، ويتم أمرنا بكتابة التعهدات، وتنفيذ العقوبات مع أننا لم نفعل شيئا أبدًا.. أفتونا مأجورين...
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا المثل بهذا اللفظ ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حد من السلف، لكن جاء نحو معناه في كتاب الله تعالى قوله جل ذكره: "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
قال ابن كثير في بيان المعنى: (يحذر تعالى عباده المؤمنين (فِتْنَةً) أي: اختبارًا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي، ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع).
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً" بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره، وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر والفساد، وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن).
ويشهد له ما ورد عن ابن عباس، في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب.
وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث "، وفي هذا المعنى نصوص كثيرة.
قال القرطبي في تفسيره: ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال علماؤنا: فالفتنة إذا عمّت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي، وانتشار المنكر، وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها، وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين، وقالوا لا نساكنكم، وبهذا قال السلف رضي الله عنهم...) وقال: (ويدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين، ومنه ما يكون نقمة للفاسقين) أ.هـ بتصرف يسير.
ومما سبق نعلم أن تنزيل ذلك المثل على الآية غير سديد، وعبث في النصوص، وما جاء في الآية من تعميم العقوبة فهو خاص بالله تعالى، وهو أعلم بعباده من أنفسهم، وله في ذلك الحكمة البالغة، (ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون)، أما المخلوق فلا يجوز له تعميم العقوبة على غير المذنب والمعتدي، (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ولأن هذا من الظلم الذي حرمه الله تعالى، وجعله على عباده محرماً، ويخشى على صاحبه العقوبة الدنيوية العاجلة، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وعلى الإدارة أن تعالج الخطأ بحكمة وروية وعدل، والخطأ لا يعالج بخطأ مثله.
كما أنه يجب على المسلم إذا رأى المنكر أو سمع به أن ينكره، ولا يقر به، فإن لم بقدر على إزالته بيده بلغ به من يقدر على إزالته وإقامة العقاب عليه –وهم الإدارة في السؤال-، ولا يجوز التواطؤ على كتم المذنب.. والله تعالى أعلم.
المجيب
عبد المجيد بن صالح المنصور
أمانة قسم الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء