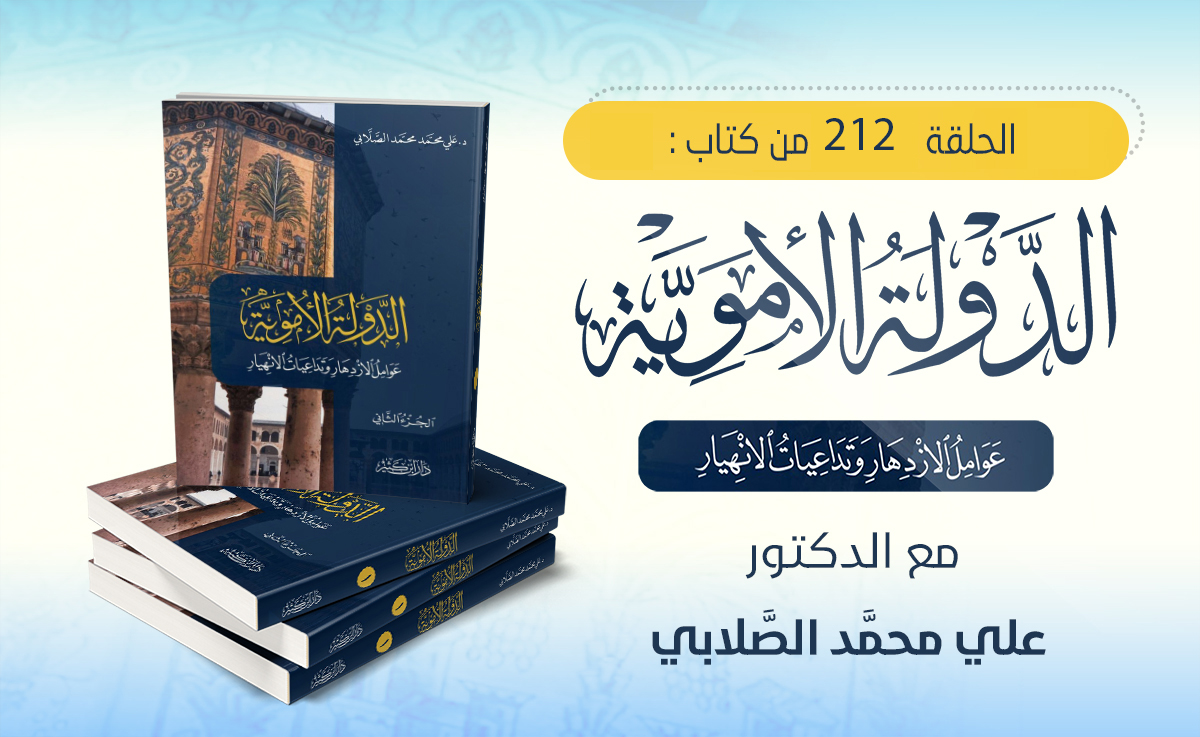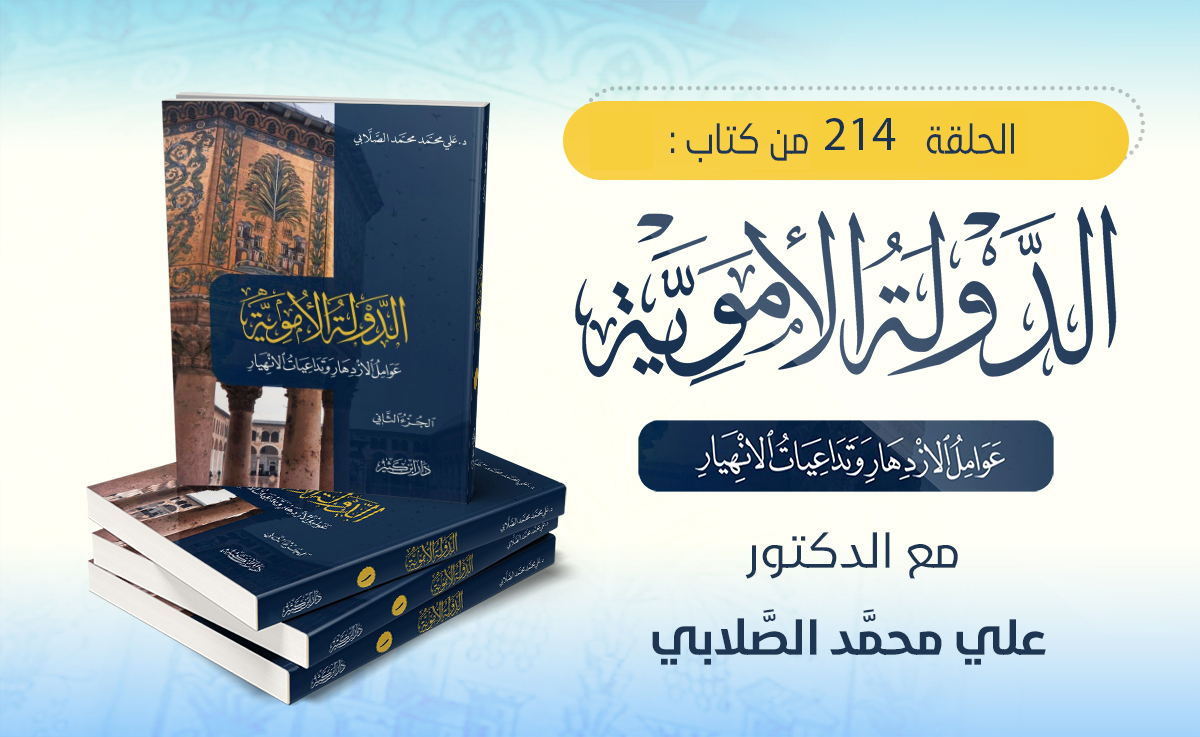(النظام المالي في عهد هشام بن عبد الملك)
من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2):
الحلقة: 213
بقلم: د. علي محمد الصلابي
9 رمضان 1442 ه/ 21 أبريل 2021
تعتبر السياسة المالية لهشام بن عبد الملك امتداداً لملوك بني أمية، ومخالفة للنهج الإصلاحي التجديدي الراشدي الذي قام به عمر بن عبد العزيز، وكانت مصادر بيت المال هي: الجزية والخراج والغنائم والزكاة، وغيرها من المصادر، وأما نفقات الدولة فكانت على مرتبات الولاة والجنود والموظفين، والإصلاحات كشق الأنهار، وإصلاح الأرض وغيرها من الأمور، ونشير إلى بعض الأمور المتعلقة بالنظام المالي.
1 ـ عودة الملكية الزراعية إلى ما كانت عليه قبل عهد عمر بن عبد العزيز:
عاد أمراء ووجهاء الدولة الأموية إلى تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة بالأخص في منطقة العراق، وقد ساعدهم في ذلك سياسة يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك في هذا الباب، ومن نماذج تلك الملكيات:
أ ـ الملكيات الكبيرة لمسلمة بن عبد الملك، الناتجة عن استصلاحه لأراضٍ واسعة في منطقة السواد، وبلغ من كبرها أنه حفر لها نهرين واسعين.
ب ـ ملكيات خالد بن عبد الله القسري، حيث بلغ دخله من غلاتها ثلاثة عشر مليون دينار، وقيل: درهم، وكذا بلغ دخل ابنه عشرة ملايين.
جـ ملكيات الخليفة هشام بن عبد الملك الواسعة في أنحاء مختلفة من الدولة، وبلغ من كبر حجم ملكياته أن منتوجاته الزراعية كانت تؤثر في المستوى العام للأسعار.
2 ـ حدث تدهور في المجال الزراعي في عهد هشام بن عبد الملك:
إلا أن هذا التدهور حاولت الدولة علاجه بإقامة بعض المشاريع، مثل:
أ ـ توصية هشام بن عبد الملك والي الموصل بحفر نهر في وسط المدينة، وقد استغرق حفر هذا النهر مدة ثلاث عشرة سنة، وذكر أن تكلفة حفره بلغت ثلاثة ملايين درهم، وقد كان لهذا النهر أهمية كبرى في تنمية الزراعة بالموصل، فمن المدة المستغرقة في حفره، وتكلفة الحفر، يتضح أن النهر كان كبيراً، ولكونه توسط المدينة، فقد استفاد منه عدد كبير من مزارع المدينة، فزادت إنتاجيتها، وقد ترتب على ذلك كله زيادة ملموسة في إيرادات الدولة من قطاع الزراعة، حيث تضاعف إيراد الدولة من الأراضي الزكوية التي استمدت سقايتها من هذا النهر بمقدار الضعف، فبعد أن كانت تسقى بالساقية والآلات من المياه الجوفية، أصبحت تسقى من النهر مباشرة، وذلك استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشر».
ب ـ أقام خالد القسري السدود على نهر دجلة لمنعها من الفيضان، وبنى القناطر، وحفر العديد من الأنهار، إلا أنه كان يمتلك الأراضي الواقعة على ضفاف تلك الأنهار.
جـ أقام مسلمة بن عبد الملك في الجزيرة الفراتية سداً عظيماً على نهر البليخ، وكان لهذا السد آثار إيجابية ملموسة على التنمية الزراعية، فقد اختزن خلف هذا السد كمية كبيرة من المياه، فزادت الموارد المائية، وأمكن تنظيم استخدامها، فضلاً عن الجزء الذي تسرب داخل الأرض فأدى إلى رفع مستوى المياه الجوفية للآبار، وعلى غرار ما سبق فقد ترتب على هذا السد زيادة في إيرادات بيت المال من القطاع الزراعي.
3 ـ إنشاء وتعبيد الطرق:
شمل اهتمام الدولة الأموية بتوفير البنية الأساسية لخدمات الطرق، ولم يقتصر الأمر على الطرق، بل شمل اهتمام الدولة بإقامة الجسور، ومثال ذلك: الجسر الذي أنشئ عام 126 هـ على النهر بمنطقة الموصل ليسهل الاتصال بين ضفتي النهر، والذي ترتب عليه ازدهار نشاط التجارة بين الجانبين، وانسياب الحاصلات الزراعية في الجانبين، كما أنه جرت محاولة فيما بين (105 هـ 120 هـ) لإقامة جسر فوق نهر دجلة، ولكن نظراً لضعف الخبرة الهندسية انهار ذلك الجسر خلال فترة وجيزة.
4 ـ بناء المدن والحصون والأسوار والأسواق:
قام بعض الولاة ببناء مدن وتجديد أسوار مدن قديمة لاتخاذها مقرات لهم، وحصوناً يلجؤون إليها وقت الحاجة، فقد بنى والي السند مدينة المحفوظة ليتخذها قاعدة لجيشه، وقد جدد أسد القسري والي خراسان، بناء مدينة بلخ في ولايته الأولى، ونقل إليها الدواوين في ولايته الثانية، وبني الحر بن يوسف قيسارية هشام في مصر، كما اتخذ هشام مدينة الرصافة قرب الرقة مصيفاً، وجدد بعض أبنيتها وسورها، كما جدد هشام سور مدينة ملطية بعد أن فكّ الحصار البيزنطي عنها، وأمر ببناء عدة حصون على حدود بلاد الشام مع البيزنطيين وشحنها بالمقاتلة. وقد اهتم والي مصر وشمال إفريقية عبيد الله بن الحبحاب بالغزوات البحرية في بحر الروم (المتوسط)، فجدد ووسع قاعدة بناء السفن الحربية في تونس، وقد نقل هشام قاعدة بناء السفن الحربية في بلاد الشام من عكا إلى صور، وبنى فيها فندقاً، ويبدو أن حركة عمرانية رافقت استصلاح الأراضي في العراق في عهد خالد القسري، قام هو ببعضها، كما بنى أخوه أسد بالكوفة سوقاً سمي باسمه، وبنى يوسف بن عمر أثناء ولايته للعراق (120 ـ 126 هـ) سوقاً بالحيرة سمي باسمه.
5 ـ العطاء:
كانت الدولة الإسلامية، قد بلغت أقصى اتساعها في عهد هشام، كما قامت في عهده ثورات قوية، لذا كانت الحاجة ماسة إلى جيش قوي كثير العدد، ومن الطبيعي أن ذلك الجيش يحتاج إلى سلاح ومال يطوف على أفراده، وكانت الدولة تقدم لجندها مبالغ سنوية كأعطيات تصرف لهم في مطلع شهر محرم من كل عام، وكان بيت المال في دمشق أو في مقر الولاية يجهز به الخليفة أو الولاة بما يحتاجونه من الأموال لصرفها بمثابة أعطيات للجند، وغير ذلك من النفقات.
وكانت تلك الأموال يجمعها العمال المتخصصون وتأتي من مصادر متعددة أهمها الخراج، ولم يكن مقدار العطاء واحداً، فقد كان عطاء بني مروان مئتي دينار، وكان العطاء يفرض لمؤيدي الدولة، فقد كتب هشام إلى والي المدينة عبد الواحد النضري، أن يفرض لقوم نصيب الشاعر، وكان هشام يفرض لبعض الشعراء خشية ألسنتهم، وقد يفرض للحاجة بأمر الخليفة، وكان الغزو يفرض على من يأخذ العطاء، فلم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء إلا عليه الغزو، فمنهم من يغزو ومنهم من يخرج بديلاً، وكانت الدولة تمنع العطاء لمن أيّد إحدى الحركات المعارضة للسلطة الأموية، وتشطب اسمه من ديوان العطاء، وكان الخليفة وحده يستطيع أن يفرض العطاء أو يمنعه، وكان العطاء يُعطى في بداية شهر محرم من كل عام، ويوزعه الولاة على عرفاء الجند، وهم في العادة عن المقدمين في قبائلهم، فيوزعه هؤلاء على أتباعهم من الجند.
6 ـ ديوان الأوقاف:
كانت الدولة الأموية تتميز بكثرة الدواوين التي تساعد على تنظيم أمور الدولة، وكانت تتطور مع الزمن، وتكتسب الخبرات، ومن أشهر تلك الدواوين: ديوان الجند، وديوان الخراج، وديوان الرسائل، وديوان الخاتم، وديوان البريد، وديوان الطراز، وديوان المستغلات، وديوان الصدقات، وديوان النفقات، وفي عهد هشام بن عبد الملك أقيم ديوان جديد هو ديوان الأحباس ـ الأوقاف ـ؛ فقد كان أول قاضٍ بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر في زمن هشام، وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم، فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً لها... فلم يمت توبة حتى صار للأحباس ديوان عظيم، وكان ذلك سنة 118 هـ. وبعد هذا أخذ القضاة ينظرون في أمور الحجر وغيره، ثم جمعوا النظر في الحدود إلى النظر في الحقوق.
هذه بعض الأمور المتعلقة بالنظام المالي في عهد هشام، وقد اختصرتها قدر الإمكان خوفاً من الإطالة.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf
الجزء الثاني:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC139.pdf
كما يمكنكم الاطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com