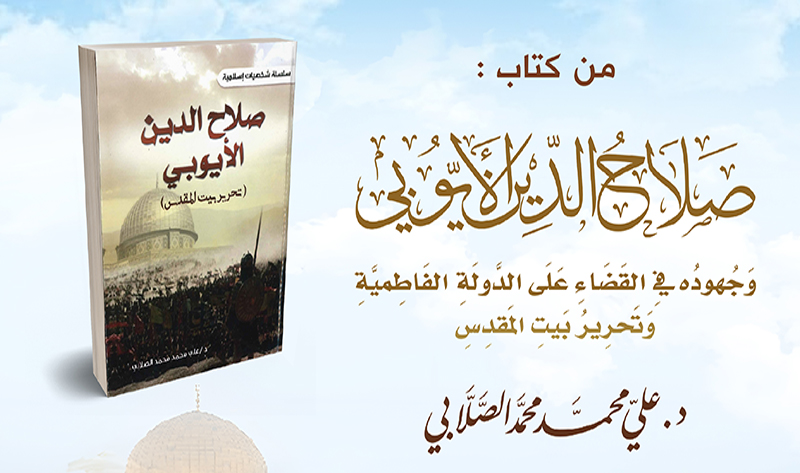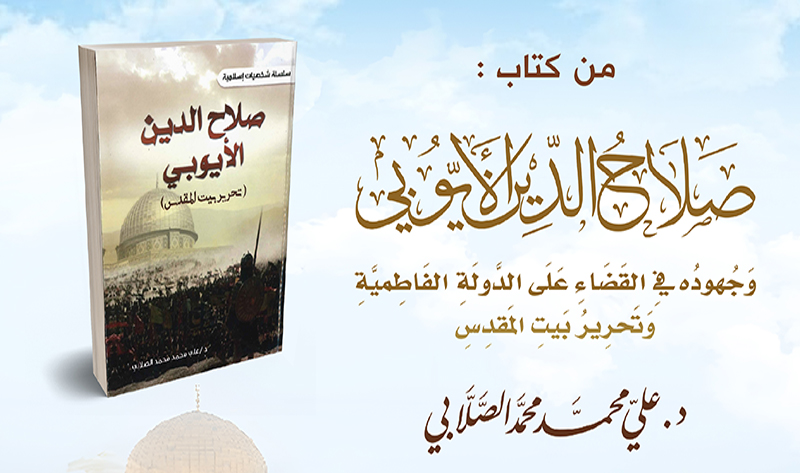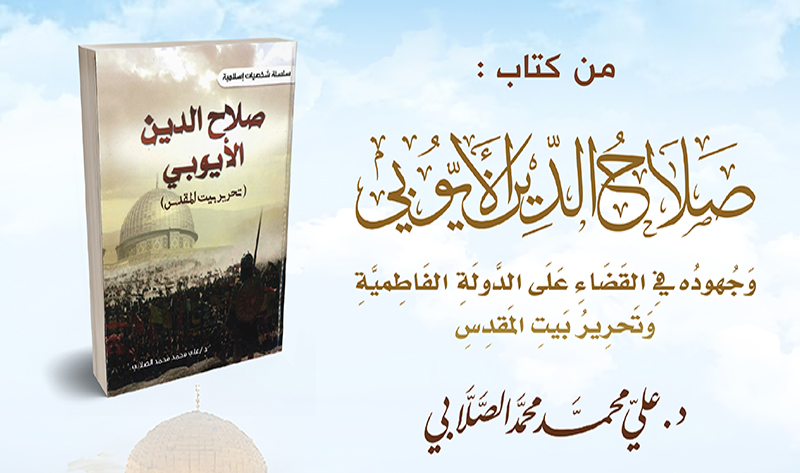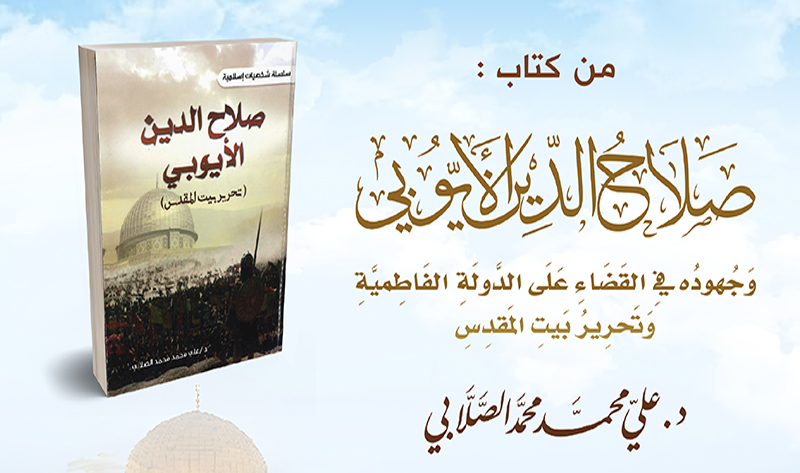في سيرة صلاح الدين الأيوبي:
إدارة شؤون القتال والسِّلم والأسرى في الدولة الأيوبية:
الحلقة: الثانية و الستون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يوليو 2020
1 ـ مجلس حرب جيش صلاح الدين: كان من الطبيعي أن يكون لصلاح الدين مساعدون ، يعينونه على توجيه سياسة الحرب ، ووضع الخطط العسكرية ، وإدارة شؤون الدولة ، وكان هؤلاء يشكِّلون مجلساً شبيهاً بما يطلق عليه أركان الجيش ، ويتكوَّن من: صلاح الدين ـ وكان يرأس الاجتماعات عادةً ـ وعضوية إخوته ، لاسيَّما الملك العادل ، وأولاده الكبار خاصَّةً الملك الأفضل عليَّاً ، والملك الظاهر غازي ، وأولاد أخيه مثل تقي الدين عمر، وخاله شهاب الدين محمود الحارمي ، وكبار الأمراء، والقادة القدامى الجدد ، ومستشاره الحكيم القاضي الفاضل ، وقاضي العسكر بهاء الدين بن شدَّاد المؤرِّخ ، وبهاء الدين قراقوش ، وسيف الدين المشطوب الهكَّاري ، وقادة اخرين مثل أبو الهيجاء الهذباني ، وعلم الدين سليمان بن جندر ، وأمير الأسطول المصري حسام الدِّين لؤلؤ، وأصحا المدن ، والقلاع المعروفين من أمثال مظفر الدين كوكبري ، وشمس الدين ابن المقدَّم ، وعز الدين جورديك ، والفقيه ضياء الدين عيسى الهكَّاري ، وكان لكلٍّ من هؤلاء حقُّ إبداء الرأي في صراحةٍ تامَّة ما داموا يتصرفون ، وينطلقون من مبدأ خدمة دولة صلاح الدين ، وجيشه.
وكان المجلس يجتمع كلَّما رأى صلاح الدين ضرورة في ذلك. وسوف نلاحظ ـ بإذن الله ـ من خلال الأحداث في هذا الكتاب: أنَّ صلاح الدين شاور أصحابه في كلِّ المناسبات ، والأحداث الخطيرة ، ووافق على رأيهم عن رضاً حيناً ، وعن كرهٍ حيناً اخر حفاظاً على مصلحة المسلمين ، وإيثاراً لرضائهم ، وحرصاً منه على احترام رأي أمرائه.
2 ـ خطط وأساليب القتال: كان الهدف الأسمى للجيش الأيوبي في قتاله هو طرد المحتلَّين الصليبيين؛ الذين استقرُّوا في الساحل الشامي الممتدِّ من أقصى الشمال من أنطاكية إلى أقصى الجنوب في عسقلان ، وكذلك في بعض الأجزاء الدَّاخلية ، مثل: بيت المقدس ، والكرك ، والرُّها ، وطبرية ، وغيرها. فالهدف الاستراتيجي في القتال الأيوبي هو استعادة الأراضي التي يحتلُّها الصَّليبيُّون منذ أواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سلكت الجيوش الإسلامية مختلف السبل ، وشتَّى الأساليب سواء عن طريق المجابهة المباشرة مع العدوِّ ، أو عن طريق إضعافه اقتصادياً ، ومعنوياً ، وحصره في نقاط الارتكاز التي حصَّنها ، فالمسلمون ـ لاسيما في عصر صلاح الدين ـ اتَّبعوا مختلف التكتيكات للإيقاع بالصَّليبيين ، ولم تكن الخطط العسكرية في الجيش الأيوبي يصنعها صلاح الدين وحده ، بل كان يعينه مجلسه الاستشاري؛ على الرَّغم من أنَّ قيادة الجيش المركزية ظلَّت بيد صلاح الدين ، والنَّجاح يكون في الغالب مضموناً إذا حافظ القائد على الاتصال الدائم بالأعداء، وقد تحلُّ الهزائم به إذا فقد ذلك الاتصال. وكان اليزك (الفرقة الاستطلاعية) يقوم بدور أساسي في هذا الصَّدد ، فكان واسطة اتصالٍ دائم بين قيادة الجيش ، وقوى العدو. ومن الأساليب التي استعمالها الجيش الأيوبي نجد أنفسنا أمام جملة من الأعمال ، والإجراءات التي يمكن إدراجها تحت اسم الأعمال التكتيكية ، ومن هذه الأعمال:
3 ـ قطع الأشجار: من الأعمال التي قصد منها إضعاف العدو: أنه أوعز إلى جنده بقطع كروم ضياع صفد في غور الأردن في موقعه بيت الأحزان؛ التي حدثت سنة 575هـ/1179م وأمر بحصد غلاَّتهم ، وقصد من هذا تحطيم اقتصاد العدوِّ ، وجعله لا يستفيد من الكروم ، وأخشابها ، ومن الحبوب التي حصدها الجند ، وقد تكرَّر هذا العمل في مناسباتٍ عديدة ، فيذكر المؤرخ محمد بن تقي الدين عمر الأيوبي: أنَّ السلطان سار بمن انتخب من عساكره ، وتوجَّه بهم إلى الكرك في مطلع سنة 578 هـ/1182 م ووصل إليها بعد أيام ، فوجد بها جمعاً عظيماً من الفرنج ، فنزلنا قريباً منهم ، فأذللناهم ، وضايقناهم ؛حتى لاذوا بالجدار ، فاستولينا عليهم ، فقطعنا أشجارهم ، ورعينا زروعهم وكذلك فعلوا حين تهيؤوا لموقعة حطِّين الحاسمة حين ساروا إلى حصن الكرك ، وأخافوا أهله ، وأخذوا ما كان حوله ، ورعوا زرعهم ، وقطعوا أشجارهم ، وكرومهم ، ثم ساروا إلى حصن الشُّوبك ، وفعلوا به مثل ذلك.
4 ـ قطع المياه:كان لتكتيك قطع الماء أثره العميق في إضعاف العدوِّ، وهزيمته. فالمعروف: أنَّ سيطرة الجيش الأيوبي على منابع الماء يوم حطِّين كان أحد أسباب هزيمة العدو ، كما هو معلوم، حين، حجز بينهم وبين الماء؛ حتى قتلهم العطش، ولجأ الجيش الأيوبي إلى إفساد مياه بعض ينابيع القدس سنة 587 هـ/1191 م للحيلولة دون وقوع هذه المدينة بأيدي الصليبيين بعد هزيمة المسلمين المعروفة في عكَّا.وكان إفساد الماء يتمُّ عن طريق إلقاء الزَّرنيخ، أو طرح الجيف فيه.
5 ـ أسلوب الحرب الخاطفة: ومن الخطط التي اتَّبعها تطبيقه لأسلوب الحرب الخاطفة ، ومباغتة العدو ، والانتصار عليه قبل أن يستطيع تجميع قواه. وهذه الخطَّة تظهر معالمها بوضوح أكثر في سنتي 583هـ 584هـ/1187 ـ 1188م حين لم يكتف بالانتصار الحاسم في حطين ، بل إنه أتبع الانتصار بانتصاراتٍ لاحقةٍ سريعةٍ بحيث يمنع الصليبيين من التَّجمُّع في مكانٍ واحدٍ ، والاشتباك معه في موقعه مكشوفةٍ أخرى ، فعلى أثر فوزه في حطين هجم الجيش الأيوبي على التوالي على عكَّا ، وصفورية ، والناصرة ، وقيساريَّة ، ونابلس ، والداروم ، وفتحها جميعاً ، وحين استعصت عليه مدينة صور بسبب استحكاماتها؛ اضطر إلى تركها ، وأستأنف فتوحه في البقاع الأخرى ، وتوَّجها بفتح بيت المقدس ، والمدن السَّاحلية ، والداخلية ، ففتح هونين ، وجبلة ، واللاذقية ، وصهيون ، ثم توجَّه شمالاً ، فاستولى على حصون بكاس ، والشغر ، وبرزية ، ودربساك ، وبغراس المحيطة بإمارة أنطاكية الصليبية ، ثم اتجه قسم من جيشه مرَّةً أخرى إلى الجنوب ، ففتح في أواخر سنة 584هـ/1188م حصن الكرك المتين؛ التي سميت بصخرة الصحراء ، وأخيراً فتح صفد ، وكوكب قبل أن يعود إلى دمشق لقدوم فصل الشتاء ، ولأخذ قسطٍ من الرَّاحة.
6 ـ خطة القتال بالتناوب: أعاد صلاح الدين الكرَّة على صور ، وعند أسوارها طبَّق خطَّةً نفذها بنجاح في فتح بعض القلاع ، مثل: برزية ، وهي خطة القتال بالتناوب ، وذلك بأن قسم عسكره إلى ثلاثة أقسام ، يقاتل كلُّ قسم منها فترةً محدَّدة ، ثم يستريح ليواصل القتال قسمٌ ثانٍ ، ثم ثالث. وقد قصد باتِّباعه لهذا الأسلوب إنهاك الصَّليبيين ، وعدم فسح المجال لهم ليرتاحوا؛ إلا أنَّ الأسلوب اصطدم بمتانة أسوار صور؛ إضافةً إلى وضع المدينة الطوبوغرافي.
7 ـ خطة شقِّ صفوف الصَّليبيين: اتَّبع صلاح الدين خطَّة شقِّ صفوف الصَّليبيين ، والإيقاع بينهم ، وكسب ودِّ بعض قادتهم في محاولةٍ منه لإضعافهم ، فيذكر ابن شدَّاد: أنَّ السُّلطان جلس ذات مر ةٍ في شوال 578 هـ/1191 م واستحضر صاحب صيدا لسماع رسالته ، وكلامه ، فحضر ، وحضر معه جماعةٌ وصلوا معه ، وكان المؤرِّخ المذكور حاضراً ، وأكرم السُّلطان ضيوفه الصَّليبيين إكراماً عظيماً ، وحادثهم ، وقدَّم بين أيديهم ما جرت العادة ، ولمَّا رفع الطعام؛ اختلى بهم ، ثم تقرَّر أن يصالح السُّلطان المركيز مونتفرات صاحب صور ، الذي انضمَّ إليه جماعةٌ من أكابر الفرنجة؛ منهم صاحب صيدا ، واشترط صلاح الدين على المركيز المنشق أن يظهر عداوته للفرنجة الذين انشقَّ عنهم ، وكان سبب ذلك شدَّة خوفه منهم إضافةً إلى خلافه معهم بسبب الزَّواج ، وبذل له السُّلطان الموافقة على شروطٍ قصد بها الإيقاع بينهم على حدِّ قول ابن شداد.
8 ـ توطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع المدن الإيطالية: ومن الاجراءات الحكيمة؛ التي لجأ إليها صلاح الدين بصدد إضعاف العدوِّ اقتصادياً قيامه بتوطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع دويلات المدن الإيطالية ، مثل: (بيزا ، وجنوا ، والبندقية) فمنذ أن تولَّى الحكم في مصر صار يبذل الجهود لجذب تجارة هذه المدن إلى مصر ، وراح يعقد الاتفاقات مع هذه الدويلات لتبادل السُّفراء معها ، وقد انتفع صلاح الدين من هذه الاتفاقيات من ناحيتين:
ـ ازدياد موارد دولته بسبب النشاط التجاري ، فحصل على حاجته من الحديد ، والخشب ، والشَّمع.
ـ إضعاف تجارة الصَّليبيين؛ لاسيما إذا عرفنا: أنَّ صلاح الدين كان يسيطر على البحر الأحمر ، ولا شكَّ: أنَّ هذه التجارة أدت إلى الاهتمام بإعادة بناء الأسطول الإسلامي الأيوبي. ففي خطاب وجَّهه صلاح الدين إلى الخليفة العباسي سنة 571هـ/1175م قال: ومن هؤلاء الجيوش: البنادقة ، والبياشنة ، والجنويون ، كلُّ هؤلاء تارةً يكونون غزاةً ، لا تطاق ضراوة ضرِّهم ، ولا تطفأ شرارة شرِّهم ، وتارةً يكونون سفَّاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة، وتقصر عنهم يد الأحكام المرهونة ، وما منهم إلا من هو الان يجلب إلى بلدنا الة قتاله، وجهاده ، ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله ، وتلادة ، وكلُّهم قد قُرَّرت معهم المواصلة، وانتظمت معهم المسالمة على ما نريد ، ويكرهون ، وعلى ما نؤثر ، وهم لا يؤثرون. وهذه العلاقات بين مصر والمدن الإيطالية لم تكن بالأمر الجديد ، بل هي استمرار لما كانت عليها في العهد الفاطمي ، لكن صلاح الدين نجح في المحافظة عليها ، وتطويرها.
9 ـ تخريب المدن: وممَّا يُذكر بصدد خطط صلاح الدين الحربية: أنه لجأ في سني صراعه الأخيرة مع الصليبيين ـ الذين كان يقودهم ريتشارد قلب الأسد ـ إلى تخريب مدينة عسقلان؛ التي كانت المفتاح الجنوبي لبيت المقدس ، وطريق القوافل الذاهبة إلى مصر ، وكان المسلمون يطلقون عليها عروس الشام لحسنها ، ولجأ السُّلطان إلى هذا الإجراء حين عجز جيشه عن الدِّفاع عنها ، وخشي أن يستولي عليها الصَّليبيون ، وهي عامرةٌ ـ كما حصل لعكَّا ـ فيقطعوا بها طريق مصر.
ورأى صلاح الدين إدِّخار قوة جيشه الدِّفاعية لحفظ بيت المقدس ، واستشار صلاح الدين أخاه الملك العادل ، وأكابر أمرائه في ذلك ، فأقرُّوه على رأيه ، وقال علم الدين سليمان بن جندر أحد كبار مستشاريه: هذه يافا قد نزل العدوُّ بها ، وهي مدينة تقع في الوسط بين عسقلان ، والقدس ، ولا سبيل إلى حفظ المدينتين معاً ، فاعمد إلى إشرافها ، وحصنها. وهكذا تقرَّر تخريب عسقلان والواقع: أنَّ هذه المدينة لم تكن الوحيدة التي تعرَّضت لهذا المصير، بل تقرَّر تخريب حصن الرَّملة كذلك ، وحصن النَّطرون؛ الذي كان من أملاك الداوية ، وجزءاً من سور يافاً ، وغزة ، واللد ، والدَّاروم الواقعة في أقصى ساحل الشام الجنوبي، وقد خرَّبها صلاح الدين حين ملك الساحل في سنة 584هـ ، وهذا ما حصل لحصن سرمينية أيضاً ، فبعد أن فتحه الملك الظاهر غازي في جمادى الاخرة سنة 584هـ/1188م أخرج أهله منه ثمَّ هدمه ، وسواه مع الأرض ، وعفى أثره وخرَّب حصن يازور بسواحل الرَّملة من أعمال فلسطين ، وخرَّب معه بلدة «بيت جبرين» قبيل عقد الصُّلح مع ريتشارد.
10 ـ تأمينه للطريق الموصل بين مصر والشام: وممَّا يدخل ضمن خطط صلاح الدين الاستراتيجية تأمينه للطريق الموصل بين مصر والشام, والذي تبلغ المسافة بينهما مسيرة حوالي ثلاثين يوماً. وشيَّد صلاح الدين القلاع ، والمنازل ، وأقام الحراسة على طول الطريق بين مصر والشام ، فأعاد الأمن ، والسلام إلى سيناء وقد اعتاد صلاح الدين ، وقوَّاده أن يسلكوا هذا الطريق في غدواتهم ، وروحاتهم إلى الشام.
11 ـ تحصين المدن والثغور: واهتمَّ بتحصين مدينتي مصر ، والقاهرة ، وثغور الدِّيار المصرية ، ومداخلها ، وأهمُّها في عهد صلاح الدين ، الإسكندرية ، ودمياط ، ورشيد ، وعيذاب ، ونيس ، وأدرك صلاح الدين مدى الخطر الذي قد لحق بمصر من ناحية الشَّمال من جانب الصليبيين ، وكان ما حصل في دمياط حين حاصرها أموري براً ، وبحراً سنة 565هـ/1169م جعله يولي هذا الثَّغر قدراً كبيراً من اهتمامه ، فكان حريصاً على تحصينه ، وكذلك اهتمَّ بتحصين سواحل البحر الأحمر ، وأمَّا داخل مصر فأهم التحصينات التي أقامها كانت في مدينة القاهرة ، فقد شرع السُّلطان في عمارة سور القاهرة ، لأنَّه كان قد تهدَّم أكثره ، وصار طريقاً لا يردُّ داخلاً، ولا خارجاً ، وولاَّه لقراقوش الخادم.
12 ـ موسم القتال: كانت الاستعدادات للقتال تبدأ بانتهاء موسم الشتاء ، وارتفاع درجات الحرارة مع قدوم الرَّبيع، أمَّا ما كان يجري في الشتاء بين الجانبين؛ فلم يكن يتعدَّى المناوشات القصيرة ، ووضع الكمائن ، وإرسال فرق الاستطلاع لمعرفة أحوال العدو ، وإذا نظرنا إلى فترات المعارك ، نلاحظ: أنها تقع خلال الثمانية ، أو التسعة أشهر التي تبدأ مع انتهاء حدَّة البرد ، وتنتهي مع قدوم الشتاء. وإذا تابعنا اليوميات الخاصَّة بتحرُّكات صلاح الدين؛ التي دوَّنها كلٌّ من العماد الكاتب ، وابن شدَّاد ، وغيرهما من المؤرخين المعاصرين ، واللاحقين؛ نرى: أنَّ القتال ، ووصول جيوش الأطراف إلى الميدان يتوقَّف في فصل الشتاء ، ولكن ما أن ينتهي هذا الفصل القارس والموحل ـ لاسيما في بلاد الشام ـ حتى يدبَّ النشاط في الجيش ، فيبدأ بالاستعداد لمجابهة عدوِّه ، وتصل إلى ميدان القتال قوات الأطراف.
وأما بعد أن ينتهي موسم القتال ، فتعود العساكر إلى بلدانها. يقول العماد: إنه حين هجم الشتاء العنيف ، وانحرف خريف الخريف ، واشتعلت رؤوس الجبال شيباً للثلج ، وحلَّ الوحل المخيم ، طلب الأمراء من صلاح الدين الأذن بالعودة إلى بلادهم للرَّاحة ، والاستجمام ، فسار صاحب سنجار ، وتلاه صاحب جزيرة ابن عمرو ، وبعد ابن صاحب الموصل. ويذكر ابن شدَّاد بهذا الصدد تحت عنوان: (عود العساكر من الجهاد): أنَّه لما هجم الشتاء ، وهاج البحر ، وأمن العدو أن يضرب مصافاً ، وأن يبالغ في طلب البلد ، وحصاره من شدَّة الأمطار ، وتواترها؛ أذن السلطان للعساكر الإسلامية في العود إلى بلادها؛ لتأخذ نصيباً من الرَّاحة ، وتجمَّ خيولها إلى وقت العمل. وقد تكرَّرت حوادث قدوم العساكر إلى ساحة المعركة لإنجاد الجيش الصلاحي المركزي ، بعد انتهاء فصل الشتاء، ثم العودة إلى أوطانها بمجيء هذا الفصل.
وضمن أيام القتال كان صلاح الدين يستبشر بيوم الجمعة نظراً لمكانة هذا اليوم ، وقدسيته لدى المسلمين، وهذا لا يعني: أنَّه كان يتوقف عن القتال في أيام الأسبوع الأخرى في انتظار يوم الجمعة ، لكنَّه كان يتفاءل من نتيجة القتال؛ إذا صادف ، وكان اليوم هو يوم الجمعة ، ففي وقعة حطِّين يسيِّر عساكره وسط نهار الجمعة من ربيع الآخر من سنة 583هـ تبركاً بدعاء الخطباء على المنابر ، فربما كانت أقرب إلى الإجابة ، ودخل جيش صلاح الدين عكَّا يوم الجمعة، وفي فتوح قلاع الساحل الشمالي لبلاد الشام؛ أي: القلاع المحيطة بأنطاكية اتفقت: أن جميعها فتحت في أيام الجمعة ، وهي علامة قبول دعاء الخطباء المسلمين ، وسعادة السُّلطان ، حيث يسر الله له الفتوح في اليوم الذي تضاعف فيه ثواب الحسنات.
ولعلَّ مجلس حرب صلاح الدين كان يخطط لجعل القتال يقع في يوم الجمعة ، وهذا يعني: أن هذا اليوم كان له تأثيره الطيب على نفوس المقاتلين المسلمين، واندفاعهم البطولي في القتال. ونرى: أن النصر والهزيمة لا علاقة لهما بيوم محدَّد، وتأثير يوم الجمعة بالنسبة لصلاح الدين كان نفسياً ، والانتصارات كانت تحصل حتَّى في غير أيام الجمعة ، ثم إن انتصاراته لم تقتصر على هذا اليوم؛ إضافة إلى أنَّه لم يخلُ من هزائم أُلحقت بجيشه.
13 ـ معاملة الأسرى: لم يكن صلاح الدين يميل إلى سفك الدِّماء ، والانتقام من الأسرى الصَّليبيين على الرَّغم من أنَّهم جاؤوا في الأساس غزاةً محتلِّين لبلاد المسلمين. وفيما يروى عنه في هذا الصَّدد: أنَّه منع أولاده من قتل الأسرى؛ لكيلا تنموا في نفوسهم غريزة سفك الدَّم ، فلربما إذا اعتادوا على قتل أسراهم ، وهم صغار ، فسيفعلون ذلك دون تفريق بين المسلم ، والكافر ، بل إنَّه حذَّر ولده الملك الظاهر ـ وهو ابن العشرين سنة ـ من إراقة الدم في اخر وصيةٍ له أثناء مرضه الأخير. وبصورةٍ عامة نجد: أنَّ معاملتهم كانت تتابين بين تشغيلهم في أعمال السُّخرة ، وحجزهم في دمشق ، وعرضهم للبيع ، أو قتلهم. ولعلَّ من الصواب أن نقول: إن صلاح الدين لم يشذ عن القادة ، أوالحكام السابقين في طريقة تعامله مع الأسرى كنور الدين محمود؛ الذي سار صلاح الدين على نهجه في طريقة حكمه ، وكان يجهز على الأسرى في بعض المناسبات ، كما حدث في سنة 552هـ/1157م حين جلب له الأسرى ، فأمر بضرب أعناقهم ، وكذلك نور الدين محمود يسجنهم في أكثر الأحيان ، لاسيما القادة الكبار منهم ، كما حدث لأرناط «رينودي شاتيون» صاحب أنطاكية ثم «الكرك» الذي حبسه خمس عشرة سنة، ثم أطلق الأمير كمشتكين ، أحد أمراء نور الدين سراحه بعد وفاته نكاية بصلاح الدين.
وكان القصد من الإبقاء على حياة الأسرى ـ لاسيما الأمراء منهم ـ هو الاستفادة منهم في إجراء عملية التبادل مع الأسرى المسلمين؛ إذ إنَّ المعروف عن نور الدين محمود حرصه الشديد على فكاك أسرى المسلمين ، سواء بالتبادل ، أو بالفداء ، ولا سيما الأسرى المغاربة منهم؛ لأنَّهم غرباء عن الشام ، ولا أهل لهم فيها. فمما يذكره ابن جبير بهذا الصَّدد: أن من جميل صنع الله تعالى لأسرى المغاربة في الشام: أن الملوك ، والأغيناء كانوا يخرجون مبلغاً من مالهم يخصِّصونه لافتكاك الأسرى المغاربة. وحرص صلاح الدين على الاقتداء بنور الدين محمود ، والسير على منواله في هذا ، بل إنه ما برح يطلق سراح الأسرى الصليبيين الفقراء دون مقابل ، كما حدث لدى فتحه بيت المقدس ، إضافةً إلى قيامه بافتكاك الأسرى المسلمين ، وقد تحتم ذلك عليه بوصفه المسؤول عن حياة المحاربين ، ولأنَّ بتحريرهم من الأسر يطلق قوةً إسلاميَّةً حبيسةً في معسكر العدو ، ومن ثم فإنَّ ذلك عملٌ من أعمال البر والتقوى.
وسار على هذا النهج بعض أمرائه ، فممَّا يُذكر عن مظفر الدين كركبري صاحب أربيل ، صهر صلاح الدين: أنَّه كان يبعث برسله مرَّتين في كلِّ سنةٍ إلى بلاد الساحل «الشام» ومعهم المال الكثير لتحرير الأسرى المسلمين من أيدي الصليبيين ، حتى إنَّ سبط ابن الجوزي يقول: إنَّ أموال إمارته قد استنفذتها الصدقات. وقدَّر هذا المؤرخ عدد أسرى المسلمين الذين حرَّرهم هذا الأمير بنحو ستين ألف أسير ، ما بين رجلٍ ، وامرأة. ومن وقائع حسن معاملة الأسرى ما حصل سنة 587هـ/1191م حين أحضروا إليه خمسين أو أربعين نفراً صليبياً من بيروت ، وكان بينهم شيخ طاعنٌ في السن ، لم يبق في فمه ضرسٌ ، ولدى إحضاره أمام صلاح الدين طلب من الترجمان أن يسأله عن السَّبب الذي حمله على القدوم إلى المشرق؛ وهو في هذا العمر ، وغيرها من الأسئلة ، فأجاب الصليبي الهرم على أسئلة السُّلطان ، فرقَّ له السلطان ، ومنَّ عليه، وأطلقه ، وأعاده راكباً على فرس إلى معسكر العدو.
في حين كان صلاح الدين ينتقم من بعض الأسرى شرَّ انتقام ، لأنهم ارتكبوا جرائم شنيعة لا تغفر إِلا بسفك دمهم ، بل والتشهير بهم قبل الشُّروع بقتلهم ، كما سيأتي بيانه في محلِّه بإذن الله. ونجد: أنَّ صلاح الدين كان يرى: أنَّ من الأفضل الإبقاء على حياة الأسرى للاستفادة من طاقتهم في بعض الأعمال ، فحين شرع ببناء حصن القاهرة «قلعة صلاح الدين» سخَّر هؤلاء الأسرى في القيام بالأعمال الشاقَّة ، كنشر الرُّخام ، ونحت الصخور العظام، وحفر الخندق المحدق بسور الحصن ، وكان خندقاً ينقر بالمعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب ، ولا سبيل ـ كما يقول ابن جبير ـ أن يمتهن في ذلك البنيان سوى العلوج الأسارى من الرُّوم.
وذكر مؤرخٌ مصريٌّ متأخرٌ: أنَّ قراقوش كان يستعمل في بناء القلعة والسُّور خمسين ألف أسيرٍ صليبي.
14 ـ المعاهدات بين صلاح الدين والصَّليبيين: كان أول المعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين في مستهلِّ سنة 571هـ/صيف 1175م, أي: في بداية استقرار صلاح الدين في بلاد الشام ، ولا ريب: أنَّ ضغط الظروف السياسية ، والاقتصادية ، والعسكرية ، وغيرها هو الذي دفعه إلى عقد هذه الهدنة مع الصليبيين ، وأيضاً: حاجته إلى وقتٍ إضافي لتصفية حسابه مع الجماعات الإسلامية المناوئة له ، وكونه القائد الذي ينبغي عليه قيادة الجبهة الإسلامية ضدَّ الصَّليبيين ، إضافةً إلى قطع الطَّريق على الجماعات الإسلامية التي رغبت في التعاون مع الصَّليبيين على حساب صلاح الدين ، لاسيما أتابكة الموصل ، وحلب.
وهذه الأسباب جميعها دفعت السُّلطان ، والصليبيين إلى إيقاف القتال ، وقيام فترة سلم بينهما ، وحين تمَّ عقد الهدنة أمر السلطان العساكر المصرية بالعودة إلى مصر ، نظراً لانتفاء الحاجة إلى وجوده في الشام بالإضافة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في الشَّام ـ كما قلنا ـ وكذلك حاجة مصر إلى جندها في موسم الحصاد ، فيذكر العماد: أنَّ السُّلطان أذن لعسكر مصر بالانصراف ، والإقامة في مصر «ريثما يستوعب المغل». والوقع أنَّ صلاح الدين لم يعقد هذه الهدنة أو غيرها إلا وهو حذر من الصليبيين مخافة أن ينقضوها ، كا حدث فعلاً ، فكان يتَّخذ لنفسه الحيطة من الشروط ، والبنود التي تقيد العدو ، وتمنعه من القيام بالعدوان ، وكذلك لم يكن يلقي السِّلاح ، ويركن إلى السلم مع عدوٍّ محتل، بل إنَّه كان يضع جيشه في حالة استعداد ، وترقُّب دائمين ، ولا ينقطع عن القيام بمناوشته خشية غدره ، وكذا كان صلاح الدين يستشير مجلس حربه حين يعزم على الاتفاق مع العدو لإيقاف القتال.
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي: