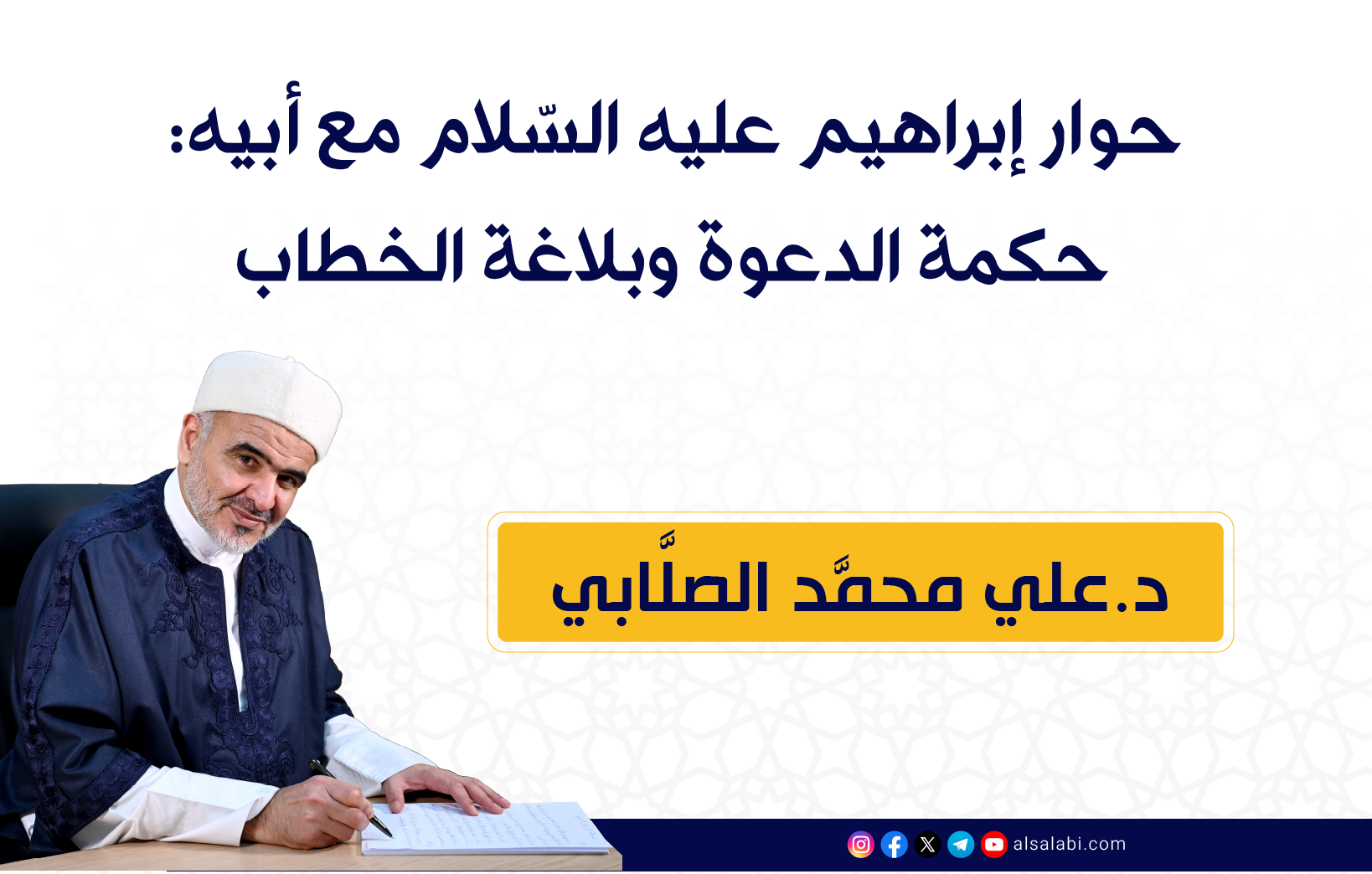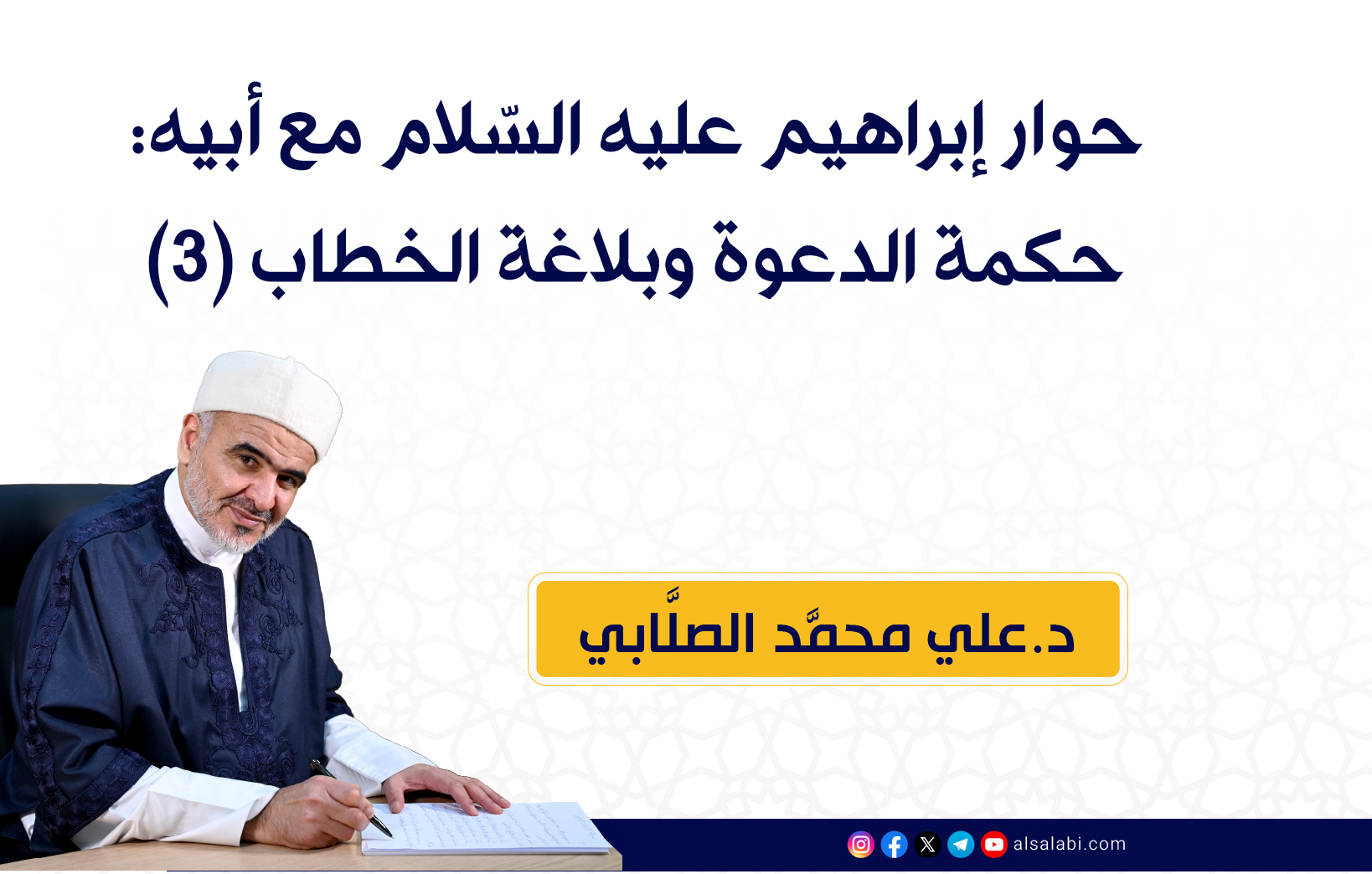حوار إبراهيم عليه السّلام مع أبيه: حكمة الدعوة وبلاغة الخطاب
بقلم: د. علي محمد الصلابي
أثناء تلاوة القرآن الكريم، وخلال مرورنا على سيرة إبراهيم عليه السلام، نقف مع أحد أعظم مشاهد الدعوة التي ذكرها وخلّدها هذا الكتاب الرباني؛ وهو حوار الخليل إبراهيم عليه السّلام مع أبيه، حوارٌ يجمع بين صفاء العقيدة ولطف الخطاب، وبين قوة الحجة ورقة القلب. فقد قدّم إبراهيم نموذجًا فريدًا للداعية الذي يجمع بين الحكمة والرفق، فبدأ دعوته بنداءٍ يفيض محبة: {يَا أَبَتِ}، ثم ساق الحجج الواضحة التي تُبطل عبادة الأصنام، بأسلوب عقلي هادئ يلامس الفطرة. إنّ تأمّل هذا الحوار يكشف لنا منهج الأنبياء في بيان الحق، وكيف تكون النصيحة بصبر ورفق وأدب وإخلاص.
قال تعالى: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم:42[:
يتوجه النبي إبراهيم عليه السلام إلى أبيه بكلام يهز أعطاف السامعين، ويأخذ بمجامع القلوب في الاستدراج والإذعان والانقياد بألطف العبارات وأرشقها وهو مشتمل على حسن الملاطفة والاستدراج والرفق في الخصمة والحجاج والأدب العالي وحسن الخلق الحميد. (بلاغة الاحتجاج العقلي، زينب الكردي، ص204)
ونعيش في هذه الآيات الكريمة مع الخليل - عليه السّلام - وهو يحاور أباه ويعظه، ويُبطل له عقيدته الفاسدة بأدب واحترام وحكمة ورفق.
وقد بدأ وعظ أبيه وإرشاده بندائه وقوله: {يَا أَبَتِ}، وهو نداء لطف ومحبة، استفتح به ليُحنن قلب أبيه ويستلطفه، والتاء في قوله {يَا أَبَتِ} عوض عن ياء المتكلم، وذكرها بدلاً عن الياء مبالغة في التلطيف.
ونادى أباه مع أنه في حضرته؛ لإثارة انتباهه وإيقاظ نفسه وتهيئة ذهنه، والإقبال عليه بوعي وتركيز، واستخدم إبراهيم - عليه السّلام - في نداء أبيه أداة النداء {يَا} التي للبعيد على الرغم من أنه قريب منه وبجواره؛ لإشعار أبيه بعلو منزلته، ورفعه مكانته في نفس ابنه، وقد كرّر نداء بــــ {يَا أَبَتِ} أربع مرات، وهو نداء يهمش له كل أب ويرق له ويتلذذ به، وهو نداء فيه من الرفق والتودد واللين والاستمالة لما فيه، وقد توجّه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلصٌ له النصيحة.
وبعد تلك التهيئة النفسية الرائعة ألقى على أبيه حجة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله الخطأ، فقال له: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا}، فابتدأ حواره بالحجة الراجحة إلى الحسِّ، واستفهم عن السبب الذي حدا بأبيه أن يعبد وثناً من حجارة، وقد وصف الوثن بثلاث صفات مذمومة: أحدها: لا يسمع، ثانيها: لا يبصر، ثالثها: لا يغني شيئاً.
تأمل فطنة الداعية إلى الله إبراهيم - عليه السّلام - وهو يفنّد عقيدة أبيه في الأصنام، فوصفها بأوصاف تُبطل استحقاقها للألوهية، بيانَ ذلك أنّها إذا لم تسمع ولم تبصر ولا تنفع من يطيعها، ولا تضرُّ من يعصيها فأية فائدة في عبادتها؟ وإذا كان الدعاء لبُّ العبادة، فالوثن إذا لم يسمع دعاء الداعي، فأيّة منفعة في عبادته؟ وإذا كانت لا تبصر من يتقرب إليها، فأيّة منفعة في ذلك التقرب؟ بل إذا كانت لا تبصر من يعظمها ويتقرب إليها، ولا من يحقرها ويؤذيها، فأية فائدة في عبادتها، وأيّ نفع لمن يعبدها؟ وإذا كانت لا تنفع ولا تضرّ فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأية فائدة في عبادة ما لا تستطيع حماية نفسها من الكسر والإفساد، كما فعل بها إبراهيم - عليه السّلام - فيما بعد؟ فأيّة حماية تستطيع أن تقدّمها تلك الأوثان لمن يلجأ إليها؟. (تأملات في سورة مريم، عادل أحمد الرويني، ص183)
لقد واجه إبراهيم - عليه السّلام - أبيه في عقيدته الفاسدة، بسؤال الاستفهام المشوب بالتعجب والتوبيخ لمن يعبد وثناً أو صنماً لا يملك لنفسه ولا لعابده شيئاً، أي لم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي أفعالها، فلا تسمع ولا تبصر، ولا تملك لعابدها نفعاً ولا ضرّاً، بل ولا تملك لنفسها شيئاً من النفع، ولا تقدر على شيء من الدفع؟ فهذا برهان جليّ دالّ على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً، ودلّ على تنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادته من له الكمال الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو. (إبراهيم خليل الله، علي الصلابي، ص208)
والأصل في العبادة أن يتوجه بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان، وأعلم وأقوى، وأن يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسمى. (في ظلال القرآن، سيد قطب، (4/2311))
وأن تكون العبادة لمن خلق الإنسان والمخلوقات، ولمن شأنه النفع والضرّ والثواب والعقاب، فقد ثبت عن الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الصحيحين أنه جاء إلى الحجر الأسود، فقبّله، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبّلك ما قبّلتك. (صحيح البخاري، رقم (1597)، صحيح مسلم، رقم (1270))
إنَّ العبادة هي غاية التعظيم، فلا تحقّ إلا لمن له غاية الإنعام، وهو الخالق الرازق القادر المحييّ المميت الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذيّ منه أصول النِّعم وفروعها، فهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة.
وتعرف العبادة بأنها طاعة عبد لمعبود في أمره ونهيّه، فالذين يعبدون ما دون الله من صنم أو وثن أو شمس أو قمر، هل هذه الأصنام خلقتهم أو خلقت شيئاً أو رزقتهم أو رزقت أحداً ...؟ وبماذا أمرتهم هذه المعبودات، وعن أي شيء نهتهم؟ وماذا أعدّت هذه المعبودات لمن عبدها؟ وماذا أعدّت لمن عصاها؟ وما المنهج الذي جاءت به حتى تستحق العبادة؟ الجواب هنا: لا يوجد شيء من هذا كله، إذاً فعبادتهم باطلة. (تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، (15/9097))
لقد سلك الخليل إبراهيم - عليه السّلام - في دعوة أبيه أحسن منهاج، واحتجّ عليه أبلغ احتجاج، بدأ بتخلية قلبه عن تعظيم الأصنام، فبيّن له أنّها لا تستحق شيئاً من العبادة والتعظيم لسكونها وعجزها وضعفها، فهي لا تسمع ولا تبصر، ولا تجلب نفعاً لعابدها ولا تدفع عنه ضرّاً، ثم لفت نظر أبيه إلى ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به ومنَّ عليه بالنّبوّة، فقال مكرراً نداءه بصفة الأبوة لما فيها من الاستعطاف والاستلطاف. (تأملات في سورة مريم، مرجع سابق، ص186)
المراجع:
• إبراهيم خليل الله (عليه السلام) داعية التوحيد والأسو الحسنة، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الأصالة – إسطنبول، ط1، 1444هـ - 2022م.
• بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم، زينب عبد اللطيف كامل الكردي، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط1، 2014م، ١٤٣٥ه، ص202.
• تأملات في سورة مريم، عادل أحمد صابر الرويني، دار النوادر، دمشق، سوريا، 2011م.
• في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق للطباعة، القاهرة، ط 32، 2003 م.
• صحيح البخاري، البخاري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 4، 2002م.
• صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط2، 1972م.
• تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، دار أخبار اليوم، القاهرة، 2013م.