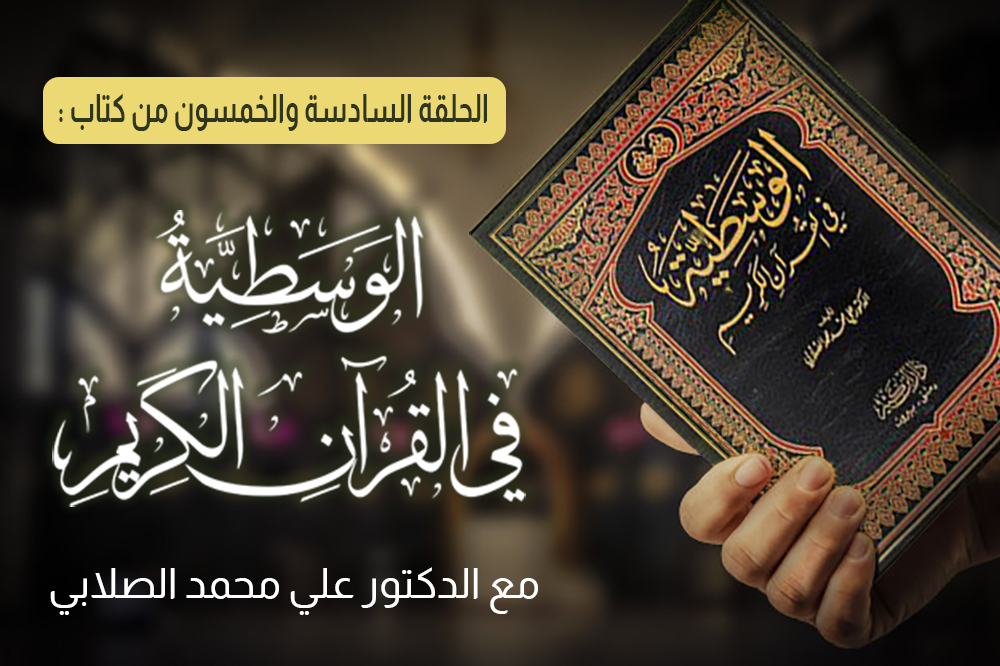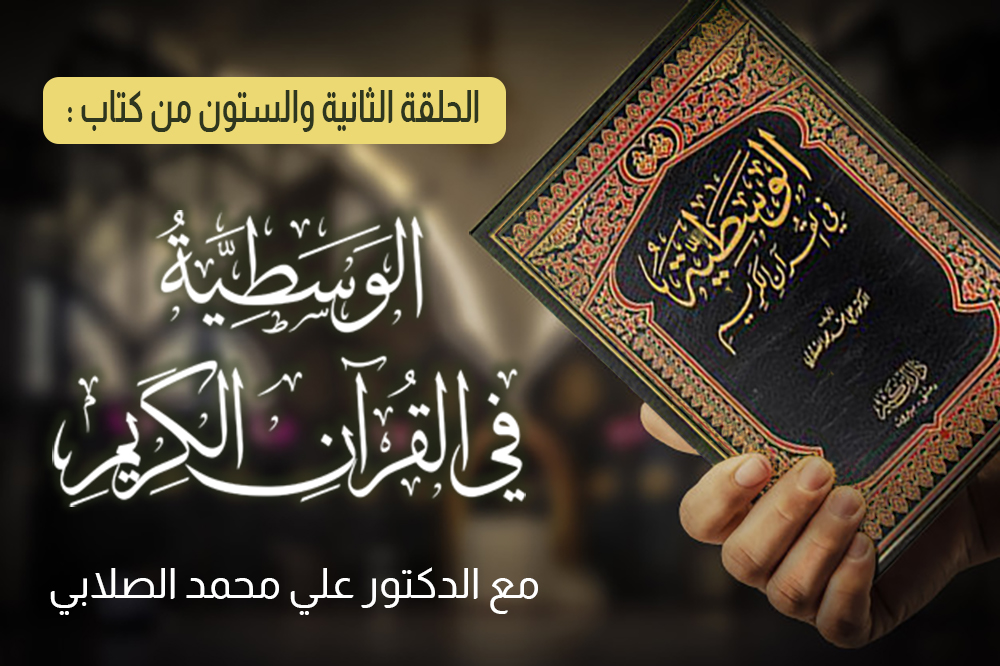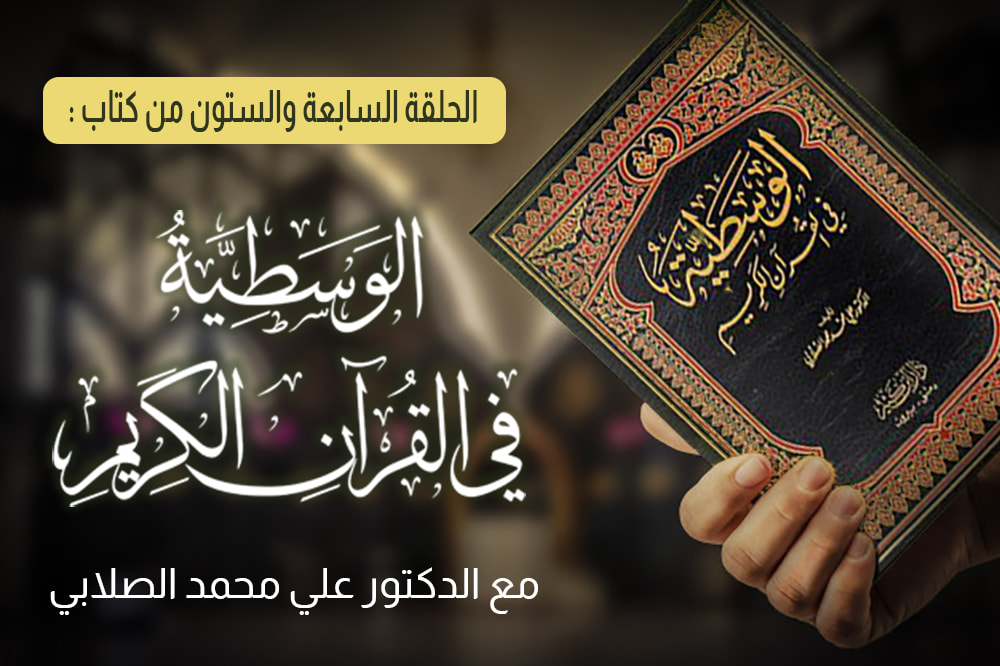من كتاب الوسطية في القرآن الكريم:
(التوجيهات القرآنية في مجال العبادة)
الحلقة: التاسعة والخمسون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الأولى 1442 ه/ ديسمبر 2020
تمهيد: إنَّ الجاهلية أفسدت العقائد، والأفكار، وأفسدت العبادات، والشعائر، وأفسدت الأخلاق، والآداب، وأفسدت النظم، والتقاليد، وأفسدت الحياة كلها، وأصابت الأديان كلها، فانحرفت عن الصراط المستقيم.
وعندما أراد الله أن يبعث سيد المرسلين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ كانت الدنيا مليئة بالعبادات والشعائر، بعضهما بقايا أديان سماوية، وبعضهما إضافات بشرية، وابتداعات شيطانية، ففقد معنى التعبد وروحه، ومعنى الإخلاص لرب العالمين. وأصبحت البشرية ضائعة بين أديان تشتت، وتعنتت، وتزمتت، وأخرى ترخصت، وغلت في الترخيص، وأصبحت الديانة كأنها لهو ولعب، وأصبح بعض البشر لا دين لهم، وجاء الإسلام، فلم يحابِ الغالين، ولم يوافق المنحرفين، بل شرعه الله {دِيناً قِيَمًا} لا عوج فيه، ولا غلو، ولا تقصير، بل كان كما قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ *قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ *}[الأنعام: 161 ـ 164].
إن في القرآن الكريم عدَّة توجيهات ومبادئ إصلاحية كانت، ولا تزال هي حجارة الأساس؛ التي يقوم عليها صرح العبادة الشعائرية في الإسلام.
وهذه الإصلاحات، والتوجيهات، والمبادئ العظيمة تدلُّ بكل وضوح على وسطيَّة القرآن في مجال العبادة. ومن هذه التوجيهات في مجال العبادة:
أولاً: لا يعبد إلا الله:
في الفترات التي طال فيها الأمد على دعوة الرسل، فنسيت، أو حرفت ضل الناس، وعبدوا أنواعاً من الالهة لا يكاد العقل يصدقها. فهناك قوم عبدوا الشمس، كما حكى القرآن عن ملكة سبأ وقومها على لسان هدهد سليمان: {وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ *} [النمل: 24] وهناك طائفة عبدت الجن ، كما قال تعالى: {بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ *}[سبأ:41].
وهناك من عبد الأصنام، والأوثان، واشتهر بذلك مشركو العرب، ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثمئة وستين صنماً، فجعل يطعن بسيفه في وجوهها، وعيونها، ويقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *} [الإسراء: 81] وهي تتساقط على رؤوسها ، ثم أمر بها، فأخرجت من المسجد، وحرقت.
وضل اليهود، والنصارى عن طريق التوحيد، وزحفت عليهم الوثنيات، فأفسدت عليهم دينهم، ونسب اليهود إلى الله ما لا يجوز أن ينسب من صفات النقص، والندم، والتعب، ومر بنا ذلك بالتفصيل، وأصبحت النصرانية مزيجاً من الخرافات اليونانية، والوثنية الرومية، والأفلاطونية المصرية، والمهم: أن القوم عبدوا المسيح الذي كان من أشد الناس عبادة لله، واعترافاً بعبوديته لربه، و {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، ذلك هو الشرك الذي انتشر في الافاق قبل نزول القرآن، وتلك هي الوثنية الجاهلية التي سيطرت على عقول الناس، وأفكارهم، وتصوراتهم، وعقائدهم.
وجاء الإسلام يدعو إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة كل ما سواه ومن سواه، من الآلهة المزعومين، والأرباب المزيفين، سواء أكانوا من البشر، أم من الجن، أم من أيِّ عالم من عوالم المخلوقات العلوية والسفلية.
إن القرآن الكريم بيّن التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة. إن سر الإسلام ـ على سعة تعاليمه ـ يتجلى في دستوره الخالد: القرآن الكريم، وسر هذا الدستور يتركز في الفاتحة: أم القرآن، والسبع المثاني، وسر هذه الفاتحة يتلخص في هذه الآية الكريمة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *} [الفاتحة:5].
إنَّ أول وصية في القرآن، وأول مبدأ يبايع عليه الرسول كلُّ من اعتنق دينه هو: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}[النساء:36].
وأول ما دعا إليه رسول الإسلام ملوك الأرض، وأمراءها هو هذه القضية الكبرى: أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تطرح الالهة، والأرباب التي اتخذها الناس من دون الله، فأذلوا أنفسهم لمن لا يستحق الذل والخضوع، ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم رسائله إلى قيصر، والنجاشي، وغيرهما من أصحاب الملك، والإمارة بهذه الآيةالكريمة من سورة آل عمران: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ} {نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ *} [آل عمران: 64].
بل عَدَّ القرآن هذه الدعوة دعوة الرسل جميعاً، فكلهم دعا قومه إلى عبادة الله وحده، واجتناب عبادة الطاغوت، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فهما معبودان لا ثالث لهما: إما الله، وإما الطاغوت، ومن استكبر عن عبادة الله سقط ـ حتماً ـ في عبادة الطاغوت.
قال تعالى:
{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}[النحل:36].
وقال سبحانه مخاطباً خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ *}[الأنبياء:25].
شدَّد الإسلام حملته على الشرك، وقعد له كل مرصد، وحاربه بكل سلاح، وقرر: أنه الإثم العظيم، والضلال البعيد، والجرم الأكبر، والذنب الذي لا يغفر. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا }وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا *}[النساء: 116].
وبيَّن القرآن الكريم: أنه ليس في العالم المخلوق شيء يستحق أن يسجد له الإنسان، أو يتضرع إليه، أو يرجوه، أو يخشاه، فالملائكة عباد لله خاشعون خاضعون: {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ } [الأنبياء: 19 ـ 20] {لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [التحريم: 6] { لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ *يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ *} [الأنبياء: 27ـ 28].
والبشر وإن علا سلطانهم، أو عظم قدرهم، أنبياء كانوا أو سلاطين هم أيضاً عباد لله، لا يملكون لأنفسهم، فضلاً عن غيرهم، ضرّاً، ولا نفعاً، ولا موتاً، ولا حياة، ولا نشوراً، والعبودية هي الوصف اللازم لهم جميعاً: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا *لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا *وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا *}[مريم: 93 ـ 95].
والشمس، والقمر، والنجوم إن هي إلا كواكب مسخرات بأمره تعالى، لا يجوز أن ينحني صلبٌ من أجلها راكعاً، أو يَخِرُّ وجهٌ من أجلها ساجداً: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *}[فصلت:37].
وكل ما يُدعى من دون الله في الأرض، أو السماء هو مخلوق عاجز لا قدرة له، محتاج لا قيام له بذاته، ضعيف لا يقوى على حياة نفسه. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} [الحج: 73] وقال تعالى: { قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً *أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا *} [الإسراء: 56 ـ 57] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *}[الأعراف: 194].
ثانياً: تحرير العبادة من رق الكهنوت:
إنَّ رجال الدين جعلوا من أنفسهم في الديانات النصرانية، واليهودية وسطاء بين الناس وبين الله.ومن ثمَّ قيدوا العبادات بمكان معين يدخل في سلطتهم، لا تجوز إلا فيه، وقيدوها بوسيط معين، يقوم بعملية السرقة من أموال الناس باسم الدين، وجعلوا لذلك مراسيم، وطقوساً كهنوتية خاصة لا تُقبل بدونها.
وقد بالغ رجال الدين المسيحي في العصور الوسطى في فرض هذه المظاهر الكهنوتية، فعلَّقوا في معابدهم رسوماً، وتماثيل للعذراء والمسيح، وعدَّتها الكنيسة شعائر تعبدية واجبة التقديس.
وكان من أعجب ما صنعوه: أنهم اتخذوا من الجنة مصدراً للثروة يبيعون منها قراريط، وأسهماً لمن يدفع الثمن المعلوم، وعلى قدر المدفوع يكون عدد الأسهم.
ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا: أن أحد الأثرياء اليهود أراد أن يقابل هذه السخريات العجيبة بسخرية أمَرَّ، وأعجب، فقد ذهب إلى أحد البابوات، ولم يشتر منه الجنة، كما كان يفعل المسيحيون، ولكنه اشترى منه صفقة أخرى هي: جهنم! فباعها له بثمن بخس؛ لأنَّها سلعة لا يرغب فيها أحد؛ ولكن اليهودي الماكر أعلن للمسيحيين جميعاً: ألا يبالوا بشراء الجنة بعد اليوم ؛ لأنه قد اشترى من البابا جهنم، ولن يدخل أحدٌ فيها قالوا: فعاد البابا، واشتراها بأضعاف ما باعها به!!.
والرؤساء الروحانيون في المسيحية يزعمون: أن لهم سلطة المنح، والمنع، والغفران، والحرمان، والإدخال في رحمة الله، والطرد منها ؛ لأن المسيح قال لبعض تلاميذه على حدِّ زعمهم: سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكل ما ربطته على الأرض يكون مربوطاً في السموات، وكل ما حللته على الأرض يكون محلولاً في السموات.
أما القرآن الكريم؛ فقد حرر العبادة من القيود المكانية المتزمتة، ولم يشترط المكان الخاص في عباداته إلا في الحجِّ، لما فيه من فوائد تفوق فائدة التحرر من المكان، من التجمع العالمي للمسلمين حول أول بيتٍ وضع للناس.
ومع اشتراط المكان لعبادة الحج، فليس فيه أي شائبة لتأثير الكهنوت، وليس فيه أي ثغرة لتدخل الوسطاء، والكهان بين المسلم وبين الله، وشأنه في ذلك في سائر عبادات الإسلام.
إنَّ العبادات في القرآن الكريم لا تتوقف على توسيط هيكل، أو تقريب كهانة، إنَّ المسلم يصلي حيث أدركه موعد الصلاة {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ويصوم ويفطر في داره أو في موطن عمله.
ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سدانة، ولا حق عنده لأحد في قربانه، غير حق المساكين، والمعوزين، ويذهب إلى صلاة الجماعة، فلا تتقيد صلاته الجامعة بمراسم كهانة، أو إتاوة حراب، ويؤمه في هذه الصلاة الجامعة من هو أهلٌ للإمامة بين الحاضرين باختيارهم لساعتهم إن لم يكن معروفاً عندهم قبل ذلك.
إن عقيدة المسلم في الله لا تتيح مكاناً لأولئك الوسطاء الذين يتحكمون في ضمائر عباد الله، فاعتقاد المسلم في الله يقوم على حقيقتين:
أولاهما: أنه تعالى فوق عباده، علو قهر، ومكانة، وذات سلطان، وتصرفه لا يشبهه شيء، ولا يحكم عليه شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ } [الأنعام: 18] {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى: 11] {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} [الإخلاص : 1ـ 4].
أما المسلم؛ فقد عرف من كتاب الله العزيز: أن الأرض كلها محراب كبير، فحيثما توجه يستطيع أن يتجه بعبادته لله. وفي هذا يقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: 115].
ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل».
وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع الإعجاب العظيم والتأثير البالغ من كثيرين من غير المسلمين، حتى من رجال الأديان أنفسهم؛ حتى إن الأسقف (لوفروا) قال: لا يستطيع أحد يكون خالط المسلمين لأول مرة، ألا يدهش بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عيناك مشاهدته أن ترى رجلاً ليس عليه أدنى مسحة للرياء، ولا أقل شائبة من حب الظهور، يذر عمله الذي يشغله كائناً من كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المعيَّن.
ولقد كان هذا المشهد العجيب في الأديان أحد العوامل التي أثرت في وجدان المحامي الكبير الأستاذ زكي عريبي عميد الطائفة اليهودية في مصر والذي اهتدى إلى الإسلام في عام 1960م، ومما جاء في محاضراته (لماذا أسلمت؟) قوله: (وما سمعت المؤذن يؤذن في الفجر أ،و في الظهر، أو في أي وقت آخر إلا شعرت بأنه صوت الله، الذي يفصل بين الحق والباطل، والحلال والحرام، ويهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم، وأركب السيارة في السفر وعلى الطريق بين الحقول، وبين الفضاء تقع عيني على رجل متواضع يقف بين يدي الله في ثياب رثة مهلهلة، يقف على مصلَّىً صغير، مفروش بالرقيق من الحصير على شاطئ ترعة متواضعة يصلي لله في خشوع، وابتهال، فكانت نفسي تهفو إلى أن أصلي مثل صلاته، كنت أعتقد: أن هذه نفحات الله في الأرض يلقيها في نفوس عباده الصالحين).
والحقيقة الثانية:
أنه تعالى ـ مع عظمته، وعلوِّ شأنه ـ قريب من خلقه، بل هو معهم أينما كانوا، في جلوتهم وفي خلوتهم، يسمع ويرى، ويرعى ويهدي، ويعطي من سأله، ويجيب من دعاه، فهو تعالى قريب في علوه، عَلِيٌّ في دنوه، وقد جمع تعالى بين العظمة والعلو، وبين القرب والدنو في اية واحدة، فقال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *}[الحديد:4].
وقد عبر القرآن على لسان إبراهيم ـ أبي الأنبياء ـ عن العلاقة بين الإنسان، والله، فقال: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ *وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ *وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ *وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ *وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ *}[الشعراء: 78 ـ 82] وقال سبحانه: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } [ق: 16] وقال تعالى: { وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ } [الواقعة: 85] وقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}[البقرة:186].
ومن اللطائف في هذه الآية: أنَّ سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور قد وقع في القرآن بضع عشرة مرة، وكان كلُّ جواب عن تلك الأسئلة مقترناً بكلمة (قل) مثل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ}[البقرة:189].
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *}[البقرة: 219]. وكان مقتضى تلك الآيات أن يقال في هذه الآيةأيضاً: وإذا سألك عبادي عني فقل: إني قريب ، ولكن أسلوب هذه الآيةخالف المعتاد، ولم يأمر الله رسوله أن يقول للناس ذلك، وقال سبحانه مباشرة (فإني قريب) ولهذا الأسلوب البياني دلالته، وإيحاؤه في الأنفس والعقول ؛ إذ لم يجعل الله واسطة بينه وبين عباده، وهذا من وسطيَّة القرآن الكريم في جانب العبادة؛ حيث حرر العبادة من رقِّ الكهنوت، وقد ردَّ القرآن الكريم على من زعم: أن له منزلة خاصة من الله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ *}[المائدة: 18].
وحكى عن المسيح: أنه يقول لربه يوم القيامة في شأن من ادعوا الانتساب إلى دينه: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *} [المائدة: 118] وبيّن القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرّاً، ولا نفعاً إلا ما شاء الله، قال تعالى: {قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ *} [الأعراف:188].
هذه وسطيَّة القرآن في العبادة حرصت على تحرير الإنسان من رقِّ الكهنوت، ومن الوسطاء بين العبد وخالقه.
فالمسلم تعلَّم من القرآن الكريم أن يكلم ربه بلا ترجمان، وأن يناجيه بما شاء حيث شاء، ومتى شاء، وأن يقف بين يديه بلا حجاب، ولا واسطة إلا العمل الصالح.
قال تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا *وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا *}[النساء: 123 ـ 124].
أو الدعاء بالأسماء الحسنى:
قال تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *}[الأعراف:180].
أو الدعاء في ظهر الغيب من أهل الصلاح لإخوانهم:
قال تعالى:{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *}[الحشر: 10].
ثالثاً: التوازن بين الروحيَّة والماديَّة:
التوازن والاعتدال بين الروحية، والمادية، أو بين الدين، والدنيا هو توجيه قراني دعا إليه المولى عز وجل في كتابه العزيز ؛ ليصلح ما أفسده محرفو الأديان في مجال العبادة.
غلوُّ اليهودية في أمر الدنيا:
لا تكاد تجد في أسفار التوراة الخمسة الحالية للروحانية أثراً، ولا للاخرة مكاناً، حتى الوعد، والوعيد في هذه الأسفار للمطيعين والعصاة، إنما يتعلقان بأمور دنيوية، وسيطرت عليها النزعة المادية الخالصة، فالخصب، والصحة، والثراء، وطول العمر، والنصر على الأعداء، ونحوها من المكاسب الدنيوية الزائلة، هي المثوبات التي تبشر بها التوراة، وأضداد هذه الأمور من الجدب، والمرض، والموت، والوباء، والفقر، والهزيمة ونحوها للذين يعرضون عن الشريعة، فليس للأجزية الروحيَّة، ولا الأخروية مكان في التوراة.
إهمال المسيحيَّة لأمر الدنيا:
أما في الإنجيل؛ فالدعوة فيه قوية إلى إلغاء قيمة هذه الدنيا، واعتبار هذه الأرض بمثابة منفى الإنسان، وطلب النجاة والسعادة هناك، في العالم الاخر، حيث تقوم مملكة السماء، فمن أراد ملكوت السماء؛ فليعرض عن هذه الأرض، ومن أراد العالم الاخر، فليرفض هذا العالم، أو هذه الدنيا، وهكذا لا تحسُّ في الإنجيل: أن لك في الدنيا نصيباً، وأن لك في طيبات الحياة حظّاً، ولا تشعر: أن لبدنك عليك حقّاً، وأن لك في عمارة الأرض دوراً، ولم تقف الدعوة على التقشف، والتزهد، وإهمال الحياة الأرضية عند الحد الذي جاء به الإنجيل، بل ابتدع النصارى نظام الرهبانية، بما فيه من قسوة على النفس، وتحريم للزواج، وكبت الغرائز، ومصادرة للنزوع إلى الزينة، والطيبات من الرزق، وانتشر هذا النظام العاتي، وكثر أتباعه، وأصبح ما يتعبدون به لله، ويتقربون به إليه هو البعد عن النظافة، والتجمل، واعتبار العناية بالجسم ونظافته ونوازعه رجساً من عمل الشيطان.
وقد ذكر أبو الحسن الندوي في كتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» صوراً للجموع الرهبانية وغلوها، ما تقشعر منها الجلود، وتفزع القلوب، وتدهش العقول، وهذه الصور ـ كما يقول الأستاذ الندوي ـ قليل من كثير جدّاً: (وكان بعض الرهبان لا يكتسون دائماً، وإنما يتسترون بشعرهم الطويل، ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام، وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع، والابار النازحة، والمقابر، ويأكل كثير منهم الكلأ، والحشيش، وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثمون من غسل الأعضاء، وأزهد الناس عندهم، وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة، وأوغلهم في النجاسات، والدنس، وكانوا يفرون من ظلِّ النساء، ويتأثمون من قربهن، والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون: أن مصادفتهن في الطريق، والتحدث إليهن ـ ولو كن أمهات، أو أزواجاً، أو شقيقات ـ تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية). وذكر من هذه المضحكات المبكيات شيئاً كثيراً.
ثالثاً: التوازن سمة القرآن والسنة النبوية:
وهكذا كانت اليهودية في إغفالها للاخرة، وللروح، وهكذا كانت المسيحية في تحقيرها للدنيا، والجسد.
فلما جاء الإسلام كانت سمة التوازن والاعتدال في كل الافاق والنواحي، الاعتدال الذي يليق برسالة عامة خالدة، جاءت لتسع أقطار الأرض، وأطوار الزمان، وتُشَرِّعَ لشتى الأجناس، والطبقات، والأفراد في مختلف شؤون الحياة، الاعتدال بين أشواق الروح، وحقوق الجسد، بين بواعث الدين، ومطالب الدنيا، الاعتدال بين العمل لهذه الحياة والعمل لما بعد الحياة.
وبيّن القرآن الكريم: أن على المسلم ألا يشغله حقُّ الجسد عن حقِّ الروح، وألا تشغله رغائب الدنيا العاجلة عن حقائق الاخرة الباقية، عليه ألا ينسى الله فينسى حقيقة نفسه، وماهية وجوده، وفي هذا يقول القرآن : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *}[الحشر: 18 ـ 19].
إنَّ مهمة العبادة في الإسلام الأخذ بيد الإنسان؛ حتى لا تغرقه أعمال الدنيا في لجة النسيان، حيث ينسى الله، فيُنْسِيه الله نفسَه. ومهمة العبادة أن تقوم بالتنبيه والتذكير لمن نسي مولاه، أو غفل عن أخراه، ثم تدع الإنسان يعود بعد أدائها إلى دنياه يلقاها ساعياً حثيث الخطى، وثيق العرا.
إن القرآن الكريم وضع المسلم في وضعه الرشيد بين الدين والدنيا.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *}[الجمعة: 9 ـ 10].
وهذا هو شأن المسلم: عملٌ، وبيعٌ قبل الصلاة، ثم صلاةٌ، وسعيٌ إلى ذكر الله ثم ـ بعد انقضاء الصلاة ـ انتشار في الأرض، وابتغاء من فضل الله، وفضل الله هنا هو الرزق والكسب.
ورواد المساجد في الإسلام ليسوا شيئاً متعطلاً، ولا رهباناً متطلبين، وإنما هم كما وصفهم القرآن : {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ *}[النور:37].
فهم أناس لهم دنياهم وأعمالهم من تجارة وبيع، وما أشد ما تشغل التجارة والبيع، ولكن ذلك لم يلههم عن حق الله.
وفي سياق الحج يرسم القرآن الكريم لنا صورة واضحة لصنفين من الناس الذين يدعون الله ويسألونه في تلك المنازل. قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ *وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ *}[البقرة: 200 ـ 202].
هكذا قسم القرآن الناس في الموقف الذي تسمو فيه الأرواح، وتدنو القلوب من ربها، وتهب عليهم نسمات الذكريات المحمدية من قريب، والذكريات الإبراهيمية من بعيد.
قسمان فقط ذكرهما القرآن : طلاب دنيا وما لهم في الاخرة من خلاق، وهم ذلك الصنف الذي توعده الله في آية أخرى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا *} [الإسراء: 18] وطلاب دنيا وآخرة يطلبون الحسنة في الحياتين، والسعادة في الدارين، دعاؤهم: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً}والحسنة في الدنيا ذهب العلماء إلى أقوال متعددة فيها: العافية، والمرأة الصالحة، الأولاد الأبرار، أو العلم النافع، أو الرزق الواسع، أو المحبة بين الناس، أو نحو ذلك، فكل هذا مما يحقق حسنة الدنيا.
ولم يذكر القرآن الكريم القسم الثالث من الناس ـ بحسب التقسيم العقلي ـ وهو من لا يطلب إلا حسنة الاخرة، وماله في الدنيا من أرب، وكأنه يعلمنا: أن هذا الصنف لا يكاد يوجد في الناس، فالحياة بمتاعبها الجمة، وحقوقها المتنوعة تفرض على طالب الاخرة أن يدعو ربه لييسر له سبيل دنياه، ويعينه على أداء حقوقها، ويخفف عنه متاعبها، ثم هو يشعرنا: أن إهمال الدنيا، وإهدار شأنها في حساب طالب الاخرة إنما هو أمر مذموم خارج عن سنة الفكرة، وصراط الدين معاً.
ولهذا لم يقبل رسول الله فكرة الانقطاع عن الدنيا من أجل الرغبة في الاخرة، والاعتزال المطلق لعبادة الله، وكلما رمق في بعض أصحابه نزعةً إلى هذا اللون من السلوك الذي عرف في بعض الأديان الأخرى؛ قوَّم عوج أفكارهم، وهداهم للتي هي أقوم.
إنَّ وسطيَّة القرآن الكريم في العبادة، جعلت العبادة لا تنعزل عن الدنيا، والدنيا لا تحيف على العبادة، بل جمعت بين الأمور بدون إفراط، أو تفريط، أو غلو، أو جفاء.
رابعاً: الرخص والتخفيفات في العبادة دليلٌ على وسطيَّة القرآن :
قد علمنا: أنَّ من ملامح الوسطيَّة رفع الحرج في الشريعة، واليسر في الأحكام، وعدم التكليف بما لا يطاق ، ويظهر رفع الحرج في باب العبادة واضحاً في الرخص والتخفيفات التي تدل على اليسر ورفع الحرج في عباداته وتكاليفه في عامة الأحــــوال ، فإن القرآن الكريم ، والسنة النبوية شرعت ألواناً من الاستثناءات ،والإعفاءات، والتسهيلات في أحوال خاصة، وهي تلك التي توجد للإنسان نوعاً من المشقة يؤوده، ويثقل ظهره، ويقعد به عن مواصلة السير. فالسفر مثلاً تقتضيه مطالب الحياة التي جاء الدين بإقرارها، بل بتمجيدها والدعوة إليها.
كالسفر في طلب الرزق: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}[الملك: 15].والسفر للحج إلى بيت الله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *}[الحج: 27].
والسفر لطلب العلم، وغير ذلك من الأغراض الدينية والدنيوية، والمرض مثلاً من ضرورات الحياة وبلائها الذي لا يكاد يسلم منه إنسان بمقتضى النشأة الإنسانية، والتركيب البشري: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ *}[البلد: 4].
والجهاد من مطالب الحياة وضروراتها معاً؛ إذ الإسلام لم يشرعه إلا دفاعاً عن النفس، وتأميناً للدعوة، ودرءاً للفتنة، وإنقاذاً للمستضعفين، وتأديباً للناكثين.
وفي هذه الأمور الثلاثة ـ السفر، والمرض، والجهاد ـ قرر الإسلام تيسيرات شتى:
من رخص الصلاة:
فجعل للمسافر في الصلاة القصر: يصلي الرباعية ـ كالظهر، والعصر، والعشاء ـ ركعتين فقط، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
ورخص له في الجمع بين الصلاتين ـ الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ـ فأجاز جمعهما في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، كما رخص للمريض أن يصلي قاعداً، أو مضطجعاً على جنبه، أو مستلقياً على ظهره حسب استطاعته، وليس على المريض حرج، وفي (الطهارة) ـ التي هي شرط لصحة الصلاة ـ رخص لمن يتعذر عليه استعمال الماء من مريض، أو مسافر، أو نحوهما أن يترك الوضوء إلى التيمم بالصعيد الطيب من رملٍ، أو ترابٍ، أو حجرٍ، أو نحوه تيسيراً من الله، ورحمة بعباده:
قال تعالى:{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *}[المائدة:6].
وقد ذكر القرآن هذا الحكم أيضاً، في سورة النساء قائلاً: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا *}[النساء:43 ].
وفي هذه الآيات يتبيَّن للمسلم: أن هذه الرخص في العبادات مظهر يتجلَّى الله فيه بأسمائه: (العفو، الغفور، الكريم، الرحيم، الذي يريد أن يطهر عباده، ويتم عليهم النعمة) .
وهذا دليل على وسطيَّة القرآن في العبادات.
من رخص الجهاد:
وفي الجهاد شرع الله صلاة الحرب، أو الخوف، وجعلها في الرباعية (ركعة واحدة) تيسيراً، وإعانة لهم على عدوهم وعند التحام الصفوف قبل الله منهم الصلاة كيفما استطاعوا: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}[البقرة:239 ].
فلا يشترط فيها ركوع، ولا سجود، ولا استقبال قبلة.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرِّقون بين الصلاة، والجهاد، فتلك عمود الإسلام، وهذا ذروة سنامه، وقد فرض الله على المجاهدين أن يحملوا أسلحتهم، ويأخذوا حذرهم، وهم بين يديه خاشعون، ولربهم مبتهلون مناجون: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً}[النساء: 102].
رخص الصيام:
وفي صيام رمضان رخَّص المولى ـ عز وجل ـ للمسافر في الإفطار،بل أوجبه عليه إذا كان في صومه مشقة ظاهرة عليه، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البرِّ الصَّوم في السفر».
وبذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة: أن الصيام إذا أتعب صاحبه، وأجهده لا يجوز له الصيام.
وكذلك رخص للمريض بالفطر في رمضان، ويقضي هو والمسافر عدَّةً من أيام أخر، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ آخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: 185].
ورخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين بالفطر في الصيام عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فصام؛ حتى بلغ الكَدِيْدَأفطر، فأفطر الناس».
ومبدأ التخفيف والتيسير في العبادة من أجل المرض، والسفر، والجهاد مبدأٌ نزل به القرآن منذ مطلع فجر الإسلام في مكة، ففي سورة المزمل قال تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ}[المزمل:20].
وبهذا يتَّضح للقارئ الكريم عظمة المنهج الرباني، ووسطيته في كافة المجالات التشريعية من عقائد، وأخلاق، وعبادة، وحرصه على رفع الحرج، وتيسير الأمور، وتسهيلها على الناس. والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/29.pdf
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي: