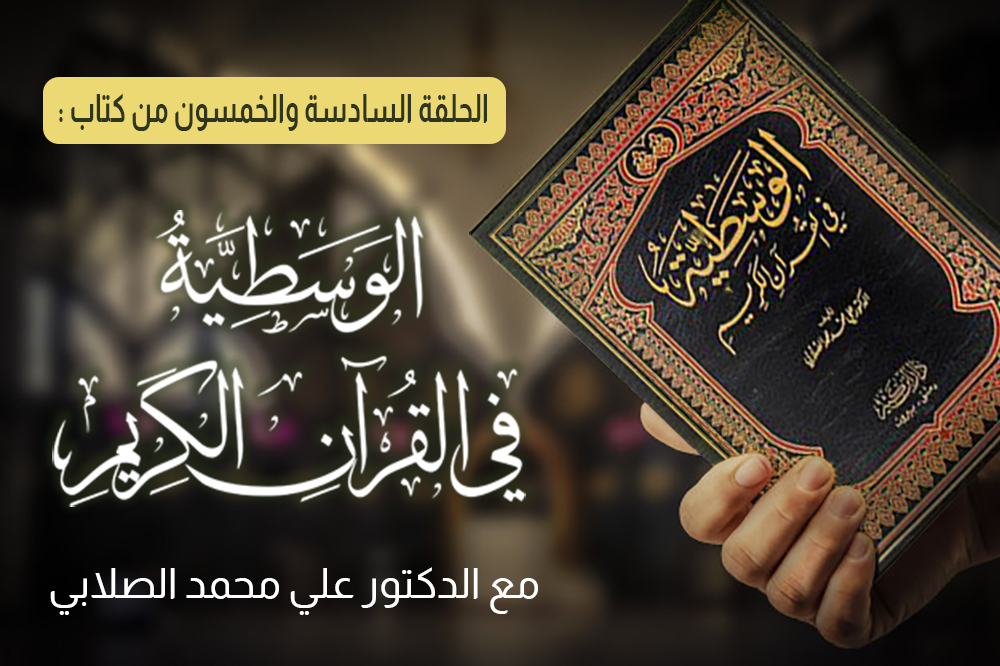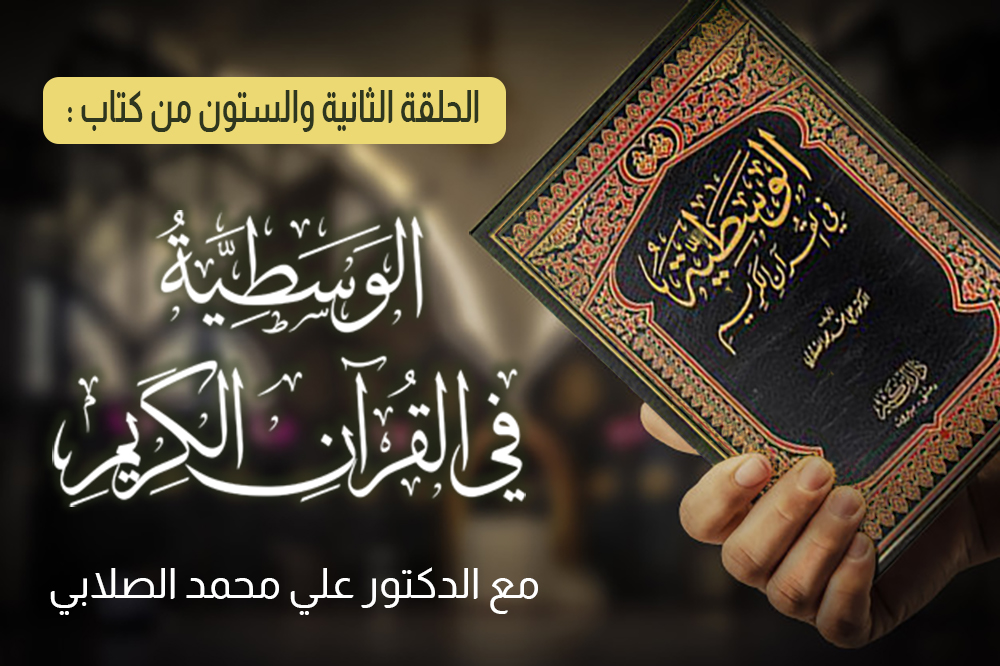من كتاب الوسطية في القرآن الكريم:
(شروط قبول العبادة في القرآن الكريم)
الحلقة: السادسة والخمسون
بقلم: د. علي محمد الصلابي
جمادى الأولى 1442 ه/ ديسمبر 2020
من وسطيَّة القرآن الكريم بيانه لشروط قبول الأعمال، وجاءت الايات، والأحاديث النبوية التي رسمت هذه الشروط وأصَّلتها، وجعلتها في شرطين اثنين، هما: أولاً: الإخلاص، وثانياً: المتابعة. وبينت الايات، والأحاديث ضرورة توفر الشرطين في قبول أيِّ عمل:
الشرط الأول: الإخلاص:
وهذا الشرط متعلق بالإرادة، والقصد، والنية، والمقصود به: (إفراد الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بالقصد، والطاعة).
والنية تقع في كلام العلماء بمعنيين، كما قرر ذلك ابن رجب، فقال: (أحدهما: تميز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن العصر مثلاً... إلى أن قال: والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له، أم لله وغيره، وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف المتقدِّمين...).
والأدلة على هذا الأصل في القرآن، والسنة، وكلام السلف، ومن سار على نهجهم كثيرة. فمن القرآن قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ *أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ *}[الزمر: 2 ـ 3].
قال ابن كثير: (أي: لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له).
وقوله عز وجل: {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ *وَأُمِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ *قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي *}[الزمر: 11 ـ 14] وقوله تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ *}[الأعراف:29].
قال ابن كثير: (أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محلِّها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله، وجاؤوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة، وأن يكون خالصاً من الشرك).
وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [النساء: 125 ]قال ابن القيم: (فإسلام الوجه: إخلاص القصد، والعمل لله...).
ومن الأحاديث النبوية:
1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه».
قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرحه لهذا الحديث: (...فهذا يأتي على كل أمر من الأمور... وهو أنَّ حظ العامل من عمله نيته.. وأنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيراً؛ حصل له خير، وإن نوى شرّاً؛ حصل له شر... وهاتان كلمتان جامعتان، وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء...).
وقال الشوكانيرحمه الله في مقدِّمة أدب الطالب عند ذكره لهذا الحديث: (...حصول الأعمال، وثبوتها لا يكون إلا بنية، فلا حصول، أو لا ثبوت لما ليس كذلك، فكل طاعة من الطاعات، وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية؛ لا اعتداد بها، ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية؛ فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث، واللعب...).
2 ـ وفي الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يَغُلُّ عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم...».
قال ابن القيم: (أي: لا يبقى فيه غلٌّ، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله، وتنقيه منه، وتخرجه عنه، فإن القلب يغلُّ على الشرك أعظم غِلٍّ، وكذلك يغل على الغش، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة، والضلالة، فهذه الثلاثة تملؤه غلاً، ودغلاً. ودواء هذا الغل، واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص، والنصح، ومتابعة السنة).
وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري؛ فهو للذي أشرك فيه، وأنا منه بريء».
وعن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر؛ ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا شيء». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً، وابتُغي به وجهه».
وعن معاذ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسَرَ الشريك، واجتنب الفساد في الأرض؛ فإن نومه، ونُبْهَهُ أجرٌ كله، وأما من غزا فخراً، ورياء، وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض؛ فإنه لن يرجع بالكفاف».
وعنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من طلب العلم؛ ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه؛ أدخله الله في النار».
وفي حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به، فعرَّفه نعمته، فعرفها. قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت! قال: كذبت، ولكنك قاتلت؛ لأن يقال جريءٌ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم، وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به، فعرَّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت، ولكنك تعلمت، ليقال: عالم، وقرأت القرآن ؛ ليقال: قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار، ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرَّفه نعمه، فعرفها. قال: فما علمتَ فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك! قال: كذبت، ولكنك فعلت؛ ليقال: جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار».
وأما ما ورد عن السلف في الإخلاص؛ فهو كثير وفير، وإليك قليل من أقوالهم:
1 ـ عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ قالا: (لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول، وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة).
2 ـ وعن أبي العاليةقال: (كنا نتحدث منذ خمسين سنة: أن الأعمال تعرض على الله تعالى ما كان له منها؛ قال: هذا لي، وأنا أجزي به، وما كان لغيره؛ قال: اطلبوا ثواب هذا ممَّن عملتم له).
3 ـ وعن مُطَرِّف بن عبد الله: أنه قال: (صلاح القلب، بصلاح العمل، وصلاح العمل، بصحَّة النية).
4 ـ وعن يحيى بن أبي كثير: أنه قال: (تعلموا النية، فإنها أبلغ من العمل).
5 ـ ومما روي عن الفضيل بن عياض: أنه تلا قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [تبارك: 2] فقال: (أخلصه، وأصوبه، قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه، وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاً، ولم يكن صواباً؛ لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يقبل؛ حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة).
الشرط الثاني في قبول العبادة:
الموافقة للشرع: وهذا الشرط تعلق بالعمل سواء كان عمل القلب، وهو ما يسمى بالاعتقاد، أو عمل الجوارح. وهذان هما مدار العبادة، ومحل الإيمان الذي هو اعتقادٌ بالجنان، ونطق باللسان وعمل الأركان، فلابد من متابعة الشرع والانقياد له في أعمال القلوب كالحب والبغض، وفي أعمال الجوارح، التي يتعبد بها الإنسان.
وسوف أذكر بعض الأدلة على هذا الأصل من الكتاب، والسنة، وكلام السلف.
أما الأدلة من القرآن فكثيرة منها:
1 ـ قوله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *}[الأنعام:153].
2 ـ وقوله سبحانه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}[المائدة:3].
3 ـ وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً *}[النساء:125].
ومن السنة:
1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسوله».
2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».
3 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد».
4 ـ وعن العرباض بن ساريةـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك».
من كلام السلف عليهم رضوان الله:
1 ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: (إنا نقتدي، ولا نبتدي، ونتبع، ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر).
2 ـ وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: (إنا ناساً يجادلونكم بشبه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل).
3 ـ وعن مُطَرِّف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغين في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ: (سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، عز وجل، واستكمال لطاعة الله، عز وجل، وقوة على دين الله، تبارك وتعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها، واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله تعالى ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيراً).
وقد ورد عن السلف من هذا القبيل كثير، وفي هذا القليل الذي ذكرناه ما يسدُّ حاجة الاستدلال هنا.
وبعد ذكر شَرطي العبادة المقبولة عند الله ـ سبحانه وتعالى ـ يتبين: أن (...دين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل..).
وهذان الأصلان هما من حقيقة كلمة التوحيد، والركن الأول من هذا الدين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام حين قال: (ودين الإسلام مبنيٌّ على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلهاً اخر...).
الأصل الثاني: (أن نعبده بما شرع على لسانِ رسله...).
(وبالجملة، فمعناه أصلان عظيمان، أحدهما: ألا نعبد إلا الله، والثاني: أّلا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بعبادة مبتدعة).
إن الغاية من خلق الإنسان وكتابة الموت والحياة عليه واضح في قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [تبارك: 2] والأحسن عملاً يتضمن أمرين، كما فسر ذلك الفضيل بن عياض ـ
رحمه الله ـ عندما قال: (أحسنه؛ أي: أخلصه، وأصوبه). فأخلصه هو (لا إله إلا الله). وأصوبه هو (محمد رسول الله) وهو الذي أشارت إليه سورة الفاتحة أمُّ القرآن الكريم: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *}[الفاتحة: 6 ـ 7].
والذين أنعم الله عليهم هم الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ والذين ساروا على هذا {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *}، أي: الصواب الموصل للغاية وهذا الطريق وسط بين طريقين.
وبهذا يتضح فساد طريق العبَّاد الروحانيين من نصرانية محرفة، أو شعوذة، أو صوفية باطلة، أساسها الجهل، فزاغت عن الطريق، وتجنبت الإصابة المنشودة؛ وإن صلحت نياتهم ومقاصدهم، وخلوصهم من كل شائبة شركٍ لأحدٍ اخر، إلا أنهم ابتعدوا عن المنهج الرباني المرسوم في قبول العبادة.
وكذلك يتضح فساد طريق علماء السوء، الذين أخطؤوا الغاية من العلم، فما صلحت غايتهم؛ وإن كانوا على بينة من الطريق، لكن أعينهم تنظر إلى غاية أخرى يتلمسوها على جنبات الطريق، ففقدوا التثمير، والإخلاص المقصود والمنشود، فسقطوا دون الغاية الكبرى المتعبدين بالسير نحوها. ويذكر عادة كمثال لهؤلاء السالكين اليهود؛ الذين غضب الله عليهم، لتنكبهم الصراط المستقيم عن علم.
أما الوسط؛ فهو الصراط المستقيم الذي هو عين الوسطيَّة، وبذلك يتضح: أن شَرطي قبول العبادة دليل على وسطيَّة القرآن في باب العبادة.
يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي: