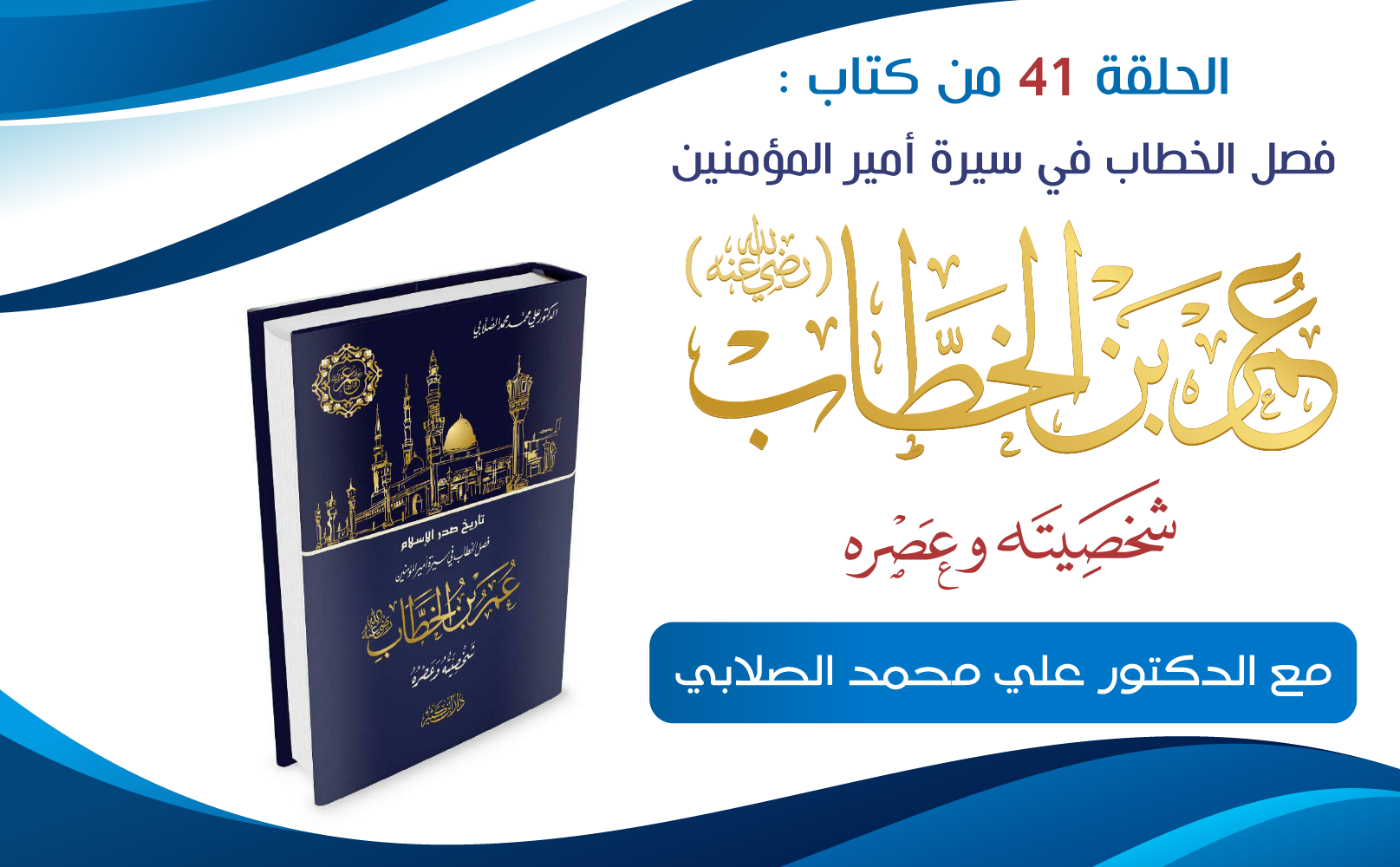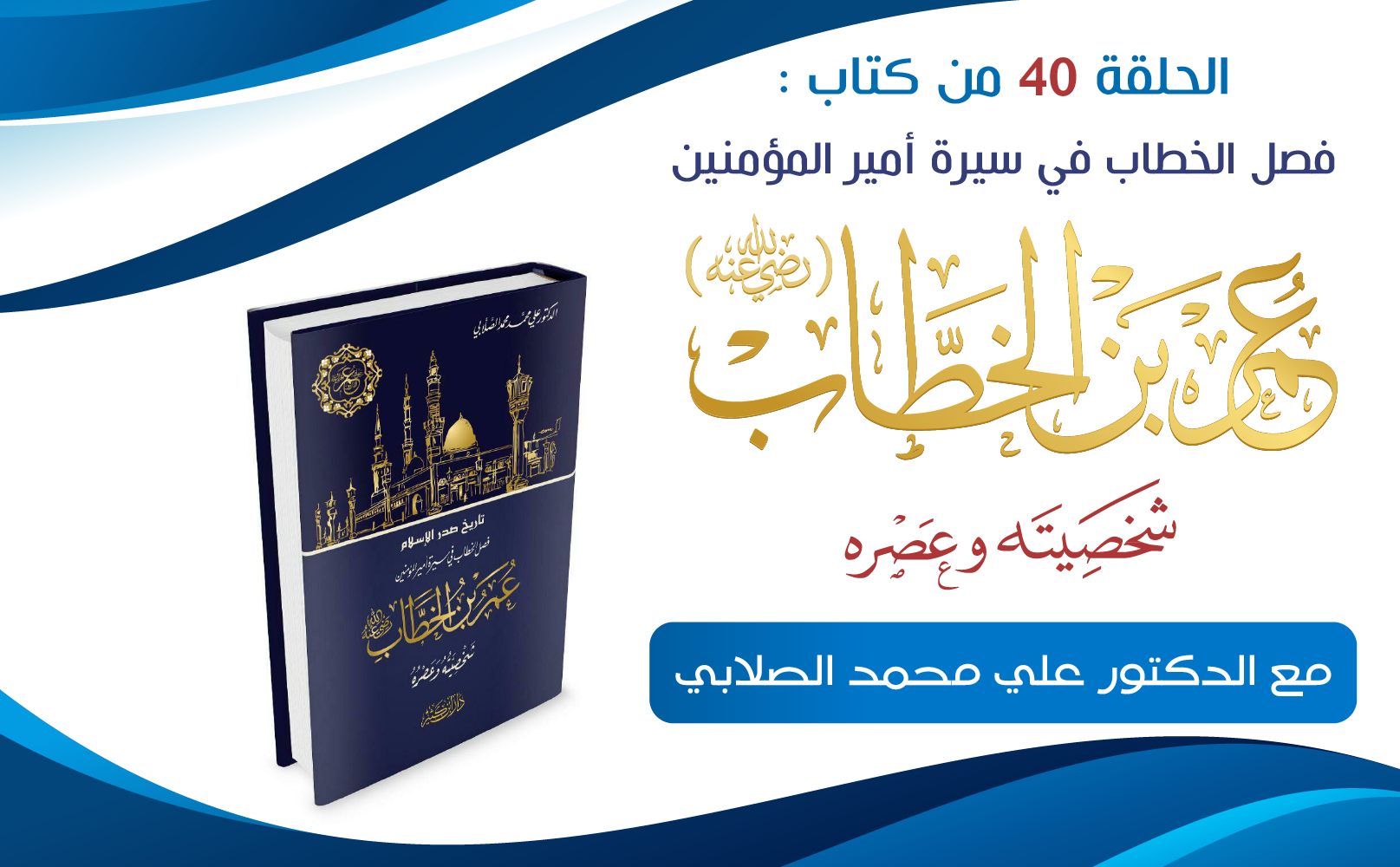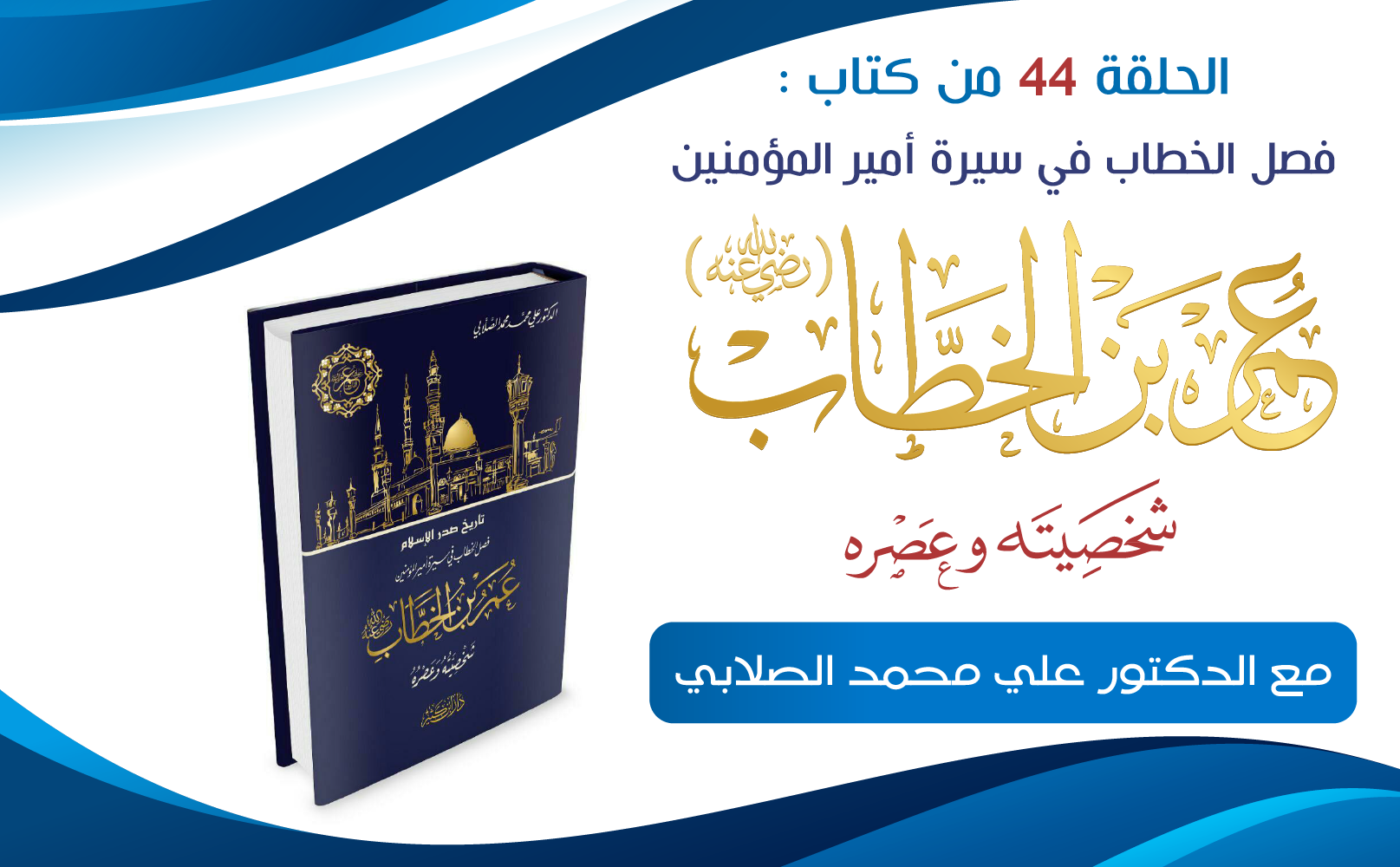خشية الفاروق رضي الله عنه على المسلمين من الدُّخول في حياة التَّرف، والنَّعيم؛ نصائح من جوهر الفهم السليم للقرآن الكريم والسنة المطهرة
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة الثانية والأربعون
كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يخشى على المسلمين الدُّخول في حياة التَّرف، والنَّعيم، وما يترتَّب على ذلك من نتائج سيئةٍ في الدُّنيا، والاخرة، فعندما نزل أهل الكوفة، واستقرَّت بأهل البصرة الدَّار عرف القوم أنفسهم وثاب إِليهم ما كانوا فقدوا، ثمَّ إِنَّ أهل الكوفة استأذنوا في بنيان القصب، واستأذنه فيه أهل البصرة، فقال عمر: العسكر أحَدُّ لحربكم، وأذكى لكم، وما أحبُّ أن أخالفكم، وما القصب ؟ قالوا: العِكرش إِذا رَوِي قصَّب فصار قصباً. قال: فشأنكم. فابتنى أهل المِصْرَيْنِ بالقَصَب.
ثمَّ إنَّ الحريق وقع بالكوفة, والبصرة, وكان أشدَّهما حريقاً الكوفة, فاحترق ثمانون عريشاً, ولم يبق فيها قصبة شوال, فما زال النَّاس يذكرون ذلك, فبعث سعد منهم نفراً إلى عمر يستأذنونه في البناء باللَّبِن, فقدموا عليه بالخبر عن الحريقة ما بلغ منهم, وكانوا لا يدعون شيئاً ولا يأتونه إلا وآمروه فيه (يعني شاوروه) فقال: افعلوا, ولا يزيدنَّ أحدكم على ثلاثة أبياتٍ (يعني: غرف) ولا تطاولوا في البنيان, والزموا السُّنَّة تلزمكم الدَّولة, فرجع القوم إلى الكوفة بذلك, وكتب عمر إلى عتبة, وأهل البصرة بمثل ذلك. قال: وعهد عمر إلى الوفد, وتقدَّم إلى النَّاس ألا يرفعوا بنياناً فوق القدر, قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم في السَّرف, ولا يخرجكم من القصد.
هذا ومن استعراض هذا الخبر يتبيَّن لنا: أنَّ أولئك القوم كانوا زاهدين في مظاهر الدُّنيا, فهم يريدون من المساكن ما يكنُّهم من الشَّمس, والمطر, والبرد, والحرِّ, ولا يهمُّهم التمتُّع بالقصور, والبيوت العالية, ولذلك اختاروا التَّعريش بالقصب الَّذي كان أيسر الأشياء لديهم؛ حتَّى اضطرُّوا إلى البناء بالطِّين, ومع ذلك نجد عمر ـ رضي الله عنه ـ يضع لهم الاحتياطات اللازمة لمنع التنافس, والتَّطاول في البنيان.
وهذا إدراك يعيد المدى لما يتوقع أن تكون عليه الأمة من الغنى بعد الفتوح, فهو يحاول في هذا التَّوجيه وأمثاله أن يحدَّ من اندفاع الأمَّة نحو الإسراف والتَّرف, وأن يحملها على حياة القصد, والاعتدال, ومن كلام عمر ـ رضي الله عنه ـ السَّابق يتبيَّن لنا: أنَّ المقصود بالبناء الَّذي لا خير فيه ما قرب من الإسراف, وأخرج عن القصد, والاعتدال, وإنَّ من أعظم مظاهر الإسراف التَّطاول في البنيان, وذلك لأنَّ البنيان يستهلك من الإنسان مالاً كثيراً, ووقتاً طويلاً, فإذا انصرف له الإنسان بالاهتمام؛ استحوذ على تفكيره حتَّى يبقى هو الهمُّ الأكبرُ عند بعض النَّاس, ولئن كان ما يخشاه عمر ـ رضي الله عنه ـ من الانفتاح الدُّنيوي في عهده, ويحاول أن يحجز الأمَّة عن التوغُّل فيه من ناحية البناية لا يعدو أن يكون بناءً محدوداً ينتهي إعداده في أمدٍ قصير, فإِنَّ إعداد البناءِ في عصرنا هذا يستغرق سنواتٍ من العمر, ثم قد يعقبه في أحوالٍ كثيرة ديونٌ متراكمة يظلُّ صاحبها يجمع فضول أمواله لسدادها.
وقد يمرُّ عليه سنون من عمره وهو لا يعرف عن الزَّكاة شيئاً, مع أنَّه يعتبر من المتوسطين في الغنى الَّذين هم غالبية النَّاس, لأنَّ القصور الَّتي تعارف أكثر الناس عليها تتطلَّب أنواعاً عاليةً من الأثاث, والكماليات؛ الَّتي ترهق طالبها, وتجعله يظلُّ يلاحق أنفاسه سنواتٍ علَّه يصل إلى ما تصبو إليه نفسه من مُشاكلة النَّاس في مظاهر الحياة الدُّنيا, وفي خضمِّ هذا التَّنافس تضيع أحياناً بعض مطالب الإسلام الحيوبَّة من العبادات الماليَّة الَّتي على رأسها الزَّكاة, والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله تعالى, كما أنَّه قد ينشغل فكر الإنسان أحياناً عن الأمور المهمَّة كالصَّلاة وطلب العلم.
ـ قول عمر: ما لا يقرِّبكم من السَّرف, ولا يخرجكم من القَصْد:
يعني: أنَّ حدود البناء المشروع ما لا يقرِّب صاحبه من الإسراف, وهو مجاوزة الحدِّ المشروع, ولا يخرجه عن حدِّ الاعتدال, وقد ترك عمر ـ رضي الله عنه ـ تحديد ذلك لهم؛ لأن لكلِّ بلدٍ عرفاً خاصاً يتحدَّد به الإسراف والاعتدال, والتقتير، فالقصد إذاً يحدِّده العُرْفُ السَّائد في البلد لدى أوساط النَّاس من أهل الاستقامة بالاعتدال في الأمور الدنيويَّة.
ـ قوله: الزموا السُّنَّة تلزمكم الدَّولة:
يعني أنَّ الالتزام بالطَّريق المستقيم الّذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سببٌ في الإدالة على النَّاس, والتمكين في الأرض، كما جاء في قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 55].
لقد كان هذا التَّزهيد من عمر ـ رضي الله عنه ـ في مظاهر الدُّنيا مع أنَّ المسلمين آنذاك كانوا يتنافسون في هذا الزُّهد, فكيف بمن جاؤوا بعدهم على مرِّ العصور ممَّن يتنافسون على مظاهرِ الدُّنيا؟ هذا ولقد كان أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ حريصاً على علاج أمر الانفتاح المادِّي الَّذي كان في عصره حيث فُتحت بلاد الفرس وأجزاءٌ من بلاد الرُّوم, فأفاء الله تعالى على المسلمين من غنائم الفتوح, وفيء البلاد, وخراجها أموالاً عظيمةً, ولقد خطب أمير المؤمنين خطبةً بليغةً شخَّص فيها ذلك الموقع, وأرشد المسلمين إلى السُّلوك الأمثل.
لقد قال رضي الله عنه: إنّض الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشُّكر, واتَّخذ عليكم الحجَّة فيما آتاكم من كرامة الآخرة, والدُّنيا, عن غير مسألةٍ منكم له, ولا رغبةٍ منكم فيه إليه, فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه, وعبادته, وكان قادراً أن يجعلكم لأهون خلقه عليه, فجعل لكم عامَّة خلقه, ولم يجعلكم لشيءٍ غيره, وسخَّر لكم ما في البرِّ, والبحرِ, ورزقكم من الطَّيبات لعلَّكم تشكرون. ثمَّ جعل لكم سمعاً, وبصراً.
ومن نعم الله عليكم نعمٌ عمَّ بها بني آدم, ومنها نعمٌ اختصَّ بها أهل دينكم, ثمَّ صارت تلك النِّعم خواصُّها وعوامُّها في دولتكم، وزمانكم، وطبقتكم، وليس من تلك النِّعم نعمةٌ وصلت إِلى امرىءٍ خاصَّة إِلا لو قسم ما وصل إِليه منها بين النَّاس كلِّهم؛ أتعبهم شكرُها، وفدحهم حقُّها إِلا بعون الله مع الإِيمان بالله ورسوله، فأنتم مستخلفون في الأرض، قاهرون لأهلها، قد نصر الله دينكم، فلم تصبح أمَّةٌ مخالفةً لدينكم إِلا أمَّتان، أمَّة مُسْتَعْبَدَةٌ للإِسلام وأهله، يجزون لكم، يُستصفَوْن معايشهم، وكدائحهم ورشح جباههم، عليهم المؤونة ولكم المنفعة، وأمَّة تنتظر وقائع الله، وسطواته في كلِّ يومٍ وليلةٍ، قد ملأ الله قلوبهم رعباً، فليس لهم معقلٌ يلجؤون إِليه، ولا مهرب يتَّقون به، قد دهمتهم جنود الله ـ عزَّ وجل ـ ونزلت بساحتهم مع رفاغةالعيش، واستفاضة المال، وتتابع البعوث، وسدِّ الثُّغور بإِذن الله، مع العافية الجليلة العامَّة الَّتي لم تكن هذه الأمَّة على أحسن منها مذ كان الإِسلام، والله المحمود مع الفتوح العظام في كل بلد. فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشَّاكرين، وذكر الذَّاكرين، واجتهاد المجتهدين، مع هذه النِّعم الَّتي لا يحصى عددها، لا يقدر قدرها، ولا يستطاع أداء حقِّها إِلا بعون الله ورحمته ولطفه، فنسأل الله الَّذي لا إِله إِلا هو الَّذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته، والمسارعة إِلى مرضاته، واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم، واستتمُّوا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم مثنى، وفرادى، فإِنَّ الله عز وجل قال لموسى: {أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} [إبراهيم: 5]. وقال لمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ} [الأنفال: 26].
فلو كنتم مستضعفين محرومين خير الدُّنيا على شعبة من الحقِّ، تؤمنون بها، وتستريحون إِليها، مع المعرفة بالله ودينه، وترجون بها الخير فيما بعد الموت؛ لكان ذلك، ولكنَّكم كنتم أشدَّ الناس معيشةً، وأثبتهم بالله جهالةً، فلو كان هذا الذي استشلاكم به لم يكن معه حظٌّ في دنياكم، غير أنَّه ثقةٌ لكم في اخرتكم؛ الَّتي إِليها المعاد، والمنقلب، وأنتم من جهد المعيشة ما كنتم عليه أحرياء أن تشحُّوا على نصيبكم منه، وأن تظهروا على غيره قَبْلَه؛ ما إِنَّه قد جمع لكم فضيلة الدُّنيا، والاخرة، ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم، فأذكركم الله الحائل بين قلوبكم إِلا ما عرفتم حقَّ الله، فعملتم له، وقسرتم أنفسكم على طاعته، وجمعتم مع السُّرور بالنِّعم خوفاً لها، ولانتقالها، ووجلاً منها، ومن تحويلها، فإِنَّه لا شيء أسلبُ للنِّعمة من كفرانها، وإن الشكر أمن للغير، ونماء للنعمة، واستيجاب للزِّيادة، هذا لله عليَّ من أمركم، ونهيكم واجبٌ.
للاطلاع على النسخة الأصلية للكتاب راجع الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي، وهذا الرابط:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book172(1).pdf