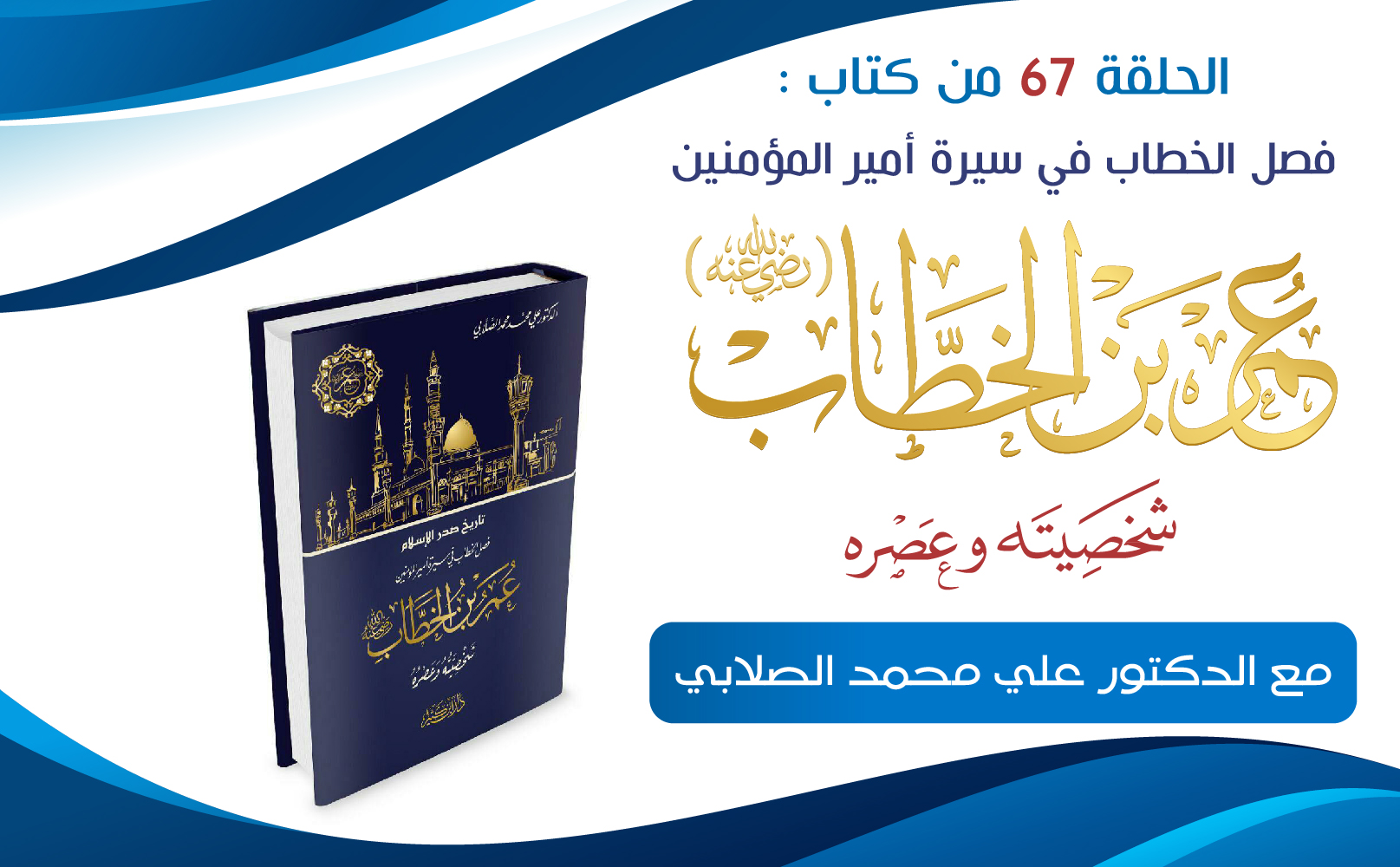تأمير سعد بن أبي وقّاص على العراق وبدايات الإستعداد لمعركة القادسية؛ وصايا، رسائل، وأحداث
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة الثامنة والستون
لمَّا علم الفاروق: أنَّ الفرس يعدُّون العدَّة، ويتجمَّعون لاستئصال القوَّة القليلة من المسلمين المتبقِّية في العراق؛ أمر بالتَّجنيد الإِجباري؛ ذلك: أنَّ الحالة تقتضي ذلك، ولذلك أمر المثنَّى أن ينظر فيما حوله من القبائل ممَّن يصلح للقتال، ويقدر عليه، فيأتي به طائعاً، أو غير طائعٍ، وهذا هو التَّجنيد الإِجباري؛ الذي راه عمر، وكان أوَّل من عمل به في الإِسلام، وبهذا يسقط ما قاله محمَّد فرج: صاحب كتاب (العسكرية الإِسلاميَّة) من أنَّ التَّجنيد الإِجباري ظهر في الدَّولة الأمويَّة، فها هو عمر الفاروق قد أمر به، ونُفِّذ الأمر، فما وصل كتاب أمير المؤمنين للمثنَّى إِلا وبدأ بتنفيذ ما فيه على الفور، وطبق الخطَّة الَّتي رسمها له في تحرُّكاته، وأرسل الفاروق إِلى عمَّاله ألا يدعوا أحداً له سلاحٌ، أو فرسٌ، أو نجدةٌ، أو رأي إِلا أرسلوه إِليه، يأمرهم بالتَّجنيد الإِجباري، ويطلب منهم أن يرسلوا المجنَّدين الجدد إِليه؛ ليرسلهم إِلى العراق، لقد تغيَّر الموقف في بلاد فارس مع مجيء يزدجرد للحكم فقد تغيَّر موقف الفرس كالتَّالي:
_خ استقرارٌ داخليٌّ تمثَّل في تنصيب يزدجرد، واجتماعهم عليه، واطمأنَّت فارس، واستوثقوا، وتبارى الرُّؤساء في طاعته، ومعونته.
_خ تجنيدٌ عامٌّ شمل كلَّ ما استطاع الفرس أن يجنِّدوه، وتوزيع الفرق في كلِّ أنحاء الأراضي الَّتي فتحها المسلمون.
_خ وأخيراً إِثارة السُّكان، وتأليبهم على المسلمين، حتَّى نقضوا عهدهم، وكفروا بذمَّتهم، وثاورا بهم.
وتغيَّر موقف المسلمين، وأصبح كالتَّالي:
_خ الانسحاب: خروج المثنَّى، والقوَّاد الاخرين على حاميتهم من الأرض الَّتي فتحوها من بين ظهراني العجم.
_خ التَّراجع: والتَّفرُّق في المياه الَّتي تلي الأعاجم على حدود الأرض العربيَّة، والأرض
الفارسيَّة، وقد نزل المثنَّى في ذي قار، ونزل النَّاس الطَّفَّ، فشكَّلوا في العراق مسالح ينظر بعضهم إِلى بعضٍ، ويغيث بعضهم بعضاً عند الحاجة.
_خ مقابلة التَّجنيد الإِجباري عند الفرس بالتَّجنيد الإِجباري لدى المسلمين.
وهذه المرحلة الثَّالثة في فتوحات العراق تبدأ بتأمير سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ على الجهاد في العراق سنة 14هـ، فقد استهلَّت هذه السَّنة الرَّابعة عشرة وعمر ـ رضي الله عنه ـ يحثُّ النَّاس، ويحرِّضهم على جهاد الفرس، وركب ـ رضي الله عنه ـ أوَّل يومٍ من المحرَّم في هذه السَّنة في الجيوش من المدينة، فنزل على ماءٍ يقال له: صِرَار، فعسكر به عازماً على غزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة عليَّ بن أبي طالب، واستصحب معه عثمان بن عفَّان، وسادات الصَّحابة، ثمَّ عقد مجلساً لاستشارة الصَّحابة فيما عزم عليه، ونودي: الصَّلاة جامعة، وقد أرسل إِلى عليٍّ، فقدم من المدينة، ثمَّ استشارهم، فكلُّهم وافقوه على الذَّهاب إِلى العراق إِلا عبد الرحمن بن عوف، فإِنَّه قال له: إِني أخشى إِن كُسرتَ أن يضْعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإِنِّي أرى أن تبعث رجلاً، وترجع أنت إِلى المدينة، فاستصوب عمرُ والنَّاسُ عند ذلك رأي ابن عوف. فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إِلى العراق ؟ فقال: قد وجدته. قال: ومن هو ؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزُّهري، فاستجاد قوله، وأرسل إِلى سعدٍ، فأمَّره على العراق.
1 ـ وصيَّةٌ من عمر لسعدٍ رضي الله عنهما:
لمَّا قدم سعد إِلى المدينة أمَّره عمر ـ رضي الله عنهما ـ على حرب العراق، وقال له: يا سعد بني وُهَيب ! لا يغرنَّك من الله أن قيل: خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإِنَّ الله ـ عَزَّ، وجَلَّ ـ لا يمحو السَّيِّأى بالسَّيِّأى، ولكنَّه يمحو السَّيِّأى بالحسن، فإِنَّ الله تعالى ليس بينه وبين أحدٍ نسبٌ إِلا طاعته، فالنَّاس شريفهم، ووضيعهم في ذات الله سواءٌ، الله ربُّهم، وهم عباده يتفاضلون بالعافية، ويدركون ما عنده بالطَّاعة، فانظر الأمر الَّذي رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عليه منذ بُعث إِلى أن فارقنا؛ فالزمْه؛ فإِنَّه الأمر. هذه عظتي إِيَّاك إِن تركتها، ورغبت عنها؛ حبط عملك، وكنت من الخاسرين.
وإِنَّها لموعظةٌ بليغةٌ من خليفةٍ راشدٍ عظيمٍ، فقد أدرك عمر ـ رضي الله عنه ـ جانب الضَّعف؛ الذي يمكن أن يؤتى سعد من قبله، وهو أن يُدلي بقرابته من النَّبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله ذلك على شيءٍ من الترفُّع على المسلمين، بالمبدأ الإِسلامي العامِّ؛ الذي يعتبر مقياساً لكرامة المسلم في هذه الحياة، حيث قال: الله ربُّهم، وهم عباده، يتفاضلون بالعافية؛ ويدركون ما عنده بالطَّاعة. فقوله: يتفاضلون بالعافية: يعني: بالشِّفاء من أمراض النُّفوس، فكأنَّه يقول: يتفاضلون بالبعد عن المعاصي، والإِقبال على طاعة الله تعالى. وهذه هي التَّقوى الَّتي جعلها الله سبحانه ميزاناً للكرامة بقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، وهو ميزانٌ عادلٌ رحيمٌ بإِمكان كلِّ مسلمٍ بلوغه إِذا جَدَّ في طلب رضوان الله تعالى، والسَّعادة الأخروية، ثمَّ ذكَّره عمر في اخر الموعظة بلزوم الأمر الَّذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الالتزام بالدِّين كلِّه، وتطبيقه على النَّاس.
2 ـ وصيةٌ أخرى:
ثمَّ إِنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ أوصى سعد بن أبي وقَّاص مرَّةً أخرى لمَّا أراد أن يبعثه بقوله: إِنِّي قد وَلَّيتك حرب العراق، فاحفظ وصيَّتي، فإِنَّك تقدم على أمرٍ شديدٍ كريهٍ لا يخلص منه إِلا الحقُّ، فعوِّد نفسك، ومن معك الخير، واستفتح به، واعلم: أنَّ لكلِّ عادةٍ عتاداً، فعتاد الخير الصَّبر، فالصَّبر على ما أصابك، أو نابك، تجتمع لك خشيةُ الله، واعلم: أنَّ خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته، واجتناب معصيته، وإِنَّما أطاعه من أطاعه ببغض الدُّنيا، وحبِّ الاخرة، وعصاه من عصاه بحبِّ الدُّنيا، وبغض الاخرة، وللقلوب حقائق ينشئها الله إِنشاءً، منها السِّرُّ، ومنها العلانية، فأمَّا العلانية؛ فأن يكون حامده، وذامُّه في الحقِّ سواءً، وأمَّا السِّرُّ فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه، وبمحبَّة النَّاس، فلا تزهد في التحبُّب، فإِنَّ النَّبيِّين قد سألوا محبَّتهم، وإِنَّ الله إِذا أحبَّ عبداً حبَّبه، وإِذا أبغض عبداً بغَّضه، فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند النَّاس، ممَّن يشرع معك في أمرك.
وفي هذا النَّصِّ عبرٌ نافعةٌ، منها:
ـ إِنَّ لزوم الحقِّ يخلِّص المسلم من الشَّدائد، وذلك أنَّ من لزم الحقَّ كان مع الله تعالى، ومن كان مع الله تعالى؛ كان الله معه ـ جلَّ، وعلا ـ بنصره، وتأييده، وإِنَّ هذا الشُّعور ليعطي المسلم دفعاتٍ قويَّةً نحو مضاعفة العمل، ومواجهة الصِّعاب، والمازق، إِضافةً إِلى الطُّمأنينة النَّفسيَّة الَّتي يتمتَّع بها من لزوم الحقِّ قولاً وعملاً، بخلاف من حاد عن طريق الحقِّ، فإِنَّه يشعر بالقلق، والالام المتعدِّدة؛ الَّتي منها تأنيب الضَّمير، والخوف من محاسبة النَّاس، والدُّخول في مجاهيل المستقبل؛ الَّتي تترتَّب على الانحراف.
ـ وذكر عمر ـ رضي الله عنه ـ أنَّ عدَّة الخير الصَّبر، وذلك أنَّ طريق الخير ليس مفروشاً بالخمائل، بل هو طريقٌ شاقٌّ شائكٌ، يتطلَّب عبوره جهاداً طويلاً، فلا بدَّ لسالكه من الاعتداد بالصَّبر، وإِلا انقطع في أثناء الطَّريق.
ـ وذكر: أنَّ خشية الله تعالى تكون في طاعته، واجتناب معصيته، ثمَّ بيَّن الدَّافع الأكبر الذي يدفع إلى طاعته، ألا وهو: بغض الدُّنيا، وحبُّ الاخرة، والدَّافع الأكبر الَّذي يدفع إِلى معصيته هو حبُّ الدُّنيا، وبغض الاخرة.
ـ ثمَّ ذكر: أنَّ للقلوب حقائق، منها: العلانية، ومثَّل لها بالمعاملة مع النَّاس بالحقِّ في حالي الغضب، والرِّضا، وألا يحمل الإِنسان ثناء النَّاس عليه على مداراتهم في النُّكول عن تطبيق الحقِّ، ولا يحمله ذمُّهم إِيَّاه على ظلمهم، ومجانبة الحقِّ معهم.
ـ وذكر من حقائق القلوب السِّرَّ، وجعل علامته ظهور الحكمة من قلب المسلم على لسانه، وأن يكون محبوباً بين إِخوانه المسلمين، فإِنَّ محبة الله تعالى لعبده مترتبةٌ على محبَّة المسلمين له؛ لأنَّ الله تعالى إِذا أحبَّ عبداً حبَّبه لعباده. فإِذا كان سعد بن أبي وقَّاصٍ المشهود له بالجنَّة بحاجةٍ إِلى هذه الوصيَّة؛ فكيف بنا، وأمثالنا، ونحن ينقصنا الكثير من فهم الإِسلام، وتطبيقه.
3 ـ خطبة لعمر رضي الله عنه:
وسار سعدٌ إِلى العراق ومعه أربعة الاف مجاهدٍ، وقيل: في ستة الافٍ، وشيَّعهم عمر من صرار إِلى الأعوص، ثمَّ قام في النَّاس خطيباً، فقال: إِنَّ الله تعالى إِنَّما ضرب لكم الأمثال، وصرَّف لكم القول؛ ليحيي به القلوب، فإِنَّ القلوب ميِّتةٌ في صدورها حتَّى يحييها الله، مَنْ علم شيئاً؛ فلينتفع به، وإِنَّ للعدل أماراتٍ وتباشير، فأمَّا الأمارات؛ فالحياء، والسَّخاء، والهين، واللِّين، وأمَّا التَّباشير؛ فالرَّحمة، وقد جعل الله لكلِّ أمرٍ باباً، ويسَّر لكلِّ بابٍ مفتاحاً، فباب العدل الاعتبار، ومفتاحه الزُّهد، والاعتبار ذكر الموت بتذكُّر الأموات، والاستعداد له بتقديم الأعمال، والزُّهد أخذ الحقِّ من كلِّ أحدٍ قبله حقٌّ، وتأدية الحقِّ إِلى كلِّ أحدٍ له حقٌّ، ولا تصانع في ذلك أحداً، واكتف بما يكفيك من الكفاف، فإِنَّ من لم يكفه الكفاف لم يغنه شيءٌ، إِنِّي بينكم وبين الله، وليس بيني وبينه أحدٌ، وإِنَّ الله قد ألزمني دفع الدُّعاء عنه، فأنهوا شكاتكم إِلينا، فمن لم يستطع؛ فإِلى مَنْ يبلغناها؛ نأخذ له الحقَّ غير متعتعٍ.
4 ـ وصول سعد إِلى العراق، ووفاة المثنَّى:
سار سعد بجيشه حتَّى نزل بمكانٍ، يقال له: « زرود »، من بلاد نجد، وأمدَّه أمير المؤمنين بأربعة الاف، واستطاع سعد أن يحشد سبعة الاف اخرين من بلاد نجد، وكان المثنَّى بن حارثة الشَّيباني ينتظره في العراق ومعه اثنا عشر ألفاً.
وأقام سعد بزرود استعداداً للمعركة الفاصلة مع الفرس، وانتظاراً لأمر أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وقد كان عمر عظيم الاهتمام بهذه المعركة، لم يدع رئيساً، ولا ذا رأيٍ، ولا ذا شرفٍ، ولا ذا سلطةٍ، ولا خطيباً، ولا شاعراً إِلا رماهم به، فرماهم بوجوه النَّاس وغررهم، وبينما كان سعد مقيماً بجيشه في زرود مرض المثنَّى مرضاً خطيراً، يقول الرُّواة: إِنَّ الجراحة الَّتي جرحها يوم الجسر انتقضت عليه، واستشعر دنو أجله، واشتدَّ وجعه، واستخلف على مَنْ معه بشير بن الخصاصيَّة، وطلب المثنَّى أخاه المعنَّى، وأفضى إِليه بوصيته، وأمره أن يعجل به إِلى سعد، ثمَّ أسلم المثنَّى الرُّوح إِلى بارئها، فانطفأ السِّراج المضيء، وأفلت هذه الشَّمس المشرقة الَّتي ملأت فتوح العراق نوراً، ودفئاً.
وقد جاء في وصيته لسعدٍ: ألا يقاتل عدوَّه، وعدوَّهم ـ يعني: المسلمين ـ إِذا استجمع أمرهم، وملؤهم في عقر دارهم، وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجرٍ من أرض العرب، وأدنى مردةٍ من أرض العجم، فإِن يظهر الله المسلمين عليهم؛ فلهم ما وراءهم، وإِن تكن الأخرى؛ فاؤوا إِلى فئةٍ، ثمَّ يكونون أعلم بسبيلهم، وأجرأ على أرضهم، إِلى أن يردَّ الله الكرَّة عليهم.
فما أشبه لحظات المثنَّى الأخيرة باللَّحظات الأخيرة للخليفة أبي بكرٍ ـ رضي الله عنهما ـ كلاهما ترك الدُّنيا وهو يفكِّر للمسلمين في هذه الفتوح، ويوصي لها. توفِّي أبو بكر وهو يوصي خليفته عمر بندب النَّاس، وبعثهم لفتح العراق، وتوفِّي المثنَّى وهو يورِّث القائد الجديد لحرب العراق سعد بن أبي وقَّاص تجاربه الحربيَّة ضدَّ الفرس، فهو يجود بنفسه، وهو يفكِّر، ويدبِّر، ويوصي سعداً، ولمَّا انتهى إِلى سعدٍ رأي المثنَّى، ووصيته؛ ترحَّم عليه، وأمَّر المعنَّى بن حارثة على عمله، وأوصى بأهل بيته خيراً.
وممَّا يلفت النَّظر في هذا الخبر: أنَّ المثنَّى قد أوصى بزوجته سلمى بنت خصفة التيميَّة إِلى سعد بن أبي وقاص، وحملها معه المعنَّى، ثمَّ خطبها سعد بعد انتهاء عدَّتها، وتزوَّجها، فهل أراد المثنَّى أن يبرَّ زوجته بعد رحيله بضمِّها إِلى بطلٍ عظيمٍ من أبطال الإِسلام، شهد له رسول الله بالجنة ؟ إِنَّه نوعٌ من الوفاء نادر المثال، أم أنَّها كانت ذكيَّةً، وعاقلةً، وقد تكون لديها خبرةٌ من حروب زوجها، فأراد أن ينتفع المسلمون بها ؟ كلُّ ذلك محتملٌ، وهو غيضٌ من فيض مما تحلَّى به ذلك الجيل الرَّاشد من الفضائل، وعظائم الأمور.
وممَّا ينبغي الإِشادة به، والإِشارة إِليه، موقفٌ قام به المعنَّى قبل إِبلاغ هذه الوصيَّة، وذلك أنَّه علم بأنَّ أحد أمراء الفرس وهو الازاذمرد بعث قابوس بن المنذر إِلى القادسيَّة، وقال له: ادع العرب، فأنت على من أجابك، وكن كما كان اباؤك ـ يعني: المناذرة الَّذين كانوا ولاة الفرس ـ فنزل القادسيَّة، وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النُّعمان يكاتبهم به مقاربةً، ووعيداً، فلمَّا انتهى إِلى المعنَّى خبره، أسْرَى المعنَّى من «ذي قار» حتَّى بيَّته، فأنامه، ومن معه، ثمَّ رجع إِلى ذي قار.
5 ـ مسيرة سعد إِلى العراق، ووصيَّة عمر رضي الله عنهما:
جاء الأمر من عمر أمير المؤمنين إِلى سعد بن أبي وقَّاص ـ رضي الله عنهما ـ بالرَّحيل من « زرود » إِلى العراق استعداداً لخوض المعركة الفاصلة مع الفرس، وأوصاه بالوصيَّة التالية: أمَّا بعد فإِنِّي امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كلِّ حالٍ، فإِنَّ تقوى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أفضل العدَّة على العدو، وأقوى العدَّة في الحرب، وامرك ومن معك أن تكونوا أشدَّ احتراساً من المعاصي منكم من عدوِّكم، فإِنَّ ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوِّهم، وإِنَّما ينصر المسلمون بمعصية عدوِّهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوَّةٌ؛ لأنَّ عددنا ليس كعددهم، ولا عدَّتنا كعدَّتهم، فإِذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإِنَّا لا نُنصر عليهم بفضلنا، ولم نغلبهم بقوَّتنا.
واعلموا: أنَّ عليكم في سيركم حفظةً من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله، وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا: إِنَّ عدوَّنا شرٌّ منَّا، ولن يسلَّط علينا وإِن أسأنا، فربَّ قومٍ سُلِّط عليهم شرٌّ منهم، كما سُلِّط على بني إِسرائيل ـ لمَّا عملوا بمساخط الله ـ كفرة المجوس، فجاسوا خلال الدِّيار، وكان وعداً مفعولاً.
واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النَّصر على عدوِّكم، أسأل الله ذلك لنا، ولكم، وترفق بالمسلمين في مسيرتهم، ولا تجشِّمهم مسيراً يتعبهم، ولا تقصِّر بهم عن منزلٍ يرفق بهم حتَّى يبلغوا عدوَّهم والسَّفر لم ينقص قوَّتهم، فإِنَّهم سائرون إِلى عدوٍّ مقيمٍ، جامِّ الأنفس، والكراع، وأقم بمن معك كلَّ جمعة يوماً وليلةً حتَّى تكون لهم راحةٌ، يجمعون فيها أنفسهم، ويَرُمُّون أسلحتهم، وأمتعتهم، ونحِّ منازلهم عن قرى أهل الصُّلح، والذِّمَّة، فلا يدخلها من أصحابك إِلا من تثق بدينه، ولا ترزأ أحداً من أهلها شيئاً، فإِنَّ لهم حرمةً، وذمَّةً، ابتليتم بالوفاء بها، كما ابتلوا بالصَّبر عليها، فما صبروا لكم؛ فوفُّوا لهم، ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصُّلح، وإِذا وطئت أدنى أرض العدوِّ؛ فَأَذْكِ العيون بينك وبينهم، ولا يخف عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئنُّ إِلى نصحه، وصدقه، فإِنَّ الكذوب لا ينفعك خبره، وإن صدق في بعضٍ، والغاشَّ عينٌ عليك، وليس عيناً لك، وليكن منك عند دنوك من أرض العدوِّ أن تكثر الطَّلائع، وتبثَّ السَّرايا بينك وبينهم، فتقطع السَّرايا أمدادهم ومرافقهم، وتتبع الطَّلائع عوراتهم، وانتق الطَّلائع من أهل الرأي، والبأس من أصحابك، وتخيَّر لهم سوابق الخيل، فإِن لقوا عدواً؛ كان أوَّل مَنْ تلقاهم القوَّة من رأيك، واجعل أمر السَّرايا إِلى أهل الجهاد، والصَّبر على الجلاد، ولا تخصَّ أحداً بهوى، فيضيع من رأيك وأمرك أكثر ممَّا حابيت به أهل خاصَّتك، ولا تبعث طليعةً، ولا سريَّةً في وجهٍ تتخوَّف فيه صنيعةً ونكايةً، فإِذا عاينت العدوَّ فاضمم إِليك أقاصيك، وطلائعك، وسراياك، واجمع إِليك مكيدتك، وقوَّتك، ثمَّ لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتالٌ، حتَّى تبصر عورة عدوِّك، ومقاتله، وتعرَّف الأرض كلَّها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوِّك كصنيعته بك، ثمَّ أذك حراسك على عساكرك، وتحفَّظ من البيات جهدك، ولا تؤتى بأسيرٍ ليس له عهدٌ إِلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوَّك، وعدوَّ الله، والله ولي أمرك ومن معك، وولي النَّصر لكم على عدوِّكم، والله المستعان.
فهذا خطابٌ عظيمٌ يشتمل على وصايا نافعةٍ، يوضِّح لنا جانباً مهمّاً من عظمة عمر ـ رضي الله عنه ـ وهو خبرته العالية في التَّخطيط الحربيِّ، وقد كان التَّوفيق الإِلهي واضحاً في كلِّ توجيهاته، ووصاياه، ويمكننا أن نستخلص بعض المبادأى الهامَّة الَّتي اشتملت عليها تلك الوصيَّة، منها:
ـ أمر الجيش بطاعة الله، وتقواه في كلِّ الأحوال، باعتبار: أنَّ هذا هو السِّلاح الأوَّل، والتَّنبيه أنَّ العدوَّ الأوَّل هو الذُّنوب، ثمَّ المحاربون الكفَّار، ولفت النَّظر إِلى أنَّ ثمَّة رقابةً دقيقةً، ودائمةً من الملائكة على أفراد الجيش الإِسلاميِّ، والإِشارة إِلى ضرورة الاستحياء من المعاصي؛ إِذ لا يعقل أن يعصي المرء وهو في ساحة الجهاد في سبيل الله، والتَّأكيد على أنَّه من المجافي للصَّواب اتِّخاذ سلوكيَّات العدوِّ معياراً لتبرير سلوكيَّات الجيش الإِسلاميِّ، واستحضار الحاجة الدَّائمة إِلى معونة الله.
ـ أمَّا المبدأ الثَّاني؛ الَّذي أكدت عليه رسالة عمر إِلى سعدٍ؛ فهو: رعاية الطَّرف الأول في العلاقة محلَّ البحث ضدَّ أيِّ خطرٍ، وتأكيد حرمة قرى أهل الصُّلح، وتلمُّس أسباب تأمينها، وتأمين الصُّورة الإِسلاميَّة من أيَّة اثارٍ عكسيَّةٍ تؤثِّر على نجاح عملية الاتِّصال بين المسلمين وغير المسلمين من جرَّاء سلوكيَّاتٍ غير مستقيمةٍ من جانب بعض العناصر الإِسلاميَّة، وسعياً لتحقيق متطلبات هذا المبدأ أمر عمر أميره بمراعاة أسباب الحفاظ على معنويَّات الجيش، وإِيصاله إِلى أرض العدوِّ وهو قادرٌ على المواجهة، فقال: ترفَّق بالمسلمين في سيرهم.. إِلى أن قال: يكون ذلك لهم راحةً يجمعون بها أنفسهم، ويصلحون أسلحتهم، وأمتعتهم. وبعد التَّأكيد على أسباب صيانة، وسلامة الأنفس والعتاد الحربيِّ الإِسلاميِّ نبَّه عمر إِلى أنَّ الوقاية خيرٌ من العلاج، وأنَّ من أهمِّ أسلحة الجيش الظُّهور بسلوكيَّاتٍ إِسلاميَّةٍ، يوافق فيها القول العمل، فأمر عمر ـ كإِجراء احتياطيٍّ ـ بإِبعاد منازل الجيش عن قرى الصُّلح درءاً لإِمكانية وقوع أيَّة تجاوزات، تعود بالسَّلب على العلاقة المراد إِقامتها، وعدم السَّماح إِلا لأهل الثِّقة بدخول قرى الصُّلح، والتَّأكيد على حرمة أهل الصُّلح، ولزوم الوفاء لهم.
ـ ونصَّت رسالة عمر على مبدأٍ ثالثٍ، وهو: التنوُّع في أسلوب المعاملة حسب نوعيَّة شريك الدَّور، والرِّفق بأهل الصُّلح، وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، فلقد طلب عمر من أميره، ألا يظلم أهل الصُّلح بغية النَّصر على أهل الحرب، وأن يستعين بمن يثق به من أهل المناطق الجارية فتحها، على أن تكون دواعي الثِّقة المطلقة بمعنى: التحرُّز فيها؛ كيلا يؤتى من قبيل الإِفراط في حسن الظَّنِّ.
ـ أمَّا المبدأ الرَّابع؛ فهو ضرورة جمع معلوماتٍ كافيةٍ عن العدوِّ، فلقد نبَّه عمر إِلى ضرورة إِسناد أمر جمع المعلومات إِلى طلائع استطلاعٍ من أفضل عناصر الجيش مع تسليحها بأفضل ما بحوزة الجيش من أسلحة، ذلك أنَّ العدو قد يكشف بعضها، فيكرهها على الدخول في قتالٍ، ويجب بالتَّالي أن تكون من القوَّة بحيث تحدث الأثر النَّفسي المطلوب في العدوِّ بإِشعاره بقوَّة الجيش، وبتلمُّس أسباب الكفِّ عن استخدام القوَّة.
ـ أما المبدأ الخامس والأخير في رسالة عمر؛ فهو: وضعه الرَّجل المناسب في المكان المناسب، واعتبار: أنَّ الغرض من جمع المعلومات عن العدوِّ ليس التمكُّن من محاربته، بقدر ما هو التَّحرُّز من استكراه الطَّرف الثَّاني للمسلمين على القتال، ولذا يجب على المسلمين الكفُّ بعد الأخذ بالأسباب، والتأهُّب ما وجدوا إِلى ذلك سبيلاً مع أخذ الحيطة، والحذر البالغين.
6 ـ الاستعانة بمن تاب من المرتدِّين:
إِنَّ أبا بكر الصِّدِّيق ـ رضي الله عنه ـ لم يستعن في حروب الردَّة، ولا في حركة الفتوحات بمرتدٍّ، وأمَّا عمر ـ رضي الله عنه ـ فقد استنفرهم بعد أن تابوا، وصلح حالهم، وأخذوا قسطاً من التَّربية الإِسلاميَّة، إِلا أنَّه لم يولِّ منهم أحداً، وقد جاء في روايةٍ: أنه قال لسعد بن أبي وقَّاصٍ في شأن طليحة بن خويلد الأسدي، وعمرو بن معدي كرب الزُّبيدي: استعن بهما، ولا تولينَّهما على مئةٍ، فنستفيد من سنة الخليفتين الرَّاشدين: أبي بكرٍ، وعمر اللَّذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكرٍ، وعمر » نستفيد من سنَّتهما هذه: أنَّ من ارتدَّ عن الإِسلام، ثمَّ تاب، ورجع إِليه، فإِنَّ توبته مقبولةٌ، ويكون معصوم الدَّم، والمال، وله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، غير أنَّه لا يُولَّى شيئاً من أمور المسلمين المهمَّة، وخاصَّةً الأعمال القياديَّة، وذلك لاحتمال أن تكون توبته نفاقاً، وإِذا كانت كذلك، وتولَّى قيادة المسلمين، فإِنَّه يفسد في الأرض، ويقلب موازين الحياة، فيقرِّب أمثاله من المنافقين ويبعد المؤمنين الصَّادقين، ويحوِّل المجتمع الإِسلامي إِلى مجتمعٍ تسوده مظاهر الجاهليَّة، فكانت هذه السُّنَّة الرَّاشدة من الخليفتين الرَّاشدين لحماية المجتمع الإِسلاميِّ من تسلُّل المفسدين إِلى قيادته، وتوجيهه، ولعلَّ من حكم هذه السُّنَّة أيضاً ملاحظة عقوبة المرتدِّين بنقيض قصدهم، فالَّذين يرتدُّون من أجل الحصول على الزَّعامات، والقيادات إِذا أظهروا التَّوبة، وعادوا إِلى الإِسلام، يحرمون من هذه القيادات عقوبةً لهم، وردعاً لكلِّ من تسوِّل له نفسه أن يخرج عن الخطِّ الإِسلامي، ويبحث عن الزَّعامة في معاداة الإِسلام، وموالاة أعدائه.
7 ـ كتاب من أمير المؤمنين إِلى سعد بن أبي وقاص:
وصل إِلى سعد بن أبي وقَّاص كتابٌ من أمير المؤمنين وهو نازلٌ في شرافٍ على حدود العراق يأمره فيه بالمسير نحو فارس، وقد جاء في هذا الكتاب: أمَّا بعد: فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين، وتوكَّل على الله، واستعن به على أمرك كلِّه، واعلم فيما لديك: أنَّك تقدم على أمَّةٍ عددهم كثير، وعدَّتهم فاضلة، وبأسهم شديدٌ، وعلى بلدٍ منيعٍ ـ وإِن كان سهلاً ـ كؤودٍ لبحوره، وفيوضه، ودادئه، إِلا أن توافقوا غيضاً من فيضٍ، وإِذا لقيتم القوم، أو أحداً منهم؛ فابدؤوهم الشَّدَّ، والضَّرب، وإِيَّاكم والمناظرة ـ لجموعهم ـ يعني الانتظار بعد المواجهة ـ ولا يَخْدعُنَّكم، فإِنَّهم خَدَعَةٌ مَكَرَةٌ، أمرهم غير أمركم، إِلا أن تجادُّوهم ـ يعني: تأخذوهم بالجدِّ ـ وإِذا انتهيت إِلى القادسية، فتكون مسالحك على أنقابها، ويكون النَّاس بين الحجر، والمدر، على حافَّات الحجر، وحافات المدر، والجراع بينها، ثمَّ الزم مكانك، فلا تبرحه، فإِنَّهم إِن أحسُّوك أنغضتهم؛ رموك بجمعهم، الَّذي يأتي على خيلهم، ورجلهم، وحدِّهم، وجدِّهم، فإِن أنتم صبرتم لعدوِّكم، واحتسبتم لقتاله، ونويتم الأمانة؛ رجوت أن تنصروا عليهم، ثمَّ لا يجتمع لكم مثلهم أبداً، إِلا أن يجتمعوا، وليست معهم قلوبهم، وإِن تك الأخرى كان الحجر في أدباركم، فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم إِلى أدنى حجرٍ من أرضكم، ثمَّ كنتم عليها أجرأ، وبها أعلم، وكانوا عنها أجبن، وبها أجهل، حتَّى يأتي الله بالفتح عليهم، ويردَّ لكم الكرَّة.
وهذه الوصيَّة في اختيار المكان الَّذي يستقرُّ فيه الجيش تشبه وصية المثنَّى لسعدٍ حيث اتَّفق رأي عمر، والمثنَّى في اختيار المكان، وكانت تلك الوصيَّة من المثنَّى نتيجة خبرة أكثر من ثلاث سنوات في حرب الفرس، وهذا دليلٌ على براعة عمر ـ رضي الله عنه ـ في التَّخطيط الحربيِّ، مع أنَّه لم تطأ قدماه أرض العراق ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وتتضمَّن هذه الوصيَّة إِبقاء الجيش بعيداً عن متناول الأعداء، ثمَّ رميهم بالسَّرايا الَّتي تنغِّص عليهم حياتهم، وتثير عليهم أتباعهم، حتَّى يضطر المسلمون إِلى منازلتهم في المكان الَّذي تمَّ اختياره.
8 ـ من أسباب النَّصر المعنوية في رأي عمر رضي الله عنه:
كتب عمر ـ رضي الله عنه ـ إِلى سعد يذكِّره بأسباب النَّصر المعنويَّة، وهي الَّتي تأتي في المقام الأوَّل، وقد جاء في كتابه: أمَّا بعد: فتعاهد قلبك، وحادث جندك بالموعظة، والنِّيَّة، والحِسْبَة، وَمَنْ غفل فليحدثهما، والصَّبر، الصبر، فإِنَّ المعونة تأتي من الله على قدر النِّيَّة، والأجر على قدر الحِسْبَة، والحذر، الحذر على ما أنت عليه، وما أنت بسبيله، واسألوا الله العافية، وأكثروا من قول: « لا حول، ولا قوة إِلا بالله » واكتب إِليَّ أين بلغ جمعكم، ومن رأسهم الَّذي يلي مصادمتكم ؟ فإِنَّه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليه، والَّذي استقر عليه أمر عدوِّكم، فصف لنا منازل المسلمين، والبلد الَّذي بينكم وبين المدائن صفة كأنِّي أنظر إِليها، واجعلني من أمركم على الجليَّة، وخف الله، وارجه، ولا تُدلَّ بشيءٍ، واعلم: أنَّ الله قد وعدكم، وتوكَّل لهذا الأمر بما لا خُلف له، فاحذر أن تصرفه عنك، ويستبدل بكم غيركم.
ففي هذا الكتاب يوصي عمر ـ رضي الله عنه ـ بتعاهد القلوب، فإِنَّ القلب هو المحرِّك لجميع أعضاء الجسم، والحاكم عليها، فإِذا صلح؛ صلح الجسم كلُّه، ثمَّ يوصيه بموعظة جنده، وتذكيرهم بالإِخلاص لله تعالى، واحتساب الأجر عنده، ويبيِّن: أنَّ نصر الله مترتبٌ على ذلك، ويحذِّره من التَّفريط في المسؤولية الَّتي تحمَّلها، وما يستقبله من الفتوح، ويذكِّرهم بوجوب ارتباطهم بالله تعالى، وأنَّ قوَّتهم من قوَّته، ويوصي قائد المسلمين بأنْ يكون بين مقام الخوف من الله تعالى، والرَّجاء لما عنده، وهو مقامٌ عظيمٌ من مقامات التَّوحيد، وينهاه عن الإِدلال على الله بشيءٍ من العمل، أو ثناء النَّاس، ويذكِّره بما سبق من وعد الله تعالى بانتصار الإِسلام، وزوال ممالك الكفر، ويحذِّره من التَّهاون في تحقيق شيءٍ من أسباب النَّصر، فيتخلَّف النَّصر عنهم ليتمَّ على يد غيرهم ممَّن يختارهم الله تعالى.
9 ـ سعد ـ رضي الله عنه ـ يصف موقع القادسيَّة لعمر ـ رضي الله عنه ـ وردُّ عمر عليه:
كتب سعد إِلى عمر ـ رضي الله عنهما ـ يصف له البلدان الَّتي يتوقَّع أن تكون ميداناً للمعركة الفاصلة، إِلى أن قال: وأنَّ جميع مَنْ صالح المسلمين من أهل السَّواد قبلي إِلبٌ لأهل فارس، قد خفُّوا لهم، واستعدُّوا لنا، وإِنَّ الَّذي أعدُّوا لمصادمتنا رستم في أمثالٍ له منهم، فهم يحاولون إِنغاضنا، وإِقحامنا، ونحن نحاول إِنغاضهم، وإِبرازهم، وأمر الله بعدُ ماضٍ، وقضاؤه مسلمٌ إِلى ما قدِّر لنا، وعلينا، فنسأل الله خير القضاء، وخير القدر في عافية[(1963)] ! فكتب إِليه عمر: قد جاءني كتابك، وفهمته، فأقم بمكانك حتَّى ينغض الله لك عدوَّك، واعلم: أنَّ لها ما بعدها، فإِن منحك الله أدبارهم؛ فلا تنزع عنهم حتَّى تقتحم عليهم المدائن فإِنَّه خرابها إِن شاء الله. ومن خلال رسالة عمر يتبيَّن: أنَّه اتَّخذ القرار المناسب، وهو:
ـ أن يثبت سعد في مواقعه، فلا يبارحها.
ـ ألا يبادر العدوَّ بالقتال، بل يترك له أمر هذه المبادرة.
ـ أن يعمد إِلى استثمار النَّصر، ويطارد العدوَّ حتَّى المدائن، فيفتحها عليه، ومع الأخذ بالأسباب المادِّيَّة الَّتي لا بدَّ منها في إِحراز النَّصر لم يترك الفاروق الجوانب المعنويَّة، وشنَّ حربٍ نفسيَّةٍ على الخصوم في عقر دارهم، وعزِّ ملكهم، وقوَّة سطوتهم، فأرسل إِلى سعد: إِنِّي ألقي في رُوعي: أنَّكم إِذا لقيتم العدو؛ غلبتموهم، فمتى لاعب أحدٌ منكم أحداً من العجم بأمانٍ، وإِشارةٍ، أو لسانٍ كان عندهم أماناً، فأجروا له ذلك مجرى الأمان، وإِيَّاكم والضَّحك ! والوفاء، الوفاء ! فإِنَّ الخطأ بالوفاء بقيَّة، وإِنَّ الخطأ بالغدر هلكةٌ، وفيها وهنكم، وقوَّة عدوِّكم.
لقد كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يعيش مع الجيش الإِسلامي بكلِّ مشاعره، وأحاسيسه، ولقد تكاثفت عليه الهموم حتَّى أصبح لا يهنأ بعيشٍ، ولا يقرَّ له قرارٌ حتَّى يسمع أخبارهم، وإِنَّ في مثل هذا الإِلهام من الله تعالى تخفيفاً من العبء الكبير؛ الَّذي تحمَّله عمر، وتثبيتاً للمسلمين وتقويةً لقلوبهم، ونلاحظ: أنَّ الفاروق ـ رضي الله عنه ـ ذكَّر المسلمين بشيءٍ من عوامل النَّصر المعنوية، حيث حثَّهم على الالتزام بشرف الكلمة، والصِّدق في القول، والوفاء بالعهود، ولو كان من التزم بذلك أحد أفراد المسلمين، أو كان هناك خطأ في الفهم، فلم يقصد المسلم الأمان، وفهمه العدوُّ أماناً.
للاطلاع على النسخة الأصلية للكتاب راجع الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي، وهذا الرابط:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book172(1).pdf