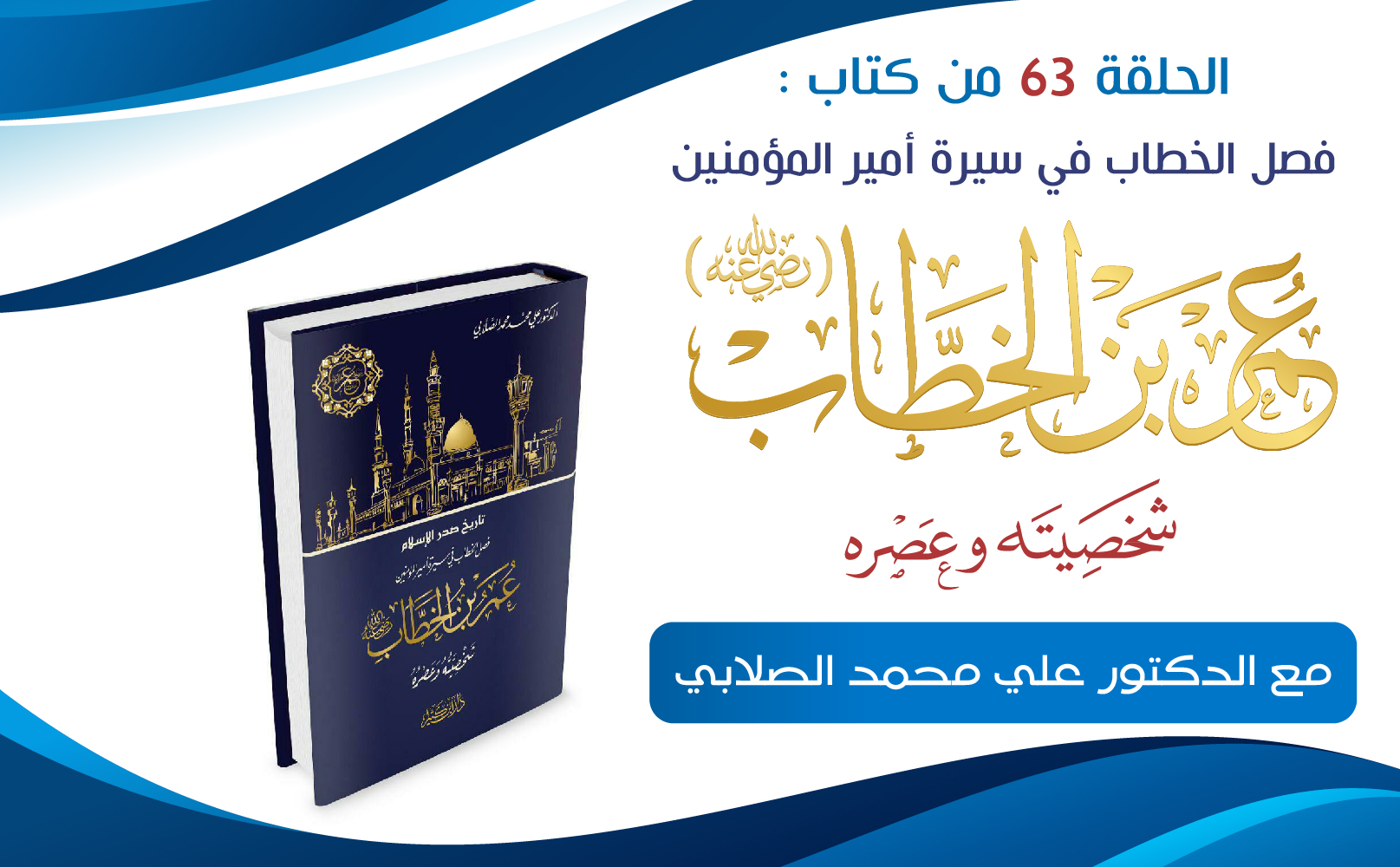قصَّة عزل الفاروق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما؛ أحداث ملهمة ودروس مستفادة
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة الرابعة و الستون
وجد أعداء الإِسلام في سعة خيالهم، وشدَّة حقدهم مجالاً واسعاً لتصيُّد الرِّوايات الَّتي تظهر صحابة رسول الله في مظهرٍ مشين، فإِذا لم يجدوا شفاء نفوسهم؛ اختلقوا ما ظنُّوه يجوز على عقول القارئين، لكي يصبح أساساً ثابتاً لما يتناقله الرُّواة، وتسطِّره كتب المؤلفين. قد تعرَّض كلٌّ من عمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد ـ رضي الله عنهما ـ لمفتريات أعداء الإِسلام؛ الَّذين حاولوا تشويه صفحات تاريخهما المجيد، ووقفوا كثيراً عند أسباب عزل عمر لخالد بن الوليد ـ رضي الله عنهما ـ وألصقوا التُّهم الباطلة بالرَّجلين العظيمين، وأتوا برواياتٍ لا تقوم على أساسٍ عند المناقشة، ولا تقوم على البرهان أمام التَّحقيق العلميِّ النَّزيه. وِإليك قصَّة عزل خالد بن الوليد على حقيقتها بدون لفٍّ، أو تزويرٍ للحقائق، فقد مرَّ عزل خالد بن الوليد بمرحلتين، وكان لهذا العزل أسباب موضوعيَّة.
1ـ العزل الأوَّل:
عزل عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ خالد بن الوليد في المرَّة الأولى عن القيادة العامَّة، وإِمارة الأمراء بالشَّام، وكانت هذه المرَّة في السنة الثالثة عشرة من الهجرة غداة تولِّي عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وسبب هذا العزل اختلاف منهج الصِّدِّيق عن الفاروق في التَّعامل مع الأمراء، والولاة، فالصِّدِّيق كان من سنَّته مع عمَّاله، وأمراء عمله أن يترك لهم حرِّيَّة التَّصرُّف كاملةً في حدود النِّظام العامِّ للدَّولة، مشروطاً ذلك بتحقيق العدل كاملاً بين الإفراد والجماعات، ثمَّ لا يبالي أن يكون لواء العدل منشوراً بيده، أو بيد عمَّاله، وولاته، فللوالي حقٌّ يستمدُّه من سلطان الخلافة في تدبير أمر ولايته دون رجوعٍ في الجزئيَّات إِلى أمر الخليفة. وكان أبو بكر لا يرى أن يكسر على الولاة سلطانهم في مالٍ، أو غيره ما دام قائماً في رعيتهم.
وكان الفاروق قد أشار على الصِّدِّيق بأن يكتب لخالدٍ ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ: ألا يعطي شاةً، ولا بعيراً إِلا بأمره، فكتب أبو بكر إِلى خالدٍ بذلك، فكتب إِليه خالد: إِما أن تدعني وعملي، وإِلا فشأنُك، وعملُك، فأشار عليه بعزله، ولكنَّ الصِّدِّيق أقرَّ خالداً على عمله.
ولما تولَّى الفاروق الخلافة؛ كان يرى أنَّه يجب على الخليفة أن يحدِّد لأمرائه، وولاته طريقة سيرهم في حكم ولاياتهم، ويحتِّم عليهم أن يردُّوا إِليه ما يحدث حتَّى يكون هو الَّذي ينظر فيه، ثمَّ يأمرهم بأمره، وعليهم التَّنفيذ؛ لأنَّه يرى: أنَّ الخليفة مسؤولٌ عن عمله، وعن عمل ولاته في الرَّعية مسؤوليَّةً لا يرفعها عنه أنَّه اجتهد في اختيار الوالي. فلمَّا تولَّى الخلافة؛ خطب النَّاس، فقال: إِن الله ابتلاكم بي، وابتلاني بكم، وأبقاني بعد صاحبي، فوالله لا يحضرني شيءٌ من أمركم فيليه أحدٌ دوني، ولا يتغيَّب عنِّي، فالوا فيه عن الجزاء، والأمانة، ولئن أحسن الولاة؛ لأحسنَنَّ إِليهم، ولئن أساؤوا لأنكلنَّ بهم، وكان يقول: أرأيتم إِذا استعملت عليكم خير مَنْ أعلم، ثمَّ أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما عليَّ ؟ قالوا: نعم. قال: لا ! حتَّى أنظر في عمله، أَعمِل بما أمرته، أم لا ؟، فعندما تولَّى الفاروق الخلافة أراد أن يعدل بولاة أبي بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ إِلى منهجه، وسيرته، فرضي بعضهم، وأبى اخرون، وكان ممَّن أبى عليه ذلك خالد بن الوليد. فعن مالك بن أنسٍ: أنَّ عمر لمَّا ولِّي الخلافة كتب إِلى خالد: ألا تعطي شاةً، ولا بعيراً إِلا بأمري. فكتب إِليه خالد: إِمَّا أن تدعني وعملي، وإِلا فشأنك بعملك. فقال عمر: ما صدقتُ الله إِن كنت أشرت على أبي بكرٍ بأمرٍ، فلم أنفِّذه. فعزله. ثمَّ كان يدعوه إِلى العمل، فيأبى إِلا أن يخلِّيه يفعل ما يشاء، فيأبى عليه.
فعزل عمر خالداً من وجهةٍ سياسة الحكم، وحقُّ الحاكم في تصريف شؤون الدَّولة ومسؤوليَّته عنها، وطبيعيٌّ أن يقع كلَّ يومٍ مثله في الحياة، ولا يبدو فيه شيءٌ غريبٌ يحتاج إِلى بيان أسباب تتجاذبها رواياتٌ، واراء، وميولٌ، وأهواءٌ، ونزعاتٌ، فعمر بن الخطَّاب خليفة المسلمين في عصرٍ كان الناس فيه ناساً لا يزالون يستروحون روح النُّبوَّة، له من الحقوق الأوَّليَّة أن يختار من الولاة والقادة من ينسجم معه في سياسته، ومذهبه في الحكم، ليعمل في سلطانه ما دامت الأمَّة غنيةً بالكفايات الرَّاجحة، فليس لعاملٍ، ولا قائدٍ أن يتأبَّد في منصبه، ولا سيَّما إِذا اختلفت مناهج السِّياسة بين الحاكم والولاة ما كان هناك مَنْ يغني غناءه، ويجزي عنه، وقد أثبت الواقع التَّاريخي: أنَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ كان موفقاً أتمَّ التَّوفيق وقد نجح في سياسته هذه نجاحاً منقطع النَّظير، فعزل، وولَّى، فلم يكن من ولاه أقلَّ كفايةً ممَّن عزله، ومردُّ ذلك لروح التَّربية الإِسلاميَّة الَّتي قامت على أن تضمن دائماً للأمَّة رصيداً مذخوراً من البطولة، والكفاية السِّياسيَّة الفاضلة. وقد استقبل خالدٌ هذا العزل بدون اعتراضٍ، وظلَّ رضي الله عنه تحت قيادة أبي عبيدة رضي الله عنه حتَّى فتح الله عليه قنَّسرين، فولاه أبو عبيدة عليها، وكتب إِلى أمير المؤمنين يصف له الفتح، وبلاء خالد فيه، فقال عمر قولته المشهورة: أمَّر خالد نفسه، رحم الله أبا بكر ! هو كان أعلم بالرِّجال منِّي.
ويعني عمر بمقولته هذه: أنَّ خالداً فيما أتى به من أفانين الشَّجاعة، وضروب البطولة قد وضع نفسه في موضعها الَّذي ألفته في المواقع الخطيرة من الإِقدام والمخاطرة، وكأنَّما يعني عمر بذلك: أنَّ استمساك أبي بكر بخالدٍ، وعدم موافقته على عزله برغم الإِلحاح عليه إِنَّما كان عن يقين في مقدرة خالدٍ، وعبقريَّته العسكريَّة، الَّتي لا يغني غناءه فيها إِلا احاد الأفذاذ من أبطال الأمم.
هذا وقد عمل خالد تحت إِمرة أبي عبيدة نحواً من أربع سنوات، فلم يعرف عنه: أنَّه اختلف عليه مرَّةً واحدةً، ولا ينكر فضل أبي عبيدة، وسمو أخلاقه في تحقيق وقع الحادث على خالدٍ، فقد كان لحفاوته به، وعرفانه لقدره، وملازمته صحبته، والأخذ بمشورته، وإِعظامه لآرائه، وتقديمه في الوقائع الَّتي حدثت بعد إِمارته الجديدة أحسن الأثر في صفاء قلبه، صفاءً جعله يصنع البطولات العسكريَّة النَّادرة، وعمله في فتح دمشق، وقنَّسرين، وفحل شاهدُ صدقٍ على روحه السَّامية الَّتي قابل بها حادث العزل، وكان في حاليه سيف الله خالد بن الوليد، ويحفظ لنا التَّاريخ ما قاله أبو عبيدة في مواساة خالد عند عزله:.. وما سلطان الدُّنيا أريد، وما للدُّنيا أعمل، وإِنَّ ما ترى سيصير إِلى زوالٍ وانقطاعٍ، وإِنَّما نحن أخوان، وقُوَّامٌ بأمر الله عزَّ وجل، وما يضير الرَّجل أن يلي عليه أخوه في دينه، ودنياه، بل يعلم الوالي: أنَّه يكاد يكون أدناهما إِلى الفتنة، وأوقعهما في الخطيئة لما تعرض من الهلكة إِلا من عصم الله عزَّ وجل، وقليل ما هم.
وعندما طلب أبو عبيدة من خالدٍ أن ينفِّذ مهمَّة قتاليَّةً تحت إِمرته؛ أجابه خالد قائلاً: أنا لها ـ إِن شاء الله تعالى ـ وما كنت أنتظر إِلا أن تأمرني ! فقال أبو عبيدة: استحييت منك يا أبا سليمان ! فقال خالد: والله لو أُمِّر عليَّ طفلٌ صغيرٌ لأطيعنَّ له، فكيف أخالفك وأنت أقدم منِّي إِيمانًا، وأسبق إِسلاماً، سبقت بإِسلامك مع السَّابقين، وأسرعت بإِيمانك مع المسارعين، وسمَّاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، فكيف ألحقك، وأنال درجتك، والان أُشهدك أنِّي قد جعلت نفسي حبساً في سبيل الله تعالى، ولا أخالفك أبداً، ولا وليتُ إِمارةً بعدها أبداً. ولم يكتف خالد بذلك فحسب بل أتبع قوله بالفعل، وقام على الفور بتنفيذ المهمَّة المطلوبة منه.
ويظهر بوضوحٍ من قول خالد، وتصرُّفه هذا: أنَّ الوازع الدِّيني والأخلاقي كان مهيمناً على تصرُّفات خالدٍ، وأبي عبيدة رضي الله عنهما. وقد بقي خالدٌ محافظاً على مبدأ طاعة الخليفة، والوالي بالرُّغم من أنَّ حالته الشَّخصيَّة قد تغيَّرت من حاكمٍ إِلى محكوم بسبب عزله عن قيادة الجيوش.
إِنَّ عزل خالد هذه المرَّة (الأولى)، لم يكن عن شكٍّ من الخليفة، ولا عن ضغائن جاهليَّة، ولا عن اتِّهامه بانتهاك حرمات الشَّريعة، ولا عن طعنٍ في تقوى، وعدل خالدٍ، ولكن كان هناك منهجان لرجلين عظيمين، وشخصيَّتين قويَّتين، كان يرى كلٌّ منهما ضرورة تطبيق منهجه، فإِذا كان لابدَّ لأحدهما أن يتنحَّى؛ فلابدَّ أن يتنحَّى أمير الجيوش لأمير المؤمنين من غير عنادٍ، ولا حقدٍ، ولا ضغينةٍ.
إِنَّ من توفيق الله للفاروق تولية أبي عبيدة ـ رضي الله عنه ـ لجيوش الشام، فذلك الميدان بعد معركة اليرموك كان يحتاج إِلى المسالمة، واستلال الأحقاد، وتضميد الجراح، وتقريب القلوب، فأبو عبيدة ـ رضي الله عنه ـ يسرع إِلى المسالمة إِذا فتحت أبوابها، ولا يبطأى عن الحرب إِذا وجبت عليه أسبابها، فإِن كانت بالمسالمة جدوى؛ فذاك وإِلا فالاستعداد للقتال على أهبته، وقد كان أبناء الأمصار الشَّاميَّة يتسامعون بحلم أبي عبيدة، فيقبلون على التَّسليم إِليه، ويؤثرون خطابهم له على غيره، فولاية أبي عبيدة سنَّةٌ عمريَّةٌ، وكانت ولايته للشَّام في تلك المرحلة أصلح الولايات لها.
2ـ العزل الثاني:
وفي (قنِّسرين) جاء العزل الثاني لخالدٍ، وذلك في السَّنة السَّابعة عشرة، فقد بلغ أمير المؤمنين: أنَّ خالداً وعياض بن غنم أدربا في بلاد الروم، وتوغَّلا في دروبهما، ورجعا بغنائم عظيمةٍ، وأنَّ رجالاً من أهل الافاق قصدوا خالداً لمعروفه، منهم الأشعثُ بن قيسٍ الكندي، فأجازه خالدٌ بعشرة الاف، وكان عمر لا يخفى عليه شيءٌ في عمله، فكتب عمر إِلى قائده العامِّ أبي عبيدة يأمره بالتَّحقيق مع خالد في مصدر المال الَّذي أجاز منه الأشعث تلك الإِجازة العامرة، وعزله عن العمل في الجيش إِطلاقًا، واستقدمه المدينة، وتم استجواب خالد، وقد تمَّ استجواب خالد بحضور أبي عبيدة، وترك بريد الخلافة يتولَّى التحقيق، وترك إِلى مولى أبي بكر يقوم بالتَّنفيذ، وانتهى الأمر ببراءة خالدٍ أن يكون مدَّ يده إِلى غنائم المسلمين، فأجاز منها بعشرة الاف ولما علم خالد بعزله، ودَّع أهل الشَّام، فكان أقصى ما سمحت به نفسه من إِظهار أسفه على هذا العزل الَّذي فرَّق بين القائد وجنوده أن قال للنَّاس: إِن أمير المؤمنين استعملني على الشَّام حتَّى إِذا كانت بثينةً، وعسلاً؛ عزلني. فقام إِليه رجلٌ فقام: اصبر أيها الأمير ! فإِنَّها الفتنة. فقال خالد: أما وابن الخطَّاب حيٌّ، فلا.
وهذا لون من الإِيمان القاهر الغلاب، لم يرزقه إِلا المصطفون من أخصَّاء أصحاب محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فأيَّة قوَّةٍ روحيَّة سيطرت على أعصاب خالد في الموقف الخطير ؟ وأيُّ إِلهامٍ ألقى على لسان خالدٍ ذلك الردّ الهادأى الحكيم.
سكن الناس، وهدأت نفوسهم بعد أن سمعوا كلمة خالد في توطيد قواعد الخلافة العمريَّة، وعرفوا: أنَّ قائدهم المعزول ليس من طراز الرِّجال الَّذين يبنون عروش عظمتهم على أشلاء الفتن، والثَّورات الهدَّامة، وإِنَّما هو من أولئك الرِّجال الذين خلقوا للبناء، والتشييد، فإِن أرادتهم الحياة على هدم ما بنوا؛ تساموا بأنفسهم أن يذلَّها الغرور المفتون.
ورحل خالد إِلى المدينة، فقدمها حتى لقي أمير المؤمنين، فقال عمر متمثلاً:
صَنَعْتَ فَلَمْ يَصْنَعَ كُصُنْعِكَ صَانِعٌ وَمَا يَصْنَعُ الأقوامُ فَالله يَصْنَعُ
وقال خالدٌ لعمر: لقد شكوتُك إِلى المسلمين، وبالله إِنَّك في أمري غير مُجملٍ يا عمر ! فقال عمر: من أين هذا الثَّراء ؟ قال: من الأنفال، والسُّهمان، ما زاد على السِّتين ألفًا فلك، فقوَّم عمر عروضه فخرجت إِليه عشرون ألفًا، فأدخلها بين المال. ثمَّ قال: يا خالد ! والله إِنَّك عليَّ لكريمٌ، وإِنَّك إِليَّ لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيءٍ. وكتب عمر إِلى الأمصار: إِنِّي لم أعزل خالداً عن سخطةٍ، ولا خيانةٍ، ولكنَّ النَّاس فُتنوا به، فخفت أن يوكلوا إِليه، ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا: أنَّ الله هو الصَّانع، وألا يكونوا بعرض فتنةٍ.
3ـ مجمل أسباب العزل، وبعض الفوائد:
ومن خلال سيرة الفاروق يمكننا أن نجمل أسباب عزل خالدٍ ـ رضي الله عنه ـ في الأمور التَّالية:
ـ حماية التَّوحيد: ففي قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: ولكنَّ النَّاس فتنوا به، فخفت أن يُوكَلوا إِليه، ويُبتلَوا به، يظهر خشية عمر من فتنة النَّاس بخالدٍ، وظنِّهم أنَّ النَّصر يسير في ركاب خالدٍ، فيضعف اليقين بأنَّ النَّصر من عند الله، سواءٌ كان خالدٌ على رأس الجيوش، أم لا، وهذا الوازع يتَّفق مع حرص عمر على صبغ إِدارته للدَّولة العقائديَّة الخالصة، بخاصَّةٍ وهي تحارب أعداءها حرباً ضروساً متطاولةً باسم العقيدة، وقوَّتها، وقد يقود الافتتان بقائدٍ كبيرٍ مثل خالد خالداً نفسه إِلى الافتتان بالرَّعية، وأن يرى نفسه يوماً في مركز قوَّة لا يرتقي إِليها أحدٌ، بخاصَّةٍ: أنَّه عبقرية حربٍ، ومنفق أموالٍ، فيجرُّ ذلك عليه وعلى الدَّولة أمر خسرٍ، وهو إِن كان احتمالاً بعيداً في ظلِّ ارتباط النَّاس بخليفتهم عمر، وإعجابهم به، وفي ظلِّ انضباط خالدٍ العسكريِّ وتقواه، فقد يحدث يوماً بعد عمر، ومع قائدٍ كخالد، ممَّا يستدعي التَّأصيل لها في ذلك العصر، ومع أمثال هؤلاء الرِّجال، والخوف في هذا الأمر من القائد الكفء أعظم من الخوف من قائدٍ صغيرٍ لم يبل أحسن البلاء، ولم تتساير بذكره الأنباء.
وقد أشار شاعر النِّيل حافظ إِبراهيم ـ رحمه الله ـ إِلى تخوُّف عمر، فقال في عمريَّته في الدِّيوان:
وَقِيْلَ خَالَفْتَ يَا فَارُوقُ صاحِبَنَا فِيْهِ وَقَدْ كَانَ أَعْطَى القَوْسَ بَارِيْهَا
فقَالَ خِفْتُ افْتِتَانَ المُسْلِمِيْنَ بِهِ وَفِتْنَةُ النَّفْسِ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيْهَا ـ اختلاف النَّظر في صرف المال:
كان عمر يرى أنَّ فترة تأليف القلوب، وإِغراء ضعفاء العقيدة بالمال، والعطاء قد انتهت، وصار الإِسلام في غير حاجةٍ إِلى هؤلاء، وأنَّه يجب أن يوكل النَّاس إِلى إِيمانهم، وضمائرهم، حتَّى تؤدِّي التَّربية الإِسلاميَّة رسالتها في تخريج نماذج كاملةٍ لمدى تغلغل الإِيمان في القلوب، بينما يرى خالدٌ: أنَّ ممَّن معه من ذوي البأس، والمجاهدين في ميدانه من لم تخلص نيَّتهم لمحض ثواب الله، وأنَّ أمثال هؤلاء في حاجةٍ إِلى من يقوِّي عزيمتهم، ويثير حماستهم من هذا المال، كما أنَّ عمر يرى: أنَّ ضعفة المهاجرين أحقُّ بالمال من غيرهم، فعندما اعتذر إِلى النَّاس بالجابية من عزل خالدٍ، قال: أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس، ولا شكَّ: أن عمر، وخالداً مجتهدان فيما ذهبا إِليه، ولكن عمر أدرك أموراً لم يدركها خالدٌ رضي الله عنهما.
ـ اختلاف منهج عمر عن منهج خالدٍ في السياسة العامَّة:
فقد كان عمر يصرُّ على أن يستأذن الولاة منه في كلِّ صغيرةٍ، وكبيرةٍ، بينما يرى خالدٌ: أنَّ من حقه أن يُعطى الحرِّيَّة كاملةً من غير الرُّجوع لأحدٍ في الميدان الجهادي، وتطلق يده في كلِّ التَّصرُّفات إِيماناً منه بأنَّ الشَّاهد يرى ما لا يراه الغائب.
ولعلَّ من الأسباب أيضاً: إِفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات حتَّى تتوافر في المسلمين نماذج كثيرةٌ من أمثال خالد، والمثنَّى، وعمرو بن العاص، ثمَّ ليدرك النَّاس: أنَّ النَّصر ليس رهنًا برجلٍ واحدٍ، مهما كان هذا الرَّجل.
ـ موقف المجتمع الإِسلاميِّ من قرار العزل:
تلقَّى المجتمع الإسلاميُّ قرار العزل بالتَّسليم لحقِّ الخليفة في التَّولية، والعزل، فلم يخرج أحدٌ عن مقتضى النِّظام، والطَّاعة، والإِقرار للخلافة بحقِّها في التَّولية، والعزل، وقد روي: أنَّ عمر خرج في جوف اللَّيل، فلقي علقمة بن علاثة الكلابي، وكان عمر يشبه خالداً إِلى حدٍّ عجيب، فحسبه علقمة خالداً، فقال: يا خالد ! عزلك هذا الرَّجل، لقد أبى إِلا شحَّاً حتَّى لقد جئت إِليه وابن عمٍّ لي نسأله شيئاً، فأمَّا إِذ فعل؛ فلن نسأله شيئًا. فقال له عمر يستدرجه ليعلم ما يخفيه: هيه! فما عندك؟ قال: هم قومٌ لهم علينا حقٌّ فنؤدِّي لهم حقَّهم، وأجرنا على الله، فلمَّا أصبحوا؛ قال عمر لخالدٍ، وعلقمة مشاهدٌ لهما: ماذا قال لك علقمة منذ اللَّيلة ؟ قال خالدٌ: والله ما قال شيئاً، قال عمر: وتحلف أيضاً ؟ فاستثار ذلك علقمة وهو يظنُّ أنَّه ما كلم البارحة إِلا خالداً، فظلَّ يقول: مه يا خالد ! فأجاز عمر علقمة، وقضى حاجته، وقال: لأن يكون من ورائي على مثل رأيك ـ يعني: حرصه على الطَّاعة لولي الأمر وإِن خالفه ـ أحبُّ إِليَّ من كذا، وكذا.
وهذا وقد جاء اعتراضٌ من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة ابن عمِّ خالد بن الوليد بالجابية، فعندما قال عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ للناس: وإِنِّي أعتذر إِليكم من خالد بن الوليد، إِنِّي أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف، وذا اللسان، فنزعته، وأمَّرت أبا عبيدة بن الجراح. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب ! لقد نزعت عاملاً استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفًا سلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواءً نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قطعت الرَّحم، وحسدت ابن العمِّ ! فقال عمر بن الخطاب: إِنَّك قريب القرابة، حديث السنِّ، مغضبٌ في ابن عمِّك. وهكذا اتسع صدر الفاروق لابن عمِّ خالد بن الوليد، وهو يذبُّ عن خالدٍ حتَّى وصل دفاعه إِلى دعوى اتهامه للفاروق بالحسد، ومع ذلك ظلَّ الفاروق حليماً.
4ـ وفاة خالد بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش الموت:
دخل أبو الدَّرداء على خالد في مرض موته، فقال له خالد: يا أبا الدرداء ! لئن مات عمر؛ لترينَّ أموراً تنكرُها. فقال أبو الدرداء: وأنا والله أرى ذلك ! فقال خالد: قد وجدت عليه في نفسي في أمورٍ، لمَّا تدبَّرتها في مرضي هذا، وحضرني من الله حاضرٌ؛ عرفت: أنَّ عمر كان يريد الله بكلِّ ما فعل، كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث من يقاسمني مالي، حتَّى أخذ فرد نعلٍ وأخذت فرد نعلٍ، ولكنَّه فعل ذلك بغيري من أهل السَّابقة، وممَّن شهد بدراً، وكان يغلظ عليَّ، وكانت غلظته على غيري نحواً من غلظته عليَّ، وكنت أدلُّ عليه بقرابته، فرأيته لا يبالي قريباً، ولا لوم لائم في غير الله، فذلك الَّذي ذهب عنِّي ما كنت أجد عليه، وكان يكثر عليَّ عنده، وما كان ذلك إِلا على النَّظر: فقد كنت في حربٍ، ومكابدةٍ، وكنت شاهداً، وكان غائباً، فكنت أعطي على ذلك، فخالفه ذلك في أمري.
ولما حضرته الوفاة، وأدرك ذلك؛ بكى، وقال: ما من عملٍ أرجى عندي بعد لا إِله إِلا الله من ليلةٍ شديدة الجليد في سرِيَّةٍ من المهاجرين، بتُّها وأنا متترسٌ والسَّماء تنهلُّ عليَّ، وأنا أنتظر الصُّبح حتَّى أغير على الكفَّار. فعليكم بالجهاد، لقد شهدت كذا، وكذا زحفاً، وما في جسدي موضع شبرٍ إِلا وفيه ضربةٌ بسيفٍ، أو رميةٌ بسهمٍ، أو طعنةٌ برمحٍ، وها أنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء ! لقد طلبت القتل في مظانِّه، فلم يُقَدَّرْ لي إِلا أن أموت على فراشي.
وأوصى خالدٌ أن يقوم عمر على وصيَّته، وقد جاء فيها: وقد جعلتُ وصيَّتي، وتركتي، وإِنفاذ عهدي إِلى عمر بن الخطَّاب، فبكى عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال له طلحة بن عبيد الله: إِنَّك وإِيَّاه كما قال الشاعر:
لاَ أَلْفَيَنَّك بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْدُبُنِي وَفِي حَيَاتِي مَا زَوَّدْتَنِي زَادِي
فقد حزن عليه الفاروق حزناً شديداً، وبكته بنات عمِّه، فقيل لعمر أن ينهاهنَّ، فقال: دعهنَّ يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقعٌ، أو لقلقةٌ، على مثل أبي سليمان تبكي البواكي.
وقال عنه: قد ثَلَمَ في الإِسلام ثلمةً لا ترتق، وليته بقي ما بقي في الحمى حجر، كان والله سداداً لنحور العدوِّ، ميمون النَّقيبة. وعندما دخل على الفاروق هشام بن البختري في ناسٍ من بني مخزوم، وكان هشام شاعراً، فقال له عمر: أنشدني ما قلت في خالد، فلمَّا أنشده؛ قال له: قصَّرت في الثَّناء على أبي سليمان ـ رحمه الله ـ إِن كان ليُحبُّ أن يذلَّ الشِّرك وأهلُه، وإِن كان الشَّامت به لمعترضاً لمقت الله، ثمَّ تمثَّل بقول الشَّاعر:
فَقُلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِلافَ الَّذِي مَضَى تَهَيَّأْ لأُخْرَى مِثْلَهَا فَكَأنْ قَدِفَمَا
عَيْشُ مَنْ قَدْ عَاشَ بَعْدِي بِنَافِعِي وَلا مَوْتُ مَنْ قَدْ مَاتَ بَعْدِي بِمُخْلِدِي
ثمَّ قال: رحم الله أبا سليمان ! ما عند الله خيرٌ له ممَّا كان فيه، ولقد مات فقيداً، وعاش حميداً، ولقد رأيت الدَّهر ليس بقائلٍ. هذا وقد توفي، ودفن بحمص ببلاد الشَّام عام 21 هـ، رحمه الله رحمةً واسعةً، وأعلى ذكره في المصلحين.
للاطلاع على النسخة الأصلية للكتاب راجع الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي، وهذا الرابط:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book172(1).pdf