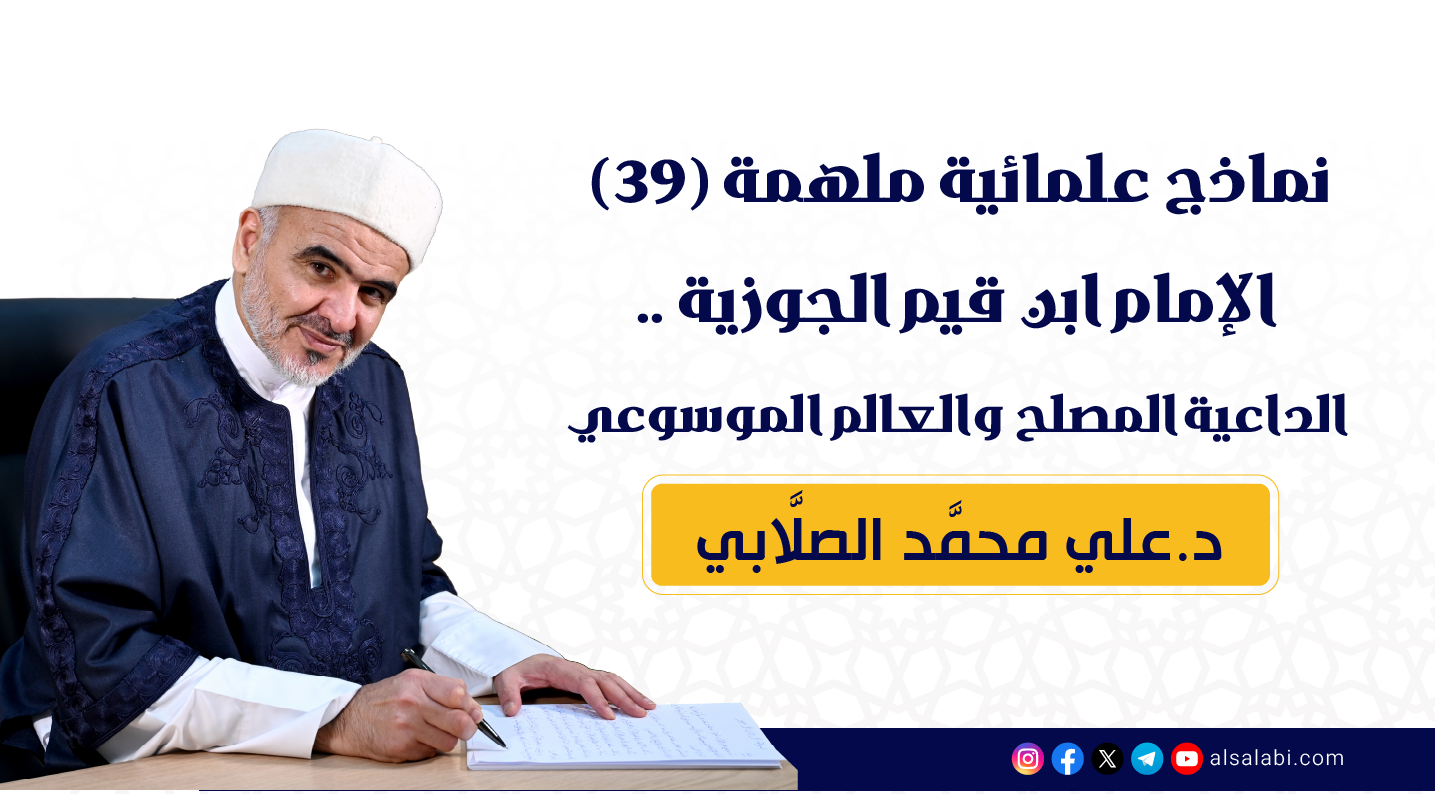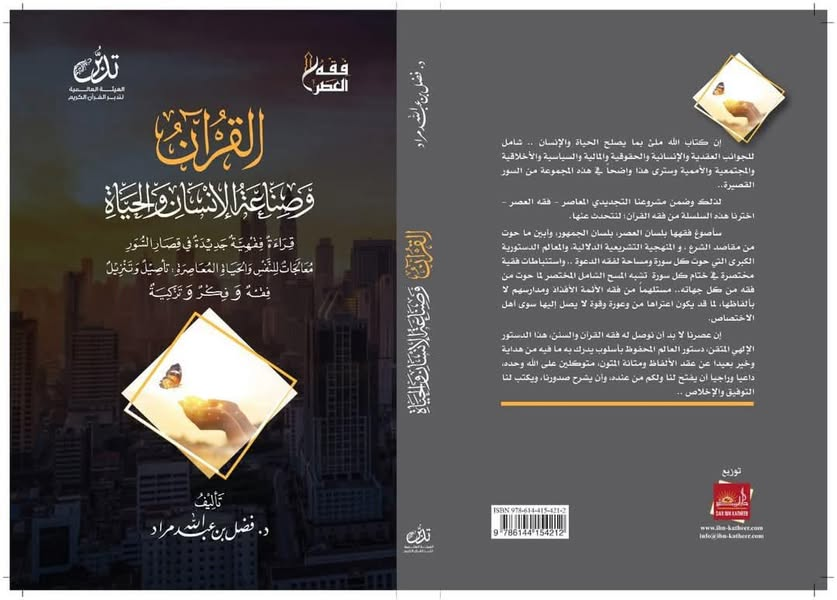نماذج علمائية ملهمة (39)
الإمام ابن قيم الجوزية .. الداعية المصلح والعالم الموسوعي
الكاتب: د. علي الصلابي
(الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)
هو العالم الجليل والإمام الفذ، والعَلَم المتبحر، والمفسر المحدث، العابد، الزاهد، الورع، كثير الصلاة والتهجد، دائم الذكر، طويل الفكر، غزير العلم ، صاحب التصانيف الرائعة، والمصنفات النافعة، النحوي، الأصولي، المتكلم، الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي، المشهور بابن قيم الجوزية.
أولاً: اسمه ونسبه ومولده:
اسمه محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَرِيز، الزُّرَعِي الأصل، ثم الدمشقي، الحنبلي، المشهور بابن قَيِّم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله. ولد ابن القيم سنة (691هـ)، وقال الصفدي: "مولده سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة". وذهب كلٌ من الشيخين شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في ترجمته إلى أن ولادته كانت في "إزرع"، وتحول بعد ذلك إلى دمشق. (الصفدي، الوافي بالوفيات، ج2 ص195)
اشتهر شمس الدين محمد بلقب ابن قيّم الجوزية، وأن سبب شهرته بهذا الاسم هو أن والده «أبا بكر بن أيوب الزرعي» كان قيّمًا على «المدرسة الجوزية» الواقعة بمدينة دمشق مدةً من الزمن، فاشتهر بعد ذلك بلقب «قيّم الجوزية» واشتهرت من بعده ذريته بهذا الاسم. (بكر أبو زيد، ابن قيم الجوزية حياته آثاره، ص. 23-26)
ثانياً: نشأته ورحلته في طلب العلم:
نشأ ابن القيم (رحمه الله) في بيتٍ محبٍّ للعلم، فبدأ بطلبه وهو لا يزال في سن السابعة من عمره. فقد كانت أسرته المحضن التربوي الذي تشكلت فيه شخصيته، وقويَ معها شغفه بالعلم ومعالي الأمور، ورسّخت في مراحل تربيته محاسن الخلق والأدب.
ولموطنه أيضاً دورٌ في تعزيز معارفه وعلومه، فقد كانت دمشق حاضرة العلم في زمانه، واجتمع له فيها كبار أئمة العلم في شتى فنونه، فاستفاد من كل ذلك، بفضل الله ثم شخصيته وقدراته العلمية المتفوقة.
وكان لوالده الفضل أيضاً في تحصيله العلمي، فيقول ابن كثير عن والد ابن القيم في البداية والنهاية: "الشيخ العابد: أبو بكر" ويصفه فيقول: "كان رجلًا صالحًا، متعبدًا، قليل التكلف، وكان فاضلًا"، وكان لهذه الاستقامة أثرها في شخصية ابن القيم، وزاد من قوة تأثير أبيه عليه، طبيعة عمله قيّمًا لمدرسة الجوزية واحتكاكه الدائم بأكابر العلماء وأفاضلهم، حيث تتلمذ ابن القَيِّم على يده في هذا العلم. (غاية النهاية في طبقات القرّاء، ج1 ص198)
ورحل ابن القيم (رحمه الله) مسافات طويلة من أجل السماع والتحصيل من العلماء في بلدان أخرى. فقد خرج ابن القيم للاجتماع بالأئمة والعلماء للاستفادة من علمهم ومذاكرتهم في المسائل العلمية، حيث أشار المقريزي إلى أن ابن القيم "قدم القاهرة غير مرة"، وارتحل في طلب العلم إلى مصر ونابلس والقدس وطرابلس ومكة كما يذكر المؤرّخون، وسمع من عدد كبير من الشيوخ، منهم والده «أبو بكر بن أيوب» فأخذ عنه الفرائض، وأخذ عن «ابن عبد الدائم»، وعن «أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» أخذ التفسير والحديث والفقه والفرائض والأصلَين، وعلم الكلام، وقد لازمه منذ قدوم ابن تيمية إلى مدينة دمشق حتى توفي (رحمه الله)، وعلى هذا تكون مدة ملازمته ودراسته على ابن تيمية سبعة عشر عاماً تقريباً. (صالح الشامي، الإمام ابن قيم الجوزية، ص41)
ثالثاً: سيرته:
- تولّيه التدريس:
نشأ ابن القيم (رحمه الله) في أحضان العلم، متردداً بين حلقاته، وذكرت التراجم أعماله في التدريس والفتوى والإمامة والتأليف. ذكر المترجمون لابن القيم إمامته «بالمدرسة الجوزية»، فيقول ابن كثير عنه: "هو إمام الجوزية وابن قيّمها"، وهذا يدل على أن إمامة جامع مدرسة الجوزية كانت العمل الذي أسند إليه، ويفيد ابن كثير أيضاً في سرده، خطابةَ ابن القيم في أحد جوامع دمشق فيقول: «وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ابن خليخان، خطب فيه الشيخ الإمام العلّامة شمس الدين ابن قيم الجوزية»، ويذكر ابن بدران أن ابن القيم أول من خطب به. (ابن كثير، البداية والنهاية، ج14 ص234 – 174)
ولم تكن مدرسة الصدرية مدرسته الوحيدة؛ فقد سبق أن درس في عدة مدارس لكن لم يحددها كتاب التراجم.
- اتصاله بابن تيمية:
كان لابن تيمية (رحمه الله) تأثير كبير على ابن القيم، وله أثرٌ واضح في ثقافته وتكوين مذهبه، واعتنى المؤرّخون بالوقت الذي التقيا به، فحددوه في سنة 712هـ/1313م، وهي السنة التي رجع فيها ابن تيمية من مصر إلى دمشق، فلازم ابن القيم مجلسه من ذاك العام، فأخذ عنه علماً جمّاً واتسع مذهبه، وهذب كتبه، وقد كانت مدة ملازمته له سبعة عشر عاماً تقريباً. (البداية والنهاية، مرجع سابق، ج14 ص234)، يقول ابن حجر العسقلاني: «وهو الذي هذّب كتبه - أي كُتب ابن تيمية - ونشر علمه، وكان ينتصر له في أغلب أقواله». وقد حصل لابن القيم بسبب اتصاله بابن تيمية، ونصره لمذهبه وتمسكه به، كثير من المضايقات؛ فقد حُبس، وأنكر عليه بعض الفقهاء في عدد من المسائل التي انتصر فيها لرأي ابن تيمية. وقد حبس معه في حبسه الأخير الذي توفي فيه، ويذكر ابن حجر أنه اعتقل بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية. (ابن قيم الجوزية حياته آثاره، ص136 - 137)=
رابعاً: مذهبه الفقهي:
وصفت معظم كتب التراجم مذهب ابن القيم بالحنبلي، وذلك لأنه نشأ في مدارس هذا المذهب، بالإضافة إلى أن أسرته كانت تتمذهب به، وقد كان والده أبو بكر الزرعي قيمًا على «المدرسة الجوزية». ولكن ابن القيم بعدما شبَّ واتصل بشيخه ابن تيمية، حصل تحول بحياته العلمية، لا بمعنى تركه المذهب، وإنما أصبح يُعنى بالدليل من الكتاب والسنة، ويتبعه حتى لو كان ذلك مخالفًا لمذهبه. (الإمام ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص102)
وقد كان يحث على هذا الطريق، فيقول في كتابه «مدارج السالكين»: "فيا أيها القارئ له، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته وعليه تبعته، فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال، لا إلى من قال، وقد ذمَّ الله تعالى من يردُّ الحق إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من يحبه. فهذا خلق الأمة الغضبية، قال بعض الصحابة: اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضًا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبًا". (ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج3 ص522)
ويعده بعض العلماء حنبليًا لا يخرج به عن دائرة المذهب، وبعضهم يعده مجتهدًا في المذهب، وبعضهم يعده مجتهدًا مطلقًا. يقول ابن العماد الحنبلي في ترجمته له: «الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق». ويقول الشوكاني في ترجمته: «شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، العلامة الكبير، المجتهد المطلق، المصنف المشهور». (الإمام ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص102)
خامساً: علمه:
وأما علمه الذي تلقاه وبرع فيه فهو يكاد يعمّ علوم الشريعة وعلوم الآلة، فقد درس التوحيد، وعلم الكلام، والتفسير، والحديث، والفقه وأصوله، والفرائض واللغة والنحو، وغيرها على علماء عصره المتفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلا كعبه وفاق الأقران. يقول تلميذه الذهبي: "عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه"، وقال ابن رجب: "الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، العارف، تفقه في المذهب، وبرع وأفتى، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفًا بالتفسير لا يُجارى فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى. والحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله، وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام، والنحو وغير ذلك، وكان عالماً بعلم السلوك، وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فنٍّ من هذه الفنون اليد الطولى". وقال أيضًا: "ولا رأيت أوسع منه علمًا، ولا أعرفَ بمعاني القرآن والسنة، وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله".
(ابن قيم الجوزية حياته آثاره، مرجع سابق، ص136 - 137)
سادساً: الإمام المصلح:
كان ابن القيم إماماً لجامع مدرسة الجوزية وخطيباً في جامع خليخان، وهذان العملان يجعلانه على صلة دائمة بالناس، يعيش معهم قضاياهم وهمومهم، ويتعرف على الانحرافات التي تغزو مجتمعهم، ومن هنا تبدأ مهمة العالم والمصلح.
فمنهج ابن القيم في الإصلاح هو العمل على ربط الناس برسولهم ﷺ اقتداء وتأسياً، وهو ما ألحًّ عليه في كتابه "زاد المعاد"؛ حتى إنه في العبادات قدّمها وصفاً لأفعال الرسول ﷺ فيها، ولم يقدمها بلغة «الفقه» من أركان وشروط وسنن، وما ذاك إلا لربط المسلم بنبيه مباشرة، كما طالب الناس بمطالعة السيرة المباركة، وحثهم على ذلك، لأن سعادة العبد في الدارين معلّقة بهديه ﷺ.
كما بذل ابن القيم جهداً كبيراً في الوصول إلى غايته "إصلاح القلوب"، فتعددت كتبه وكثرت مقالاته، فوصف أمراض القلب وبين أعراضها ووضع العلاج بين أيدي المرضى، كما دعا الأصحاء إلى اتخاذ الوقاية من هذه الأمراض، فبذل من وقته الشيء الكثير للدلالة على الحق والإرشاد إلى الصواب. (الإمام ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص305)
سابعاً: منهجه في التأليف:
تمّيزت مؤلفات ابن القيم بعذوبة الأسلوب، وحسن السياق، وجمال المعاني وجاذبية العبارات، وقد ألّف ابن القيم في مواضيعٍ بالغة الأهمية، تعتني بسلامة القلوب والثبات على الاستقامة والإخلاص في الدين، والتشويق للجنة ووعد الله للمؤمنين. فاعتمد ابن القيم (رحمه الله) في منهجه على الكتاب والسنة، يستنبط الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهلٍ مبسطٍ خالٍ من التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، متطلباً نشر التشريع وبث التوجيه رداً إلى الله ورسوله، وإلى أن يرد الناس منابع الشريعة الأولى .... وهذا منهج أصيل في عامة كتبه ومباحثه. (ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ص103)
كما نهج ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل العلم منهج الاسترواح والتطلب من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإن لم يجد أخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أبر الأمة قلوباً وأعمقها ديناً وأصحها فهوماً. وهذه صفات بارزة وسمات ظاهرة في جميع مباحثه في العقائد والأحكام، ولهذا أفاض رحمه الله تعالى بالاستدلال لهذا الأصل ووجوب الأخذ به والعمل بموجبه من ستة وأربعين وجهاً بسطها في كتابه «إعلام الموقعين». (ابن قيم الجوزية حياته آثاره، مرجع سابق، ص86 – 89)
ثامناً: وفاته:
ذكر كل من ترجم له (رحمه الله) أن وفاته كانت في ليلة الخميس، الثالث عشر من رجب، وقت أذان العشاء، سنة إحدى وخمسين وسبع مائة للهجرة، (٧٥١هـ)، وقد كمل له من العمر "ستون سنة". وأقيمت صلاة الجنازة عليه بالجامع الأموي، ثم بجامع جراح، ودفن بمقبرة الباب الصغير عند والدته. قال ابن كثير عن جنازته : وقد كانت جنازته حافلة (رحمه الله)، شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة ، وتزاحم الناس على حمل نعشه. (ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، ج14 ص234)
المراجع:
1- الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، المحقق: أحمد الأرناؤوط، دار إحياء التراث - بيروت، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
2- ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة - الرياض- السعودية، ط1، 1412ه.
3- الإمام ابن قيم الجوزية " أعلام المسلمين"، صالح أحمد الشامي، دار القلم – دمشق، ط1، 1429ه – 2008م.
4- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد إياك نستعين، للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الصميعي – السعودية، ط1، 1432ه، 2011م.
5- غاية النهاية في طبقات القرّاء، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، مكتبة ابن تيمية.
6- البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف - بيروت-لبنان.