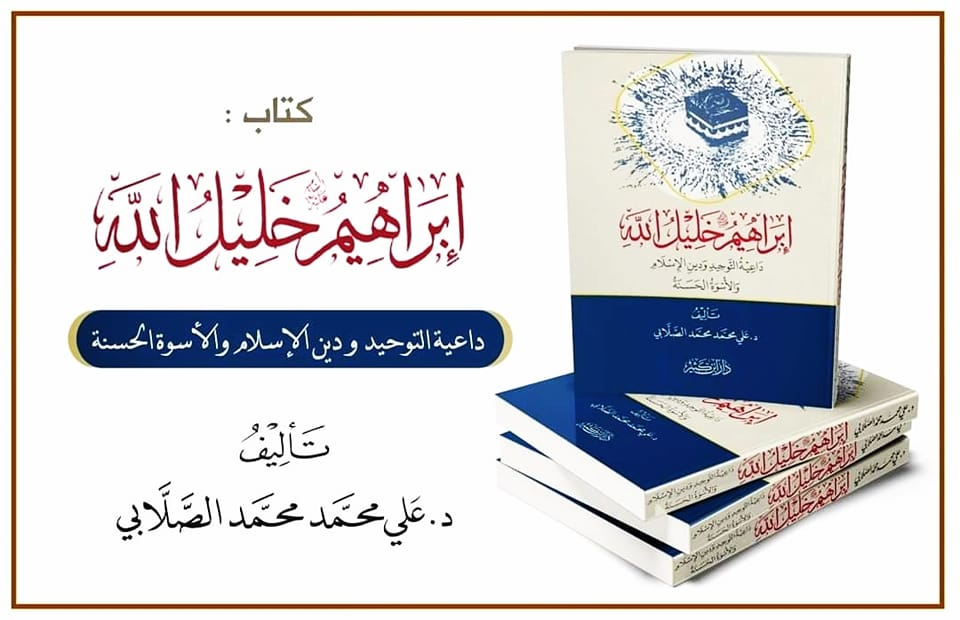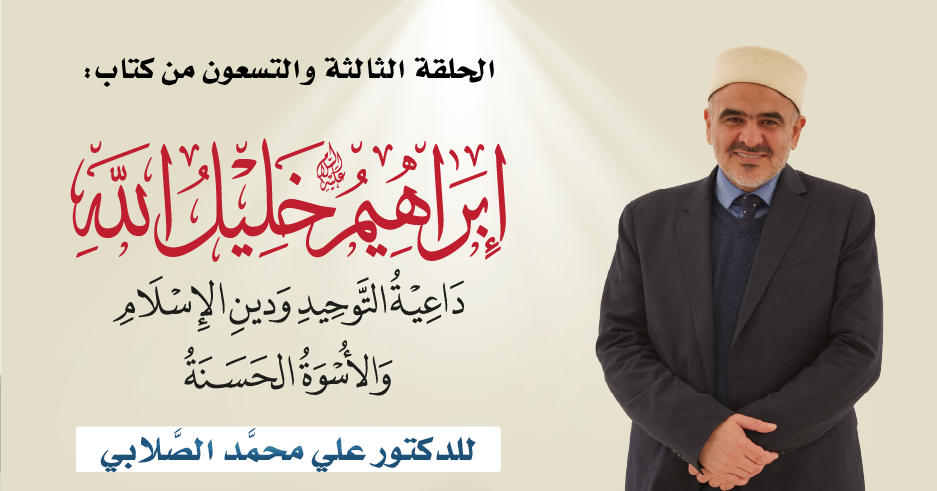تأملات في الآية الكريمة: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 95
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1444ه / سبتمبر 2022م
تعدُّ هذه الآية من اللطائف والتعابير الدقيقة في التعبير القرآني بالفعل "نكس": النون والكاف والسين أصل يدلُّ على قلب الشيء، والنكس: قلب الشيء على رأسه، نكسه، ينكسه نكساً، فانتكس وهو ناكس، ونكس رأسه أي: أماله، ونكّسه تنكيساً ونكس فلان رأسه، إذا طأطأه من ذُل، وقال: النكس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء وردّه وجعل أعلاه أسفله ومقدّمه مؤخره، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلّى الله عليه وسلّم: تعس عبد الدينار وانتكس، أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس أمره فقد خاب وخسر، والولادُ المنكوس: أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه؛ لأنه مقلوب مخالف للعادة(1).
وردت مادة "نكس" في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بثلاث صيغ، هي:
- الأولى على صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي "نكس"، في قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} ]السجدة:12[.
- والثانية على صيغة المضارع المضعَّف "ينكّس" وذلك في سورة يس، قال تعالى: {وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ} ]يس:68[.
- والثالثة على صيغة الماضي المبني للمفعول نُكِس، وذلك في سورة الأنبياء، قال الله تعالى: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ} ]الأنبياء:65[(2).
وفي قوله تعالى: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ} أي: رجعوا عما عرفوا من الحُجة لإبراهيم - عليه السّلام -، وقال الغرناطي: ثم نكسوا على رؤوسهم استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، ويحتمل أن يكون على حقيقته أي: أطرفوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة قلت: وإذا تلوت أخي المسلم قوله: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ}، وأنت متذكر الدلالات الحسية والمعنوية الواردة في النكس والانتكاس؛ فسترى العجب في هذا التعبير القرآني إذ أنك ستبصر أقواماً انقلبوا على رؤوسهم وجعلوا أعلاهم أسفلهم، ووضعوا هاماتهم موضع أقدامهم، فظهروا في مظهر ساخر مزرٍ؛ لأنهم ركبوا رؤوسهم، فانقلب إذعانهم إلى مكابرة، وقالوا في لجاجهم وعنادهم: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ} والمعنى: علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تجيب، فكيف تأمرنا بسؤالهم؟
وهذا القول اعتراف من القوم بعجز الآلهة، وأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال في فعلهم، وعندئذ برزت حجة إبراهيم - عليه السّلام - مُدويّة مجلجلة، تقرع الآذان وتفحم الألسنة بهذا الكلام البليغ، وبهذا التوبيخ العنيف الوارد في سورة الصافات وفي سورة الأنبياء(3).
وفي قوله تعالى: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ}، وحقاً لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس، وكانت الثانية نكسة على الرؤوس، كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب، حيث كانت الأولى حركة في النفس للنظر والتدبّر، وأما الثانية فكانت انقلاباً على الرأس فلا عقل ولا تفكير، وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو الحجّة عليهم، وأية حجّة لإبراهيم – عليه السّلام - أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟(4).
وفي قوله تعالى: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ}، أقرَّ القضاة بعجز أصنامهم واتصافها بالنقص، مما يتنافى مع تأليهها وعبادتها، وهو ما كان إبراهيم - عليه السّلام - يسعى إليه، ولعلّها أوّل مرة في التاريخ يقوم المتهم باستجواب قضاته، ويأخذ منهم اعترافاً بظلمهم، وإقرارهم بخطئهم، مما يؤهله لإصدار الحكم عليهم وأصبح إبراهيم - عليه السّلام - هو القاضي والحاكم مع أنه في قفص الاتهام، وأصبح القضاة هم المتهمين، المعترفين بالجريمة، وهم وراء منصة الحكم وأصدر - عليه السّلام - حكمه منكراً وموبخاً(5)، فقال: { أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا...}.
مراجع الحلقة الخامسة والتسعون:
( ) من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين، محمد فؤاد سندي، ص 145.
(2) المرجع نفسه، ص146.
(3) من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين، محمد فؤاد سندي، ص147.
(4) في ظلال القرآن، سيد قطب، (4/2387).
(5) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (5/267).
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي