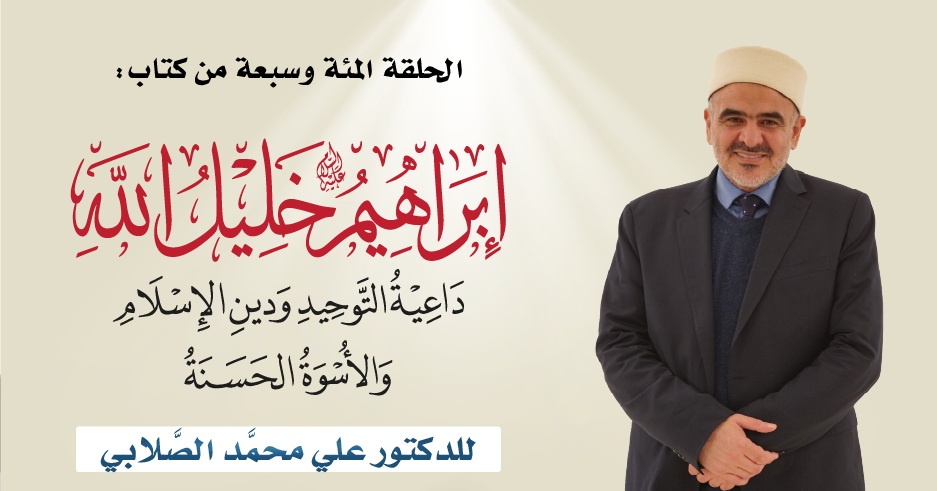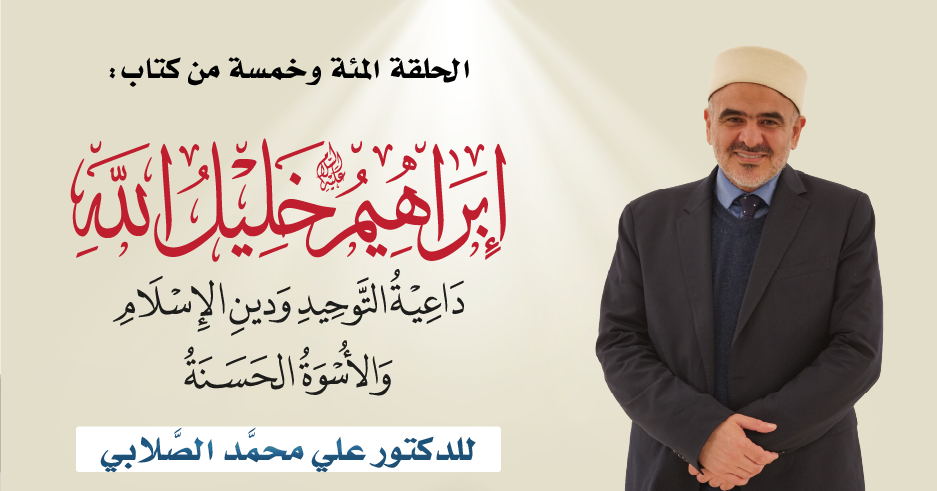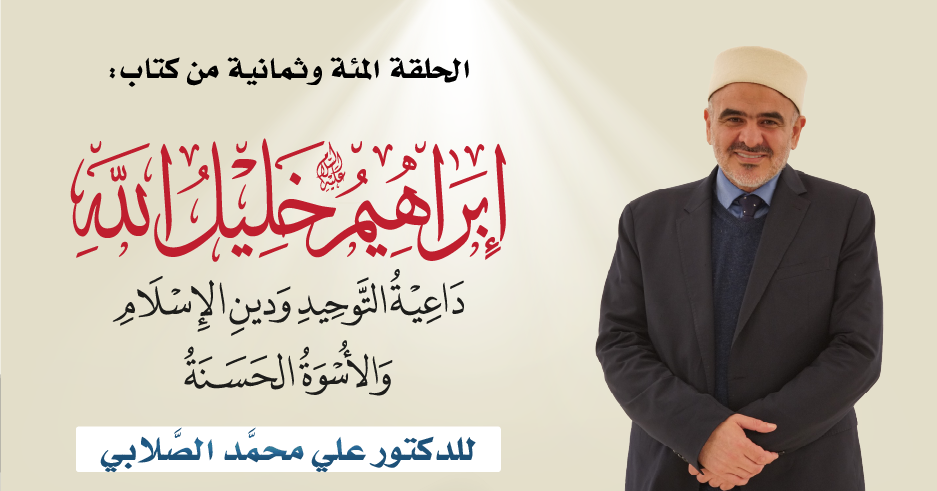تأملات في الآية الكريمة: {أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 107
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ربيع الأول 1444ه / أكتوبر 2022م
وهم يعلمون أن آلهتهم لم تقدّم لهم يوماً شيئاً ينتفعون منه، فكيف يقوم العاجز عن تقديم شيء لنفسه أن يقدمه للآخرين؟ مثلما أنّها ليس لها أن تضرّ أحداً، وقد وصف القرآن الكريم مثل هؤلاء بالضلال قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} ]الأحقاف:51[.
ومرة أخرى يختار النبي إبراهيم - عليه السّلام - كلماته بعناية وبتوفيق رباني، فقد قدّم {يَنْفَعُونَكُمْ} على {يَضُرُّونَ}، وهي فطرة إنسانية، كما هي سنة كونية إلهية حيث إن الإنسان يحبُّ جلب النفع والاستمتاع به قبل كل شيء، فهذا فيما يخصُّ الإنسان ومشاعره، ولكن في التشريع ومصالح الناس، فإن درء المفاسد واجتنابها أوْلى وهي تُقدم، لذلك فإن القاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح؛ لأنَّ المفاسد إن سادت سدّت طرق الوصول إلى المنافع، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة، بل هو أصل من أصولها(1).
وقد أشار إبراهيم - عليه السّلام - إلى {يَضُرُّونَ}، وليس "يضرونكم"، وفي ذلك إشارة لهم إلى أن هذه الآلهة لن تستطيع أن تضرَّ أحداً من الخلق حتى الكافرين بها وأعدائها، فلما سمعوا ما يقول إبراهيم - عليه السّلام - شعروا بالخيبة والهزيمة، فماذا تُراهم يجيبون؟ إن أجابوا بنعم، فسيقولون لهم اطلبوا منهم الآن شيئاً ولنرى، وإن قالوا لا، هُزموا في الحوار، فهُم بين نارين، أو إنهم بين خيارين، أحلاهما مرّ(2).
وقد قال عليه السّلام لهم: {أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ} ]الصافات:86[، وهو استفهام إنكاري، لقد سمّى آلهتهم إفكاً، والإفكُ في اللغة هو الكذب، فيذكرهم - عليه السّلام - بأن القضية عندهم كذب قائم على كذب، وهذا هو حال متّخذي الآلهة في كل زمان ومكان، فالآلهة المزعومة كذبة وخدعة، وإيهام للناس السذج من العامة البسطاء بأنها آلهة كذبة أخرى لأنّها حجارة صماء، ثم إن خليل الله إبراهيم - عليه السّلام - ألقى عليهم حجة كبيرة بأن ذكّرهم بالله رب العالمين حيث قال لهم كما جاء في سورة الصافات: {فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}.
وجاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله: أي ما ظنكم به إذا لقيتموه، وقد عبدتم غيره؟ فهو تحذير مثل قوله: {مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} ]الانفطار:6[، وقيل: أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره(3).
فهو- عليه السّلام - يذكرهم بأنهم واهمون وبعيدون عن الصواب، وهم يعبدون غير الله رب العالمين، فكل الدلائل والمنطق والتجارب تشير إلى وجود إله واحد للكون هو الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآية دلالة على أن الانصراف عن عبادة ربِّ العالمين سبحانه وتعالى لعبادة غيره من خلقه لهو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، بينما ينبغي أن تدفع الإنسان فطرته ليظن بربه سبحانه ظناً طيباً حسناً، والعبد ملزم بذلك أمام ربه سبحانه وتعالى، يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى أنا عند ظنّ عبدي بي(4).
ومن ذلك كان دأب الصالحين أنهم يحسنون الظنَّ بالله سبحانه وتعالى تقديساً وإيماناً به، وتأميناً وضماناً لأنفسهم ولمستقبلهم في الدنيا والآخرة، وذلك أصل وأساس في ملّة إبراهيم - عليه السّلام -: فعلى قدر حسن ظنّك بربّك ورجائك له، يكون توكّلك عليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولذلك فسّر بعضهم التوكل بحسن الظنّ بالله سبحانه وتعالى(5).
ويوجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المؤمنين قبل موته بثلاثة أيام - فهي وصية مودّع - أن يكون حسن ظنهم بالله ربهم سبحانه وتعالى اعتقاد جازم ويقين لا شكّ فيه، لا مجرّد خاطرة عابرة فهو يقول: لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزّ وجل(6).
قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله: أنا عند ظنّ عبدي بي، قيل: معناه بالغفران له إذا استغفرني، والقبول إذا أناب إليّ، والإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني؛ لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوي يقينه، قال: يحتمل أن يكون تحذيراً مما يجري في نفس العبد، مثل قوله سبحانه: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} وقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ}، وقال الخطابي في قوله صلّى الله عليه وسلّم: لا يموتنّ أحدكم إلا وهو حسن الظنّ بالله، يعني: في حسن عمله، فمن حَسُن عمله حسُن ظنّه، ومن ساء عمله ساء ظنّه، وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو(7).
ولكن قوم إبراهيم - عليه السّلام -، وكأي مجادل لا بُدّ لهم أن يجيبوا، أو يعلنوا هزيمتهم، ويبدو أنهم توصلوا لجواب يعتقدون أنه لا يُناسب، فقالوا لإبراهيم - عليه السّلام -: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون (8).
مراجع الحلقة السابعة بعد المائة:
(1) ملة أبيكم إبراهيم، عبد الستار كريم المرسومي، ص44.
(2) المرجع نفسه، ص 44.
(3) تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، (15/92).
(4) صحيح البخاري، رقم (7405).
(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية، (2/121).
(6) صحيح مسلم، رقم (81).
(7) شرح صحيح مسلم (إكمال المعلم بفوائد مسلم)، القاضي عياض، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419هـ، 1998م، (8/172).
(8) ملة أبيكم إبراهيم، عبد الستار كريم المرسومي، ص36
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي