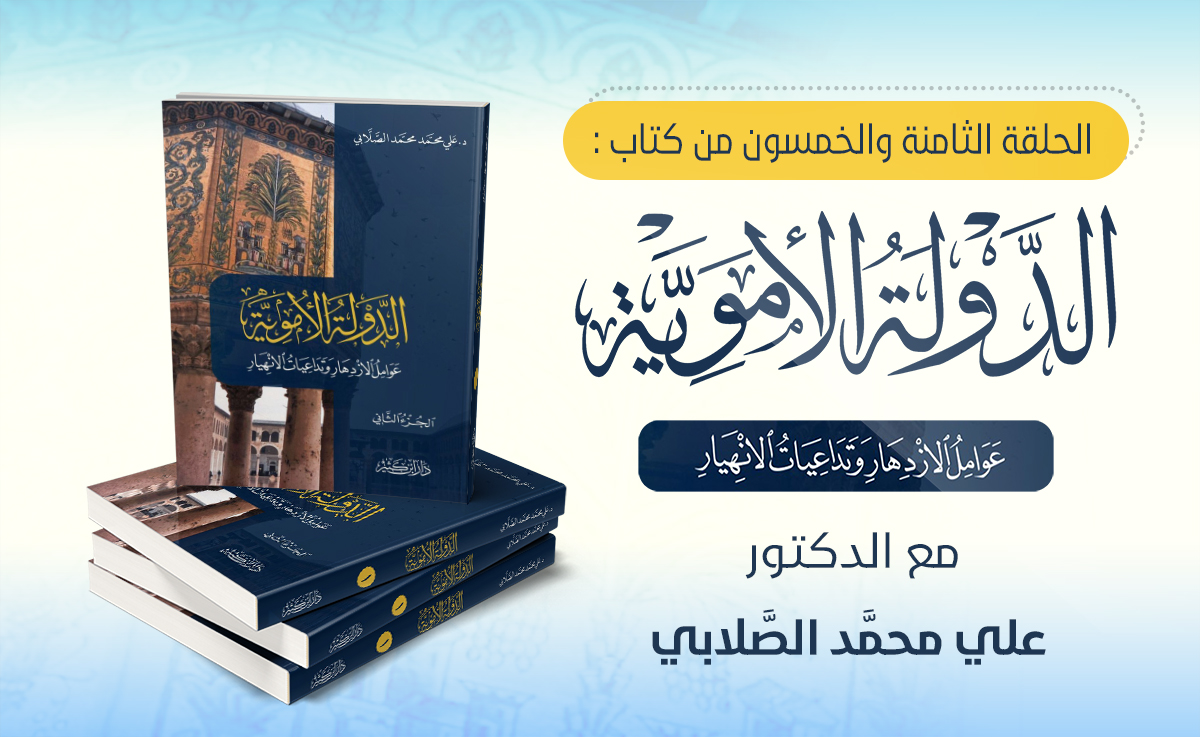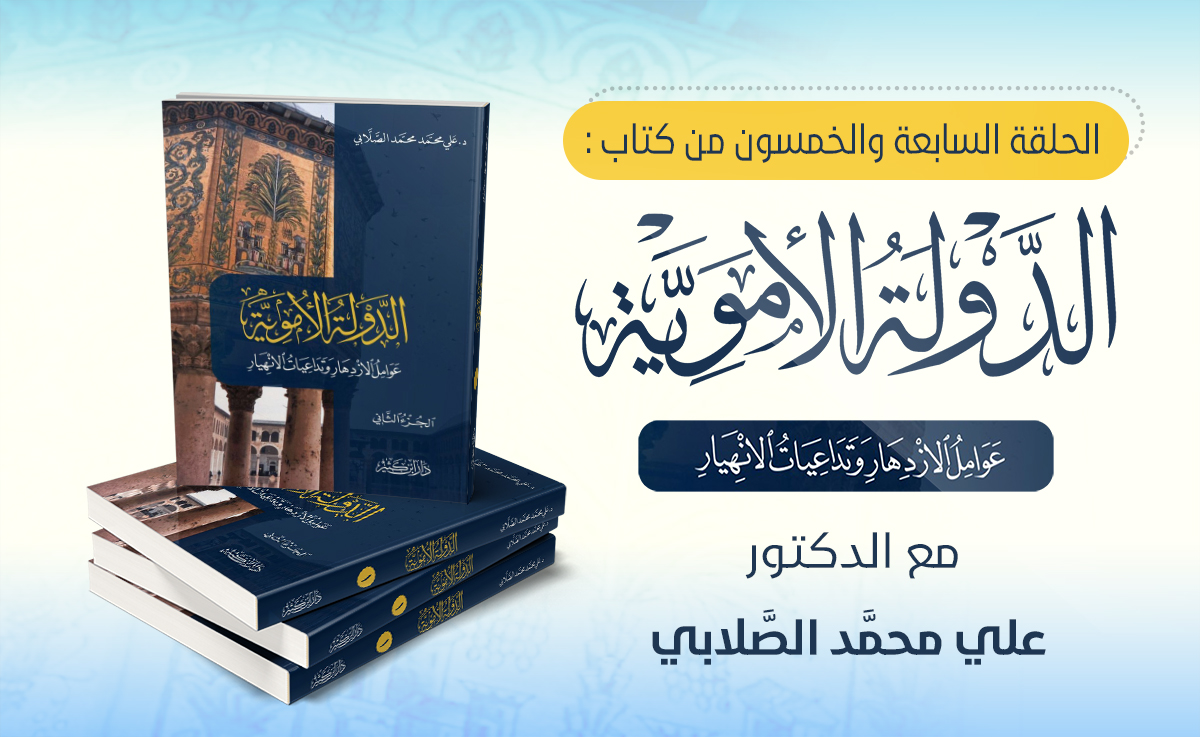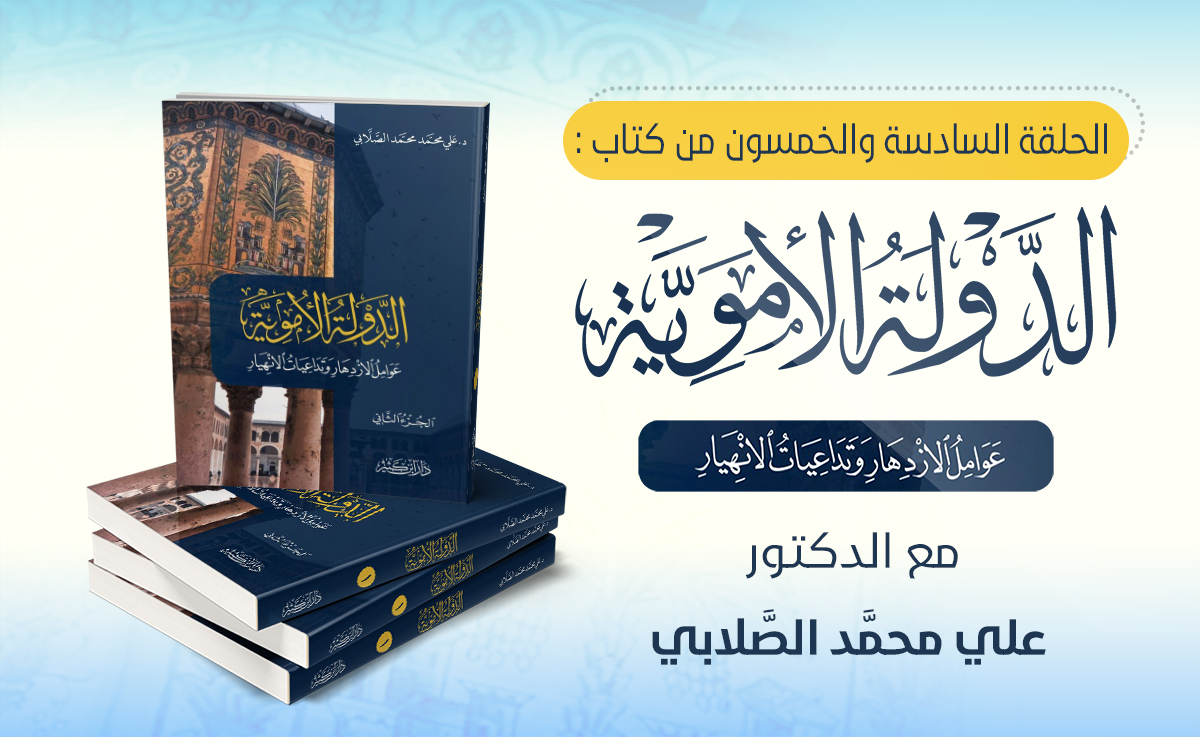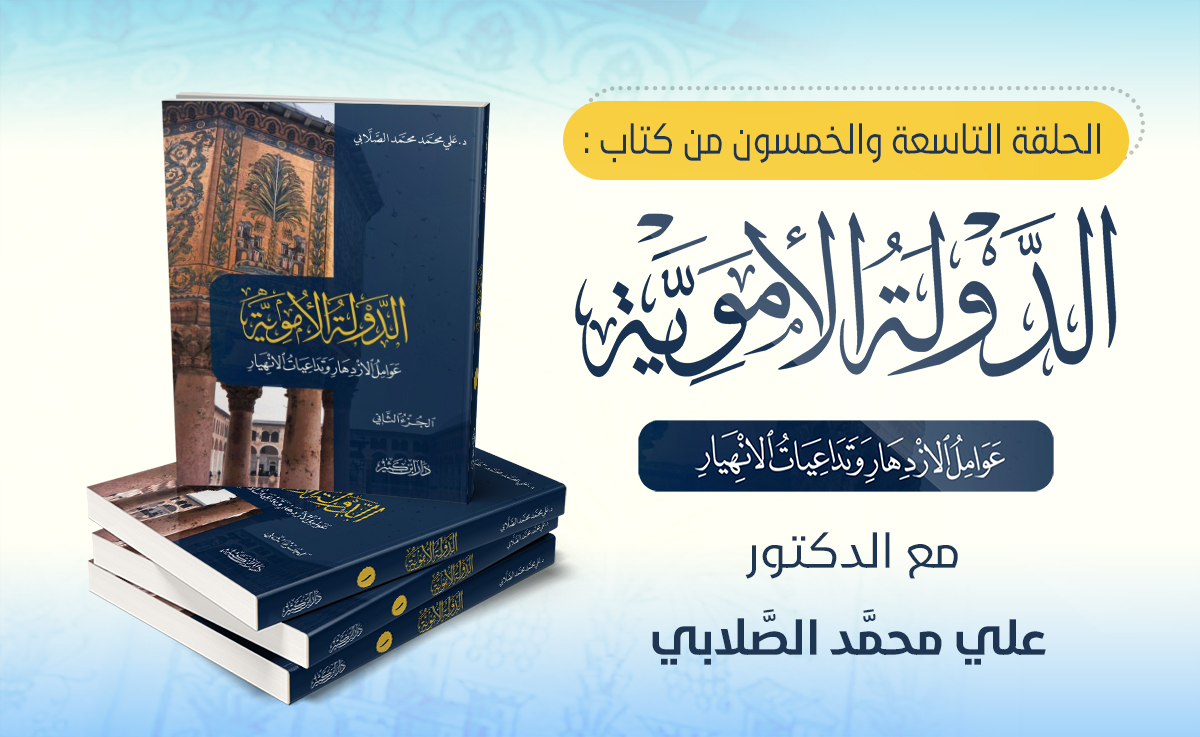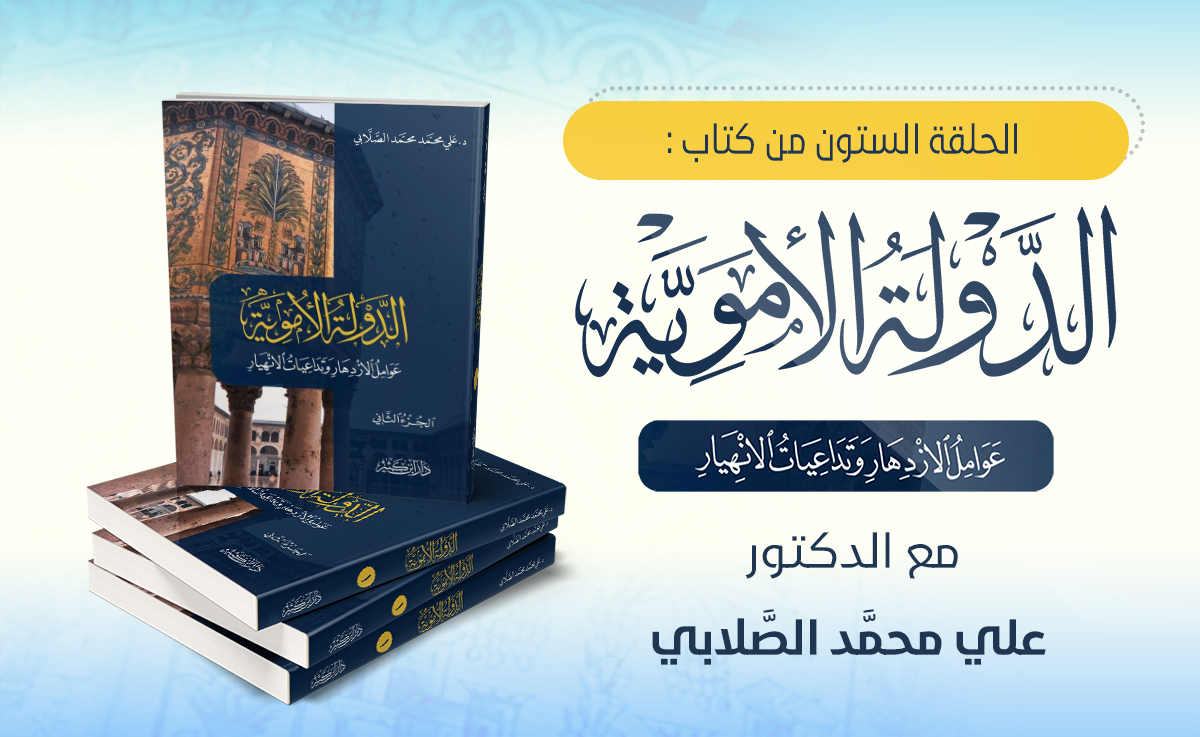من كتاب الدولة الأموية: خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
(بناء مدينة القيروان)
الحلقة: الثامنة والخمسون
بقلم الدكتور: علي محمد الصلابي
ربيع الأول 1442 ه/ أكتوبر 2020
في سنة 50 هـ بدأت إفريقية الإسلامية عهداً جديداً مع عقبة بن نافع، المتمرس بشؤون إفريقية منذ حداثة سنّه، فقد لاحظ كثرة ارتداد البربر، ونقضهم العهود، وعلم أن السبيل الوحيد للمحافظة على إفريقية ونشر الإسلام بين أهلها هو إنشاء مدينة تكون محط رحال المسلمين، ومنها تنطلق جيوشهم فأسس مدينة القيروان وبنى جامعها، وقد مهد عقبة قبل بناء المدينة لجنوده بقوله: إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام، فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزاً للإسلام إلى اخر الدهر، فاتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين، وقالوا: نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط، فقال عقبة: إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يوجب فيه التقصير للصلاة فهم مرابطون، ولم يعجبه موضع القيروان الذي كان بناه معاوية بن حديج قبله، فسار والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم، وكان موضع غيضة لا يرام من السباع والأفاعي، فدعا عليها، فلم يبق فيها شيء، وهربوا حتى إن الوحوش لتحمل أولادها.
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: يا أهل الوادي! إنا حالون إن شاء الله، فاظعنوا، ثلاث مرات فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطنا بطن الوادي: ثم قال للناس: انزلوا بسم الله، وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوة، وقد رأى قبيل من البربر كيف أن الدواب تحمل أولادها وتنتقل، فأسلموا، ثم شرع الناس في قطع الأشجار، وأمر عقبة ببناء المدينة، فبنيت وبني المسجد الجامع، وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وتم أمرها سنة 55هـ وسكنها الناس، وكان في الناس، وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا، فتغير وتنهب ودخل كثير من البربر الإسلام، واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان، وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها.
وتم تخطيط مدينة القيروان على النمط الإسلامي، فالمسجد الجامع ودار الإمارة توءمان، لا ينفصل أحدهما عن الاخر، فهما دائماً إلى جوار بعضهما، ويكونان دائماً في قلب المدينة التي يخططها المسلمون ويرتكزان في وسطها، وبينهما يبدأ الشارع الرئيس للقيروان، الذي سيسمى باسم السماط الأعظم، ثم ترك عقبة فراغاً حول المسجد ودار الإمارة في هيئة دائرة واسعة، ثم قسمت الأرض خارج الدائرة إلى خطط القبائل، ليكون استمراراً للشارع الرئيسي في الاتجاهين إلى نهاية المدينة.
وانجفل البربر من نواحي إفريقية إلى القيروان، وسكنوا حولها، وكان الكثير منهم دخل في الإسلام، وشرعوا في تعلم اللغة العربية والقران الكريم وأمور دينهم، وهكذا نشاهد فيما بين سنتي 50 و55 هـ حركة قوية بدأت في تعريب الشمال الإفريقي.
1 ـ الخصائص المتوفِّرة في موضع القيروان:
كانت الدوافع السياسية والعسكرية والإدارية والدعوية دوافع قوية في قرار عقبة في اتخاذ موقع القيروان، فقد تميز موقع القيروان بالآتي:
أ ـ بأنه لا يفصله عن مركز القيادة العسكرية في الفسطاط أي بحر أو نهر: فهو يقع على الطريق البري الذي يربط بين الفسطاط (بمصر) وبين المغرب، ويبدو أن عقبة رحمه الله أخذ بنظرية عمر بن الخطاب في بناء الأمصار والمعسكرات بألا يفصلها فاصل من نهر أو بحر أو جسر عن المدينة أو مركز القيادة، وأن تكون على طرف البر أو أقرب إلى البر والصحراء.
ب ـ موافقة الموضع لذهنية العرب ومتطلباتهم الضرورية: وتتجلى هذه الخصوصية من خلال قراءة توصية عقبة بن نافع في أن يكون الموضع قريباً من السبخة: فإن أكثر دوابكم الإبل، تكون إبلكم على بابها في مراعيها..، وكذلك في الكلمات التي عبر عنها أصحاب عقبة عندما استجمع رأيهم في الموضع المنتخب، إذ قالوا: نحن أصحاب أبل ولا حاجة لنا بمجاورة البحر.
جـ. بأنه يتمتع ببعض الإنتاجات والموارد الذاتية، فالمنطقة التي كان فيها موضع القيروان عبارة عن غيضة، كما أورد الجغرافيون، وكان مواجهاً لجبال أوراس، معقل قبائل البربر، إذن فإنه كان في بقعة زراعية تتضمن بعض المحاصيل التي تكفل للمجاهدين المسلمين مورداً غذائياً مهماً.
د ـ صحيح أن المشكلة الرئيسة التي جابهتها القيروان بعد اتخاذها كانت متمثلة بالموارد المائية، كما هي الحال في مدينة البصرة، مع وجود فارق بين المصرين، فإن مياه البصرة كانت مع الأنهار غير أنها مالحة. أما مياه القيروان الصالحة للشرب فكانت تعتمد على مصدرين:
الأول منهما: الأمطار؛ حيث كانت تخزن في صهاريج يطلق عليها اسم (المواجل).
وثانيها: مياه وادي السراويل في قبلة المدينة، لكنه كان مالحاً. لذلك فإن بعض المؤرخين حدد مصدر مياه القيروان قائلاً: وشربهم من ماء المطر. إذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول دخل ماء المطر من الأودية إلى برك عظام يقال لها: (المؤجل).. ولهم وادٍ يسمى وادي السراويل في قبلة المدينة يأتي فيه ماء مالح.. يستعملونه فيما يحتاجونه، ومع ذلك، فإن هذه المشكلة المعقدة يبدو أنها أخذت تتضاءل تدريجياً إلى حد ما.
2 ـ القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمتها العلمية:
لم تبدأ الحياة العلمية المركزة إلا بعد تأسيس القيروان سنة 50 هـ، فسرعان ما أصبحت القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمته العلمية، منها انطلق الدعاة، وإليها رحل طلاب العلم من الافاق، ومما رشح القيروان في هذه المكانة ما يلي:
أ ـ إن إنشاء مدينة القيروان يعني أن إفريقية أصبحت ولاية إسلامية جديدة وجزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي الكبير، وبالتالي سيعيش المسلمون فيها حياتهم العادية، وعلى رأسها التعليم وبث الثقافة الإسلامية، فإن القيروان مدينة رسالة وعلى أهلها تلقى مسؤولية نشر الإسلام في المغرب، فكما كانت منطلق الجيوش الفاتحة، كانت كذلك منطلق الدعاة إلى الأنحاء لنشر الإسلام، وقد شعر الصحابة بهذه المكانة للقيروان منذ تأسيسها.
ب ـ لقد تمَّ بناء الجامع وهو المدرسة الأولى في الإسلام، ولا شك أن الصحابة الذين كانوا في جيش عقبة قد جلسوا للتدريس فيه على النمط الموجود في مدن المشرق انذاك، فقد كان مع عقبة أثناء تأسيس القيروان ثمانية عشر صحابياً، وقد مكثوا فيها خمس سنوات كاملة كان عملهم فيها ـ ولا شك ـ نشر اللغة العربية، وتعليم القران والسنة في جامع القيروان، وذلك أثناء بناء مدينة القيروان، حيث لم تكن هناك غزوات كبيرة تتطلب غياباً طويلاً عن القيروان، أما في غزوة عقبة الثانية فقد كان معه خمسة وعشرون صحابياً، وسائر جيشه من التابعين، وقد انتشرت رواية الحديث النبوي الشريف في هذه الفترة، مما دعا عقبة أن يوصي أولاده ومن ورائهم جميع المسلمين بتحري حديث الثقات، وعدم كتابة ما يشغلهم عن القرآن.
جـ. لقد استقطبت القيروان أعداداً هائلة من البربر المسلمين الذين جاؤوا لتعلم الدين الجديد، قال ابن خلدون عند حديثه عن عقبة: فدخل إفريقية وانضاف إليه مسلمة البربر، فكبر جمعه ودخل أكثر البربر في الإسلام ورسخ الدين، ولا شك أن الفاتحين قد خصصوا لهم من يقوم بهذه المهمة. ومن القيروان انتشر الإسلام في سائر بلاد المغرب، فقد بنى عقبة بالمغربين الأقصى والأوسط عدة مساجد لنشر الإسلام بين البربر، كما ترك صاحبه شاكراً في بعض مدن المغرب الأوسط لتعليم البربر الإسلام، ولما جاء أبو المهاجر دينار لولاية إفريقية تألف كُسيلة وقومه وأحسن إلى البربر، فدخلوا في دين الله أفواجاً، ودعّم حسان بن النعمان ـ فيما بعد ـ جهود عقبة في نشر الإسلام بين البربر؛ حيث خصّص ثلاثة عشر فقيهاً من التابعين لتعليم البربر العربية والفقه ومبادأى الإسلام، وواصل موسى بن نُصير هذه المهمة؛ حيث أمر العرب أن يعلّموا البربر القران، وأن يفقّهوهم في الدِّين، وترك في المغرب الأقصى سبعة وعشرين فقيهاً لتعليم أهله.
د ـ كان كثير من أفراد الجيش قد صحبوا معهم زوجاتهم، ومنهم من اتخذ بإفريقية السراري وأمهات الأولاد، قال أبو العرب: روى بعض المحدثين أن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما غزا مع معاوية بن حديج كانت معه أم ولد له، فولدت له صبية من أم الولد وماتت، فدفنها في مقبرة قريش بباب سلم، فاتخذتها قريش مقبرة يدفنون فيها لمكان تلك الصبية.
ومن هنا كان لا بد من الاهتمام بتعليم النشء المسلم مبادأى الإسلام واللغة العربية، ولذلك فقد نشأت الكتاتيب بالقيروان في وقت مبكر جداً، فقد روي عن غياث بن شبيب أنه قال: كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله ﷺ يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان، فيسلم علينا ونحن في الكُتّاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه، وكان سفيان بن وهب قد دخل القيروان مرتين؛ أولاهما: سنة 60 هـ؛ أي: بعد الانتهاء من تأسيس القيروان بخمس سنوات، والثانية: سنة 78 هـ.
هـ. إن الموقع الجغرافي لمدينة القيروان كان له دور كبير في إثراء الحياة العلمية وإنعاشها، فقد كانت في موقع متوسط بين الشرق والغرب يمرّ بها العلماء والطلبة من أهل المغرب والأندلس في ذهابهم إلى المشرق، فيسمعون من علمائها، وكثير منهم يصبح أهلاً للعطاء عند عودته فيسمع منه أهلها، كما كان يدخلها من يقصد المغرب أو الأندلس من أهل المشرق.
و ـ لقد كانت التجارة في القيروان رابحة والسلع فيها نافقة، ولذلك أَمَّها كبار التجار من المشرق والمغرب وكثير منهم من المحدّثين والفقهاء، فكان ذلك عاملاً مهماً في ازدهار الحياة العلمية بالقيروان
ز ـ وممّا أسهم في تطوُّر الحياة العلمية: كون القيروان انذاك هي العاصمة السياسية، ذلك أنّه كلما جاء أمير جديد اصطحب معه مجموعة من العلماء والأدباء، كما أن كثيراً من المحدثين والفقهاء يفدون إلى العاصمة الإفريقية ضمن الجيوش القادمة من المشرق، والتي استمر مجيئها إلى ما بعد منتصف القرن الثاني، هذا بالإضافة إلى من كان يقصد الأمراء للمدح والتسلية من أهل الشعر والأدب.
ح ـ كما أن القيروان اكتسبت نوعاً من الاحترام والتعظيم باعتبارها البلد الذي أسسه صحابة رسول الله ﷺ، وظهر بها على أيديهم كثير من الكرامات، واستقر بها بعضهم مدة من الزمن، وهي اخر ما دخله الصحابة من بلاد المغرب.
كل هذه الأمور هيأت القيروان لدور الريادة العلمية في إفريقية والمغرب حتى وصفها أبو إسحاق الجبنياني بقوله: القيروان رأس وما سواها جسد، وما قام برد الشبه والبدع إلا أهلها، ولا قاتل ولا قتل على إحياء السنة إلا أئمتها.
وقد لهج المؤلفون القدامى بفضل القيروان على سائر بلاد المغرب في المجال العلمي؛ من ذلك ما وصفها به ماقديشي بأنها: منبع الولاية والعلوم، فهي لأهل المغرب أصل كل خير، والبلاد كلها عيال عليها، فما من غصن من البلاد المغربية إلا منها علا، ولا فرع في جميع نواحيها إلا عليها ابتنى، كيف لا ومنها خرجت علوم المذهب، وإلى أئمتها كل علم ينسب، ولا ينكر هذا خاص ولا عام، ولا يزاحمها في هذا الفضل أحد على طول الأمد والأيام.
وهكذا أصبحت القيروان دار العلم الإفريقية، وبرز فيها كبار المحدثين والفقهاء والقراء، ورحل إليها أهل المغرب والأندلس لطلب العلم، وقد نافح أهلها عن مذاهب السلف فصارت دار السنة والجماعة بالمغرب، لقد قامت القيروان بدور كبير في فتح شمال إفريقية كله والأندلس، ونشر الإسلام في المغرب، وأصبحت من أهم مراكز الحضارة الإسلامية.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
الجزء الثاني:
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي: