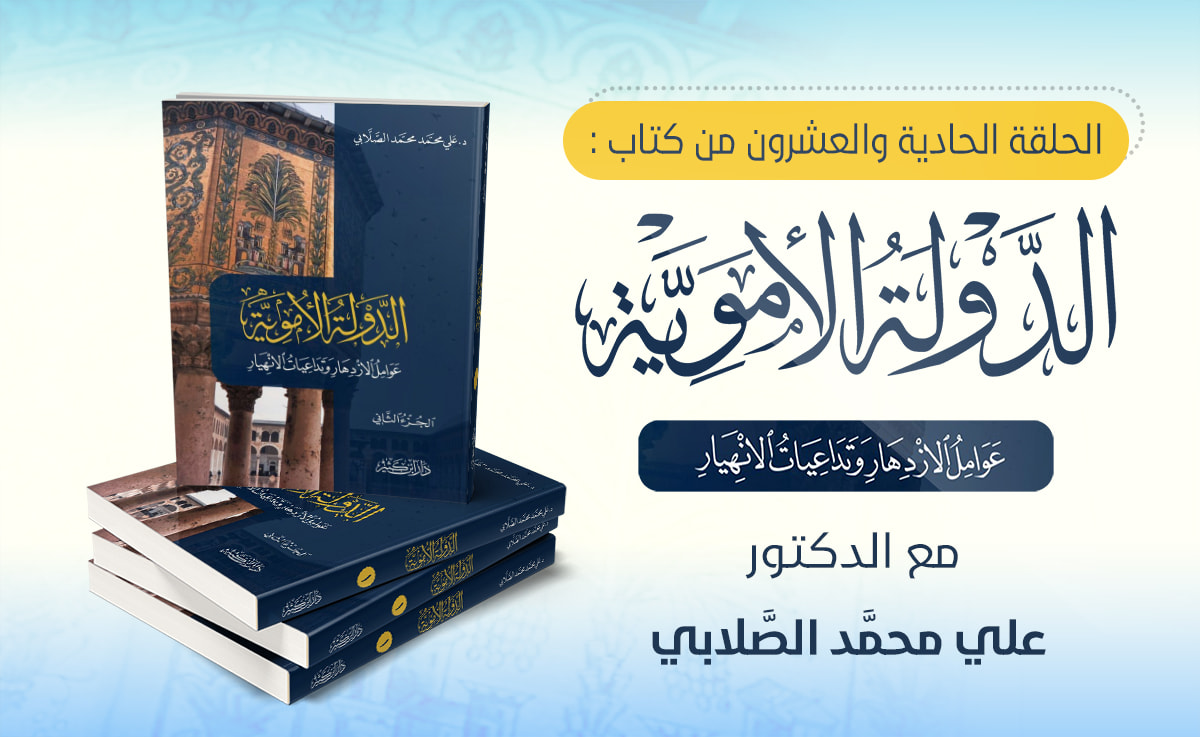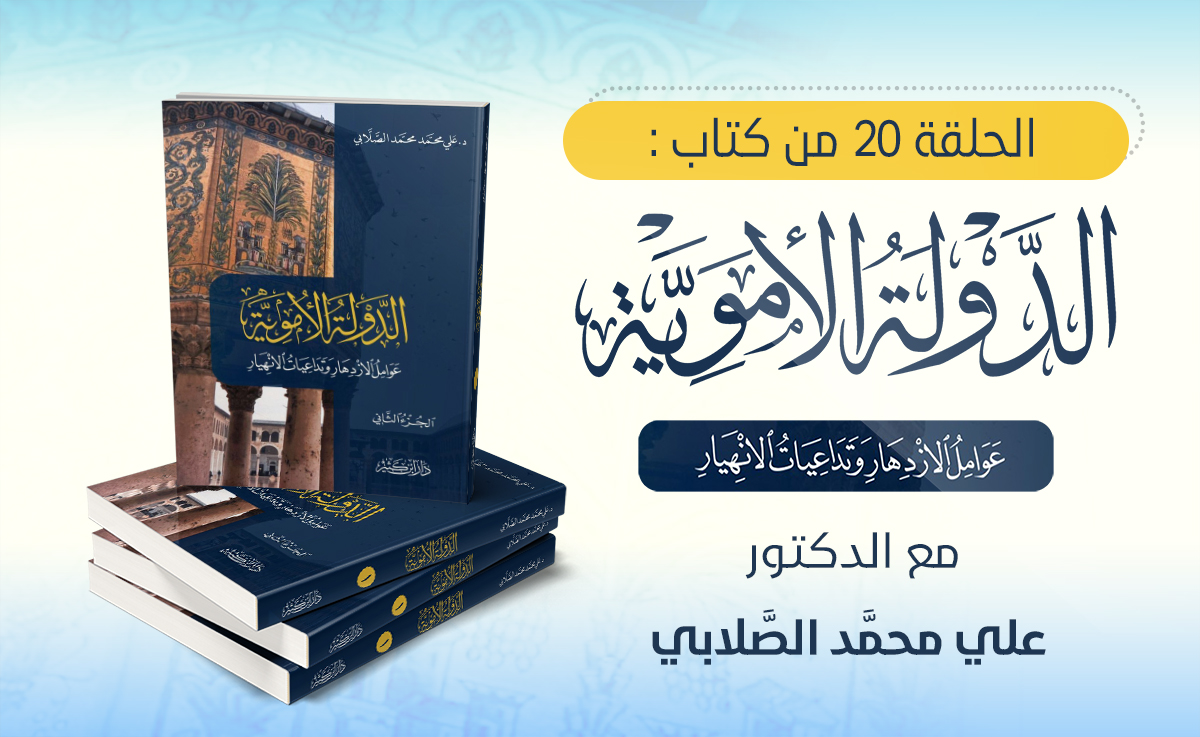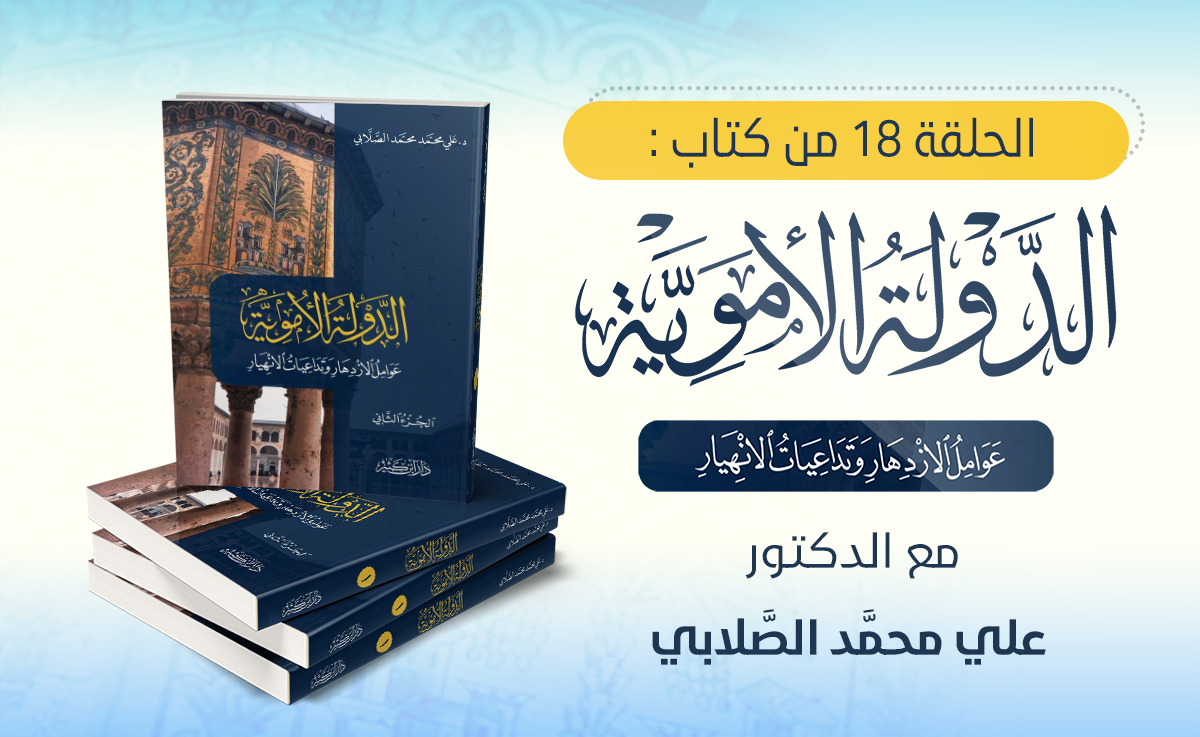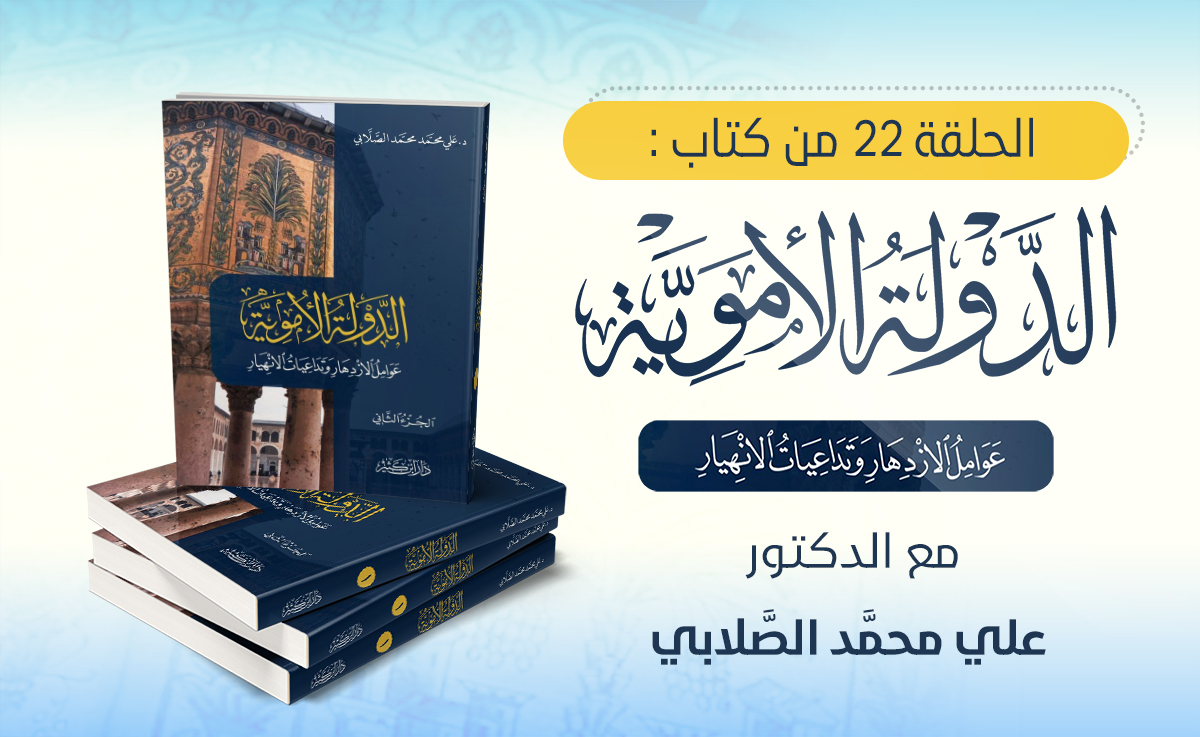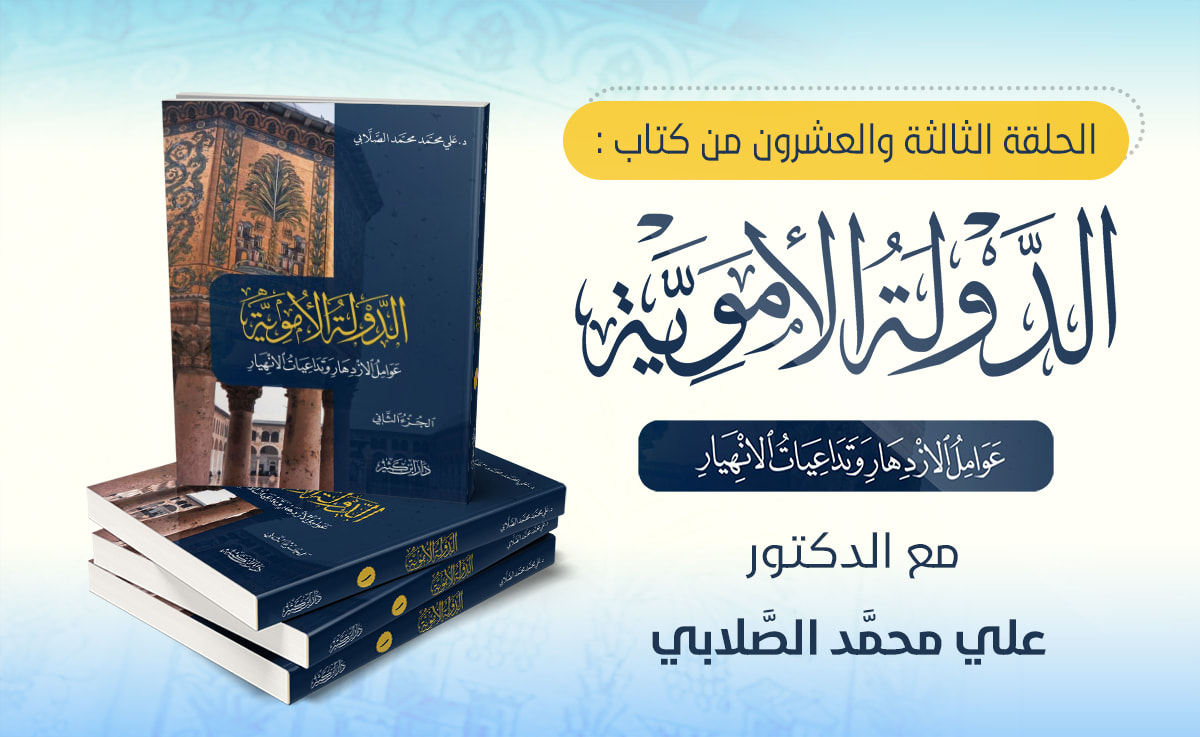الدولة الأموية: عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
(البيعة)
الحلقة: الحادية والعشرون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
محرم 1442 ه/ سبتمبر 2020
بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما اكتملت عوامل تولي معاوية الخلافة ، وتهيأت له جميع أسبابها ، فبويع أميراً للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة ، وسُمي هذا العام بعام الجماعة، وسجل في ذاكرة الأمة عام الجماعة ، وأصبح هذا الحدث من مفاخرها التي تزهو به على مر العصور ، وتوالي الدهور ، فقد التقت الأمة على زعامة معاوية ، ورضيت به أميراً عليها ، وابتهج خيار المسلمين بهذه الوحدة الجامعة ، بعد الفرقة المشتتة ، وكان الفضل في ذلك لله ثم للسيد الكبير مهندس المشروع الإصلاحي العظيم الحسن بن علي بن أبي طالب.
ويعد عام الجماعة من علامة نبوة المصطفى ، وفضيلة باهرة من فضائل الحسن، ولا يلتفت إلى ما قاله العقاد من فهم غير صحيح عن عام الجماعة في هجومه الخاطئ على المؤرخين الذين سموا سنة إحدى وأربعين هجرية بعام الجماعة ، فقد قال: فليس أضل ضلالاً ، ولا أجهل جهلاً من المؤرخين الذين سموا سنة إحدى وأربعين هجرية بعام الجماعة؛ لأنها السنة التي استأثر فيها معاوية بالخلافة فلم يشاركه أحد فيها ، لأن صدر الإسلام لم يعرف سنة تفرقت فيها الأمة كما تفرقت في تلك السنة ، ووقع فيها الشتات بين كل فئة من فئاتها كما وقع فيها، والعقاد رحمه الله لم يأت بجديد في حكمه الخاطئ بل سبقه إليه كثير من مؤرخي الشيعة ، ويكفي معاوية فخراً أن كل الصحابة الأحياء في عهده بايعوه ، فقد أجمعت الأمة على معاوية وبايعه علماء الصحابة والتابعين ، وعدوا خلافته شرعية ، ورضوا إمامته ، ورأوا أنه خير من يلي أمر المسلمين ويقوم به خير قيام في تلك المرحلة ، فروي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت خلافة معاوية عدة من أصحاب رسول الله ؛ منهم: سعد ، وأسامة ، وجابر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ومسلمة بن مخلد ، وأبو سعيد الخدري ، ورافع بن خديج ، وأبو أمامة ، وأنس بن مالك، ورجال أكثر مما سميت بأضعاف مضاعفة ، كانوا مصابيح الهدى ، وأوعية العلم؛ حضروا من الكتاب تنزيله ، وأخذوا عن رسول الله تأويله ، ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله ، منهم: المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبد الله بن محيريز في أشباه له ، لم ينزعوا يده عن مجامعة في أمة محمد .
وقال ابن حزم: فبويع الحسن ثم سلّم الأمر إلى معاوية ، وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل ، وكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ، ورأى إمامته.
فالصحابة لم يبايعوا معاوية رضي الله عنه إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة متوفرة ، ومنها العدالة ، فمن يطعن في عدالة معاوية وإمامته فقد طعن في عدالة هؤلاء الصحابة جميعهم وخوّنهم وتنقصهم. فمن رضيه هؤلاء لدينهم ودنياهم ألا نقبله ونرضى به نحن؟! ومن قال: لعلهم بايعوا خوفاً فقد اتهمهم بالجبن وعدم الصدع بالحق ، وهم القوم المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة وعدم الخوف في الله لومة لائم.
وفي مبايعة سبط رسول الله الحسن بن علي لمعاوية درس بليغ وفهم عميق لآيات النهي عن الاختلاف، قال تعالى: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣} [الأنعام: 153]. فالصراط المستقيم هو: القرآن، والإسلام، والفطرة التي فطر الناس عليها ، والسبل هي: الأهواء ، والفرق، والبدع ، والمحدثات ، قال مجاهد: ولا تتبعوا السبل: يعني البدع، والشبهات ، والضلالات.
ونهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما جاءتهم البيِّنات، وأنزل الله إليهم الكتب، فقال سبحانه: {وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥} [آل عمران: 105]. وقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبله، قال تعالى: { وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ } [آل عمران: 103].
لقد تحقق بفضل الله تعالى ثم بنجاح الحسن بن علي في صلحه مع معاوية مقصد عظيم من مقاصد الشريعة من وحدة المسلمين واجتماعهم، وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله تعالى، ونحن مأمورون بالتواصي بالحقِّ والتواصي بالصبر ، فلا بدّ من تضافر الجهود بين الدعاة ، وقادة الحركات الإسلامية ، وبين علماء المسلمين ، وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحاً حقيقياً لا تلفيقياً ، لأن أنصاف الحلول تفسد أكثر ممّا تصلح.
وقد تحدث الشيخ السعدي على الجهاد المتعلّق بالمسلمين بقيام الإلفة، واتفاق الكلمة، وبعد أن ذكر الآيات، والأحاديث الدّالَّة على وجوب تعاون المسلمين ووحدتهم قال: فإن من أعظم الجهاد السَّعي في تأليف قلوب المسلمين ، واجتماعهم على دينهم ، ومصالحهم الدينية والدنيوية.
ولا ينظر للحديث الضعيف الذي رواه ابن عدي من طريق عليِّ بن زيد ، وهو ضعيف ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد، ومن حديث مجالد ، وهو ضعيف أيضاً ، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد: أن رسول الله قال: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». أسنده أيضاً من طريق الحكم بن ظهير، وهو متروك. وهذا الحديث كذب بلا شك ، ولو كان صحيحاً لبادر الصحابة إلى فعل ذلك ، لأنَّهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم.
1 ـ انتهاء عهد الخلافة الراشدة:
انتهى عهد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنه ، فقد قال رسول الله : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً عاضّاً ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً جبرياً ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت.
وقد بين رسول الله : خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، وقوله : الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك. وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن ، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ، وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله ، فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وهذا من دلائل نبوة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً ، وبذلك تكون مرحلة خلافة النبوة قد انتهت بتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول من سنة 41 هـ؛ فالحديث النبوي الكريم أشار إلى مراحل تاريخية ، وهي:
أ ـ عهد النبوة.
ب ـ عهد الخلافة الراشدة.
جـ عهد الملك العضوض.
د ـ عهد الملك الجبري.
هـ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
وقد بين رسول الله بأنه ستكون خلافة نبوة ورحمة ، ثم يكون ملك ورحمة ، ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاً ، ولم يكونوا خلفاء الأنبياء ، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله قال: «كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر» ، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «وفوا بيعة الأول ، فالأول ، ثم أعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». فقوله: «فتكثر» دليل على من سوى الراشدين؛ فإنهم ـ أي: الراشدين ـ لم يكونوا كثيراً ، وأيضاً قوله: «وفوا بيعة الأول فالأول» دل على أنهم يختلفون ، والراشدون لم يختلفوا ، وقوله: «فأعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنة، في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم.
فمعاوية رضي الله عنه أفضل ملوك هذه الأمة، والذين كانوا قبله خلفاء نبوة، وأما هو فكانت خلافته ملك، وكان ملكه ملكاً ورحمة، وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين، ما يعلم أنه كان خيراً من ملك غيره.
ومعاوية رضي الله عنه كان عالماً ورعاً عدلاً ، دون الخلفاء الراشدين في العلم والورع والعدل ، كما ترى من التفاوت بين الأولياء ، بل الملائكة والأنبياء ، فإمارته وإن كانت صحيحة بإجماع الصحابة وتسليم الحسن ـ رضي الله عنه ـ، إلا أنها ليست على منهاج خلافة من قبله ، فإنه توسع في المباحات ، وتحرز عنها الخلفاء الأربعة، وأما رجحان الخلفاء الأربعة في العبادات والمعاملات فظاهر مما لا سترة فيه.
وقد حدد ابن خلدون مدى التغير الذي حدث ، فقدر أنها خلافة وإن كانت تحولت إلى ملك ، فإن معاني الخلافة بقيت ـ بعضها ـ وإنما كان التغير في الوازع ، فبعد أن كان ديناً انقلب عصبية وسيفاً؛ يقصد بذلك: أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الدين ، والخلافة شورى ، صار الحكم مستنداً إلى العصبية والقوة ، ولكن معاني الخلافة ـ أي: مقاصدها وأهدافها ـ بقيت ، أي أن غايات هذا الملك كانت لا تزال تحقيق مقاصد الدين والحكم وفق الشريعة الإسلامية بالعدل ، وتنفيذ الواجبات التي يأمر بها الإسلام؛ أي أن الحكم أو الملك استمر إسلامياً وشرعياً.
ولخص الأدوار التي مرت بها الخلافة فقال: فقد تبيَّن أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً ، ثم التبست معانيها واختلطت بالملك ، ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبية الخلافة ، والله مقدر الليل والنهار. فالدور الأول الذي يشير إليه هو عصر الخلفاء الراشدين؛ وهو عصر الخلافة الخالصة أو الكاملة ، والدور الثاني هو عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين ـ ولا يمنع كذلك العثمانيين ـ وهذا عصر الخلافة المختلطة بالملك ، أو الملك المختلط بالخلافة: أي الذي يحقق في الوقت نفسه مقاصد الخلافة ، أما الدور الثالث فهو عصر الملك المحض الذي صار بقصد لذات الملك والأغراض الدنيوية ، وانفصل عن حقيقة الخلافة أو معانيها الدينية. فهذا وصف أو تفسير ابن خلدون المؤرخ الفقيه للتطور الذي حدث ، والأدوار التي مرت بها الخلافة.
إن الخلافة الحقيقية أو الكاملة ، أو خلافة النبوة استمرت ثلاثين عاماً ، وهو عصر الخلفاء الراشدين ، ثم تحولت إلى ملك ، ولكن لكي نعبِّر عن الحقيقة يجب أن يراعى هذا التحديد ، وهو أن الخلافة لم تنته أو تذهب كلية ، وإنما بقيت معانيها أو مقاصدها ، وأن التغيير حصل في الأساس التي قامت عليه ، أما حقيقتها فقد بقيت ، فالتغير إذن لم يكن كلياً ، ولكن جزئياً: أي أن الخلافة في العصر الأول كانت هي الخلافة الكاملة المثالية ، ثم نقصت عن المثال من وجـه أو بعض الوجوه ، لكن معظم عناصره بقيت ، فهي خلافة أقل في الرتبة ، أو خلافة مختلطة بالملك، والرأي العام في الإسلام يتمسك بالمثال ، أو خلافة النبوة ، أو الخلافة الكاملة ، وهي تلك التي تقوم على الشورى والاختيار التام من الأمة ، وأنه إذا كان الظروف الواقعية والعوامل الاجتماعية قد حتمت أو أدت إلى هذا التطور ، فإن تحمل ذلك أو قوله لا يكون إلا مؤقتاً أو من باب الضرورة ، ولكن لا يلزم أن يكون المثل الكامل حاضراً دائماً في فكر الرأي العام ، وبمجرد أن تزول تلك العوامل والظروف تجب العودة إلى تحقيق المثل الكامل ، ولذا فإن الكتابات الإسلامية الأصيلة ظلت ملتزمة ومتشبثة بالمثال الكامل ، ولا تستخلص مبادئها إلا منه، وتفرق بين الخلافة وهي الخلافة الحقيقية الشرعية ، والخلافة الواقعية التي بعدت قليلاً أو كثيراً عن الحقيقية.
وقد ذكر ابن تيمية: أن مصير الأمر ـ أي الخلافة ـ إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة الأمراء ليس لنقص فيهم فقط ، بل لنقص في الراعي والرعية جميعاً ، فإنه كما تكونوا يولَّى عليكم ، وقد قال تعالى: {وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضَۢا} [الأنعام: 129]. لقد ذهبت دولة الخلفاء ، وصار ملكاً ظهر النقص في الأمراء، وكذلك في أهل العلم والدين ، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة ، حتى إنه لم يبق من أهل بدر إلا نفر قليل وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك ، وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية ، وأوائل الدولة العباسية.
2 ـ هل يعتبر معاوية رضي الله عنه أحد الخلفاء الاثني عشر؟:
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: دخلت مع أبي على النبي ، فسمعته يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» ، قال: ثم تكلم بكلام خفي عليَّ ، قال: فقلت لأبي: ما قال ، قال: «كلهم من قريش»، وفي رواية أخرى عن جابر: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشرة خليفة.. كلهم من قريش». وفي رواية أخرى عنه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة.. كلهم من قريش» ، زاد أبو داود في سننه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون الهرج.
وقد شرح ابن كثير هذا الحديث فقال: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق ويعدل فيهم ، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم ، بل قد وجد منهم أربعة على نسق؛ وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة ، وبعض بني العباس ، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة ، والظاهر أن منهم المهدي المُسرَّ به في الأحاديث الواردة بذكره... وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء ، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة ، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر ، الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية.
وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثني عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة، وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة وأن الناس تجتمع عليهم، ولا يزال أمر الناس ماضياً وصالحاً في عهدهم، وكل هذهِ الأوصاف لا تنطبق على من تدعي الاثنا عشرية فيهم الإمامة، فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين علي والحسن...
ثم إنه ليس في الحديث حصر لأئمة بهذا العدد، بل نبوءة منه، بأن الإسلام لا يزال عزيزاً في عصور هؤلاء، وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة، ولهذا قال ابن تيمية: إن الإسلام وشرائعه في بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم ، وعدّ معاوية من الأئمة المقصودين بالحديث.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf