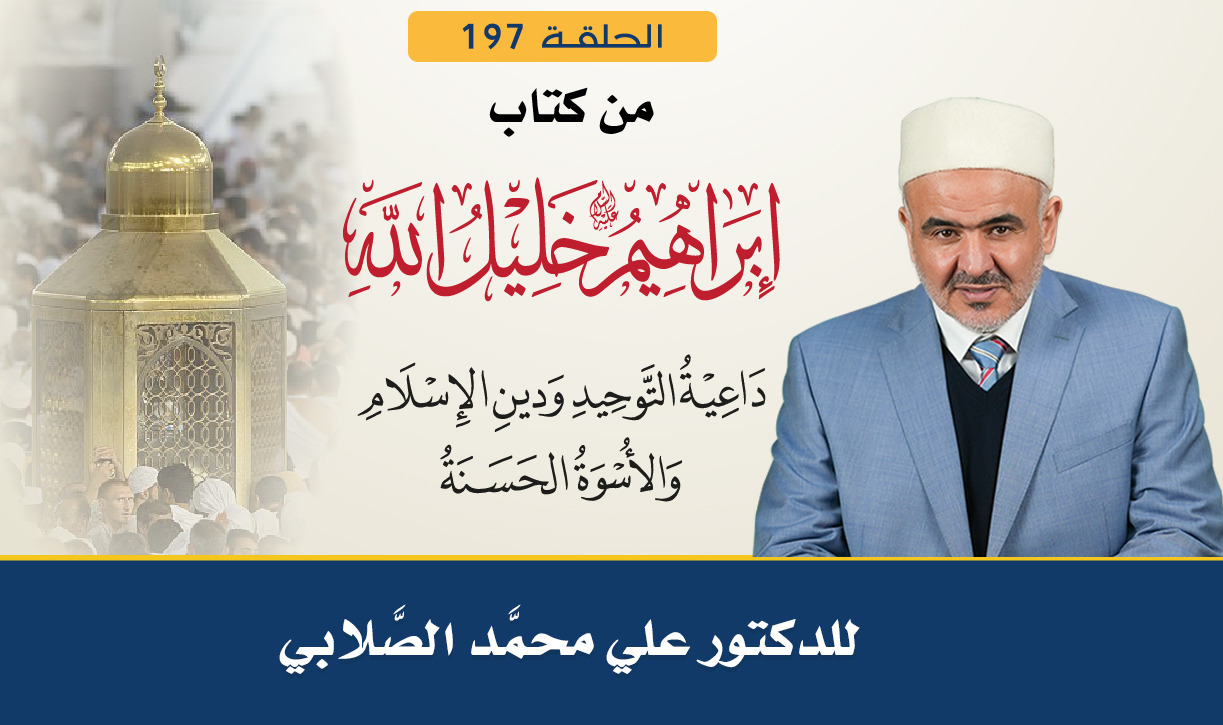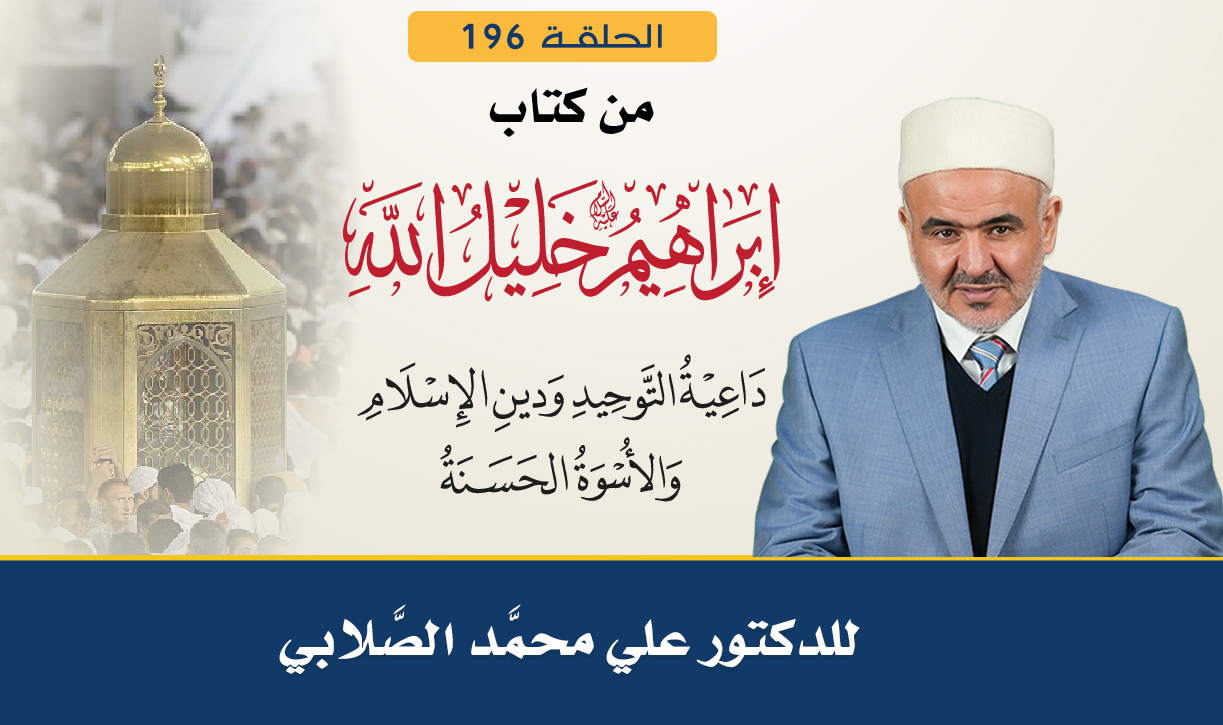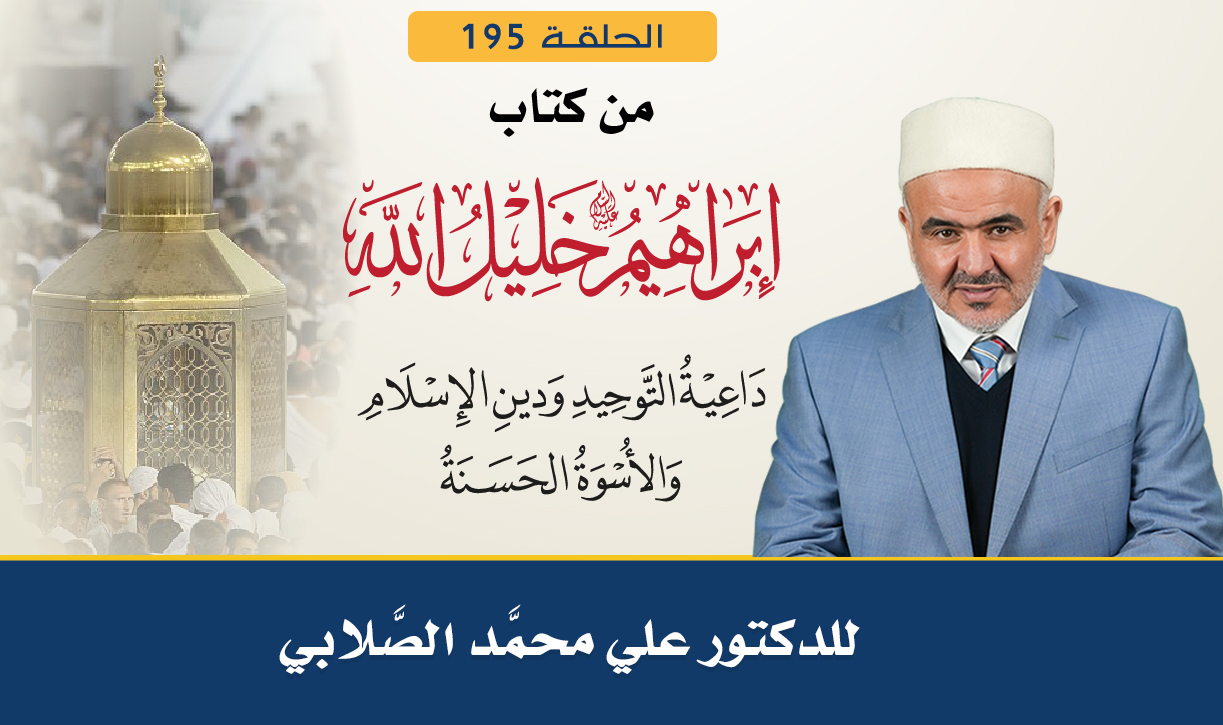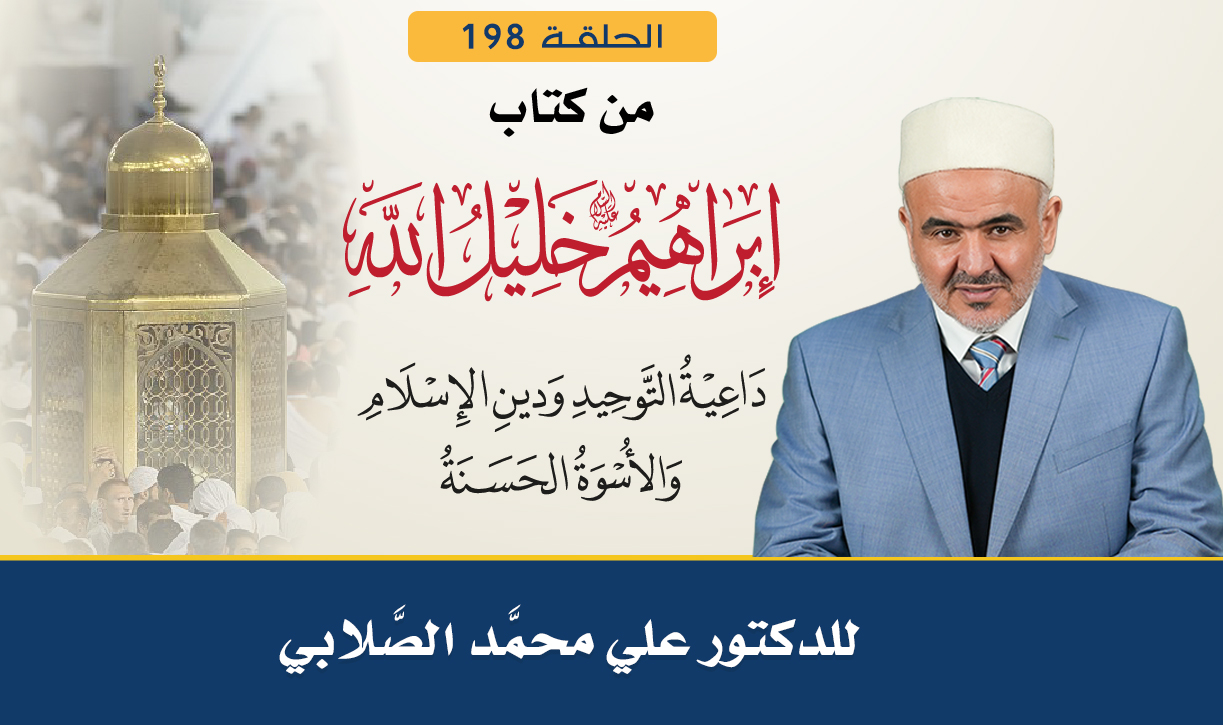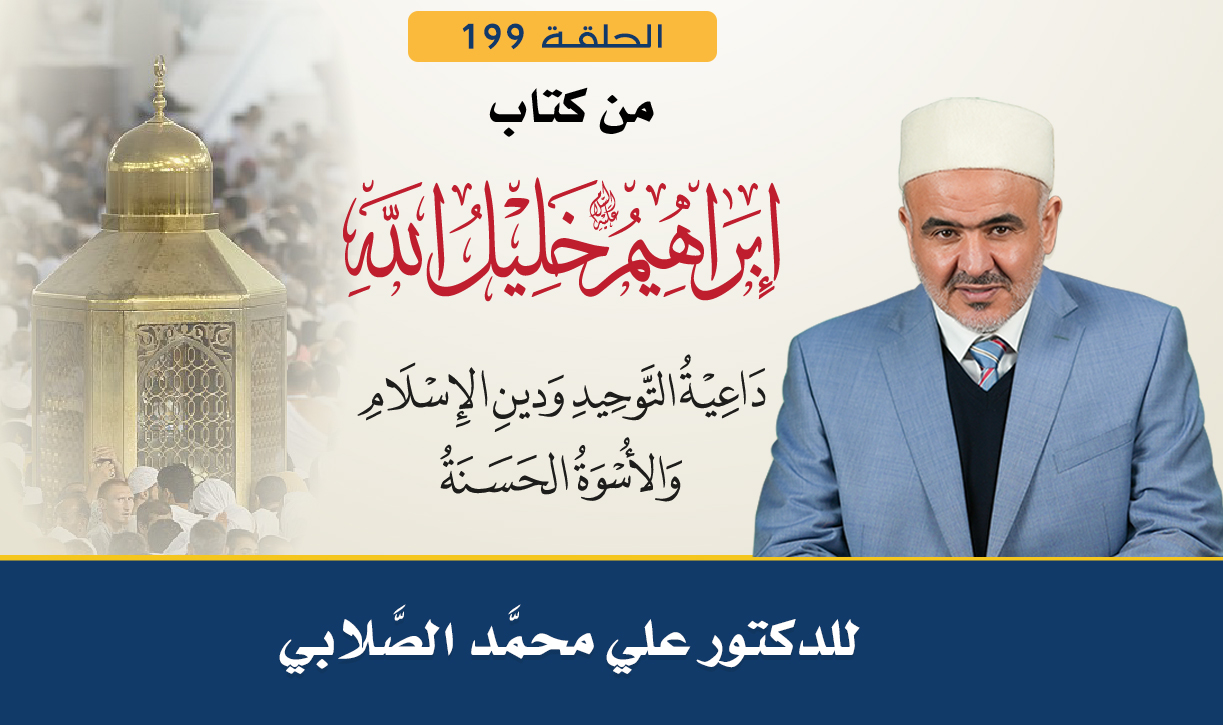تأملات في الآية الكريمة:
{وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 197
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
رجب 1444ه/ يناير 2023م
أ- {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى}:
الواو: واو عطف قصة على قصة أو استئناف.
واللام: الموطئة للقسم، وقد: للتحقيق، وخاصة إذا دخلت على الماضي، وهي كذلك هنا.
والمجيء: القدوم من قريب، والإتيان: القدوم من بعيد، والملائكة أو الرسل التي جاءت إبراهيم جاءت من بعيد، فلمَ عبر بالفعل المفيد القرب وهو جاءت؟ لأنَّ البعيد في مقياسنا قريب في مقياس الله تعالى، وهل كانت الرسل ملكاً واحداً أم مجموعة من الملائكة؟
وتدلنا {رُسُلُنَا} كانوا ثلاثة فأكثر، وهناك خلاف بين العلماء في العدد والمراد بـــ {رُسُلُنَا} الملائكة: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} ]الحج:75[.
والملائكة خلق من مخلوقات الله تعالى، بل هي من المخلوقات العظيمة، ولقد كثر ذكر الملائكة في القرآن الكريم، ووجب علينا الإيمان بهم، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة، والملائكة أجسام لطيفة، أعطيت القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، خلقت من نور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم وظائف متعددة أمرهم الله بالقيام بها.
وذكر القرآن الكريم صفات اتصفت بها الملائكة، فمنها الخَلقية كالأجنحة العظيمة، فمنهم من يملك جناحين أو ثلاثة أو أربعة، قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ]فاطر:1[.
وكذلك أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، وإنهم لا يأكلون ولا يشربون ومن الصفات الخُلقية الاستحياء، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة".
وتمثلت صفات الملائكة التي اقترنت بقصة إبراهيم - عليه السّلام - في ثلاث صفات، ألا وهي:
• القدرة على التشكّل:
لقد خلق الله الملائكة من نور، ومنحهم قدرة على التشكّل بأي هيئة، وهذا يظهر جلياً في مجيء الملائكة لإبراهيم على هيئة بشر ولم يعرفهم - عليه السّلام - في بداية الأمر، فقد أتت على صورة بشر، فنكرهم حين قدّم لهم الطعام فلم يأكلوا منه، فكشفت الملائكة عن حقيقة الأمر، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
• لا يأكلون ولا يشربون:
من صفات الملائكة أنّها لا تأكل، كما أخبر الله تعالى عنهم في معرض حوار الملائكة وإبراهيم - عليه السّلام -، فإنه قدّم لهم من الطعام العجل الحنيذ، فلم تصل أيديهم إليه، واتّفق العلماء على أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب.
• وظائف الملائكة:
ولا ننسى أن للملائكة وظائف عدة نطق بها القرآن الكريم والسنة وهي كثيرة، ومن الوظائف التي وردت في قصة إبراهيم - عليه السّلام -؛ تقديم البشارة، وإرسال العذاب ونصرتهم لعباد الله المؤمنين كما سيأتي بيانه في محله بإذن الله تعالى.
وفي قوله: {إِبْرَاهِيمَ}: هذا الرسول العظيم خليل الله، وثاني أعظم رسل الله بعد خاتم النبيين وهو أبو الأنبياء، فهو عظيم المنزلة عند الله، وعند الأمم كلها. و{بِالْبُشْرَى}: الباء متعلقة بجاءت، والبشرى الخبر السارّ الذي يكون في المستقبل قريباً أم بعيداً، والباء: للمصاحبة؛ لأنّهم جاؤوا لأجل البشرى، فهي مصاحبة لهم كمصاحبة الرسالة للمرسل بها.
وقال الشنقيطي: لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم، ولكنه أشار بعد هذا إلى البشارة بإسحاق ويعقوب، في قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} ]هود:71[؛ لأنَّ البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، كما يدل على ذلك قوله تعالى: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} ]الصافات:112[، وقوله تعالى: {قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} ]الذاريات:28[، وقوله تعالى: {قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} ]الحجر:53[.
وقيل البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: {قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ}]هود:70[، وقوله: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59)} ]الحجر:58-59[، وقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33)} ]الذاريات:32-33[، وقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ} ]العنكبوت:31[، والظاهر القول الأول، وهذه الآية الأخيرة تدلّ عليه؛ لأنَّ فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنّه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي {لَمَّا} كما ترى.
ب- {قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ}:
أي: سلّموا عليه، وردّ عليهم السّلام، ففي هذا مشروعية السّلام، وأنه لم يزل من ملّة إبراهيم - عليه السّلام -، وأنّ السّلام قبل السّلام، وأنه ينبغي أن يكون الردّ أبلغ من الابتداء؛ لأنّ سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، وردّه بالجملة الاسمية الدّالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم اللغة.
والله يقول في كتابه: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ]النساء:86[، وهكذا استقبل إبراهيم - عليه السّلام - رسل الله عزّ وجل، والآية تدل على أن السّلام هو تحية الإسلام، وهو تحية الملائكة أيضاً، وكذلك أخبر الله أنّها تحيتهم لعباده المؤمنين في الآخرة في آيات عديدة من كتابه العزيز، كقوله في سورة الرعد: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)} ]الرعد:23-24[، وكقوله في سورة الزمر أيضاً: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} ]الزمر:73[.
ج- {فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}:
والعجل هو ولد البقر، فلم يمكث إبراهيم - عليه السّلام - طويلاً حتى جاءهم بعجل مشوي، وقد عبَّر عن العجل في سورة الذاريات بقوله تعالى: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} فهو سمين وهو حنيذ.
والحنيذ المشوي على حجارة، المحماة في حفرة من الأرض، وهو من صنيع أهل البادية، يُقال: حَنذ الشاة يحنذها حنذاً، شواها بهذه الطريقة، فهي حنيذ.
إنَّ تقديم إبراهيم - عليه السّلام - عجلاً مشوياً ناضجاً لهم فور دخولهم عليه، دليل على كرمه، ومبالغة في إكرامه لهم، فكان يكفيه أن يقدم لهم شيئاً من اللحم أو يقدم لهم خروفاً، أما أن يقدم لهم عجلاً، فهذا لا يصدر إلا عن رجل كريم.
والضيافة من مكارم الأخلاق، ومن آداب الإسلام، ومن خُلق الرسل والنبيين والصالحين.
وقال ابن كثير: وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة منها:
- من الضيافة حسن استقبال الضيف.
- المبادرة إلى إعداد الطعام دون أن يسألهم عن شأنهم.
- والتعبير {فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ} يدلُّ على سرعة مبادرة الخليل إبراهيم - عليه السّلام - إلى إعداد الطعام لضيوفه الكرام.
- إعداد الطعام استغرق وقتاً قصيراً، رغم أن الطعام الذي أعدَّه وقدمه هو عجل سمين لذيذ حنيذ مشوي على الحجارة المحماة، وفي هذا ما يدل على إكرام إبراهيم عليه السّلام لضبطه وحفاوته بهم، حيث قدم لهم أفضل ما عنده.
ولذلك سُمّي إبراهيم - عليه السّلام - "أبو الضيفان"، فهو أول من أضاف الضيف؛ ولشهرته بالكرم، ومن كرمه يأتي الطعام الكثير للعدد القليل، وهذا الكرم ليس من الإسراف، فالطعام الزائد يؤكل من أهل البيت أو يوزع على الفقراء.
ومن أدب الضيافة تقريب الطعام إلى الضيوف، والملاطفة في الكلام كقوله في سورة الذاريات {أَلَا تَأْكُلُونَ} ]الذاريات:26[.
مراجع الحلقة السابعة والتسعون بعد المائة:
(1) تفسير سورة هود، أحمد نوفل، ص257.
(2) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (4/75).
(3) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (4/75).
(4) المسائل العقدية في حوارات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، تهاني إبراهيم عبد الرحمن، ص66.
(5) صحيح مسلم، رقم (2401).
(6) المسائل العقدية في حوارات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، ص68.
(7) تفسير سورة هود، أحمد نوفل، ص257.
(8) المرجع نفسه، ص257.
(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (3/29-30).
(10) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (3/29-30).
(11) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص758.
(12) القصص القرآني بين الآباء والأبناء، عماد زهير حافظ، ص136.
(13) تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، (11/655).
(14) تفسير سورة هود، أحمد نوفل، ص258.
(15) المرجع نفسه، ص258.
(16) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، صلاح الخالدي، (1/419).
(17) شرعة الله للأنبياء، محمد مصطفى الزحيلي، ص177.
(18) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، (4/264).
(19) المرأة في القصص القرآني، أحمد الشرقاوي، (1/162).
(20) تفسير سورة هود، أحمد نوفل، ص258.
(21) الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم محمد العلي، ص64.
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي