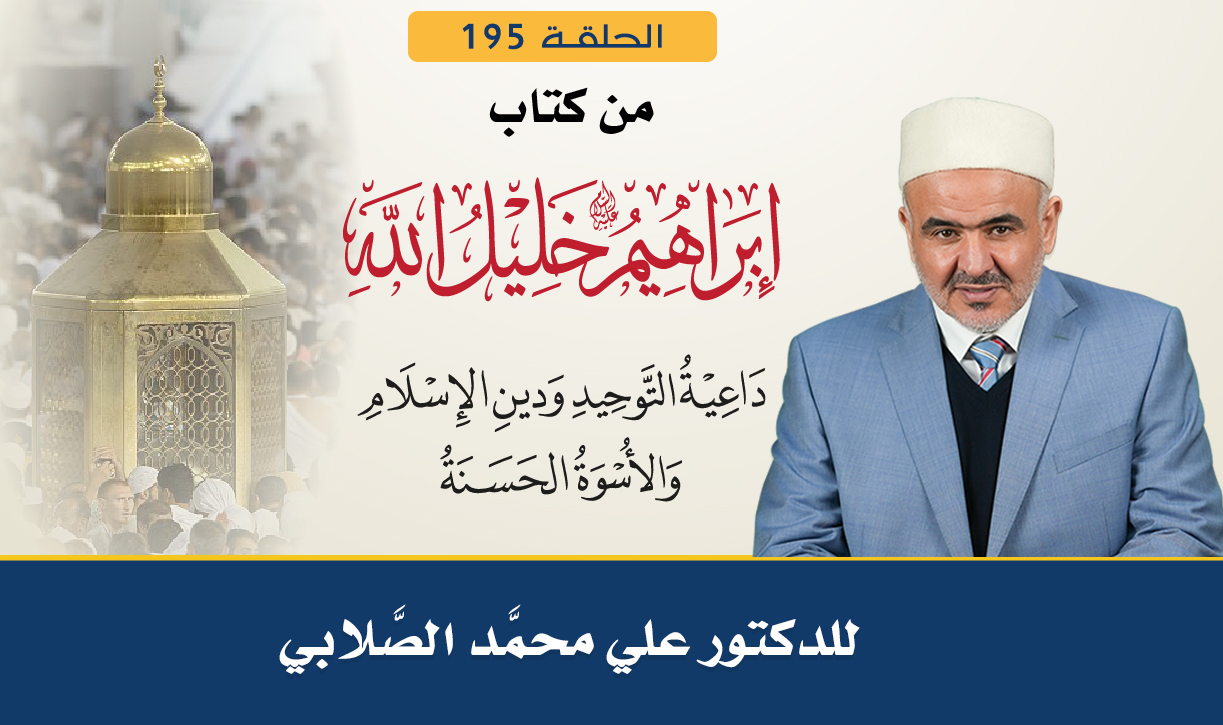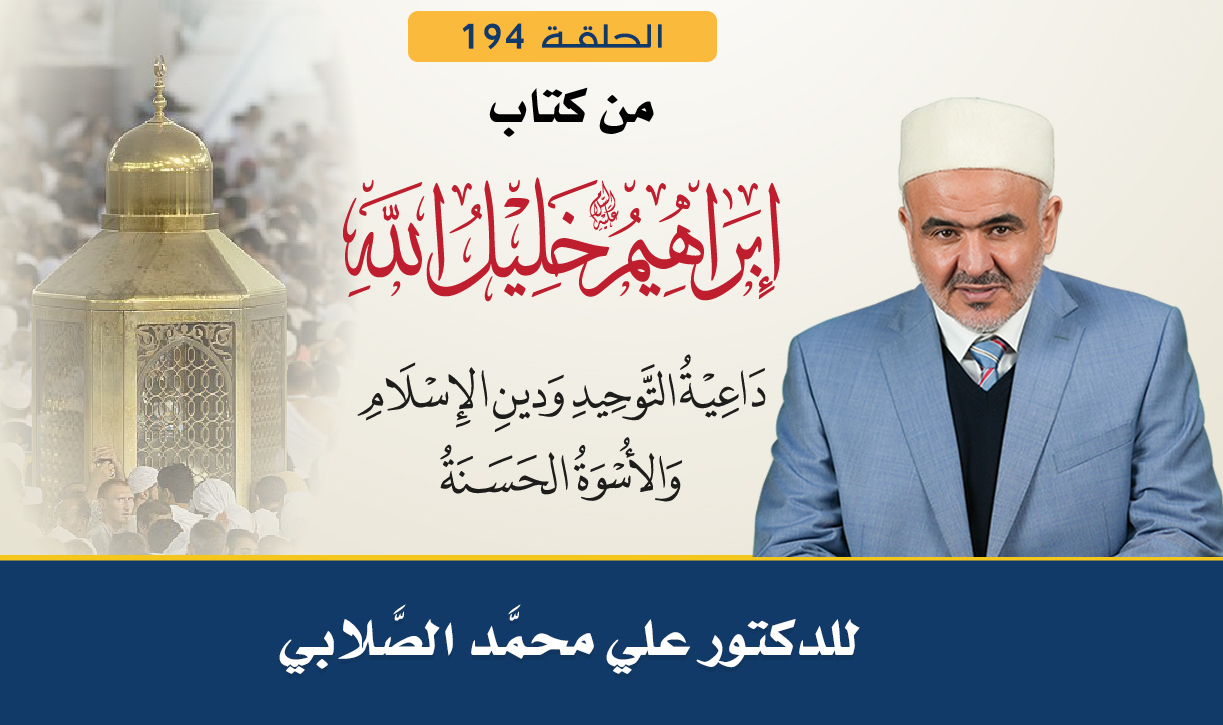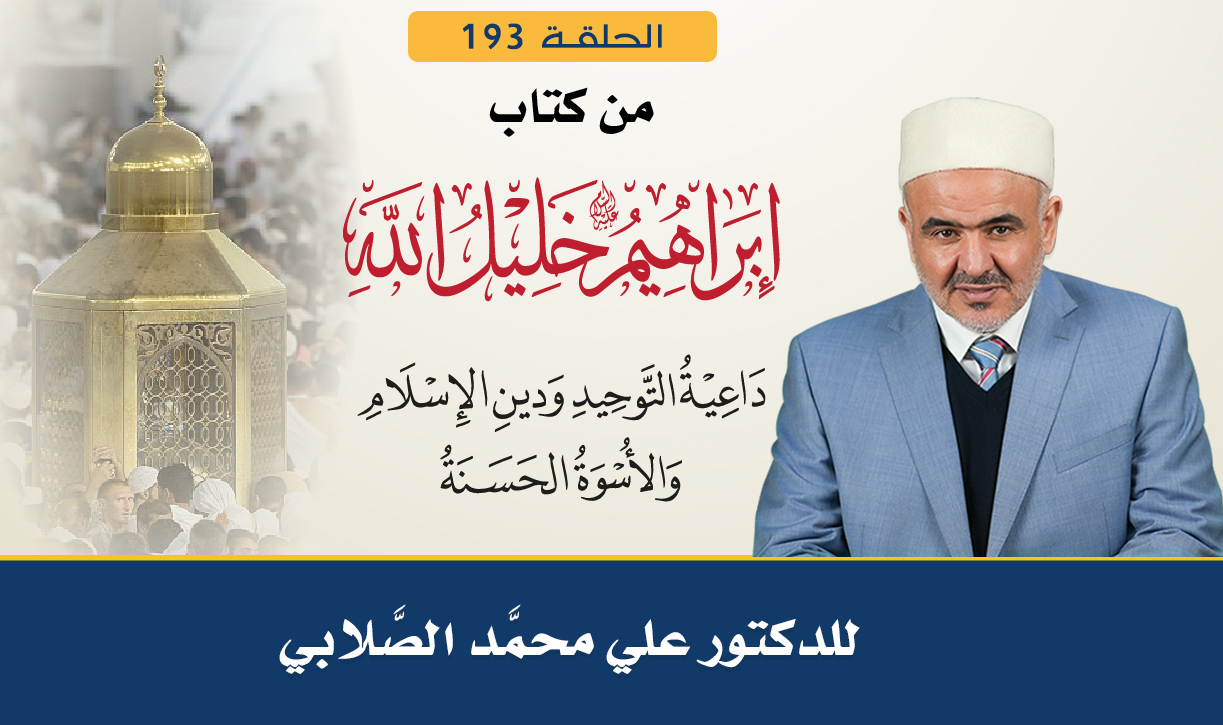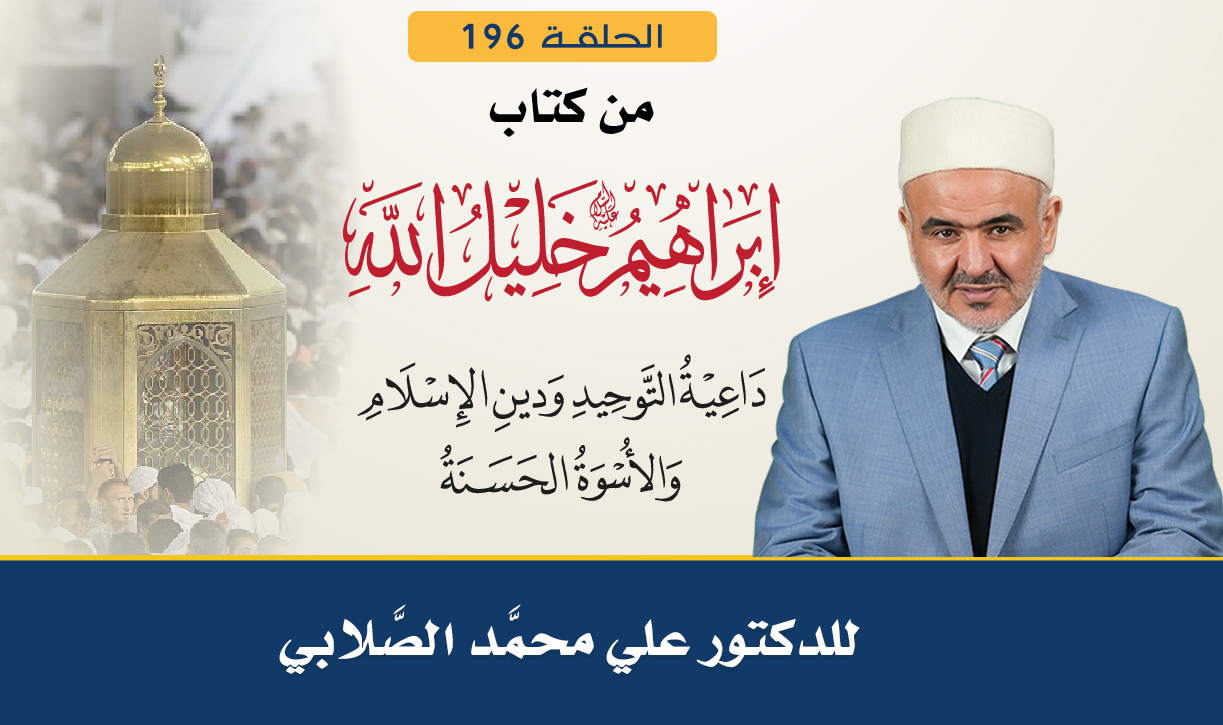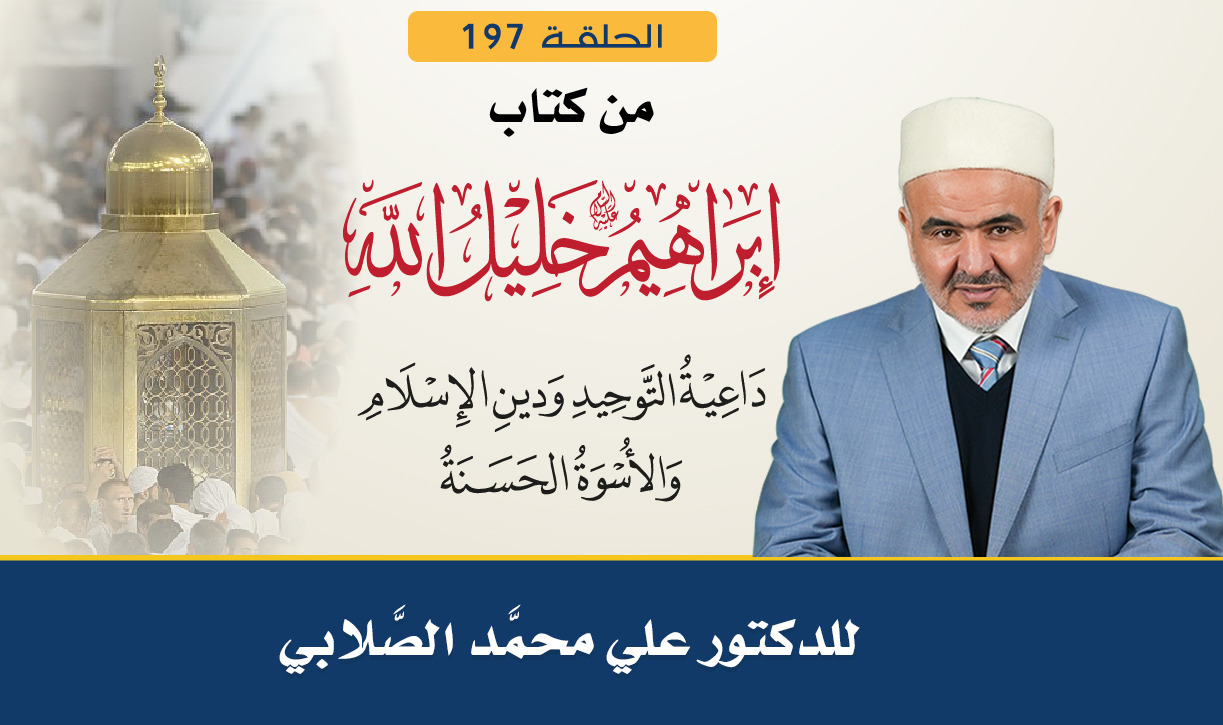تأملات في الآية الكريمة:
{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 195
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
رجب 1444ه/ يناير 2023م
لمّا نزلت الآيات الكريمة التي حثت على الاقتداء بإبراهيم - عليه السّلام - في البراء والولاء والمهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتمّ القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله تعالى عنه، فأخبرهم أن ذلك لا يدخل في المحرم(1).
وقد رخص الله عزَّ وجل لهم في الإحسان إلى من لم يقاتلوهم في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم، وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم، فلا يبخسونهم من حقوقهم شيئاً(2).
أ- صلة الأرحام من المشركين:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، فسألت النبي صلّى الله عليه وسلّم: أصلها؟ قال: نعم، قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}(3).
وقال الحافظ ابن حجر: والمعنى أنّها قدمت طالبة في برّ ابنتها لها، خائفة من ردِّها إيّاها خائبة(4)، وهكذا فسَّره الجمهور.
وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة، وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر، والأم الكافرة على الولد المسلم(5).
ب- قول الطبري:
في قوله {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، إنَّ الله عزّ وجلّ عمّ بقوله: {الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضاً دون بعض، لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له...(6).
ج- قول الشيخ عطية سالم:
إذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب المسلمين العداء، ولم يظهر سوءاً إليهم وهي في الكفار أقرب منها للمسلمين؛ لأنَّ الإحسان إلى ضعفه المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية، وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي، يقاوم صراحة هذا النص الشامل، وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير، ويؤيد عدم النسخ ما نقله القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنّها محكمة، وهذا الذي صوّبه ابن جرير الطبري تقتضيه روح التشريع الإسلامي(7).
د- قول السعديّ:
ولما نزلت هذه الآيات الكريمة، المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، وجاء في معناها: لا ينهاكم الله عن البرِّ والصّلة والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة، كما قال الله تعالى في الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلماً: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ]لقمان:15[(8).
ه- {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}:
أي العادلين(9). وفي الحديث النبويّ الشريف: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرّحمن عزّ وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا(10).
وعدّ النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح الإمام العادل من الأصناف السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه(11).
ويرى الشيخ محمد متولي الشعراوي في قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}: أنَّ البرّ يرفع عنهم الحاجة، {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} يرفع عنهم مذلّة السؤال، وقال: ومعنى {وَتُقْسِطُوا} مادة "قسط" في اللغة من الكلمات التي تدل على الشيء ونقيضه، نقول: قسط يقسط قسطاً يعني عدل. ومنها قسط قسطاً وقسوطاً يعني ظلم وجار، قال تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} ]الجن:15[، وفي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ومقسط اسم فاعل من أقسط، والهمزة هنا همزة الإزالة أي أزال القسط أو الجور(12).
ومن معاني {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}: نقول" أقسط يعني جعل الشيء أقساطاً، أي أجزاء وليس جملة واحدة والمعنى أعطوهم شيئاً من أموالكم على هيئة أقساط كل شهر، مثلاً تعطوهم شيئاً يكفيهم، ويرفع عنهم مذلة الحاجة والسؤال لا تجعله يأتيك ويذل نفسه(13).
وفي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} أي: يعطون الناس شيئاً من أموالهم دون سؤال، فالقسط هنا بمعنى الجزء من الشيء(14).
وهذه الآية توضح الفرق بين المحارب وغيره، وأنَّ الولاء المنهي عنه في الآية يقصد به المحاربون المعادون لكم، وتوضّح أيضاً الفرق بين المعاملة الحسنة الطيبة وبين الموالاة الممنوعة، فالله تعالى لا ينهى المسلمين عن الإحسان والبرّ والقسط للقبائل التي تميل للمسلمين ولا تحاربهم ولا تظاهر عليهم، مثل خُزاعة ومُزينة وأسلم وجهينة وغفار الذين كانوا مشركين، لكن هواهم مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وكانوا يحبون أن ينتصر على قريش فهؤلاء لا ينهاكم الله عنهم، وفي هذا درس لمن يجعلون الكفار في ميزان واحد في التعامل وهم ليسوا كذلك، فمنهم المعتدي المبارز بالعداوة والصدِّ عن سبيل الله، ومنهم المسالم المحايد، ومنهم المدافع عن حقوق المستضعفين من المسلمين.
وفي العصر الحاضر منهم من يكون متعاطفاً مع قضايا الإسلام، ويتحمل العناء بسبب وضوح آرائه ومدافعته عن الحق، فمثل هؤلاء يجب أن يحتفى بهم، وتمد معهم الجسور ويكرمون معنوياً ومادياً، ويعاملون بالخلق الحسن والكلام الطيب والصبر وحسن المعاملة والحفاوة والتقدير، كما أن للآباء مكان في البرِّ والإحسان كما مرّ معنا، وكذلك الزوجة الكتابية مع ما يقع بين الزوجين من المودة والرّحمة، كما قال تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} ]الروم:21[.
وكما في قصة أبي طالب الذي أحبه النبي صلّى الله عليه وسلّم وحزن على موته، فأنزل الله قوله: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} ]القصص:46[، ففرق بين الطائفتين وشرع لغير المحاربين أمرين: البر: وهو الإحسان إليهم بالقول والفعل، والقسط: وهو العدل، وفي الآية حثّ عليهما: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} فالعدل قيمة مطلقة مع كل الناس(15).
مراجع الحلقة الخامسة والتسعون بعد المائة:
(1) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص1815.
(2) في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/3544).
(3) صحيح البخاري، رقم (5978)، صحيح مسلم، رقم (1003)، وفي رواية الطبراني وابن حبان: راغبة وراهبة.
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، (5/292).
(5) التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، (34/381).
(6) تفسير الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن"، (28/65-66).
(7) التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، (34/380)؛
(8) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص1816.
(9) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (8/184).
(10) صحيح مسلم، رقم (1827).
(11) صحيح مسلم، رقم (1031).
(12) تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، (24/15128).
(13) تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، (24/15129).
(14) المرجع نفسه، (24/15130).
(15) إشراقات قرآنية، سلمان العودة، (2/111).
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي