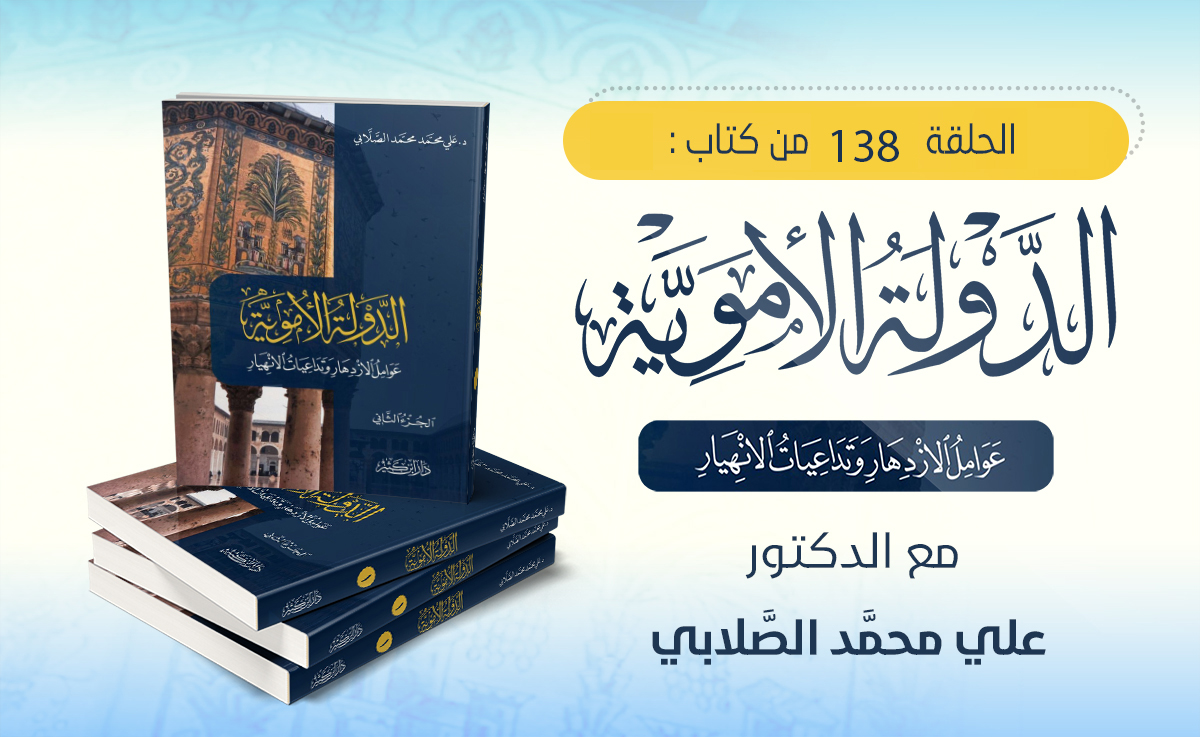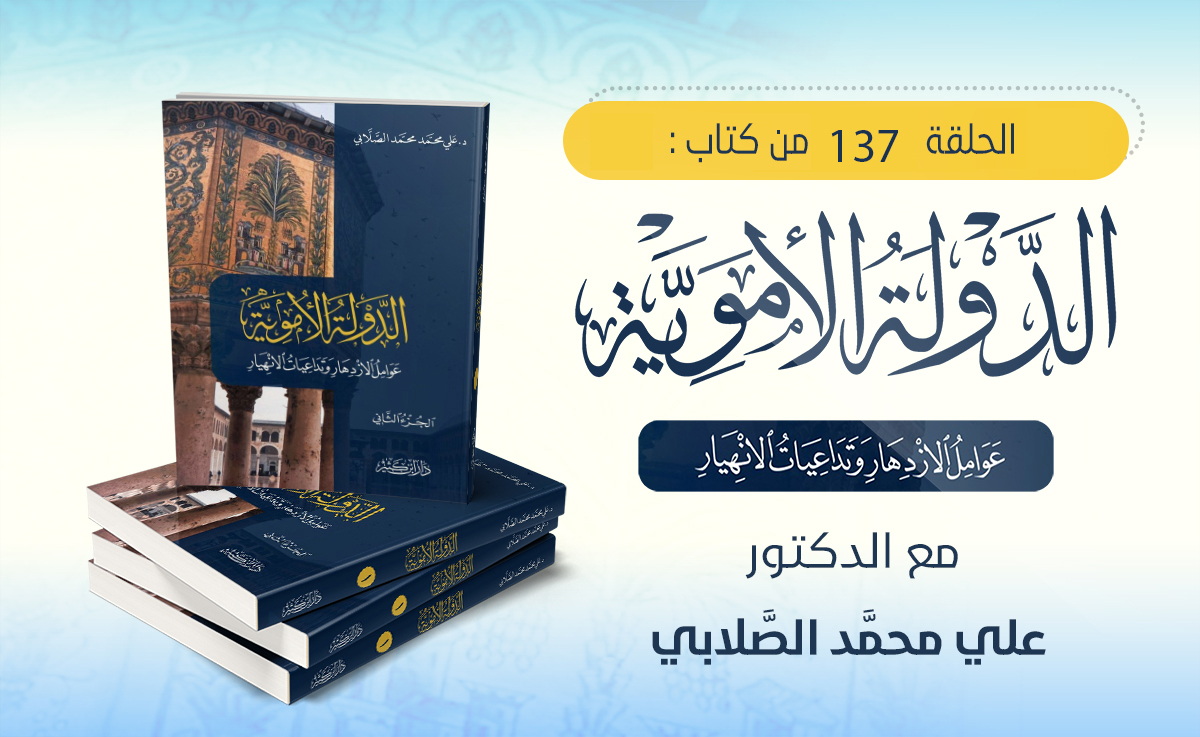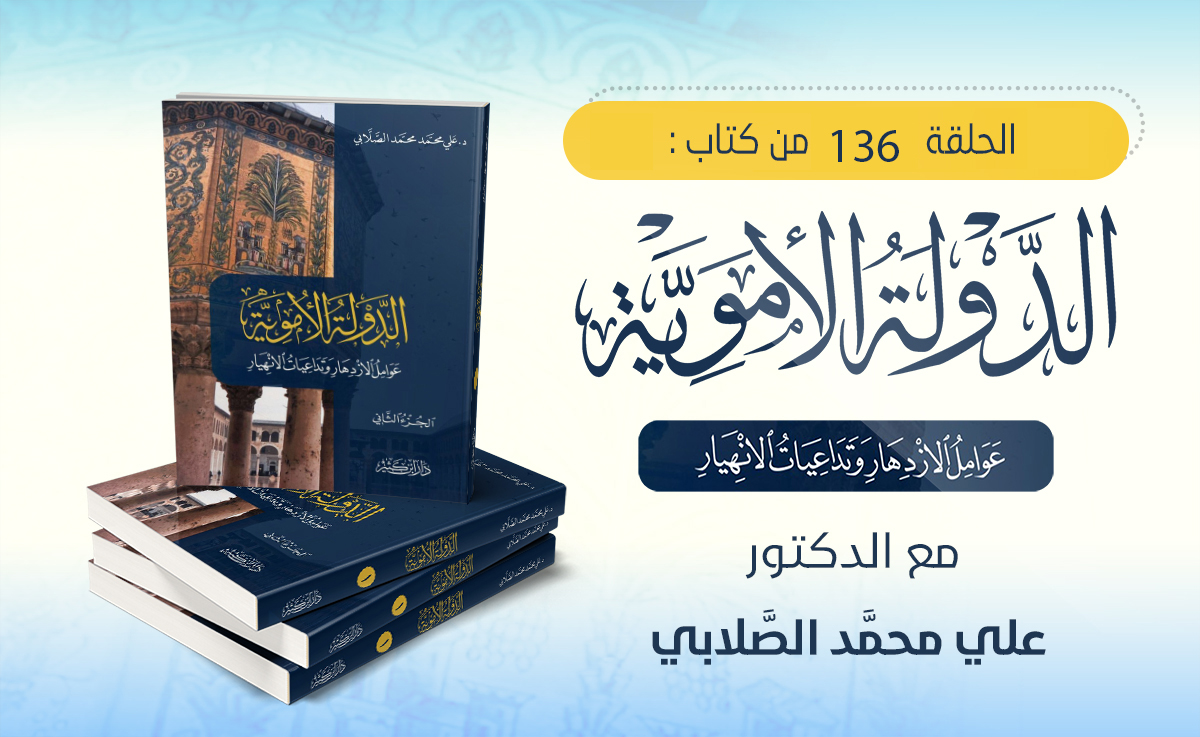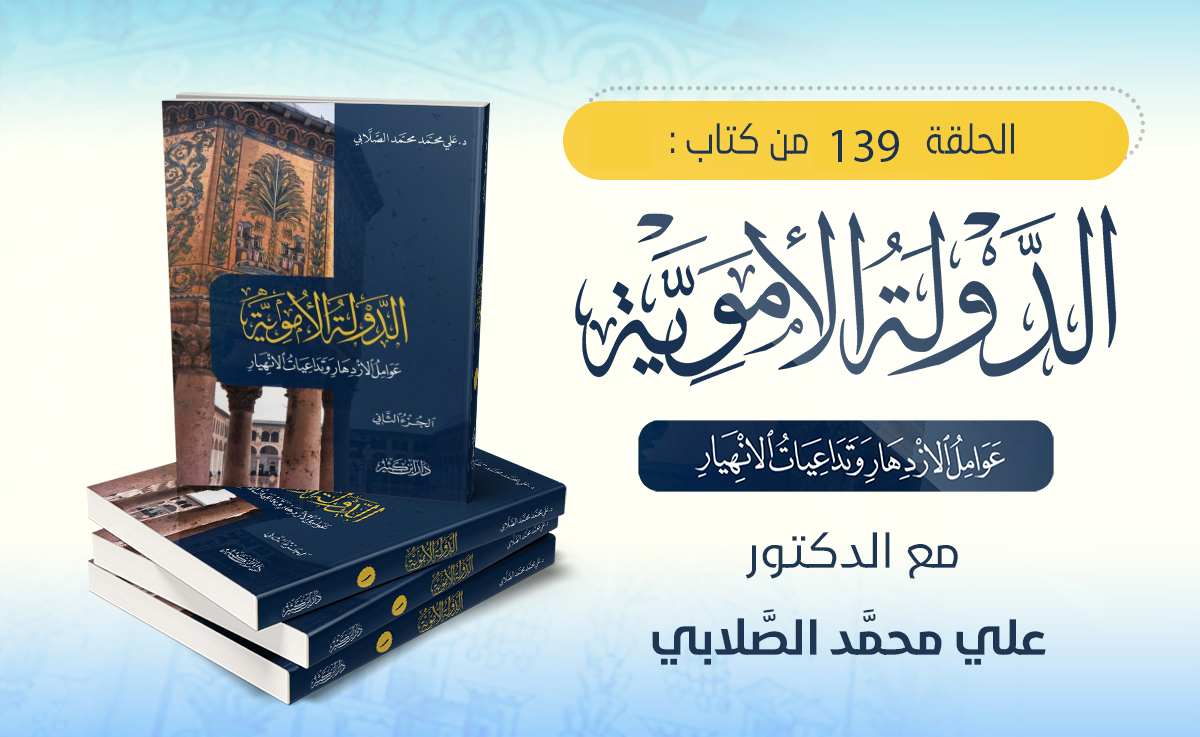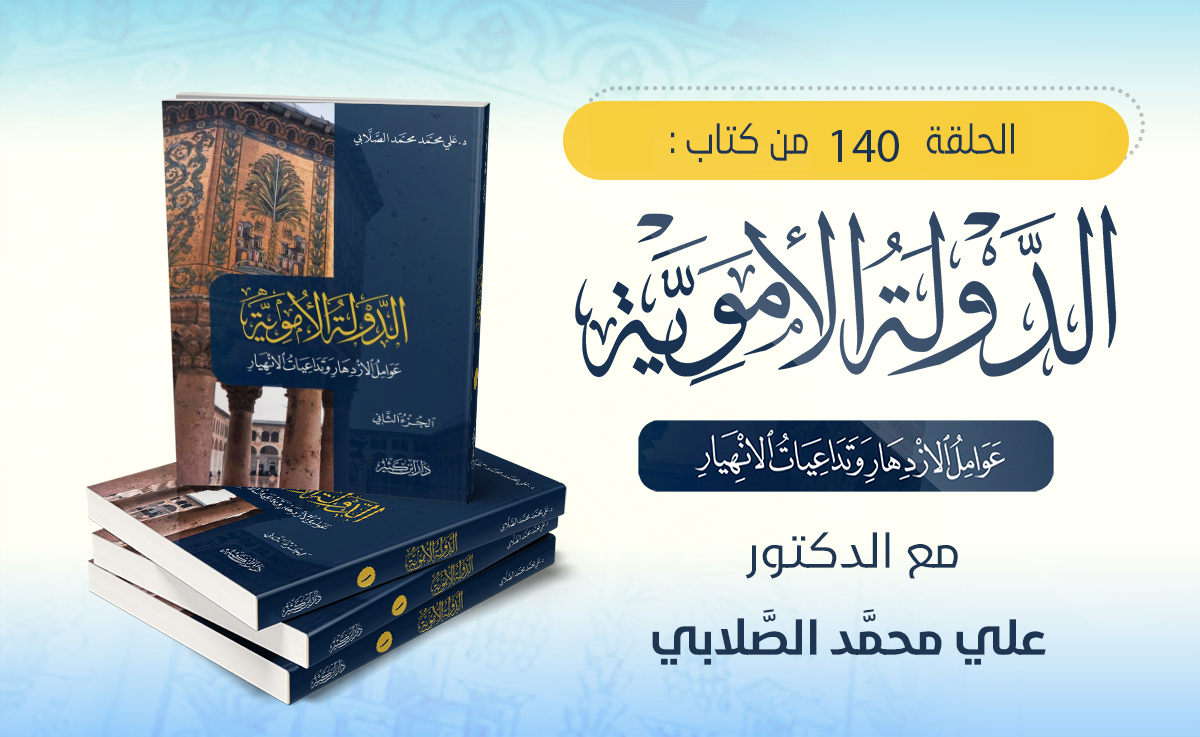من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2):
(أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات في عهد عبد الملك والوليد وسليمان)
الحلقة: 138
بقلم الدكتور: علي محمد الصلابي
جمادى الآخرة 1442 ه/ يناير 2021
أولاً: بماذا انتصر المسلمون؟:
إن ما حدث في عهد عبد الملك من فتوحات هي امتداد طبيعي للأسس المتينة والقواعد الراسخة لفقه النهوض الذي أسسه رسول الله ﷺ، وأكمل بناؤه الخلفاء الراشدون، وكانت الأمة وكثير من حكامها يعيشون لأجل العقيدة والدعوة الإسلامية، وقد انتصر المسلمون بالإسلام نفسه، فهم قد فهموه فهماً صحيحاً دقيقاً، وطبقوه على أنفسهم فأنشأ منهم خلقاً جديداً، غيَّر النفوس والقلوب والعقول، وحررها من الوثنية وعبادة غير الله، وفتح أمامهم افاق الإيمان والعمل، فاندفعوا يحملون رسالة التوحيد إلى الإنسانية كلها، فأقاموا أمة وأنشؤوا دولة كبرى، وأعلنوا كلمة الله في الأرض حقاً وصدقاً.
لقد صيغت هذه الأمة منذ عهد الرسول ﷺ على أساس واضح من الترابط بين الإسلام والإيمان، والعقيدة والعمل، وفق أصفى مفهوم للتوحيد وأصدق فهم لإقامة المجتمع الإنساني، واجتمع لها في إيمانها: العقيدة والشريعة والأخلاق دون أن ينفصل أحدها عن الاخر، وتكامل لها مفهوم المعرفة القائم على القلب والعقل.
وقد ظلت سيرة الرسول ﷺ بكل دقائقها وتفاصيلها أمام المسلمين قدوة صادقة وأسوة حسنة، وقد كانت المثل الأعلى أمام القادة والمصلحين والأبطال والمجاهدين، وما زالت وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ولقد انتصر المسلمون بقيم ومقومات ومثل كثيرة تعلموها وتربوا عليها؛ من القران الكريم وهدي الرسول الأمين ﷺ، ومن أبرز هذه القيم والمقومات: عقيدة سليمة، عبادة صحيحة، كتاب منير، أسوة حسنة، شريعة عادلة، أخلاق حميدة، جهاد في سبيل الله، تربية صالحة مستمرة، مفهوم شامل للحياة والمجتمع، بطولة في المواقف، وصمود في وجوه العدو، وغير ذلك من القيم والمقومات.
ثانياً: أسباب دخول الإسلام في البلاد المفتوحة:
كانت هناك عدة أسباب أدت إلى هذا؛ منها:
1 ـ عالمية الدعوة:
الحقيقة الثابتة التي تؤيدها النصوص القاطعة أن الإسلام دين عالمي، ورسالته للجنس البشري كله، لا لأمة دون أمة، ولا لشعب دون شعب، فمحمد ﷺ رسول الله إلى الناس كافة: {وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨} [سورة سبأ:28] ، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ *} [ الأنبياء : 107] ... إلى غير ذلك من الايات الكريمة التي توضح أن الرسالة الإسلامية للناس كافة، وأنها خاتمة رسالات السماء إلى أهل الأرض، فليس بعد القران الكريم كتاب من الله، وليس بعد محمد ﷺ رسول: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠} [سورة الأحزاب:40] . وقد قام بالتبشير بعالمية الدعوة ودعوة الأمم قادةٌ وعلماءُ؛ كموسى بن نصير، وقتيبة بن مسلم، ومحمد بن القاسم وغيرهم كثير.
2 ـ المعاملة السمحة الكريمة:
إن النماذج التي خرجها الإسلام من القادة والجنود قد اتصفوا بأخلاق حميدة وقيم سامية، فرفعت من المستوى الإنساني عند معتنقيها، فكان لها أثر كبير في إقبال أبناء البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام، فكم من أفواج من البربر دخلوا في الإسلام وقاتلوا في سبيله في عهد موسى بن نصير، وكذلك في الهند وبخارى وسمرقند وغير ذلك من البلدان، فالمسلمون لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلها، وإنما ليعمروها ويعزوا أهلها، ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد، ويخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فهم أصحاب رسالة خالدة، تحمل للناس العدل والإنصاف، وتحقق لهم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وبمجرد ما عرف الناس في البلاد
المفتوحة أهداف المسلمين الحقيقية، وتكشفت لهم حقيقة الإسلام، أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة ـ كما سنعرفه فيما بعد ـ ولقد حرص المسلمون، على الوفاء بكل ما التزموا به، ولم يكن هذا من حسن السياسة فقط؛ فالوفاء بالعهد ليس تبرُّعاً من المسلمين يمنون به على الناس، ولكنه مسؤولية واجبة عليهم، قال تعالى: { وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسُۡٔولٗا} [سورة الإسراء:34]
3 ـ إشراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة بلادهم:
كانت سياسة المسلمين منذ بداية الفتوحات من سعة الأفق والمرونة بحيث أدركوا أن استتباب الأمن وسير الأمور سيراً حسناً في البلاد المفتوحة بما يحقق خير أهلها ومصالحهم يكمن في الأسلوب الإداري الذي سيسيرون عليه، فلم يترددوا في الاستفادة من النظم الإدارية التي وجدوها في البلاد المفتوحة؛ سواء كانت خاضعة للبيزنطيين مثل الشام ومصر، أو خاضعة للفرس مثل العراق وبلاد فارس نفسها، واستفادوا من الجهاز الإداري وطبقة الموظفين الذين كانوا يسيّرون دولاب العمل في البلاد، فقد كان الوالي في العهد الأموي يتمتع بكل السلطات والصلاحيات الإدارية والمالية والعسكرية في إقليمه، وكان المسلمون يحتفظون بمناصب القضاء والشرطة والحسبة، أما ما عدا ذلك من الوظائف الإدارية فكان المجال فيها متسعاً أمام أبناء البلاد المفتوحة في الإدارة، بل إن كثيراً منهم وصلوا إلى مناصب إدارية في ظل الحكم الإسلامي كانوا محرومين منها في ظل حكومات ما قبل الإسلام كما هو الحال في مصر، فقد كان البيزنطيون يستحوذون على معظم المناصب الإدارية، بالإضافة إلى المناصب العسكرية العليا، ولا يتركون للمصريين إلا أقل القليل ، وقد توسع الأمويون في استخدام أهل الذمة في الإدارة، مما أشعرهم بالأمان والاطمئنان تجاه الدولة، فبدؤوا يقبلون على اعتناق الإسلام لترتفع مكانتهم أكثر فأكثر .
4 ـ الوضع الديني في البلاد المفتوحة:
ومما جعل أبناء البلاد المفتوحة يقبلون على الإسلام بسرعة، فساد الأديان في بلادهم وانحلالها، وفساد رجالها، سواء كانت هذه الأديان سماوية كاليهودية والمسيحية، أو وضعية كالبوذية والزرادشتية والمانوية والمزدكية وغيرها من الأديان الوثنية التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة .
هذه هي أهم العوامل والأسباب التي ساعدت في دخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام.
ثالثاً: تفسير حركة التعريب بين الشعوب المفتوحة:
نعني بالتعريب تحوُّل لسان الأهالي في البلاد المفتوحة إلى اللسان العربي وهجر لغاتهم المحلية، وقد حدث هذا في عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية في المنطقة المحصورة بين الخليج والمحيط والمعروفة حالياً بمنطقة الدول العربية؛ فقد هجر أهالي تلك البلدان لغاتهم الأعجمية، وحلت اللغة العربية محل الارامية والسريانية في الشام والعراق، والقبطية في مصر، والبربرية في بلدان المغرب، ومن أهم أسباب التعريب :
1 ـ انتشار الإسـلام:
ومهما يكن من أمر فإن انتشار الإسلام بتلك السرعة والسهولة اللتين تم بهما جاء ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ، ذلك أنه لم تكد تنقضي على وفاة الرسول ﷺ مئة سنة حتى كان الإسلام قد ثبتت ركائزه في بلاد ممتدة من المحيط الأطلسي وشبه جزيرة أيبيرية غرباً، حتى بلاد الهند وحدود الصين شرقاً، وكان لا بد أن يأتي انتشار الإسلام مصحوباً بالتعريب، لأن معتنقيه كانوا مطالبين بأداء فروضه، ومن الواضح أن النطق بالشهادتين يتطلب نطق بعض الألفاظ العربية وفهم معناها، فضلاً عن أن أداء شعائر الصلاة يتطلب معرفة فاتحة الكتاب وحفظ بعض قصار السور من القران الكريم، ثم إن الإسلام يطلب من المسلم الإنصات للقران الكريم إذا قرأى على مسمع منه، وترتيله وتدبر ما فيه من ايات بينات، وهذه كلها أمور ترتبط بمعرفة اللغة العربية وفهمها.
وطبيعي أن يكون من المتعذر على اللغات المحلية أن تستمر، فأخذت تتقلص تدريجياً، وتنكمش دائرة استعمالها لتفسح المجال أمام العربية .
وهناك حالات ترتبط ببلاد فتحها المسلمون وحكموها بضعة قرون ومع ذلك لم يتعرّب أي منهم، ونعني بهذه البلاد: فارس والتركستان، فالفرس اعتنقوا الإسلام ولكنهم احتفظوا بلغتهم، وإن جاء هذا الاحتفاظ جزئياً غير كامل؛ حيث إن اللغة الفارسية غدت تكتب وتدون بأحرف عربية من ناحية، كما أن كثيراً من الألفاظ العربية، وخاصة تلك المرتبطة بالإسلام وعلوم الدين دخلت الفارسية من ناحية أخرى .
وأما التركستان، فقد كانت حماية ما وراء النهر من عدوان الأتراك الشرقيين من أهم منجزات العصر الأموي التي مكنت السيادة الإسلامية فيما وراء النهر، وأضافوا إلى هذه الجهود جهوداً أخرى في ميدان الدعوة إلى الإسلام ونشر الثقافة العربية في البلاد، وقد وضحت هذه الجهود منذ فجر الفتح الأول، فقد كان قتيبة بن مسلم يبني المساجد في بخارى وسمرقند، ولم تكن المساجد دوراً للعبادة فحسب، إنما كانت مدارس الثقافة العربية الإسلامية، وأتبع ذلك بتوطين القبائل العربية في المدن الكبرى، وتتابعت الجهود في عهد عمر بن عبد العزيز الذي أسقط الجزية عمن أسلم، وأمر عماله بالدعوة إلى الإسلام، واستمرت هذه الجهود بعد عمر وخاصة في عهد الوالي أشرس بن عبد الله السلمي (108 ـ 110 هـ)؛ إذ كان أول من أنشأ الربط والخوانق والمدارس، وعمل على تثبيت قدم الثقافة العربية في البلاد.
ومع كل ذلك فإن اللغة العربية لم تستطع أن تنتشر رغم إسلام الأتراك وحماسهم الشديد له، وكل ما عمله الأتراك أنهم انتحلوا الخط العربي بحيث لا تجد تركياً على شيء من التعليم لا يستطيع أن يفهم لغة القران في سهولة، وهنا لابد أن نأتي إلى تلك النتيجة المنطقية ؛ وهي: أن انتشار الإسلام قد أدى إلى انتشار اللغة العربية، ولكنه لم يؤدِّ بالضرورة إلى التعريبفي المناطق الفارسية والتركية وغيرها.
2 ـ هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة:
ساعد على تعريب البلاد المفتوحة أن العرب الذين نزحوا إلى الأرض الجديدة استقر معظمهم فيها، ولم يستمروا طويلاً في حالة عزلة، وإنما أخذوا يندمجون تدريجياً مع الأهالي الأصليين، ولعل أول موجة نذكرها جاءت إلى مصر مع عمرو بن العاص، واستمرت الهجرة في العهد الأموي وأخذوا يندمجون تدريجياً مع الأهالي الأصليين .
3 ـ تعريب الدواوين:
ومن الأمور التي ساعدت على حركة التعريب، ما قام به عبد الملك من حركة التعريب في الدواوين؛ فقد أدى هذا الفعل إلى تعريب اللسان ونشر الخط العربي في كل البلدان التي توالى فيها بعد ذلك نقل دواوينها إلى اللغة العربية، ذلك أن: استخدام اللغة العربية في الشؤون الإدارية كان وسيلة فعالة كبرى إلى نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية، ومن الثابت أيضاً أن هذا الطراز لم يتم تطوره الكامل بتحقيق حروف الهجاء من أواخر القرن الأول بعد الهجرة .
4 ـ تفوق الحضارة الإسلامية:
ساعد ازدهار الحضارة الإسلامية واتساع نطاقها وتنوع افاقها على حركة التعريب؛ فهذه الحضارة ساهمت في كافة الميادين ذات الخبرة الإنسانية، سواء الدراسات النظرية والعملية، والأطعمة والأشربة والعقاقير، والأسلحة والفنون والصناعات، والنشاط التجاري والبحري، وكانت اللغة العربية أداة تلك الحضارة العظيمة ، وقد استفاد العرب من حضارات الأمم الأخرى، وقد أدى تفوق الحضارة الإسلامية إلى انتشار اللغة العربية في ربوع العالم ولكنه لم يؤدِّ إلى التعريب .
5 ـ لغة الغالبين الفاتحين:
كانت اللغة العربية هي لغة الغالبين الفاتحين، سادة البلاد، وحكامها الجدد، وثمة علاقات متبادلة بين الحاكم والمحكوم تتطلب قدراً من التفاهم المشترك الذي لا يتحقق إلا داخل إطار لغة متفق عليها بين الطرفين، ولما كان الحكام الجدد لا يعرفون لغة إلا العربية، فلم يبق أمام الشعوب التي خضعت لهم سوى تعلم العربية، هذا فضلاً عما يقال من أن ثمة عقدة نفسية عند البشر تجعل الضعيف شغوفاً بمحاكاة القوي، والمغلوب مولعاً دائماً أبداً بتقليد الغالب، وهذا القول ليس على إطلاقه، فهناك أمثلة عديدة في التاريخ قبل حركة الفتوح الإسلامية وبعدها تثبت أن تحول شعوب بأكملها إلى لغة الحكام الفاتحين ونبذها لغة الاباء والأجداد ليست القاعدة في التاريخ؛ فاللغة العربية وإن كانت لغة غالب الفاتحين فإن ذلك لم يؤدِّ إلى تعريب كل الشعوب، وإن أدى ذلك إلى انتشار اللغة العربية في تلك البلاد المفتوحة، وذلك أن الإسلام لا يجبر الشعوب على ترك لغتها وأعرافها وعاداتها ما لم تخالف الشرع.
هذه هي أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار اللغة العربية وحركة التعريب في بعض البلدان المفتوحة.
رابعاً: الحرص على سلامـة الجيـوش:
كان عبد الملك بن مروان يوصي قادته بالحذر من البيات، والتيقظ والحرص على سلامة العسكر، بإقامة الحرس، فكان قادته لا يسيرون ولا ينزلون إلا على تعبئة، ويتخذون في نزولهم الخنادق والمسالح بكل مكان مخوف والأرصاد على العقاب والشعاب ، واهتم عبد الملك بجمع الأخبار عن العدو، فلا يسير له جيش إلا وقد سبقته العيون لترصد أخبار العدو، واستطاع قادته استمالة بعض أبناء البلاد المفتوحة ليكونوا عيوناً لهم يقدمون لهم المعلومات الصحيحة عن تحركات العدو، واستعانوا أيضاً بالتجار في هذه المهمة ، فكل قادة الفتح لهم عيون يجمعون لهم المعلومات عن الأعداء، وهذا دليل على حرص القيادة على سلامة جنودها وجيوشها.
خامساً: أهميـة الشورى في إدارة الصـراع:
ومما أوصى به الخليفة عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز عندما أبقاه على ولاية مصر قولـه: «وإذا انتهى إليـك مشكل، فاستظهر عليـه بالمشورة فإنهـا تفتح مغاليق الأمور المبهمة، واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه، ولن يهلك امرؤ عن مشورة .
كما أوصى أحد قواده بقوله: لا تستعن في أمر دهمك برأي كذاب ولا معجب، فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، وأما المعجب فليس له رأي صحيح ولا روية تسلم.
ومما قاله عبد الملك في المشورة: لأن أخطأى وقد استشرت، أحب إليّ من أن أصيب وقد استبددت برأي وأمضيته من غير مشورة؛ لأن المقدم على رأيه يزري به أمران: تصديقه رأيه الواجب عليه تكذيبه، وتركه من المشورة ما يزداد به بصيرة .
وعندما تحركت الروم بأرض القسطنطينية حين عزموا على غزو المسلمين، وبلغ أمرهم عبد الملك بن مروان، نادى في أهل الشام وجمعهم في المسجد الأعظم، ثم صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس إن العدو قد كلب عليكم وطمع فيكم وهنتم عليه لترككم العمل بطاعة الله تعالى واستخفافكم بحق الله، وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله، ألا وإني قد عزمت على بعثكم إلى أرض الروم؛ فماذا عندكم من الرأي ؟ وهنا نجد أن الخليفة عبد الملك بن مروان شاور المسلمين في مرحلة الإعداد والإقرار، فيبرز بذلك مبدأ الشورى في اتخاذ القرار العسكري في الإدارة العسكرية الأموية، وأخذ قادة الخليفة عبد الملك بن مروان يعملون بالمشورة فيما بينهم في إدارتهم للمعارك الحربية وبين القيادة العليا المركزية ، وحين حضرت الخليفة عبد الملك الوفاة أوصى أبناءه بقوله: وانظروا ابن عمكم عمر بن عبد العزيز فاصدروا عن رأيه، ولا تَخَلَّوا عن مشورته، اتخذوه صاحباً لا تجفوه، ووزيراً لا تعصوه؛ فإنه من علمتم فضله ودينه وذكاء عقله، فاستعينوا به على كل مهم، وشاوروه في كل حادث. وبانتقال الخلافة إلى ابنيه الوليد وسليمان سلكا نهجه في إدارتهما العسكرية بمبدأ الشورى، وأخذهما بها لدى فتوحاتهم الإسلامية في مرحلة الإعداد والإقرار، أو التخطيط والتنفيذ .
سادساً: الاهتمـام بالحـدود البريـة:
اهتم الخليفة عبد الملك بالحدود البرية، فقام ببناء عسقلان وحصّنها ورمَّم قيسارية، وبنى بها بناءً كثيراً وبنى مسجدها، وقام بتجديد وترميم صور وعكا وأردبيل وبرذعة لما لهذه الثغور من أهمية حربية ، وبنى واليه الحجّاج بن يوسف مدينة واسط كقاعدة عسكرية تتوسط بين الأهواز والبصرة والكوفـة بمقدار واحـد قدره خمسون فرسخاً، وذلك أنه كان حينما يريد غزو خراسان ينزل جيش الشام على أهل الكوفة، فكانوا يتأذون منهم، فبنى واسطاً كمعسكر لهم، ولقد لعبت دوراً مهماً في عملية الإمداد لثغور المشرق .
وفي عهد عبد الملك فتح حصن سنان من بلاد الروم؛ حيث استفاد منه بشحنه بالجند لحماية الحدود .
واهتم عبد الملك في إدارته العسكرية بحملات الصوائف والشواتي، فكان يوليها كبار رجالات البيت الأموي، مما يدل على حرصه وعنايته في حماية وتأمين حدود الدولة الإسلامية ضد هجمات الأعداء، وكان من هؤلاء الأمراء ابنه الوليد، ومن أمراء البيت الأموي الذين تولوا حملات الصوائف والشواتي لعدة سنوات أخو الخليفة عبد الملك محمد بن مروان، الذي كان له الأثر الجميل في مباشرة تحصين وإنشاء حصن المصيصة وشحنه بالجند وبنائه لطرندة وتعزيزه إياها بالعسكر، وابنه مسلمة، بالإضافة إلى كبار القادة أمثال يحيى بن الحكم وعثمان بن الوليد وغيرهما .
واهتم الخليفة الوليد بالحدود البرية وقام بتحصينات ثغرية كالتي أنشأها بالثغور الشامية على الخط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط لحماية حدود الدولة الإسلامية من هجمات الروم، واستحداثه لأربع نقاط حصينة؛ هي: حصن سلوقيةوإقطاعه الجند للأراضي بها لتعميرها وإلصاقهم بالثغر، حصن بغراس، وعين السلور وبحيرتها، والإسكندرونة ، فأصبح هذا الخط الساحلي أكثر مناعة وحصانة في عهده من ذي قبل، وقام بفتح حصون
كثيرة ثم شحنها بالجند المرابطين؛ منها: حصن طوانة وغيرها من الحصون، واهتم الوليد بالطرق الموصلة إلى الثغور، وقام بتسهيلها وتأمينها وبنى بها القناطر لعبور الجند عليها في حملاتهم الصائفة والشاتية .
واستمر والي العراق من قبل الوليد الحجّاج بن يوسف بتحصين ثغور المشرق، وعمل المراصد بها وبناء القواعد العسكرية فيها كخوارزم ، وشيراز وخراسان وغيرها من ثغور المشرق ، واستمر الخليفة سليمان على نهج والده وأخيه في الاهتمام بالحدود البرية .
سابعاً: الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفتوحات:
من الاثار الاقتصادية والاجتماعية في عهد الخليفة عبد الملك للفتوحات؛ ظهور التجار برفقة العسكر بشراء بعض ما يغنمه الجند من العدو، فبذلك تنشط الحركة التجارية وتزدهر، كما أنه أثناء سير العسكر نحو العدو وحين يصادف مرورهم بالمدن والقرى المتواجدة في طريقهم يقومون بشراء احتياجاتهم منها، وكان والي مصر عبد العزيز بن مروان من قبل عبد الملك يحفر الخلجان بها، وكانت له بمصر ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره، ومئة جفنة يطاف بها على القبائل، تحمل على عجل من أجل الإطعام، وحين انتقلت الخلافة إلى الوليد كانت إدارته من أفضل الإدارات في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع، وسيأتي عنها الحديث في محلها بإذن الله تعالى. هذه هي أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات في عهد عبد الملك وبنيه.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf
الجزء الثاني:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC139.pdf
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com