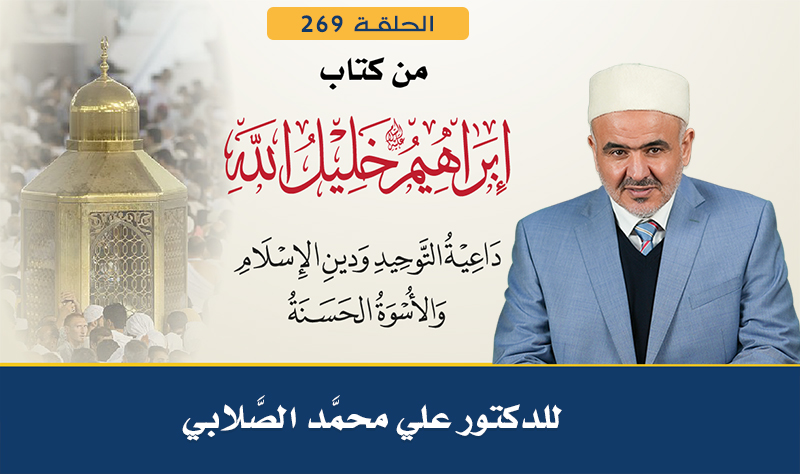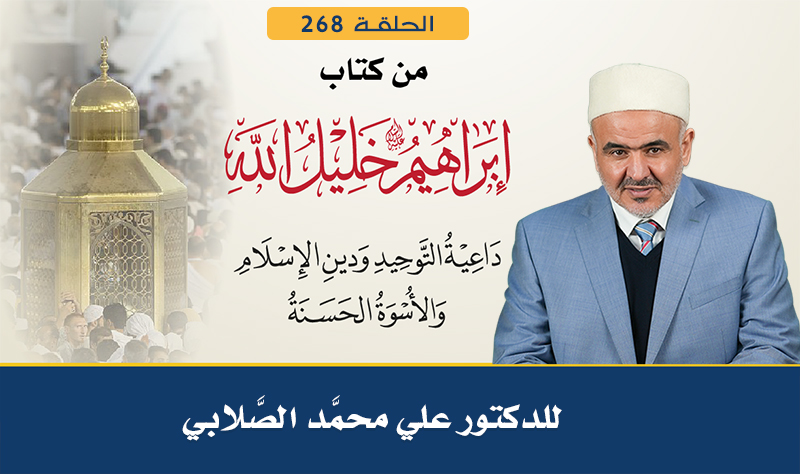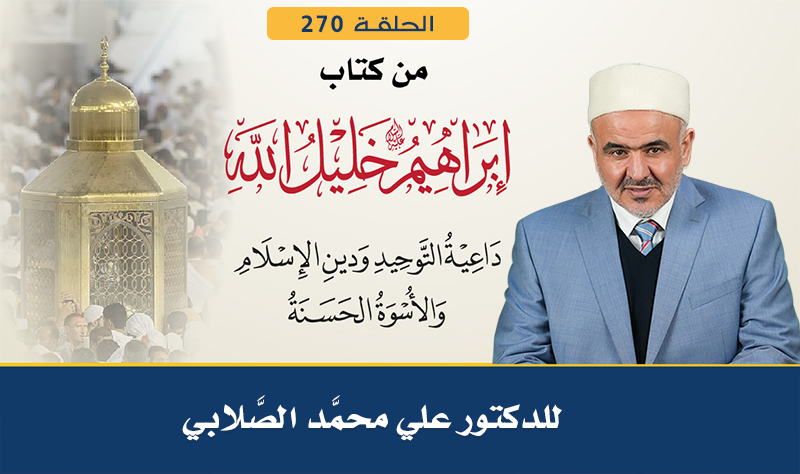تأملات في الآية الكريمة {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 269
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
شوال 1444ه/ أبريل 2023م
انتقل السّياق القرآني من توبيخ هؤلاء الذين يحاجّون في الله ويجادلون في توحيده، إلى توبيخ آخر وهو دعواهم أن رسل الله هؤلاء كانوا هوداً أو نصارى، فزعمت اليهود أن إبراهيم - عليه السّلام - كان يهودياً وزعمت النصارى أنه كان نصرانياً.(1)
1. قوله تعالى: {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى}:
جاءت {أَمْ} هنا للانتقال من موضوع إلى موضوع، وقد نفى الله هذه المزاعم في سورة آل عمران بقوله: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} ]آل عمران:67[، فموسى والتوراة كانا بعد إبراهيم بزمن، وعيسى والإنجيل كانا بعد إبراهيم بزمن، فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً؟ وقوله: {وَإِسْمَاعِيلَ} وهو أكبر أولاد إبراهيم، {وَإِسْحَاقَ} أخ إسماعيل –الولد الثاني لإبراهيم، {وَيَعْقُوبَ} وهو ابن إسحاق ويسمّى إسرائيل، {وَالْأَسْبَاطَ} وهم أبناء يعقوب الاثنا عشر.(2)
وهناك من قال: والأسباط: جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل، كالقبيلة في العرب، والمراد عامة أنبياء بني إسرائيل، الذين اختارهم الله من أسباطهم.(3)
وقوله: {كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} أي: تزعمون أن كل هؤلاء كانوا على الديانة اليهودية أو النصرانية؟ وبالإضافة إلى استعمال حجة التاريخ في الردِّ على مزاعمهم، فقد أبطل الله دعوى اليهود والنصارى هذه بطريقة أخرى.(4)
2. قوله تعالى: {قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ}:
ولا يستطيعون أن يقولوا: إنهم أعلم من الله، فمن المعلوم أنه أعلم، وهذا الاستفهام من أجل إفحام الخصم وإلزامه، فإذا قال الله شيئاً، وقال هؤلاء شيئاً يعارضه، فكلام من المعتبَر والمصدَّق؟ لا شكّ أنه كلام الله تعالى، فكأنّه يقول للمجادلين: أأنتم أعلم بدين هؤلاء الرسل أم الله أعلم بدينهم؟(5)
والإجابة معروفة: فهؤلاء الأنبياء ما كانوا هوداً ولا نصارى، بل كانوا مسلمين موحدين، كما مرّ معنا، ورسالة الإسلام هي دعوتهم ووصيتهم التي أوصوا بها أبناءهم، والتي ذكرها في الكتب المنزلة عليكم فأخفيتموها، وكتمتم الشهادة التي ائتمنكم الله عليها.(6)
3. قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ}:
أيّ: لا أحد أشدّ ظلماً في باب كتمان الشهادة، ممن أخفى وستر على الناس شهادة ثابتة عنده في كتاب دينه من الله، صادره منه عزّ وجل، وهم اليهود والنصارى، كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية وكتموا محمداً صلّى الله عليه وسلّم، وهم يعلمون أنه رسول الله، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.(7)
فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى، والله سيعاقبهم عليه أشدّ العقوبة،(8) فلهذا قال:
4. قوله تعالى: {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}:
هذا وعيد وإخبار بأمر الله تعالى، وقد نفى الله تعالى نفياً مؤكداً أنه غافل عن عملهم، بل إنه سبحانه آخذهم بذنوبهم، فنفى بــ "ما" و"الباء" الدالة على استغراق النفي.(9)
وبيّنت الآية أن الله قد أحصى أعمالهم وعدها، وادّخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى الظالمين، وهذه طريقة القرآن الكريم في ذكر العلم والقدرة، عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها: الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، ويفيد أيضاً ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها، وموجب من موجباتها، وهي مقتفية له.(10)
قال الرازي: أما قوله: {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}: فهو الكلام الجامع لكل وعيد، ومن تصور أنه تعالى عالم بسره وإعلانه، ولا يخفى عليه خافية أنه من وراء مجازاته وإن خيراً فخير، وإن شراً فشر، لا يمضي عليه طرفة عين إلا وهو خائف، ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل، مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر، فكيف بالربِّ الرقيب الذي يعلم السرَّ وأخفى، إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول.(11)
وبمناسبة زعمهم أنهم يتمسكون بما كان عليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السّلام، قال سبحانه مرة ثانية لهم (12)
مراجع الحلقة التاسعة و الستون بعد المائتين:
(1) تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المنجد، 234.
(2) تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المنجد، ص235.
(3) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (1/202).
(4) تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المنجد، ص235.
(5) المرجع نفسه، ص235.
(6) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (1/205).
(7) تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المنجد، ص235.
(8) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص100.
(9) زهرة التفاسير، الإمام محمد أبو زهرة، (1/430).
(10) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص100.
(11) التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)، (4/100).
(12) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (1/205).
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي