الطير في القرآن الكريم
الحلقة الستون
بقلم الدكتور: علي محمد محمد الصلابي
رجب 1441ه/مارس 2020م
1 ـ الطير أمة من الأمم:
الطير أمة من الأمم خلقها الله تعالى، وألهمها سبل الحياة، وجعلها برهاناً على عظمته وقدرته.
ــ قال تعالى: " وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ" (الأنعام ، آية : 28).
وفي قوله: "ِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم" أي: أصناف، وكل صنف من الدواب، أو الطير مثل بني آدم في المعرفة بالله وطلب الغذاء، وتوقي المهالك.. مع أشبه لهذا كثير، و"أُمَمٌ أَمْثَالُكُم" أي: كما لكم حياتكم الخاصة بكم كأمم وشعوب.. فهذه العوالم من الدواب والطيور مثلكم لهم حياتهم الخاصة بهم كأمم مختلفة ألوانها وأشكالها.. كل أمة تتميز عن أختها بما خصها الله تعالى من الخصائص والصفات، وهي جماعات مماثلة لكم في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر ينتابها ما ينتابكم من الحسرة أو الحزن أو الألم.. أو المرض أو الشفاء، وهي ستحاسب يوم القيامة إن طغى بعضها على بعض وظلم بعضها البعض، كما سيحاسب الإنسان، وتقتص كل منها من الآخر، وإن لم يكن من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها، بل قصاص مقابلة كما في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء".
2 ـ منطق الطير:
قال تعالى: " وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ" (النمل ، آية : 16)، ومنطق كل شيء: صوته، وقد يقع لما يفهم بغير كلام، وقد علم الله تعالى سليمان عليه السلام فهم أصوات الطير ولغاتها التي تسبح بها وتصلي " كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ" (النور ، آية : 41).
وبهذه اللغة تتفاهم الطيور مع بعضها، وقد عكف العلماء على دراسة الطير، وطباعه ولغته فوجدوا أنه بواسطة اللغة هذه يتفاهم الذكر مع الأنثى وأن بعضها يحذر بعضاً، كما تفعل العصافير بالزقزقة، ولاحظوا أن الطيور تغرد في فترات الصباح أكثر من فترة الظهيرة فتطرب الآذان وتأنس النفوس.
3 ـ سليمان عليه السلام والهدهد:
قال تعالى: "وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ" (النمل ، آية : 20 ـ 28).
يتجلى لنا الإعجاز الإعلامي في قصة هدهد سليمان والتي وردت في سورة النمل في النواحي التالية:
أ ـ استخدام المقدمة المشوقة:
حيث نرى الهدهد في هذه القصة استخدم أسلوب التشويق في بداية القصة حينما قال: " فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ" (النمل ، آية : 27).
ــ فالهدهد، أحاط أي رأى وشاهد وسمع وفهم وحلل فهو قد أحاط الموقف علماً ولذلك قال أحطت.
ــ وهو يعلم ويجزم أن سليمان لم يحط به: " بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ".
إن الهدهد يعرف حزم الملك وشدته، ولذلك بدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته، وتضمن إصغاء الملك له.. وأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له: "أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ".
ــ وهو قد تحرى ودقق وبحث وعرف أن القرية اسمها سبأ وهي في بلاد اليمن.
ــ وهو قد جاء منها بنبأ يذاع لأول مرة عند سليمان فكلمة "جِئْتُكَ" تدل على إحضار بيانات وعلم من مكان خارج عن المكان الذي أنت فيه الآن.
إذن فالهدهد استخدم أسلوب التشويق لأنه يعرف أنه جاء بسبق صحفي يذاع لأول مرة خاصة لنبي الله سليمان عليه السلام.
وهو واثق من نفسه ومن النبأ الذي جاء به، فيصفه بأنه نبأ يقين، وقد عاجل الهدهد سليمان بهذه المقدمة المشوقة لكي يمتص غضبه بسبب غيابه، ولكي يستثيره، فقول سليمان الذي توعده بالعذاب الشديد أو الذبح استثنى أن جاء الهدهد بسلطان مبين.
ب ـ التناسب:
يؤكد علماء الصحافة أن كل خبر صحفي ينبغي أن يتكون من عنوان ومقدمة وجسم للخبر وخاتمة، وعندما ننظر إلى قصة الهدهد مع نبي الله سليمان نجد أن الهدهد يبتكر شيئاً جديداً في عالم الصحافة حيث رآه يقسم جسم الخبر المؤكد الذي جاء به إلى نبي الله سليمان عليه السلام إلى نوعين:
ــ معلومات يراها الإعلامي، وترصد حواسه عن أشياء معلنة يراها بعينه ويسمعها بأذنيه ويمسكها بيديه وهي أربعة:
ـ إني وجدت امرأة تملكهم، عرف أنها امرأة، فالهدهد له عقل ويعرف الفرق بين الذكر والأنثى.
ـ تملكهم عرف العلاقة الإدارية بينها وبين قومها، فهي لا ترأسهم ولا تقودهم ولا تؤمهم فحسب، وهي ليست فقط ملكتهم، ولكنها تملكهم.
ـ وأوتيت من كل شيء ومعنى هذا أن الهدهد اطلع على ملكها وقيّمه، كما أن لديه خبرة في الأشياء عرف بها كيف يقيم هذا الملك.
ـ ولها عرش عظيم، هو يقيم عرضها ويقدر أنه عظيم، فمن الذي علمه هذا؟ لا شك أنه الله رب العالمين ولا جدال أن كل هذه الأمور الأربعة محسوسة ومدركة بالحواس الخمس أو ببعضها.
ــ أنباء عن أشياء مخفية عن الحواس فهي أشياء في عقل أو قلب بعض الناس فلا تدرك بالحواس الخمس وإنما بالعقل منها.
ـ " وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ" (النمل ، آية : 24).
وأنت لا تستطيع من رؤيتك لقوم يسجدون أن تعرف أهم يسجدون لله أم للشمس، أم نفاقاً؟ فذلك في نيتهم التي لا يمكن الاطلاع عليها من الظاهر، ولكن الهدهد عرف ما في عقولهم.
ـ فصدهم عن السبيل فهي أخبار لا تدرك بالحواس ولكن بالاطلاع على مخبوء العقل.
ـ " لَا يَهْتَدُونَ"، وهذه معناها أن الهدهد يعرف الهدى من الضلال، وهكذا نرى أن الهدهد في قصته الخبرية استخدم الألفاظ المناسبة التي تدل على المعنى المراد.
ج ـ التنوع في طريقة عرض الأبطال والأحداث:
وهذه سمة مهمة في قصة سليمان مع الهدهد، فنحن نرى تنوعاً وتعدداً في أبطال القصة، فمرة نجد نبي الله سليمان يتفقد الطير فلا يجد الهدهد، ومرة نجد الهدهد يقف بين يدي نبي الله سليمان متحدياً " أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ"، ومرة ثالثة نجد ملكة سبأ وقد عبدت الشمس من دون الله مع قومها، وهكذا التنوع في طريقة عرض الأبطال والأحداث.
ح ـ التدرج في الاتهام:
فعند التأمل الدقيق لهذه القصة نجد أن نبي الله سليمان تدرج في الاتهام، فنحن نراه اتهم نفسه أولاً: " مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ" (النمل ، آية : 20)، ثم اتهم الهدهد: " أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ".
ثم تدرج في العقوبة من الأشد على الأخف، فمن العذاب الشديد إلى الذبح، ثم إلى العفو الشامل، لو يأتي بسلطان مبين، ولا شك أن هذا التدرج من علامات الإيمان، حيث لا يترك الإنسان احتمالاً لا لإدانة نفسه قبل إدانة غيره، وألا يترك نفسه للانفعال الشديد ولكنه يهدأ حتى يصل إلى العفو.
س ـ براعة الدفاع عن النفس:
وقد تمثل في قول الهدهد معتذراً لنبي الله سليمان عليه السلام: " أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ" فهنا نجد الهدهد بدأ بمقدمة يسميها علماء الصحافة المقدمة القنبلة حيث نراها تطغى على مسألة غيابه، وتضمن إصغاء نبي الله سليمان له.
ش ـ حسن اختيار الألفاظ:
حيث تم اختيار الألفاظ في قصة هدهد سليمان عليه السلام بطريقة رائعة تدل على فهم عميق، فكانت الألفاظ تحمل معنى واحداً هو المعنى الذي قصده وأراده القائم بالاتصال، ومن أمثلة ذلك:
" أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ" فالإحاطة هنا شاملة لجميع جوانب الحدث أو الخبر الذي جاء به دون أن يترك ثغرة فيه، وكذلك عند اختياره لجملة " بِنَبَإٍ يَقِينٍ" فلقد ذكر الهدهد لفظ "نبأ" بدلاً من "خبر" لأن النبأ أصدق من الخبر، ولأنه يروي الأحداث الهامة والعظيمة والتي تهم المستمع وكذلك يدل استخدام النبأ اليقين على شدة تيقن الهدهد من صحة الأخبار والمعلومات والمتابعات الإخبارية، وتتجلى براعة الهدهد أيضاً في استخدامه للفظ " الْخَبْءَ" في حديثه حيث أظهر قدرة وعظمة الله وكذلك اختياره للفظ السجود في قوله " يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ" (النمل ، آية : 24).
فهذا دليل على أن العبادة لا تتم إلا بالسجود لله الخالق الوهاب، فالسجود أصل العبادة.
ك ـ براعة تصوير الأحداث:
فالمتأمل لهذه الآيات القرانية التي تتحدث عن قصة هدهد سليمان يكتشف براعة في تصوير الأحداث وكأنه يرى الأحداث حية أمامه، فنبي الله سليمان عليه السلام يبحث عن الهدهد في مشهد رائع والهدهد يأتي من سبأ بنبأ يقين في مشهد يشعر وكأن الأحداث تجري حية أمام عينه فهو يحس بانفعال الهدهد، وحزنه على قوم سبأ الذين يسجدون للشمس من دون الله، وهو أيضاً يحس بني الله سليمان وهو يتفقد أحوال رعيته ويبحث عن الهدهد.
و ـ الإيجاز:
وهذه سمة مهمة في قصة هدهد سليمان عليه السلام توضح الإعجاز الإعلامي في القرآن الكريم الذي يتجلى لنا في استخدام أقل الكلمات للتعبير عن أكبر عدد من الأفكار، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: " وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ" (النمل ، آية : 23).
هـ ـ انتقاء الأحداث:
وتتجلى لنا سمة انتقاء الأحداث وهي إعجاز إعلامي رائع في قول الهدهد: " وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ" (النمل ، آية : 22).
قال سليمان: وما ذاك الخبر؟ قال: إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ"، فقد تم انتقاء الحدث، فلم يذكر لنا سؤال سليمان وجيء بجواب الهدهد مباشرة.
4 ـ تسبيح الطير:
قال تعالى: " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ" (النور ، آية : 41).
هذا مشهد الإيمان والهدى والنور في الكون الفسيح، مشهد يتمثل فيه الوجود كله، بمن فيه وما فيه، شاخصاً يسبح لله: إنسه وجنه، أملاكه وأفلاكه، أحياؤه وجماده، وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه في مشهد يرتعش فيه الإنسان حين يتأمله.
إن الإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسيح، فإن من حوله، وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وحينما امتد به النظر أو طاف به الخيال، إخوان له من خلق الله، لهم طبائع شتى، وصور شتى، وأشكال شتى، ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله، ويتوجهون إليه، ويسبحون بحمده وتقواه ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه فلا يثير انتباهه لطول ما يراه ذلك مشهد الطير صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد الله " كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ".
والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه، وهو أحد خلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة، وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه، مسبحاً بحمده، قائماً بصلاته وإنه لكذلك في فطرته، وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه، وإن الإنسان ليدرك ـ حين يشف ـ هذا المشهد ممثلاً في حسه كأنه يراه، وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله، وإنه يشارك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه كذلك كان محمد بن عبد الله ـ صلاة الله وسلامه عليه ـ إذن متى سمع تسبيح الحصى تحت قدميه وكذلك الجبال معه والطير " وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإلى اللَّهِ الْمَصِيرُ".
فلا اتجاه إلا إليه، ولا ملجأ من دونه، ولا مفر من لقائه، ولا عاصم من عقابه، وإلى الله المصير.
5 ـ الطير جند من جند الله :
ــ قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ" (الفيل ، آية : 1 ـ 5).
وفي قوله: " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ"، وهو سؤال للتعجب من الحادث، والتنبيه إلى دلالته العظيمة، فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ، يقولون حدث كذا عام الفيل بعشر سنوات، والمشهور أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في عام الفيل ذاته، ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة.
وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها، إنما كانت تذكيراً بأمر يعرفونه، فالمقصود ما وراء هذا التذكير، ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك.
" أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ"، أي: أم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه، وأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة: "وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ".. والأبابيل: الجماعات، وسجيل: كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان: حجر وطين، أو حجارة ملوثة بالطين، والعصف: الجاف من ورق الشجر، ووصفه بأنه مأكول: فتيت طحين، حين تأكله الحشرات وتمزقه، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير، وتوحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدِّر لأهل الكتاب ـ أبرهة وجنوده ـ أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة حتى والشرك يدنسه والمشركون هم سدنته، ليبقى هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين مصوناً من كيد الكائدين، وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة لا يهيمن عليها سلطان، ولا يطغى فيها طاغية، ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد ويقود البشرية ولا يقاد، وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام.
وكذلك توحي دلالة هذا الحادث أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض، بل لم يكن لهم كيان قبل الإسلام، كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة، وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم، إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان، ولم ينجح إلا قلب الجزيرة من عدم تحكم الأجانب فيه، ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية، وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة، ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدولة القوية المجاورة وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبي.
وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه، وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب، قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية، بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة، ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو الإسلام، وذكروا أنهم مسلمون ورفعوا راية الإسلام وتركوا نعرة الجنس وعصبية العنصر، وإنما حملوا راية الإسلام وحدها وعقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية، ولم يحملوا قومية ولا عنصرية، ولا عصبية حملوا ديناً يعلمون الناس به، لا مذهباً أرضياً يخضعون الناس لسلطانه، وخرجوا من أرضهم جهاداً في سبيل الله وحده ولم يخرجوا ليأسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون ويتكبرون تحت رعايتها وإنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
عندئذ فقط كان للعرب وجود، وكانت لهم قوة، وكانت لهم قيادة ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله، وقد ظلت لهم قوتهم وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة، حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم الأرض وداستهم الأمم، لأن الله قد تركهم حين تركوه ونسيهم مثلما نسوه.
والإسلام الذي تقدم به العرب للبشرية وهو الذي رفعهم الله به في مكان القيادة، فإذا تخلوا عنه لم يعد لهم في الأرض وظيفة ولم يعد لهم في التاريخ دور، وهذا ما يجب أن يذكره المسلمون جيداً إذا هم أرادوا الحياة، وأرادوا القوة وأرادوا القيادة والله الهادي من الضلال.
6 ـ معجزة الطيران:
لقد أشار القرآن الكريم إلى الأنظمة التي خلقها تعالى للطير وبها يستطيع الطيران في الجو وذلك:
ــ في قوله: " أَلَمْ يَرَوْاْ إلى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" (النحل ، آية : 79).
ــ وقوله تعالى: " أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ" (الملك ، آية : 19).
لقد أشارت هاتان الآيتان إلى ناحيتين من نواحي الإعجاز العلمي في القرآن وهي الطير المسخرات والطير الصافات.
أ ـ الطير المسخرات:
ــ فقوله سبحانه: " مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ" وهي تشير إلى الأنظمة التي خلقها الله في جسم الطائر وفي التيارات الهوائية التي تمكن الطائر من الطيران، ولكي يستطيع الطائر أن يطير ويحلق في الهواء عليه أن يحقق عنصرين هامين هما: خفة الوزن والعمل على زيادة قوته واندفاعه، بالاضافة إلى وجود جناحين يدعمانه ويرفعانه في الهواء.
ـ خفة الوزن:
وهي صفة هامة تحققت للطيور عن طريق عدة سمات منها:
ــ بنية الريش: والطائر عليه أن يحتفظ برياشه نظيفة وجاهزة للطيران دائماً لكي يضمن استمراره في الحياة، كما يستخدم الطائر عادة الغدة الزيتية الموجودة في أسفل الذيل في صيانه ريشه وبواسطة هذا الزيت تنظف الطيور ريشها وتلمعه، كما أنه يقيها من البلل عندما تسبح أو تغطس أو تطير في الأجواء الممطرة.
الهيكل العظمي:
خلق الله الطيور بعظام خفيفة جوفاء، ولكنها بالغة القوة والمرونة نظراً لوجود دعامات داخلية عظيمة ويحتوي جسم الطائر على جيوب هوائية متصلة بالرئتين تسهل عليه التنفس وطفو الجسم وخفته، كما تسمح له باستنشاق مزيد من من الأوكسجين.
ــ زيادة قوة الاندفاع:
إن الشكل الإنسيابي لجسم الطائر يسهل عليه اختراق الهواء بأقل مقاومة ممكنة، وتسمح الأجنحة للطائر بالتحليق في الهواء والاندفاع إلى الأمام.
ب ـ الطير الصافات:
في طيران الطيور آيات معجزة لم تكشف إلا بعد تقدم علوم الطيران ونظريات الحركة "الديناميك" الهوائية وأكثر ما يثير العجب هو قدرة الطائر على الطيران في الجو بجناحين ساكنين حتى يغيب عن الأبصار، قال تعالى: " َأوَلَمْ يَرَوْا إلى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ" (الملك ، آية : 19).
وقد كشف العلم أن الطيور الصافة تركب من التيارات الهوائية المساعدة التي تنشأ إما من اصطدام الهواء بعائق ما، أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخن، فإذا كانت الريح هينة ظلت الأعمدة قائمة وصفت الطيور في أشكال حلزونية، أما إذا اشتدت انقلبت الأعمدة أفقياً فتصف الطيور في خطوط مستقيمة بعيدة المدى، ولقد توصل العلم أيضاً إلى أن كل طائر عندما يضرب بجناحيه يعطي رفعة إلى أعلى للطائر الذي يليه مباشرة وعلى ذلك تتخذ الطيور المهاجرة ـ بإلهام الله تعالى ـ الطيران على شكل الرقم (V)، وهذا الشكل يمكن الطير لمسافات إضافية قدرت على الأقل بـ"71%" زيادة على المسافة التي يمكن أن يقطعها فيما لو طار بمفرده، وعندما يخرج أحد الطيور من هذا المسار فإنه يواجه فجأة بسحب الجاذبية وشدة مقاومة الهواء، لذلك فإنه سرعان ما يرجع إلى السرب ليستفيد من القوة والحماية التي تمنحها إياه المجموعة، وعندما يحس قائد السرب بالتعب، لأنه يتحمل العبء الأكبر من المقاومة فإنه ينسحب إلى الخلف ويترك القيادة لقائد آخر، وهكذا تتم القيادة بالتناوب، وأما أفراد الطيور في المؤخرة فإنهم يواصلون الصياح أثناء الطيران لتشجيع الأفراد الذين في المقدمة على المحافظة على سرعة الطيران.
إن وصف طرائق طيران الطيور، بكل من "الصف" و"القبض" وهي من أسس هندسة الطيران اليوم، ولم تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان، وسبق القرآن بالإشارة إليها هو من صور الإعجاز العلمي فيه، فالصف هو جعل جناحي الطائر منبسطين على خط مستوٍ دون تحريكهما. والطائر يمضي في الهواء إلى أبعد المسافات مستفيداً بالتيارات الهوائية في أثناء سيره أو صعوده وبالجاذبية الأرضية أثناء هبوطه البطيء، دون أن يحرك الخفق أو الرفرفة أي: الضرب بالجناحين إلى أسفل ثم إلى أعلى والحركة الأولى تدفع بالطائر إلى الأمام، والثانية تدفع به إلى أعلى.
7 ـ علة تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير:
لقد أثبت علم التغذية الحديث أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها وخاصة لحوم الحيوانات المفترسة لاحتواء لحومها على سمات ومفردات تسري في الدماء وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر في أخلاقياتهم، وهذا لا يقتصر على الحيوانات وحدها، بل يشمل الطيور آكلات اللحوم كالصقور والنسور ذات المخالب الحادة، ولذلك كانت الحكمة العظيمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: "نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير".
المصادر والمراجع:
* القرآن الكريم
* علي محمد محمد الصلابي، المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم براهين ساطعة وأدلة قاطعة، دار المعرفة، صفحة (261:247).
* زغلول النجار، مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي، صفحة 324.
* عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، صفحة 415.
* محمد وهدان، الإعجاز الإعلامي في القرآن الكريم، صفحة 93:89.


.jpg)
.jpg)
.jpg)
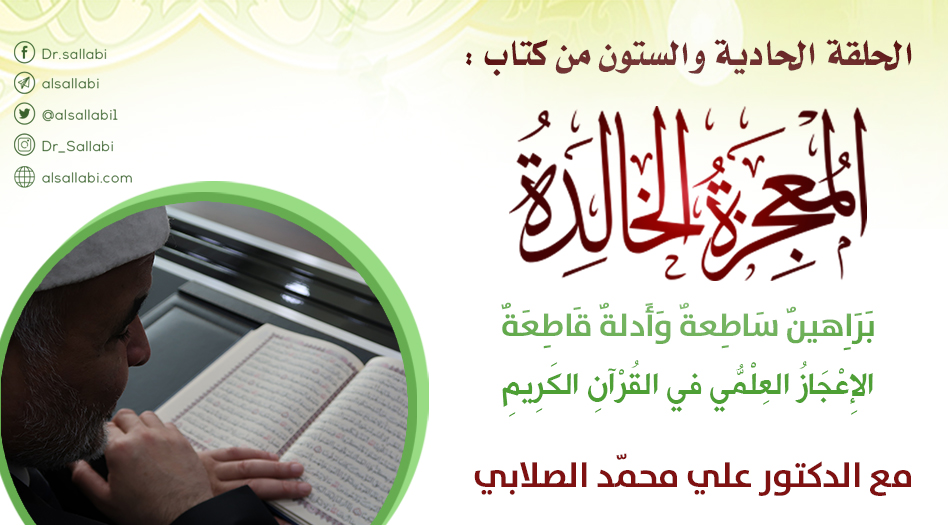
.jpg)