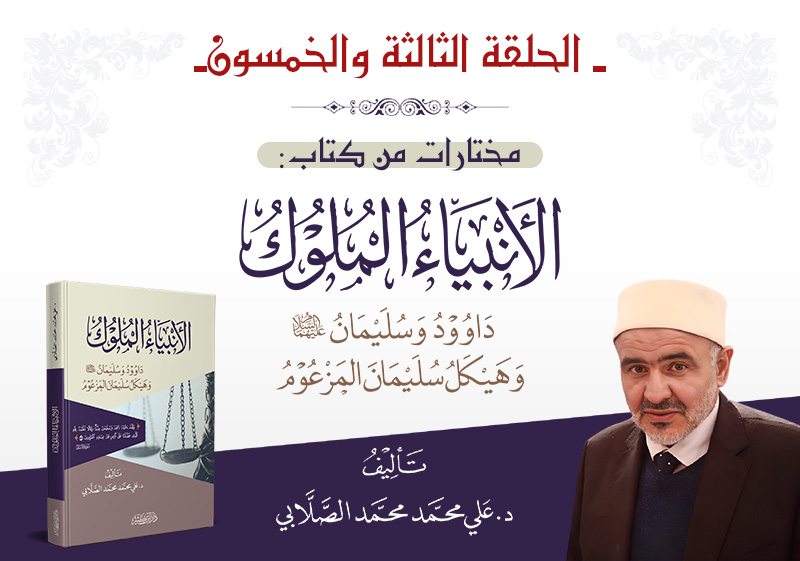سليمان (عليه السلام) والنمل
مختارات من كتاب الأنبياء الملوك (عليهم السلام)
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة (54)
قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾:
سار سليمان بجيشه المنظم المرتب في طريقهم، تتلاءم خطاهم وتتناسب حركاتهم، وفي طريقهم مروا على واد النمل. وهذا يدلنا على أن جيش سليمان كان يسير على الأرض. ويبدو أن الجيش دخل الوادي من جهته العلوية، يدلنا على ذلك أنه عُدّى فعل (أتى) بحرف الجر (على) وهو يتعدى بنفسه أو بـــ(إلى).
حتى إذا أتوا على واد كثير النمل، حتى لقد أضافه التعبير إلى النمل فسماه وادي النمل، قالت نملة، لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي، ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم، تتنوع فيها الوظائف وتؤدي كلها بنظام عجيب، يعجز البشر غالباً على اتباع مثله على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال، قالت هذه النملة للنمل، بالوسيلة التي تتفاهم بها أمة النمل، وباللغة المتعارفة بينها: ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ كي لا يحطمنّكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بكم.
هذه النملة جمعت في كلامها في هذه الآية أحد عشر جنساً من الكلام: نادت، وكنَّت، ونبّهت، وسمّت، وأمرت، وقصت، وحذرت، وخصت، وعمت، وأشارت، وعذرت، فالنداء: (يا). والكناية: (أي). والتنبيه: (ها). والتسمية: (النمل). والأمر: (ادخلوا). والقصص: (مساكنكم). والتحذير: (لا يحطمنّكم). والتخصيص: (سليمان). والتعميم: (وجنوده). والإشارة: (وهم). والعذر: (لا يشعرون). فأدّت خمسة حقوق: حق الله، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق جنود سليمان.
وفي هذه الآية دلالات على علم النمل، منها ما يأتي:
- ما ذكره الإمام السيوطي أعلاه، فإنَّ هذه اللفظة التي جمعت بها أحد عشر جنساً من الكلام، ما كانت لتخرج من النملة إلا لأنها كانت صاحبة علم.
- تسمية النملة لسليمان (عليه السلام)، دلالة كذلك على أن الله قد رزقها علماً علمت به أن هذا صاحب ملك وجند، واسمه: سليمان.
- قولها: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: وصف لسليمان (عليه السلام) وجنده بالخير والرحمة، وأنهم لا يظلمون ولا يقتلون إلا خطأً. وهذا الوصف لا يمكن أن يخرج منها إلا لعلمها بأنه نبي رحمة، ولأنها تخشى من إساءة ظن قومها بسليمان (عليه السلام) وجنده، فاعتذرت له وبيّنت براءته وجنده من أي أذى يصيبهم، كونهم لا يشعرون.
ولك أن تتأمل في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38] ؛ إن النمل أمة من الأمم في الأرض، فهو يعلم كما نعلم، وله ممالك أدهشت العلماء والبرامج التوثيقية لحياة النمل ومساكنها يجد فيها المرء ما يذهل العقول، وهو يتابع حركتها في البحث عن عيشها، والتعاون مع قومها، والاتصال الدائم بين أفرادها.
أ- قال الرازي رحمه الله:
وفي هذه الآية تنبيه على أمور: أحدها: أن من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز، وإنما يلزم من في الطريق التحرز وثانيها: أن النملة قالت: وهم لا يشعرون كأنها عرفت أن النبي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو، وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام.
ب- قال المراغي:
وفى هذه الآية تنبيه إلى هذا لإيقاظ العقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن النظم والسياسة، فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمعها لهم ليشير إلى كيفية سياستها، وحكمتها وتدبيرها لأمورها، وأنها تفعل ما يفعل الملوك، وتدبّر وتسوس كما يسوس الحكام. ولم يذكره الكتاب الكريم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء، فيفهموا حال هذه الكائنات، وكيف أن النمل أجمعت أمرها على الفرار خوفا من الهلاك، كما تجتمع على طلب المنافع، وإن أمة لا تصل في تدبيرها إلى مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حمقاء تائهة في أودية الضلال، وهي أدنى حالا من الحشرات والديدان: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: 35].
جـ- قال الشيخ همام حسن سلوم:
إن كلام النملة يدل على حرصها على أمتها من النمل، وإشفاقها عليهم، واهتمامها بهم، وتفكيرهم في تخليصهم من الخطر، وإيصالهم إلى بر الأمان، فإذا كانت نملة صغيرة بهذا الاهتمام بالنمل، وهي حشرة زاحفة صغيرة لا تكاد ترى، فلماذا لا يكون البشر -ذوو العقول والأفهام- حريصين على نصحهم وإبعاد الخطر عنهم.
إن أصحاب المسؤوليات حريٌّ بهم أن يهتمّوا لما أوكل إليهم من مهمّات، وأن يعدّوها أمانة يسألون عنها يوم القيامة، والتقصير فيها يورث غضب الرب وعذاب النار. قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ عبدٍ يسترْعيه اللهُ رعيَّةً، يموتُ يومَ يموتُ، وهوَ غاشٌّ لرعِيَّتِهِ، إلَّا حرّمَ اللهُ عليْهِ الجنَّةَ».
مراجع الحلقة:
- الأنبياء الملوك، علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، 2023، ص 242-246.
- سليمان في القرآن الكريم، همام حسن، ص 139-141.
- في ظلال القرآن، سيد قطب، (5/2636).
- الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، (3/184).
- سلطان العلم في سورة النمل، ص17.
- التفسير الكبير (24/188).
- تفسير المراغي (19/129).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي: